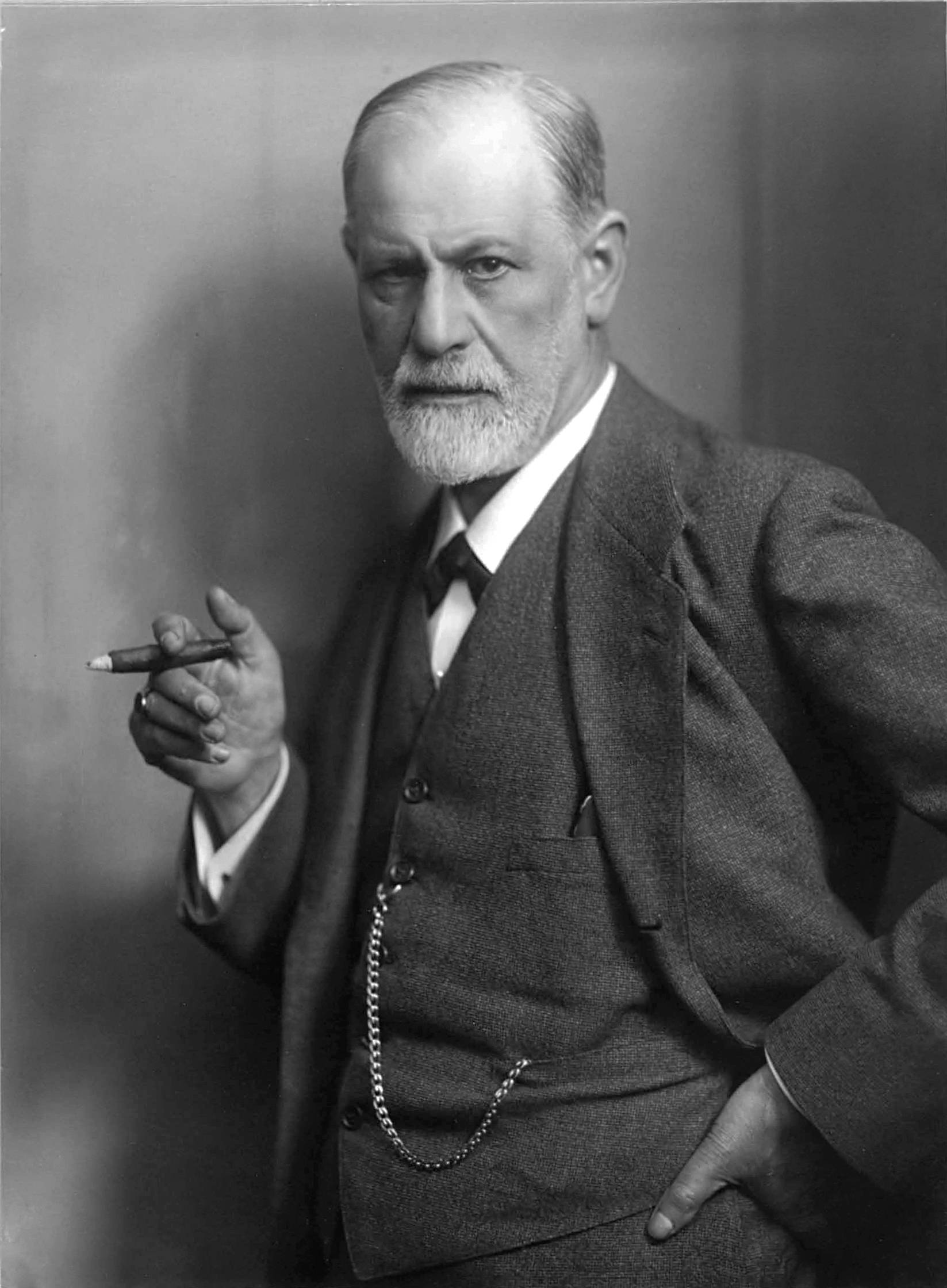صنع الدكتور مصطفى الضبع اسمه بوصفه واحداً من أهم النقاد والأكاديميين المصريين، عبر كثير من الكتب والدراسات النقدية، وأشهرها «استراتيجية المكان» و«فلاح الرواية - رواية الفلاح» و«سردية الأشياء» وغيرها من الكتب المهمة، كما أن له حضوراً كبيراً في المشهد النقدي، عبر ما يقدمه في الندوات والمؤتمرات، حتى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي حوَّلها إلى ما يشبه منتدى مفتوحاً، يقدم فيها دائماً الكثير من الأطروحات النقدية والبحثية، فضلاً عن تقديمه نصائح للباحثين الشبان، وملاحظات على الحالة الأكاديمية المصرية. في كتابه الأخير «كلمات متقاطعة» يبتعد قليلاً عن النقد، ويستعيد المبدع القديم داخله، مستأنفاً شغفه بكتابة القصة القصيرة، بعد أن طغى عليها العمل النقدي والأكاديمي لسنوات طوال.
عن هذه العودة للإبداع، ورؤيته للمشهد النقدي والإبداعي، ومشكلات الجامعات والبحث العلمي كان لنا معه هذا الحوار.

* كتابك الأحدث «كلمات... متقاطعة» مجموعة قصصية وليس كتاباً نقدياً... ما الذي أيقظ المبدع القديم الآن وأعاده رغم مرور الزمن؟
- المبدع لم ينم، ولم يغيِّر قناعاته بأن نصاً واحداً إبداعياً تجاوز قيمته ومساحة بقائه عشرات الكتب النقدية. ما حدث أن العمل الأكاديمي أولاً، والمشروعات النقدية، كانت تفرض نفسها بقوة الواقع. مثلاً، مشروعات الببليوغرافيات محاولة لسد النقص في قواعد البيانات المفتقر إليها في العمل الأكاديمي العربي، لذا كان لا بد من تأسيس المشروع، وهو ما يتطلب جهداً مضاعَفاً.
دخلتُ الحياة الثقافية مبدعاً (أول مجموعة قصصية 1992). ومع بداية الرحلة الأكاديمية، كان لا بد من التخطيط لمشروع الناقد الذي وجدتني مطالَباً بالقيام به، فلست أقرُّ بأستاذ الجامعة الذي يتقوقع داخل قاعة الدرس. لذا، كان عليَّ العناية بالناقد زمناً على حساب المبدع، مع الأخذ في الاعتبار أن الناقد المبدع له فتوحاته الواضحة، في مقابل الناقد غير الممتلك ذائقة المبدع أولاً، ومنهجية الناقد ثانياً.

* لك كتاب شهير بعنوان «استراتيجية المكان»... كيف ترى تأثير المكان عليك أنت شخصياً في تنقلاتك وتحولات شخصيتك النقدية؟
- الأمكنة تصنعنا ولا نصنعها، نحن صنيعة أماكننا بمجالاتها الحيوية (البشر، والثقافة، والطبيعة)، فلكلِّ مكان مجاله الحيوي المؤثر. عبر حياتي تحركت في ثلاث دوائر مكانية كبرى: نشأت في بقعة هي الأجمل في حياتي بطبيعتها وناسها وثقافتها، ثم انتقلت إلى القاهرة بكل نتاجها الفكري والمعرفي والثقافي. القاهرة مدينة صانعة الأقلام والمفكرين والمبدعين. ثم الدائرة المكانية الثالثة التي أعايشها الآن في تجربة جديدة وثرية (مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية)، المدينة قدمت لي الكثير من الخبرات والمعارف والتجارب الإنسانية.
وبعد هذا الزمن أظل مشدوداً إلى الدائرة الأولى، وربما لعبتْ الدائرة الثالثة دور المحفز للارتباط بموطن النشأة، حيث الشعور بالغربة حيناً، والابتعاد عن الموطن يجعلك أكثر تحفزاً وأشد حنيناً، كما أنه منحني مساحة من الوقت أستثمرها في الإنجاز.
الدوائر كلها تترجم نفسها عبر الكتابة، ولديَّ اعتقاد راسخ ويقينيّ بأن الأفكار كالبشر؛ تولَد في مكان مقدَّر لها، لذا فإن كل مكان أذهب إليه هو مكان إنتاج، فالفكرة التي وُلدتْ في مكان ما، ما كان لها أن تولد في مكان آخر.

* بدأت حياتك الأكاديمية ناقداً متخصصاً في الرواية... فلماذا اتجهتَ الآن إلى التركيز أكثر على الشعر والقصة القصيرة رغم حالة الإبداع الروائي اللافتة حالياً؟
- أولاً؛ لأني أضيق بالتخصص في حدوده الضيقة، وأؤمن بمقولة العقاد: «المتخصص نصف إنسان». ثانياً؛ لأن علاقتي بالتراث العربي، ومكاشفتي لتجارب الكُتاب الموسوعيين، وضعتني في مساحة الاقتداء أو محاولة الاقتداء بهم. ثالثاً؛ بسبب متابعتي (من خلال المشروع الببليوغرافي) لما وصل إليه الإنتاج النقدي، وهو ما يتبلور في مظهرين أساسيين: أحدهما العبور إلى الأنواع الأدبية الأخرى في محاولة للإنجاز أو لِنَقُلْ رأب الصدع. والآخر أكاديمية النقد العربي، التي أسستها منذ شهور، لتحقيق الهدف ذاته (المراجعة، وطرح المنجز على أُسس علمية لصناعة أجيال من النقاد قادرة على الإنجاز).
* عملتَ على مشروع نقدي كبير عن حضور النيل في الأدب... ما الذي وصل إليه هذا المشروع؟
- المشروع معنيٌّ بجمع تراث النيل وتقديمه مكتوباً عبر الدراسات المتنوعة، ومرئياً عبر «يوتيوب». لديَّ الآن مادة ضخمة: الكتب المؤلَّفة عن النيل، والإبداع الخاص بالنيل، شعراً ونثراً، ولوحات تشكيلية، خصوصاً ما رسمه المستشرقون، والأغنيات، والأفلام السينمائية، وغيرها، قدمت منها نحو 100 حلقة عبر «يوتيوب»، وأستعد لتقديم سلسلة أخرى أكثر تطوراً لتكون أليق بالنيل العظيم.
الهدف من المشروع يتحقق عبر ثلاثة أهداف: الأول حفظ تراث النيل للأجيال. والثاني خدمة النقد عبر تحليل نصوص بصرية وسمعية ومقروءة. والثالث وضع ببليوغرافيا تكون بمثابة قاعدة بيانات يهتدي بها كل بحث يستهدف دراسة النيل أو الكتابة عنه.
* تعمل الآن على عمل بانوراما للأدب في محافظات مصر... ما الذي دفعك إلى هذا المشروع؟
- عدة أسباب؛ أولها غياب المؤسسة، وأعني المؤسسة المشروع وليست المؤسسة «الشو» أو اللقطة أو الأنشطة السطحية. وثانياً غياب دور الجامعة في محافظات مصر، يكفي أن تقف على مساحة اتصال الجامعة وانفتاحها على الساحة الأدبية في إقليمها. هناك حركة أدبية في كل محافظة مصرية وأيضاً هناك جامعة، ولكنهما لا يلتقيان. ثالثاً بسبب غياب المشروع النقدي المنظم للمتابعة النقدية، وهو مسؤولية الصحافة الأدبية في المقام الأول.
* لماذا تهوى دائماً العمل على موسوعات كبرى تحتاج إلى وقت ومجهود يهرب منه كثيرون لأن أثرها ليس سريعاً ولا تجلب شهرةً أو مجداً؟
- لأني لا أبحث عن الشهرة أو المجد؛ الشهرة مؤقتة، والمجد لا يتحقق بعمل واحد، فهو نتاج مشروع ممتد. ثانياً: لا يمكننا تطوير العلم إلا بمراجعة منجزه السابق، وللأسف ليست لدينا مشروعات أكاديمية تنجز قواعد بيانات معرفية لما هو منجَز، لذا يعاني البحث العلمي من التكرار بسبب ذلك، المنطقي أن تكون هناك قواعد بيانات موسوعية يمكن للباحث العربي أن يتابع من خلالها كل ما أنجزه السابقون؛ فالبحث العلمي خاصة والكتابة عامة تبدأ من حيث انتهى الآخرون. ثالثاً: لأن المؤسسات تفتقر إلى الأفكار الفعالة في هذا الاتجاه، لذا لجأتُ إلى العمل المنفرد إيماناً بالحكمة الصينية «أنْ تُشعلَ شمعة خير من أن تلعن الظلام»، وفي ظل غياب المشروعات الأكاديمية الكبرى يكون على الأفراد تحمل العبء لتقديم ما يمكنهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. رابعاً: المشروع الأبقى هو المشروع القادر على تقديم خريطة موسوعية لمجال ما أو تخصص ما.
* بصفتك أكاديمياً، وكثيراً ما تستغل صفحتك على «فيسبوك» وتوجه ملاحظات إلى الباحثين في الجامعات... ما الذي حدث للجامعات والبحث العلمي في مصر، خصوصاً في حقل النقد الأدبي؟
- حوَّلت صفحتي على «فيسبوك» إلى دار نشر، فكل ما أكتبه من سلاسل هي كتب تنشَر مسلسَلة، وفي مقدمتها مجموعاتي القصصية، ففي ظل غياب المشروع النقدي من أجندة المجلات الأدبية والثقافية، وفي ظل انتشار سطحية المقالات النقدية، لم يبقَ سوى الاكتفاء بمساحة أجتهد أن تكون فاعلة ومضيئة. الذي حدث في الجامعات كارثيٌّ. أسبابه نعلمها، ونتائجه نتغاضى عنها (والعكس بالعكس). طالب الأمس الضعيف والسطحي أصبح أستاذ اليوم، ذلك الذي يُخرِّج أجيالاً من الباحثين، ويحكِّم في جوائز. يمكنك النظر إلى أقسام اللغة العربية أولاً، وأقسام اللغات المختلفة ثانياً، وجميعها معنية بدراسة الأدب بلغاته المختلفة، كيف حالها؟ وماذا تقدم من نتاج علمي؟ منطقياً -وهذا أضعف الإيمان- أن كل جامعة يخرج منها ولو ناقد واحد، أستاذ حقيقي ولو كل خمس سنوات، فأين هؤلاء؟ آفتان ضربتا النقد الأدبي في الجامعات: الأولى غياب الذائقة وسطحية المنتج، والأخرى السرقات العلمية.
* بصفتك ناقداً، ما رأيك في ظواهر مثل «البيست سيلر» وكثرة الجوائز الأدبية وما أفرزته إيجاباً وسلباً؟
- ظاهرة «البيست سيلر» لا تصنع أديباً، وهي ظاهرة مزيَّفة، وأعرف كيف يديرها الناشرون. أما كثرة الجوائز، فكان من المفترض أن تكون ظاهرة صحية، ولكنها فقدت كثيراً من منطقيتها لأسباب عدة من أبرزها التحكيم؛ التحكيم هو الحلقة الأضعف في كثير من الجوائز. سأضرب لك مثالاً هو ليس فرداً: عندما تجد باحثاً أول رواية قرأها في حياته هي الرواية التي قرر الاشتغال عليها في رسالته العلمية أو بحثه الأكاديمي، أو أول رواية قرأها في حياته هي الروايات التي يكلَّف بتحكيمها في واحدة من الجوائز... بالله عليك كيف سيكون وضعه مع التحكيم؟ أعني تحكيم الجوائز أو تحكيم رسالة علمية أو الإشراف عليها! تاريخ قراءة الشعر لدينا متحقق مع الجميع بحكم دراستنا للشعر عبر كل مراحل الدراسة، لكن الأمر يختلف تماماً في الرواية. في حالة الشعر ربما لا يكون الباحث مطالباً بتوسيع دائرة معرفته بالشعر العالمي مثلاً، لكن في الرواية إنْ لم تكن دائرة وعيك منفتحة على الرواية في دوائرها الثلاثية: محلياً وعربياً وعالمياً، فلا يمكن أن أعوِّل عليك في التعامل النقدي مع رواية. وهذا واحد من أسباب ضعف نقد الرواية وضعف التعامل معها أكاديمياً.
* كيف ترى المشهد الأدبي والنقدي حالياً سواء مصرياً أو عربياً؟
- المشهد ليس بخير (تعبير مخفف عن تعبير: المشهد كارثي)، ففي ظل غياب النقد والمراجعة تفشَّت عدة ظواهر (كارثية): أولاها ضعف المنتج الأدبي المروَّج له، في معظمه ضعيف المستوى إلى حد كبير. وثانيتها غياب النقد وافتقار كثير من النقاد (سمِّهم هكذا مجازاً) إلى الذائقة والعمق. وثالثتها غياب المشروع النقدي ممتد الأثر، وهو ترجمة لغياب المؤسسة الثقافية القادرة على تقديم مشروع يليق باللحظة التاريخية.