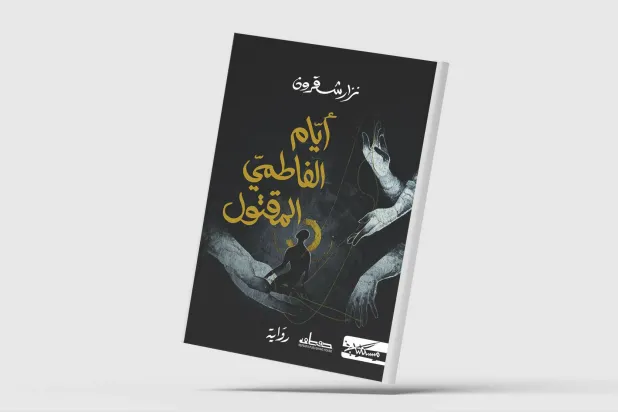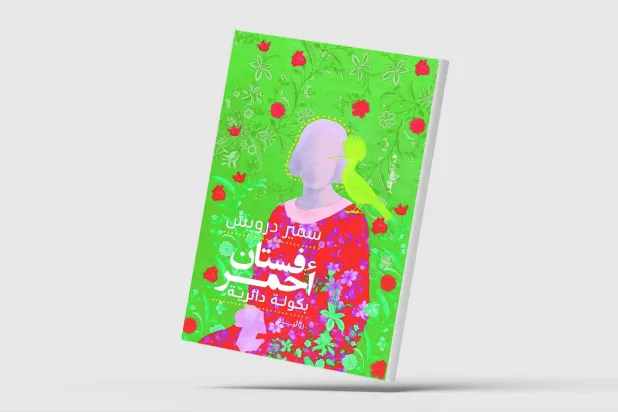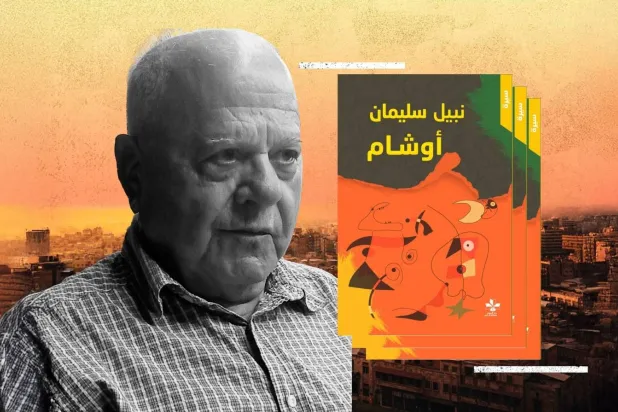يعدّ الروائي والكاتب الصحافي محمد بركة حالة خاصة في المشهد الثقافي المصري، فمع كل رواية يصدرها يثبت وجوده كأحد الأسماء المهمة، وتجد رواياته صدًى طيباً على مستوى التلقي النقدي، فضلاً عن تلقي القراء. في السنوات الخمس الماضية تخلى عن «كسله» وأصبح يصدر أعمالاً بشكل شبه منتظم، وقد مثّلت روايته «حانة الست» مرحلةً مهمةً في مسيرته، ولفتت إليه الأنظار بشدة، وهي الرواية التي ترجمت مؤخراً للإنجليزية، وبالتوازي مع صدور هذه الترجمة أصدر روايته الأحدث «مهنة سرية»، التي أحدثت ردود فعل طيبة وكتب عنها كثيرون.
«الشرق الأوسط»... حاورته حول روايته الجديدة وسيكولوجية الكتابة لديه... وهنا نصّ الحوار:

> روايتك الأحدث «مهنة سرية» يبدو فيها البطل وكأنه يتعرى روحياً كما لو كان في طقس اعتراف بكل ما اقترفه في حياته... هل كنت تقصد بهذه الاعترافات الوصول به لحالة من التطهر؟
- أكتب دائماً ما أفتقده في قراءاتي، فالروايات كثيرة والفن قليل، الشجن نادر ورعشة القلب أكثر ندرة. أحب نبرة الاعتراف في السرد، فهي تضع أبطالي في مواجهة مباشرة مع القارئ، لا مجال للتجمل أو المناورة، كما أنها تضع البطل نفسه في مواجهة مع ماضيه على طريقة «واجه أسوأ مخاوفك».
ليس الهدف بالضرورة الوصول بالبطل إلى مرحلة التطهر، بمعنى إطلاق المشاعر المكبوتة على طريقة تراجيديات المسرح اليوناني، إنما الهدف الأساسي هو امتلاك ناصية السرد المرهف الحميم الذي يشتبك في منطقة شديدة الصدق مع المتلقي من خلال الشخصية الرئيسية التي تروي تفاصيل إنسانية مدهشة، على هامش مهنة تقديم المتعة من جانب شابّ إلى السائحات مقابل المال.

> يبدأ كل فصل بسؤال وإجابة عنه تعيد تعريف بعض المفردات والمفاهيم عبر لغة محملة بحسّ تراثي وتقترب من لغة المتصوفة... هل هذا لكسر حدة الاعترافات والإحالة للدلالات الفكرية والروحية لقصة البطل؟
- كان الهدف الأول هو البحث عن عتبة أو مدخل مختلف لكل فصل، على نحو يجعله أكثر تشويقاً، بشرط أن يكون السؤال والإجابة نابعين من روح هذا الفصل، ويؤكدان على خصوصيته.
الفكرة أيضاً أنني أردت صياغة تقترب من روح الشعر وعبق التراث مع حداثة المعنى، هكذا توالت العتبات عبر أسئلة وإجابات من نوعية «سألتني ما الحرمان؟ قلت: أنين الريح وهى تبحث عن شيء تلاعبه»، «سألتني وما الحب؟ قلت: أشهر شهداء الابتذال اللغوي». ظللت أداعب أصدقائي الشعراء وأقول لهم إنني قدّمت تعريفاً للشعر لم يقدموه هم أنفسهم: «سألتني وما الشعر؟ قلت أقدم محاولات البشر لمخاطبة الآلهة».
> مكان الرواية يتراوح بين عالمين؛ الأول مكان نشأة البطل المفعم بروائح القمامة في إحدى عشوائيات القاهرة، والآخر مدينة شرم الشيخ وفنادقها بروائحها الخلابة... كيف صنعت هذا التناقض؟ وكيف ترى أثره على شخصية البطل؟
- المكان مهم في كتاباتي، هو ليس بطلاً مستقلاً بالمعنى المتعارف عليه، لكنه حاضر بشكل أو بآخر. قد يكون مدينة أوروبية رمادية مقبضة تمتص روح الراوي، وقد يكون مدينة قاسية بلا ملامح تم تشييدها حديثاً على أطراف الصحراء، أو قرية مبللة بالمطر ومغطاة بستارة صفراء من عواصف الخماسين.

في «مهنة سرية» جاء التناقض المكاني بين الحي العشوائي المخصص لتداول تجارة القمامة، وبين شرم الشيخ صارخاً، أشبه بالتناقض بين الكابوس الأسود وبين الحلم الوردي. الأول مكان نشأة البطل الذي امتلك موهبة الشعر، لكنه فضّل السير في حقل ألغام، مكان بدا كأنه شاهد العيان على بؤس الطفولة، فقر الروح قبل فقر البيوت. الثاني يتمثل بمدينة الأحلام والحرية وملتقى جميلات الغرب اللواتي يحضرن في النص ليعزفن على وتر حساس، هو اللقاء بين الشرق والغرب.
> سبق أن تُرجمت روايتك «الفضيحة الإيطالية»، ومؤخراً روايتك «حانة الست»، إلى الإنجليزية... ما رأيك في هوس بعض المبدعين العرب بترجمة أعمالهم تحت أي ذريعة بدعوى الوصول للعالمية؟
- إن لم تكن الترجمة حقيقية وعبر آليات قوية ذات مصداقية، فلن تصنع الفارق وسوف تصبح وهماً ومخدراً. ولهذا السبب تحديداً، كانت سعادتي غامرة أن تصدر «حانة الست» عن دار «Sulfur Editions» الدولية التي تمتلك فريقاً من المترجمين والمحررين الأجانب، ولا سيما الأميركيين. والجميل أن كثيراً من هؤلاء هم بالأساس روائيون وأدباء قبل أن يعملوا بصناعة النشر. وقريباً جداً، سوف تُطرح الرواية ورقياً في 120 دولة حول العالم، كما ستكون متوفرة في أكبر متاجر البيع الإلكتروني العالمية.
الترجمة الناجحة ليس شرطاً أن تحمل توقيع أجنبي «خواجة»، فهناك على الساحة من النخبة الثقافية العربية من يتقن لغة الآخر بكفاءة لا تقل عن الآخر نفسه، وبالتالي حين يتصدى للترجمة يملك ميزة تفضيلية، تتمثل في قدرته على فهم ثقافة ولغة النص الأصلي أفضل من الأجنبي. وهذا ما ينطبق على سبيل المثال على «حانة الست» التي تصدّت لترجمتها د. سلوى جودة، وهى ترجمة أشاد بها فريق محرري الناشر الأجانب.
ويظل الهوس بالعالمية بحاجة إلى مراجعة، فالأدب العربي الحالي تجاوز تلك العالمية وأصبح متفوقاً في كثير من نماذجه على نظيره في كثير من دول العالم، سواء «الطابع الإنساني» لموضوعاته أو أساليب الكتابة وتقنياتها المتطورة. أقول هذا من باب الإنصاف والموضوعية، وليس الانحياز، فأنا أتابع بشكل جيد أبرز ما يصدر روائياً في أوروبا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا. العالمية لم تعد حلماً.

> روايتك السابقة «حانة الست» أثارت كثيراً من الجدل، ويبدو أن «مهنة سرية» في طريقها لإثارة جدل جديد... كيف ترى هذا الجدل؟
- لا أتعمده إطلاقاً، لكن الناس عموماً، والقارئ بشكل خاص، يكرهون الحقيقة. لا يحبون من يهدد قناعاتهم، مهما كانت زائفة، أو من يخالف تصوراتهم الموروثة، مهما كانت وهمية. الجدل كان صاخباً وعنيفاً بسبب «حانة الست» التي تعرضت بسببها لموجة واسعة من الهجوم، بدعوى تشويه أم كلثوم كرمز، ما وصل للمطالبة بسحب الرواية من الأسواق، ورفع دعوى قضائية ضدي. والحقيقة أن كل ما فعلته هو أنني رسمت الوجه الإنساني الآخر المسكوت عنه لكوكب الشرق، معتمداً على ما قالته أم كلثوم نفسها كمرجع موثق. أردت أن تتراجع الأسطورة قليلاً لتتقدم الإنسانية.
الجدل حول «مهنة سرية» جاء مختلفاً، بسبب الطبيعة الصادمة للمهنة نفسها، لكن الجميل أن الجميع أكّد على رهافة وشاعرية التناول الذي عبّر عن التفاصيل الداخلية للمهنة بلغة ذات حساسية جمالية لافتة.
> هل تبدأ أعمالك بالبحث عن فكرة مثيرة كعادة الصحافة ثم تبدأ صياغتها سردياً؟
- الإثارة الصحافية لا محل لها من الإعراب في تجربتي الأدبية، فهي مؤقتة وتبحث عن ضجة بأي ثمن. الإثارة تصيب الأدب بالسطحية، لأنه يعمل وفق آليات معاكسة، فهو يبحث عن الخلود عبر كل ما هو عميق وإنساني. لكن هذا لا يمنع أنني أفضّل، قدر المستطاع، أن يكون موضوع كل رواية جديدة أشتغل عليها مختلفاً وجديداً. أفضّل الذهاب إلى أرض عذراء غير مطروقة لأزرع فيها شجرتي، وأضع فيها بذرة مغامرتي الفنية.
الأهم، بالطبع، من اختيار موضوع جديد أو مدهش، هو كيف ستعبر عنه، كيف ستتناوله. سؤال الأدب وتحديده دائماً هو «كيف» وليس «ماذا». طموحي أن أقدّم موضوعاً مختلفاً مع معالجة مدهشة بنفس الوقت.
> كيف ترى مشروعك الروائي وتناميه وتطوره مؤخراً، خاصة مع تزايد أعمالك في الفترة الأخيرة، مقارنة بالبدايات؟
- منذ 2005 حتى 2019 لم تصدر لي سوى روايتين، هما «الفضيحة الإيطالية» و«أشباح بروكسل»، لكن يبدو أنني تخليت عن «كسلي التاريخي» في الآونة الأخيرة، فصدرت لي 5 أعمال في 6 سنوات. البعض يرى أن في الأعمال الخمسة «غزارة إنتاجية»، لكني أراه معدلاً طبيعياً للغاية لكاتب يأخذ الإبداع على محمل الجدّ ويكتب بشكل يومي، خاصة أن رواياتي قصيرة، وأحياناً قصيرة جداً، ولا تنتمي أبداً إلى عالم المطولات.
ملامح التغيير في مشروعي الأدبي عديدة، أهمها برأيي أن عملية الكتابة نفسها صارت أكثر احترافية وانتظاماً وتأتي في صدارة اهتماماتي، وليس على هامش الحياة، أو تلعب في الوقت الضائع، كما كان يحدث في مرحلة سابقة من حياتي. هذا العام، قررت أن آخذ استراحة محارب، ولن يصدر لي عمل جديد، إلا في معرض القاهرة للكتاب 2027.
> لماذا تبدو أحياناً في تصريحاتك كما لو كنت تشعر بغصّة ما، وكأن مشروعك الروائي لم ينل ما يستحق من تقدير؟
- على العكس تماماً، أنا آخر من قد يشكو «مظلومية» أو يدعي أنه لم يحصل على تقدير كافٍ، مصرياً وعربياً. نال مشروعي الروائي إشادات واسعة واحتفاء لافتاً، أكاديمياً ونقدياً وإعلامياً، وأصبحت رواياتي مادة لأطروحات عديدة في الماجستير والدكتوراه، وهناك اهتمام متزايد بها من المترجمين إلى لغات مختلفة.
شعوري بالأسف المرير، وليس الغصة، يتعلق بجماعات المصالح التي باتت تتحكم بمفاصل الحياة الثقافية وتسيطر على الجوائز الأدبية، وترفع أسماء وتُخفض أخرى، بلا أي سبب موضوعي.
> بدأت حياتك بالحصول على جائزة صحيفة «أخبار الأدب» المصرية في التسعينات... فكيف ترى غياب الجوائز عنك، رغم الانفجار الذي تشهده على الساحة؟
كنت أصغر المتسابقين سناً في جائزة «أخبار الأدب» الأولى للقصة القصيرة، التي أجريت في صيف عام 1994، وحضر نجيب محفوظ الحفل، وخرجت الصحيفة بمانشيت تاريخي يقول «عشرون كاتباً هديتنا إلى مصر». كان من بين الفائزين أسماء صنعت تجربتها بقوة فيما بعد.
لا أعرف لماذا لم أحصل على جوائز فيما بعد، إما لأنني لا أشارك أصلاً أو ربما لأنني لست مقرباً على المستوى الشخصي من لجان التحكيم ودوائرها وحساباتها المعقدة.
ورغم ذلك، انفجار الجوائز أحدث حراكاً وحيوية وحماساً لا يمكن إغفاله. المشكلة فقط أن كثيرين أصبحوا يكتبون وفق «وصفة واحدة» وينتجون نصوصاً مهادنة، أليفة، تشبه مدونات التنمية البشرية، و«استخرج الدروس المستفادة من النصّ أعلاه». وهكذا أصبحنا أمام كم مرعب من روايات نمطية، مكررة، تشبه حساء بارداً بلا مذاق أو حليباً فاسداً.
> أخيراً، كيف أفاد عملك الصحافي لغة الروائي بداخلك واختياره لأفكار رواياته؟- لم يفدني عملي الصحافي على مستوى اللغة الأدبية، فهو يروم لغة مباشرة، واضحة، صريحة، فيما أحبّ أنا لغة السرد التي تفوح برائحة الشعر وتكتحل بالمجاز. الصحافة بشكل عام جارت على يومي ووقتي في فترات سابقة، ولم أضعها في حجمها الطبيعي إلا قبل سنوات قليلة، حين أصبحت الكتابة الإبداعية المنتظمة تتصدر أولوياتي.