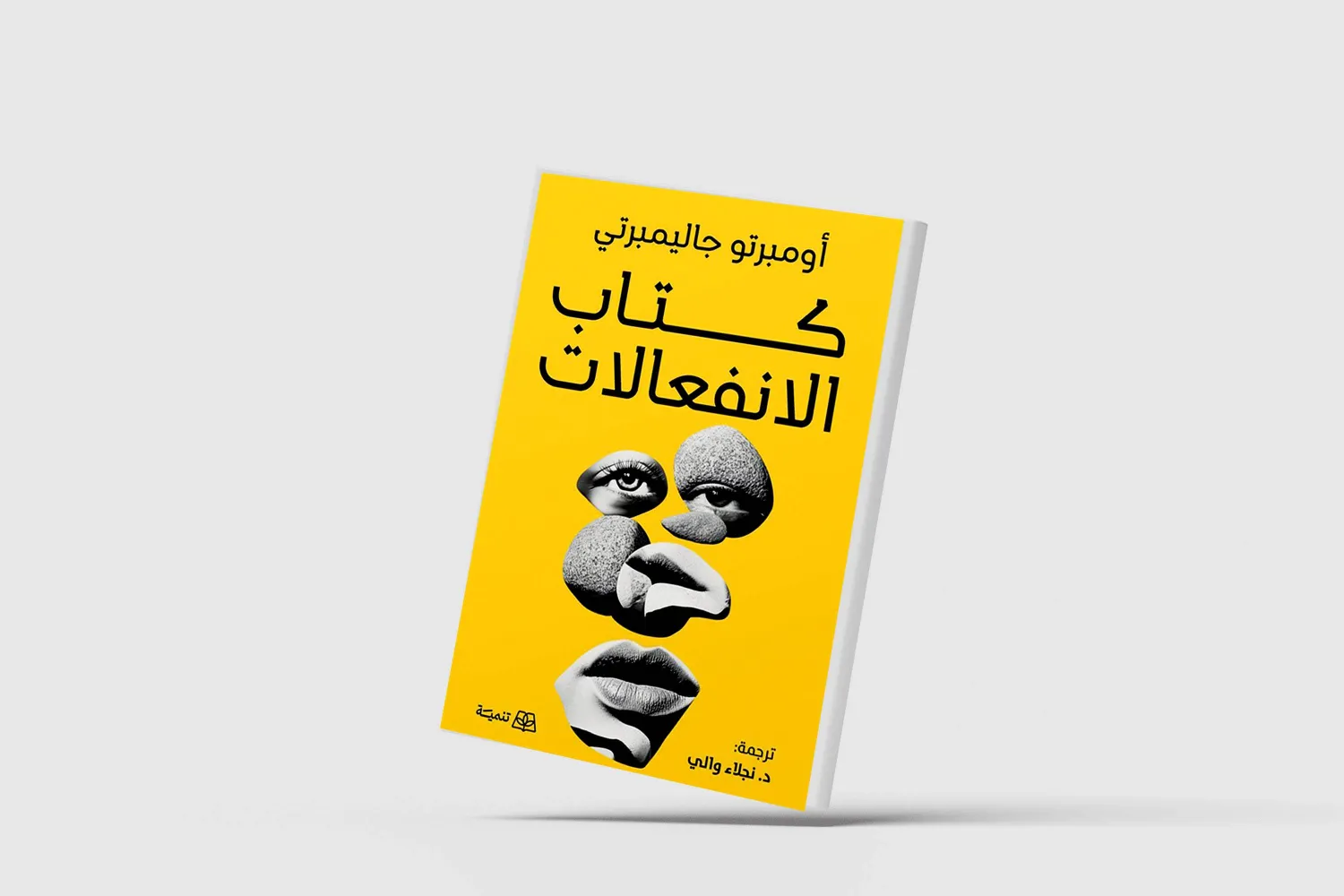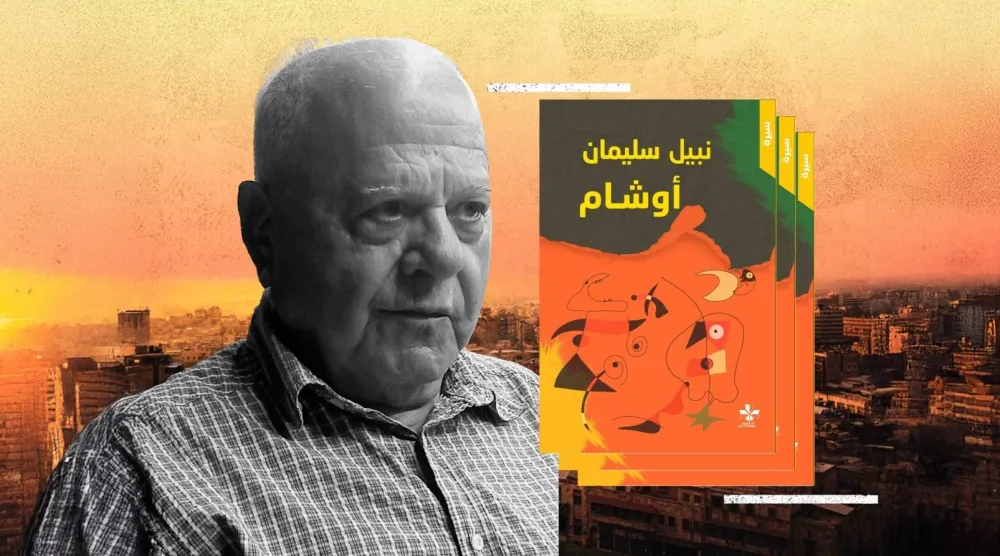يطرح «كتاب الانفعالات» للفيلسوف والأكاديمي الإيطالي أومبرتو جاليمبرتي الانفعالات بوصفها تعديلاً في كياننا النفسي، وفي علاقتنا بالعالم، مؤسِساً طرحه وتأملاته في ظلال التاريخ، والفلسفة، وعلم النفس، والتكنولوجيا.
صدرت الترجمة العربية للكتاب أخيراً عن دار «تنمية» للنشر بالقاهرة بتوقيع المترجمة المصرية الدكتورة نجلاء والي، ويقع الكتاب في خمسة أجزاء يتنقل فيها الكاتب بين مختلف النظريات التي تشرح الآليات الكامنة وراء الانفعالات، وصولاً لتأثير التقنية الرقمية عليها.
ورغم الجهود العلمية المبذولة عبر التاريخ لرصد الانفعالات، فإن جاليمبرتي يعتبر أنها ما زالت عملية معقدة، ويرجع ذلك إلى أنها تقبع في مناطق مجهولة داخلنا، وتضرب بجذور ثابتة في الجزء الأقدم من عقولنا، وتظهر آثارها في الجزء الأكثر نبلاً في وجداننا، وفي مشاعرنا وحياتنا الاجتماعية، وتوقف الكاتب عند طبيعة الانفعالات التي تتفرق بين علوم ومجالات متعددة، ما بين علم الأعصاب وعلم النفس وعلم التربية والاجتماع، والفلسفة، وحتى بوصفها مسألة «ثقافية».
حالة طوارئ
تتجه بنية الكتاب إلى محاورة النماذج الفلسفية المؤسِسة حول الانفعالات، ومجاورتها مع نماذج أكثر معاصرة، فيعود لأصل الأشياء ورصد رحلة تطوّر المشاعر لدى «إنسان الكهف» الذي يقول الكاتب إنه لولا المشاعر التي كانت تقوده لكان الجنس البشري قد انقرض، حيث يمثل شعوره بالخطر أقدم الانفعالات التي حافظت على حياته، فطوّر استجابة «لحظية» لمواجهة الخطر، حيث الوقت يجب أن يكون وجيزاً بين إدراك العامِل المُحفز للانفعال والاستجابة لها، سواء للامساك بالفريسة قبل هروبها، أو أن يهرب هو نفسه من حيوان مفترس.
ولعل هذا المشهد «البدائي» هو ما طوّر تكريس الانفعال بوصفه «رد فعل عاطفياً عميقاً»، يظهر بصورة حادة ولمدة وجيزة نتيجة محفز بيئي مثل خطر، أو محفز عقلي كذكرى، أو حتى من وحي الخيال، فالانفعال في علم اللغة يعني التحرك فيما وراء الشيء أو ما بعده، كما يشير المؤلف.
يضع الكتاب هذا النموذج الأولي في مُقاربة مع التحليل النفسي لدى فرويد الذي يُفرّق بين الخوف الذي يتطلب وجود شيء معين نخشاه، والقلق الذي يمكن تعريفه بعملية انتظار حدوث خطر، أو الاستعداد له، وقد يكون الخطر نفسه مجهولاً، والرعب المرتقب للخطر دون استعداد مسبق له، وهنا تلعب المفاجأة دورها.
ومن ثم، يتتبع جاليمبرتي حالة التفكيك الفلسفي الطويلة لتعقيدات الانفعالات مثل الغضب، والغيرة، والقلق، حتى الضحك والبكاء، ويستخدم تعبير «فقد النظام» باعتبار الانفعالات صورة من إعادة ضبط هذا النظام المُختل، فالفيلسوف الألماني كارل ياسبرز يرى الضحك والبكاء «آفتين من آفات الجسد، الذي لا يجد لهما طريقاً للخروج»، فيفقد نظامه عند نقطة معينة، ويقول الكاتب: «فقد النظام رمز، كما أن هناك رمزية في كل تعبير وإشارة، ولكنها ليست شفافة في الضحك والبكاء؛ لأن كلاً منهما استجابة متأخرة؛ استجابة على الحافة، يقتصر الضحك والبكاء على الإنسان، فهما ظاهرتان بشريتان فحسب».
كسر العدم
يُحاوِر المؤلِف النموذج الأفلاطوني حول المشاعر ما بين ثنائية الجسد والروح، ويسعى لربطها بأفكار داروين، وكارل يونغ، مروراً بجان بول سارتر الذي يتوقف عن تأمله لدلالة الانفعالات، فعلى سبيل المثال إذا كانت التغيرات الفسيولوجية الناشئة عن الغضب لا تختلف من حيث القوة عن تلك الناجمة عن الفرح، بما في ذلك زيادة في نبضات القلب وزيادة في صلابة العضلات، فهذا التشابه في الظاهر لا يعني أن الغضب شعور قوي بالفرح، وذلك ببساطة لأن دلالة الفرح تختلف عن دلالة الغضب، وإذا لم نفهم الدلالة فلن نفهم الفرح والغضب، وإن حددنا ورصدنا الأسباب والعلامات التي تصاحبهما.
ويؤكد أنه لا يمكن إدراك الانفعالات بمعزل عن سياقها الوجودي الأشمل، فإذا كان وجودنا نفسه انفتاحاً على العالم، فالانفعال إذا هو خبرة هشاشة الوجود في اللحظة التي يبدو لنا فيها هذا الوجود أو العالم مختلفاً وغير مألوف، فيترتب على ذلك فقد السيطرة، والشعور بالخطر الوشيك وتهديد خفي بالعدم يجتاحه، وربما يمكن هنا استعارة صوت هيدغر الذي اعتبر القلق هو «استشعار العدم»، وفي تيه القلق نحاول غالباً أن نكسر الصمت المطبق ببعض الكلمات التي ننطق بها بشكل عشوائي، وهو دليل على حضور العدم؛ فالقلق يكسر العدم.
تسليع المشاعر
تبدو الخبرة الانفعالية إذًا أكثر التجارب التي تظهر لنا هشاشة انفتاح الإنسان على العالم، ويشير الكاتب إلى أنه يظل هناك دائماً قدر من عدم الاتساق بين موضوعية الموقف والشحنة العاطفية التي تصاحبها، أو ما يصفه بـ«الشلل» الذي نشعر به دائماً بما لا يتناسب مع المناسبة التي سببته.
ويتوقف الكاتب عند تسخير «الانفعالات» في العصر الحديث بغرض التسليع، حيث تصبح «تسليع المشاعر» سلعة لترويج سلع أخرى، لا على أساس ما تثيره من انفعالات وليس على أسس عقلانية، بما في ذلك استغلال الساسة للعواطف في الخطابات الشعبوية، علاوة على مخاطر «تبدد الواقع» والعزلة التي يخلقها التواصل الاجتماعي الافتراضي، مُفصِلاً في الجزء الأخير من الكتاب تحديات ما يصفه بـ«النمو الانفعالي» للجيل الجديد، الذي يفتقر للتجاوب العاطفي، والذي يسمح لهم بالشعور اللحظي وقبل التفكير العقلاني، فهو يرى أن شبكة الإنترنت تسببت في «تراجع القدرات العقلية، واختزال عالم الانفعالات والمشاعر الذي لا يمكن التحقق عبر قنواتها»، ويتتبع الكاتب مسارات التعبير الإنساني بدايةً من مراحل ما قبل التاريخ حيث التعبير عن المشاعر بالنحت والرسم على الحجارة، وصولاً للتخلي عن تلك الرموز المرئية مع اختراع الكتابة، وصولاً لأجيال الديجيتال، حيث لم تصل إليهم المعارف من خلال «الكتاب» ولكن من خلال «المشاهدة»، ويؤكد الكاتب في النهاية أنه لا يُدين الإنترنت الذي فتح آفاقاً من الفُرص، ولكن في الوقت نفسه لا يعفيه من دوره في إبعادنا عن الانفعالات واستبدالها بأخرى زائفة تشبه الأوهام والهلاوس: «من يهجر الواقع ويذهب إلى عالم افتراضي، والأكثر من ذلك أن هذا يحدث دون دراية من جانبنا ودون عِلمنا».
تبدو الانفعالات كما يصفها المؤلف طريقة لفهم العالم والتعامل معه، ووسيلة للاستمرار في الوجود، ويدعو لإدراكها ليس بوصفه خللاً فسيولوجياً، ولكن بوصفها «سلوكاً منظماً» يسمح للهروب مما لا يمكن أن يتحمله الإنسان؛ الدموع والعواطف الجياشة التي تجتاح شخصاً عندما يذكّره حديث بحب كبير ضائع لا يمكن استرجاعه، وهي مشاعر يصفها أومبرتو جاليمبرتي بأنها ليست «فوضى تعبيرية، ولكنها سلوك مناسب لوجود غير قادر على مواجهة ما حدث، ولا يستطيع التسليم بالفقد».
يُفصّل المؤلف غاية الانفعال هنا بوصه سلوكاً تعويضياً له القدرة على إثارة حضور آخر قادر على تخفيف المعاناة الناتجة عن وحدة لا يمكن درؤها عند التعبير عن هذه العواطف، لتكون تلك الدموع حلاً مفاجئاً ومباغتاً للصراع.
ويتوقف الكتاب عند محطة الانفعال الجمالي، بوصفها تلك الانفعالات التي تقودنا خارج الواقع وخارج عالمنا، كتلك التي تنتابنا ونحن مشدوهون بالموسيقى، والشِعر والفنون، حيث يستدعي القريب البعيد، لنبلغ نقطة أسمى، أو ما وراء الأشياء، يستدعي الكاتب هنا «هوميروس» الذي كان يستدعي وهو أعمى، ربّات الشعر ليحكين له ما حدث في طروادة، فالانفعال بالفنون يقودنا خارج سطوة العقلانية، ما دعا هايدغر لأن يقول إن الفنانين أكثر عرضة للجنون.