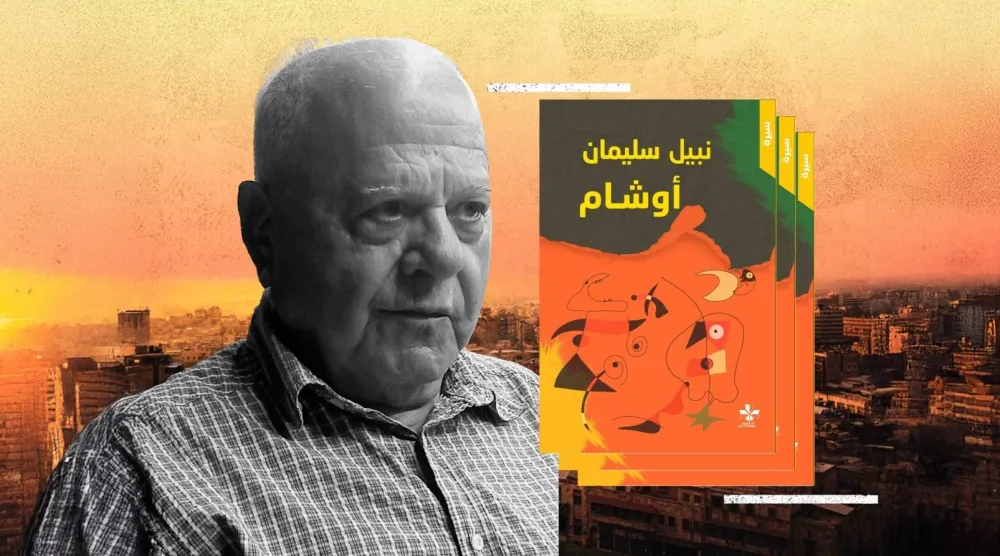خرجت من موقع سمهرم الأثري في سلطنة عُمان مجموعة من المجامر الحجرية المتعدّدة الأشكال، أشهرها مجمرة حجرية يزيّن واجهتها نقش تصويري ناتئ يتميّز برهافة كبيرة في الصناعة الفنية. تُعرض هذه المجمرة في «متحف أرض اللبان» في مدينة صلالة التابعة لولاية ظفار، حيث تتوسّط منحوتتين حجريّتين عُثر عليهما كذلك في سمهرم.
ظهر موقع سمهرم في خور روري الذي يقع على الشريط الساحلي، بين ولاية طاقة وولاية مرباط، وتبيّن أن اسمه يعود إلى مستوطنة من الطراز الحضرمي، تحوي واحداً من أهم موانئ جنوب شرقي شبه الجزيرة العربية التي لعبت دوراً كبيراً في تجارة اللبان الدولية، خلال مرحلة زمنية طويلة تمتد من نهاية القرن الثالث قبل الميلاد، إلى القرن الخامس للميلاد. بدأ استكشاف هذا الموقع في منتصف القرن الماضي، وتولّت بعثة إيطالية تابعة لجامعة بيزا مهمة مواصلة أعمال المسح والتنقيب فيه منذ عام 1997، وأسفرت هذه الحفريات عن الكشف عن مجموعة كبيرة من المجامر، منها مجمرة تميّزت بقيمة نحتية استثنائية، مصدرها معبد صغير الحجم اكتُشف خلال حملة أجرتها هذه البعثة بين عام 2008 وعام 2010.
يبلغ طول هذه المجمرة 33 سنتيمتراً، وهي مكوّنة من قاعدة هرمية مجرّدة من أي زينة، يعلوها مكعب عريض تحوي واجهته نقشاً تصويرياً يتألف من ثلاثة عناصر حيوانية متوازية. يتوسّط سطح هذا المكعب حوض دائري يبلغ عمقه نحو 3 سنتيمترات، ويشكّل هذا الحوض الإناء المخصّص للجمر واللبان وما شابه من أنواع الطيب والبخور. النقش ناتئ، ونتوؤه البارز بقوّة يسكب عليه طابع النحت، وقوام هذا النحت أسد يحضر في وضعيّة المواجهة وسط وعلين في وضعية جانبية. يقف هذا الأسد بثبات منتصباً على قائمتيه الأماميتين المستقيمتين، وتشكّل هاتان القائمتان عمودين تستقر فوقهما كتلة الرأس الدائرية الكبيرة. يطل وجه الأسد من وسط هذه الدائرة، فاتحاً شدقه إلى أقصى حدّ، وكأنه يزأر في جمود تام.
تحيط بهذا الوجه المزمجر لبدة عريضة مكوّنة من خصلات شعر عمودية متوازية، ويعلو هذه اللبدة شقّ عريض يفصل بين خصلتين عريضتين تستقرّان فوق الجبين. العينان بيضاويتان، ويتوسّط كلاً منهما ثقب دائري يمثّل البؤبؤ. الأذنان ضخمتان، وهما دائريتان، وكل منهما محدّد بإطار مقوّس ناتئ. الأنف عريض وأفطس، وتعلوه فتحتان بيضاويتان كبيرتان. الفم فارغ، ويتمثّل بشدق عريض يكشف عن نابين مسنّنين. القدمان محدّدتان، وتتميّزان كذلك بضخامتهما، ويتكوّن كل منهما بثلاث طبقات متوازية من الكتل المرصوصة.
بدأ استكشاف الموقع في منتصف القرن الماضي وتولّت بعثة إيطالية تابعة لجامعة بيزا مهمة مواصلة أعمال المسح والتنقيب فيه منذ عام 1997
يقف هذا الليث بين وعلين متقابلين في شكل معاكس، أي الظهر في مواجهة الظهر. يدير كل من هذين الوعلين رأسه إلى الخلف في حركة واحدة جامعة، وكأنه يحدّق بالأسد الرابض في الوسط. النسب التشريحية متوازنة، والعناصر التشكيلية متآلفة ومتناغمة. يقف كل وعل على أربع قوائم حدّدت مفاصلها بدقّة، ويعلو رأس كل منهما قرنان مقوّسان مزيّنان بسلسلة من الوحدات المستطيلة المرصوفة. ملامح الوجه الواحد مختزلة، وتتكون من ثقب غائر يمثل العين، وشق بسيط يمثّل الفم. تتبنى صورة هذين الوعلين قالباً معروفاً شاع في جنوب جزيرة العرب، وشواهده في هذا الميدان عديدة، منها ما هو منقوش، ومنها ما هو منحوت. في المقابل، تخرج صورة الأسد عن القوالب الفنية المتعدّدة الخاصة بهذا الحيوان، وتهب هذا التأليف طابعاً فريداً خاصاً تتميّز به هذه المجمرة.
تُعرض هذه القطعة الفنية في «متحف أرض اللبان» بمدينة صلالة، بين منحوتتين من الحجر الجيري، تتميّزان كذلك بخصوصية كبيرة في التكوين الفني، ومصدرهما كذلك موقع سمهرم. عن يمين المجمرة، يحضر وجه آدمي شكّل في الأصل جزءاً من تمثال كبير على الأرجح. العينان واسعتان، وهما مفتوحتان ومحدقتان، مع بؤبؤ دائري غائر في الوسط. الأنف قصير، وهو مدمّر، وما بقي منه لا يسمح بتحديد شكله الأصلي. الفم عريض، مع شق طويل في الوسط يفصل بين شفتين مكتنزتين غابت حدودهما في الكتلة الجيرية. وعن يسار المجمرة، يحضر أسد فقدَ قوائمه الأربع للأسف، كما فقد الجزء الأكبر من ملامح وجهه، وما تبقّى منها يتمثّل في أنف بارز، وفم مفتوح، يحدّه شدقان مجوّفان.
تشهد هذه القطع لتقليد فني نحتي ضاعت آثاره على ما يبدو؛ إذ لا نجد ما يشابهها في ميراث سمهرم الفني بروافده المتعدّدة. في المقابل، يعكس هذا التقليد بنوع خاص أثر جنوب الجزيرة العربية الفني الذي طبع جزءاً كبيراً من هذا الميراث الذي كشفت عنه عمليات التنقيب والمسح المستمرة منذ سبعة عقود.