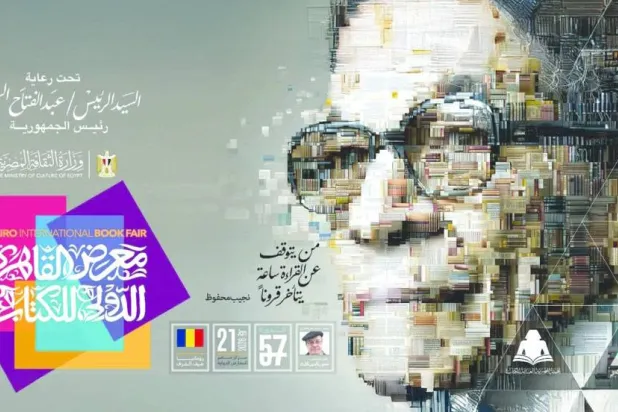لئن عبّر أمين الريحاني، لا سيّما في مطالع شبابه، عن ميول طبيعيّة وتأمّليّة ذات مصدر رومنطيقيّ، فإنّ ما يبقى ويرسخ من أدبه، ومن تكوينه كأديب وكإنسان، شيء مختلف.
فبالمقارنة مع جبران خليل جبران الذي يصغره بسبع سنوات، والذي شاركه تجربة الهجرة المبكرة إلى الولايات المتّحدة، نجدنا حيال افتراق بارز: فمع جبران، هناك موقف ذو خلفيّة روسويّة تمجّد الطبيعة وتذمّ المجتمع وتهجوه، ومع الريحاني، هناك تورّطٌ في الواقع وفي العالم الحيّ وشؤونه، كما لو أنّ الريحاني الناضج قد انفصل عن الريحاني الشابّ. وتورّطٌ كهذا هو ما قاده إلى الصحافة وإلى أدب الرحلات كما أثار فيه فضول الاكتشاف والتعرّف، بحيث جاء كتابه «ملوك العرب» الذي نحتفل بمئويّته، بوصفه الأثر الأهمّ في دلالته على التوجّه المذكور.
وإذا استخدمنا القاموس المهنيّ في الصحافة، قلنا إنّ الريحاني كان كاتب «تحقيق» من طراز رفيع. والتحقيق أشدّ أبواب الصحافة توسيعاً لمواضيع التناول واحتضاناً للأصوات على خلافها، وهذا فضلاً عمّا يتطلّبه من ثقافة ومتابعة واسعتين لدى المحقِّق.
وكما في كلّ عمل تحقيقيّ محترم، احتلّ كلّ فرد يلتقيه الريحاني مكاناً وأهميّة في ما يكتب. ولئن بدا بعض الأفراد عرضة للنقد، كما في حالات وأوضاع بعينها، فإنّ الريحاني الذي كان ينقد لم يكن يشهّر. هكذا استطاعت نصوصه أن تقدّم إسهامات معرفيّة رفيعة، يمكن أن نسمّيها بلغة اليوم سوسيولوجيّة وأنثروبولوجيّة، في المسائل التي تناولتها.
وهذا ما ترافق مع اشتغال على اللغة العربيّة وعلى تحديثها. فهو واحد ممّن أعطوا دفعة قويّة لتلك الوجهة التي بدأت في جبل لبنان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والتي كانت الإرساليّات الأجنبيّة والترجمات التي أنجزتها عنصراً تأسيسيّاً فيه وفي الحضّ عليه.
وبهذه المعاني جميعاً، وخصوصاً من خلال الكتابة الصحافيّة والتحقيقيّة، كسر الريحاني صورة كانت سائدة للأديب وللمثقّف بوصفه «عبقريّاً» غريب الأطوار، غير مفهوم، يقول ما لا يقوله سواه ويهتمّ بما لا يهتمّ به غيره.
فهو في تقريبه الأدب من الصحافة والصحافة من الأدب كان يحدّث الأدب ويضفي على الصحافة عمقاً أكبر. وبهذا جميعاً رأينا انشغالاته تشبه انشغالات بعض الأدباء الصحافيّين الذين عرفهم القرن العشرون، كالأميركيّين جون ريد وإرنست همنغواي ومارثا غيلهورن، والروسيّ اسحق بابل، والبولنديّ ريسّارد كابوشنسكي.
وفي إحاطته الصحافيّة هذه، وكتابُ «ملوك العرب» شاهد قويّ على ذلك، تحدّث عن كلّ ما رأى وعن كلّ ما احتكّ به على نحو أو آخر. فهو كتب عن الخرافات وعن العادات، عن الملل والنحل، عن تاريخ المناطق والفِرق والعائلات والأديان والطوائف لدى كلّ من الحاكم والمحكوم، وإلى القبائل والعشائر والبطون والأفخاذ، كتب عن الأدباء والكتّاب والشعراء، وعن الكلمات وأصولها بالفصيح منها والعاميّ، وعن الطبيعة بأعشابها وحشائشها وصخورها وبواديها، وعن المآكل وطرق طبخها.

وقدّم صورة عن عالمه الذي وصل به إلى تعريفنا بالهندوس والزرادشتيّين والمتصوّفين، وبلهجات المناطق وقراباتها، وبالتاريخ وعلم الآثار، وشؤون التربية والتعليم، والمدن والقرى والدساكر، وبالحروب والمناوشات والمعارك، لا سيّما حين تحدّث عن العراق في العشرينات، وبالسفن والمراكب والصيد البحريّ وجمع اللؤلؤ وتجارته، وبالمهن والأشغال كذلك.
ولئن كان الريحاني يكتب فصولاً من تاريخ تلك الظاهرات والممارسات، فقد بدا حريصاً على التعامل مع التاريخ بغير طرق الماضي الشفويّة، فـ «التاريخ غير السجع. يجب أن يكون للتاريخ عينان وعقل ووجدان، ولا بأس إذا كان له شيء من البداهة والتصوّر. أمّا القلب فلا حاجة له فيه، ولا يجوز».
وإلى «ملوك العرب»، كان لشغفه بالناس والأمكنة معاً أن أنتج «تاريخ نجد الحديث وملحقاته» و«قلب العراق» و«قلب لبنان» وأعمالاً أخرى، وهذا فضلاً عن اهتمامات فكريّة وثقافيّة بالعناوين التي شغلت زمنه، ولا تزال تشغل زمننا، كالثورة الفرنسيّة وروسيا البلشفية وقضيّة فلسطين ومسائل القوميّة وسواها. وكان من علامات وعيه الكونيّ اهتمامه بالصراع البريطانيّ – الفرنسيّ على المنطقة، وبعلاقات الدول ودور مصالحها في تقرير سياساتها.
فهو كائن كوزموبوليتيّ، يعرف العالم ويجيد فهمه والعيش فيه وفي ثقافاته والتجوال على تخومها. فقد استدخل القيم والأفكار الغربيّة في الثقافة العربيّة، وكتب بالانجليزيّة وربّما كان أوّل عربيّ يفعل هذا، وتأثّر بالشاعر والت ويتمان واهتمّ بتحديث التعبير الشعريّ التقليديّ. لكنّنا مثلما نقع في نصّه وفي هوامشه على المسرحيّ إبسن والمؤرّخ غيبون والمستشرق هوغارث، فإنّنا نقع على القزويني وابن الأثير وابن خلدون والشعراء العرب الأقدمين، وطبعاً على أبي العلاء المعرّي الذي ترجم الريحاني بعض أعماله إلى الإنجليزيّة. ولكنّنا أيضاً نتعرّف إلى متابعته للشعراء المعاصرين كمعروف الرصافي وجميل صدقي الزهاوي وسواهما.
صحيح أنّه عبّر عن بعض آراء زمنه التي لم تعد مستساغة في زمننا، لكنّه لم يخطىء في الأساسيّات، فرأى مثلاً في العبوديّة والنخاسة «تجارة معيبة»، واعتبر أنّ «البليّة، كلّ البليّة، هذا الجهل المسلّح، هذا الإجرام باسم القوميّة، هذه اللصوصيّة باسم الاستقلال».
وكمثل تعدّده الثقافيّ كان متعدّد الانتماءات والهويّات، لا يتظاهر بكتمان أيّ منها. فهو مسيحيّ ولبنانيّ وعربيّ ومعنيّ على نحو وثيق بالثقافة الغربيّة وأسئلتها، وقبل كلّ شيء آخر، هو ذو نزوع إنسانويّ يجعله «الرجل النهضويّ» النموذجيّ.
وفي أغلب الظنّ كان لتكوينه هذا، المصحوب بفضول إلى المعرفة وإلى استقصاء الحقائق من طريق طرح الأسئلة وزيارة المناطق، أن جلب عليه تهمة الجاسوس. ذاك أنّ مَن يختلف ويسأل ويستفهم ويتلصّص ويتنقّل لم يكن شخصاً مألوفاً في بداية القرن الماضي في عالم عربيّ كان يومذاك متقوقعاً على نفسه ومكتفياً بذاته.
والعالم العربيّ هذا كان شغلاً شاغلاً للريحاني. فهو كتب أيّام العرب ووقائعهم في عشرينات القرن الماضي، وبدا في «ملوك العرب»، كما في كتب سواه، يحمل لهذا العالم برنامجاً للتحديث والتقدّم لا يبرأ من علمويّات ذاك الزمن ومن ميله إلى التحقيب الصارم وإلى توزيع الشهادات في التقدّم والتأخّر، وكذلك من إصداره أحكام قيمة ومعادلات مغلقة وملزمة. فنحن «في زمان سيّده المال وحاكمه الاقتصاد ومديره الأوّل العلم، وليس عندنا من الثلاثة ما يؤهّلنا اليوم لوظيفة صغيرة في معمل هذا الزمان الأكبر».
والريحاني كان كارهاً للتخلّف، جعله اهتمامه بتقدّم العرب أشدّ إصراراً على نقد التخلّف المذكور. فحين تحدّث عن أقاليم اعتبرها متأخّرة عهدذاك، كتب التالي: كأنّك هناك «تعود فجأة إلى القرن الثالث للهجرة. لا مدارس ولا جرائد ولا أدوية ولا أطبّاء ولا مستشفيات... إنّ الإمام لَكلُّ شيء، هو المعلّم والطبيب والمحامي والكاهن. هو الأب الأكبر».
وهو إذ دافع عن استقلال العرب وحذّر من لعب الإنجليز عليهم وتلاعبهم بهم ضدّ بعضهم، أرفق موقفه بالتوكيد على اكتساب شروط نيل الاستقلال أو الارتفاع إلى سويّته. وهو لم يُخفِ التناقضات العربيّة – العربيّة، ولا قال «كلّنا أخوة»، ولا اتّهم المستشرقين بأنّهم مَن يثير البغضاء في ما بيننا، مدركاً مصاعب الوحدة بين العرب، علماً بحماسته لها، ومحاولاً البحث عن تدرّج فيها يرافقه توسيع المساحات المشتركة.
والحال أنّ فكرة التدرّج كانت عضويّة في فكره، فهو إذ أراد التخلّص من الاستعمار، حثّ الاستعمار، في هذه الغضون، على أشكال أقلّ جلافة في السيطرة وأشدّ اكتراثاً بمصالح السكّان، وحين كان يتناول العلاقة بالدول الغربيّة، وخاصّة بريطانيا المتمدّدة عهد ذاك في الخليج، كان يؤكّد على ضرورة البحث عن مصالح جامعة، من غيرَ أن يكون غافلاً عن المطامع.
وهذا، في عمومه، بدا له ضروريّاً في عشرينات القرن الماضي، بعد الحرب العالميّة الأولى وأهوالها، وبعد «مبادئ وودرو ويلسون» وتأسيس «عصبة الأمم»، وما تبدّى للريحاني ولسواه من المثقّفين عالماً جديداً يولد وينبغي أن يكون للعرب فيه موقع ومكانة.
ورغم كثرة الجوانب والأوجه التي يتناول فيها الحكّام العرب في عشرينات القرن الماضي، فإنّ ما يستوقفني هنا هو ما قد تجوز تسميته بنزع الأسطرة والسحر عن السياسة والسياسيّ. ففي تلك الحقبة، ولم يكن هناك تلفزيون، ولا كانت الصور الفوتوغرافيّة شائعة، رأيناه يتوقّف عند المواصفات التي لم يكن الكثيرون يتناولونها في الحاكم. فهو يصفه بجسمه وملبسه وحركات يديه، محاولاً أن يستقي من وصفه بعض المعاني والدلالات الأوسع. فالسلطان، ثمّ الملك، عبد العزيز «هدم بكلمة من كلماته حواجز الرسميّات فجعل نفسه، تنازلاً، في مقام الصنو والرفيق»، كما أنّ «الرجل فيه أكبر من السلطان». وهو أيضاً «طويل القامة مفتول الساعد، شديد العصب، متناسق الأعضاء، أسمر اللون، أسود الشعر، ذو لحية خفيفة مستديرة... يلبس في الصيف أثواباً من الكتّان بيضاء وفي الشتاء قنابيز من الجوخ تحت عباءة بُنّيّة». وإذ يتناول فيصل الأوّل، ملك العراق، يقول: «كنت أرى في أنامله دليل الاضطراب، إذ كان يُخرج الخاتم من بنصره فيلعب به كأنّه سبحة ثمّ يعيده إليه».
فهو كان مهموماً بتبديد الغموض الذي يحيط بالسياسيّ وبصانع القرار، ويجعلهما مَرئيّين وجزءاً من عالم البشر الأحياء. فالحاكم يُقدَّم، عند الريحاني، بوصفه إنساناً ذا ملامح وذا جسد وعادات وطباع، وهو إلى ذلك ليس كائناً غرائبيّاً عصيّاً على الفهم، عديم الصلة بعناصر ملموسة أكانت علاقاتٍ أهليّة واجتماعيّة، أو تراتُباً سلطويّاً ينمّ عن جماعات المجتمع وعصبيّاتها وقوّتها.
وهذا قبل عقود على موجتين عرفتهما المنطقة في إضفاء المبالغة والهالة على الزعيم: الموجة الأولى التي تمثّلت في زعامات الانقلاب العسكريّ ممّن اعتُبروا أيدي تنفّذ أوامر التاريخ، فأطلّوا على الجماهير من شرفة المجد والغموض. أمّا الموجة الثانية فتلك التي عبّر عنها بقوّة أكبر كثيراً سياسيّون زعموا أنّ لهم مراجعَ في الغيب فاختبأوا وراء غموض وسحر مصنوعين، كما لو أنّهم سرّ أو لغز لا يُفكّ ولا يُفهم.
وبهذه المعاني جميعاً، فإنّ قيمة كتاب «ملوك العرب» الأولى، كما أراها، كامنة في معاصرتها لحياتنا ولبعض أسئلتنا الحارقة، وهذا رغم انقضاء قرن على الكتاب. ولربّما كانت قيمة الريحاني الأولى أنّه لا يزال قادراً على أن يعاصرنا.
- كلمة ألقيت في الندوة التي أقامتها «دارة الملك عبد العزيز» في الرياض تكريماً لأمين الريحاني وللذكرى المئويّة لكتابه «ملوك العرب»