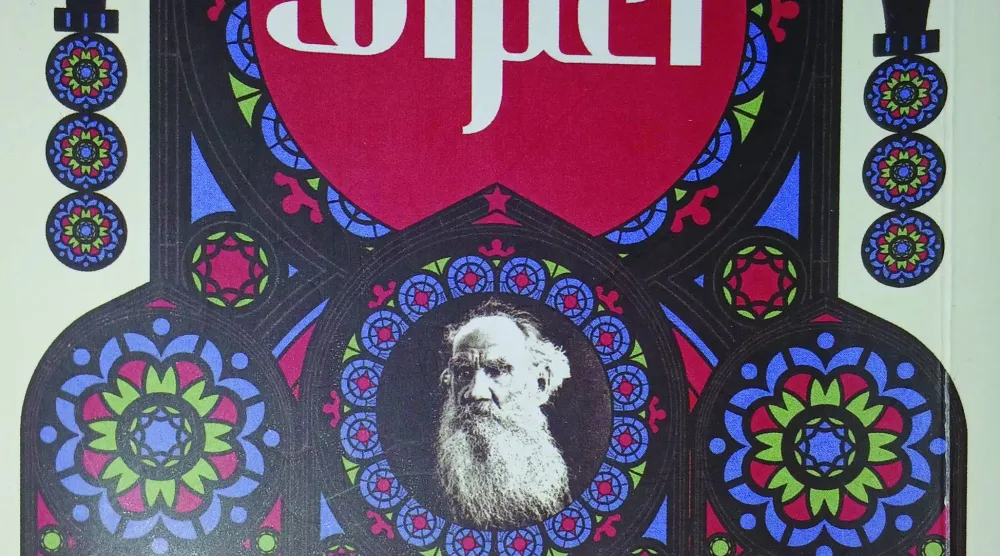باستثناء عبق الذكريات، لديّ القليل مما أفكر فيه الآن كي أصير مثلما تشاء نفسي، وإنني أتساءل أحياناً: بماذا تُفيدُني الذكريات، وأنا أرويها مثل حكاية مهدّئة للنفس؟ إننا نستدعي الأدب لإحياء ما فات من سنيننا، فاللغة ليست أداةً للتواصل فحسب، وإنما هي فضاء حيّ للتذكّر. سأحظى وفق هذا المفهوم بمتعةِ تخيّلِ لوحةٍ فيها رفاقي في أيام الدراسة، وأخشى أن يرسم اليراع أخيلةً بائسةً لا غير، إذا ما قُورنت بالحقيقة.
يقول صاحب المثل القديم: «بغداد أكبر من العالم». نحن في حيّ باب المعظّم، نسبة إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، حيث يُناهزُ ارتفاع الأشجار علوّ صوتِ المؤذّن من الجوامع السبعة القريبة؛ جامع الأزبك والمُراديّة والأحمديّة والحِيدرخانة والسليمانيّة والسراي والعاقولي، وجميعها بُنيت عندما كانت بغداد ولاية عثمانيّة. على شاطئ نهر دجلة القريب قامت الكلّيّة التي حصلتُ فيها على شهادة الطبّ، وأسّسها الإنجليز الذين حكموا العراق عقب الحرب العالميّة الأولى، وكان أوّل عميد لها سندرسن باشا، طبيب العائلة المالكة في العراق، وهذا الكلام لا أقصد به التباهي ولا التأسّي، ولا منزلة بين منزلتين، وربما خلص قارئ المقال إلى فحوى لم تكن في البال، ووظيفة الأدب هي السير به في هذا القصد.
في مبنى الكليّة يُطالعُ الزائرُ أولاً سلّماً حلزونيّاً يرتفع برشاقة إلى هيكل شبه دائريّ، هي المكتبة التي تُشرفُ على حديقة حافلة بالورود. يا لجلالة من يجلس عند طاولة هناك، ويُذاكرُ علوم الطبّ! في ذلك اليوم البعيد مرّ بالمكان شيخٌ، وأشار إلى المبنى قائلاً:
- هذا من صُنعِ يدي.
كان الشيخ يقصد المشفى القريب من الكليّة لغرض العلاج، وزار المكان ربما ليتأكّد أن البناء سوف يظلّ حيّاً بعد موته. بعد أن دخلتُ المكتبة واسترحتُ، ومن النافذة القريبة ظلّت آثار خطوات الشيخ على الدرب ماثلة أمامي. لهذه الذكرى من القوّة أنّها تبدو الآن حقيقيّة، وأشاءُ أن أنتسبُ إلى البنّاء البغدادي هذا، في طريقي في العلم والأدب والمعيشة، والأهمّ من ذلك، سماع صوت الوطن في أيّ مكان أحلّ به. ثم تمضي خطوات الزائر إلى الكليّة في ساحات وأبنية وحدائق تناهز مساحتها ثلاثة كيلومترات مربّعة، وتبدو مثل قطعة حرير موشّاة بجواهر قديمة وجديدة. في تلك السنين كان هناك جوّ من النهوض العامّ في البلاد، فالرئيس الشابّ صدام حسين متحمّس لنقل البلد بخطوات واسعة إلى دولة متقدّمة ومزدهرة، وفي الوقت نفسه كانت الحرب العراقيّة الإيرانيّة تقرع الأبواب بقوّة، وكانت فاتحة لسلسلة من الحروب، وهذا ليس موضوعنا.
إذا أردتَ السؤال عن مستوى جامعة ما، عليك بفحص قاعة الدرس فيها، وكانت عبارة عن صرح فخم يشبه ما في أروقة الأمم المتحّدة، فيه جناحان يفصل بينهما مدرج عالٍ، الأيمن يضمّ طالبات وطلّاب العاصمة، والجانب الأيسر خُصّص للوافدين من المحافظات، والفروق بين شاغلي الجناحين عديدة، رغم أن المستوى المعيشيّ متساوٍ تقريباً، وهي الطبقة المتوسّطة العليا، أو دونها بقليل. يعود التباين بالدرجة الرئيسيّة إلى اختلاف البيئة في القرية عنها في المدينة، والتشدّد الديني لدى بعض العائلات الحضريّة. من هذه الفروق اختلاط الجنسين في الجانب الأيمن من القاعة، بينما انقسم الذكور والإناث في جهة اليسار بحدّ قاطع مثل شفرة السكّين، الطالبات في الصفوف الأماميّة فحسب، كأنهن يشغلن القسم الخاصّ بالحريم في البيوت الشرقيّة، كما أن الحجاب والجبّة الإسلاميّة هما اللباس السائد، وبألوان كامدة بين السواد والرمادي والبُنّي الغامق، كأن عتمة رماديّة حزينة تسود الجوّ في هذا الجانب، في الوقت الذي انشغلت طالبات القسم الأيمن بالأناقة والشياكة اللتين مصدرهما أسواق بغداد ذلك الزمان، وكانت تضاهي بيروت وباريس ولندن، والمشهد هنا يشبه غماماً سديميّاً يتخلله شعاع ذهبيّ، مصدره، بالإضافة إلى الثياب القشيبة، حديث الطالبات والطلّاب باللهجة البغداديّة الغنيّة بالتوافقات النغميّة الساحرة. الفتيات، بقمصانهنّ البيض، كأنهنّ أزهار بيضاء مزهرة، وبمناديلهنّ المعطّرة وابتساماتهنّ الرقيقة الرضيّة، يبدين مثل أيقونات سعيدة تُثبت للعالم بنورها وهدوئها أن الفعل «تبغدد» لا يزال حيّاً، رغم جور الزمان على مدينة بغداد. قُلْ هي حياة من نوع آخر كانت تسود هذا الجانب من الصرح الدراسي، وكنتُ موزّعاً في الحقيقة بين الجانبَين، لأني وُلدتُ في مدينة العمارة، وأسكن العاصمة، لكنّ قلبي كان يميل إلى جهة اليمين، فصار مقعدي الدائم، تقريباً، هناك.
حميَتْ بمرور سنين الدراسة ضراوة الحرب العراقيّة الإيرانيّة، وكانت البلاد تسير بخطى ثابتة باتّجاه صناعة ديكتاتور سوف يُذيق العراقيين جميعاً أنواع العذاب، بما فيهم رفاقه وأصدقاؤه وأهل بيته، وكانت لنا، نحن الدارسين، حصّة منها، على نوعين في جانبي قاعة الدرس، عذابات مضيئة، وأخرى مُرّة. دار الزمان منذ ذلك التاريخ أربعة عقود عشناها بصورة شاقّة وصعبة، أخشى أنني لست في حاجة إلى أن أصفها بأنها صراع يستدعي قوّة وشجاعة هائلتين كي نجتاز أربع حروب كُبرى: حرب الخليج الأولى والثانية والغزو الأمريكي والحرب الأهليّة، وتفرّقنا شتاتاً في الأرض، ثم اجتمعنا ثانية في منصّتين على «الواتساب» من الغريب أنهما تشبهان نصفي القاعة التي تلقّينا فيها العلم في سنين الدراسة. من يستطيع أن يقرأ هذه المعادلة بوضوح، ويؤمن بنتائجها؟ منصّة «واتساب» تضمّ من كان يجلس في جهة اليمين، وأخرى تجمع جماعة الميسرة، وهم القادمون من خارج العاصمة، الغالبيّة منهم ينحدرون من بيئات ريفيّة، أو مدنيّة تسود عوائلها أفكار دينيّة متشدّدة، والملاحظ أنها البيئة ذاتها التي نشأت فيها أحزاب اليسار في السابق، والأحزاب الإسلاميّة فيما بعد، مثل «حزب الدعوة» الذي كان نشطاً في تلك السنين.
كأن تاريخ العراق الحديث يمثّله الصَّرح الدراسي في كليّة الطبّ بطوبوغرافيته التي ذكرتُها، حيث يشتدّ الصراع غالباً بين قوى اليمين واليسار، أو بين السنّة والشيعة، أو العرب والعجم، أو الغربيّة والشرقيّة... إلى آخر التسميات التي فرّقت بلد الرافدين منذ القدم. دائماً وأبداً، وهذا الكلام يقوله علماء الأنثروبولوجيا، يؤدي لقاء الحضارات إلى كارثة، إن لم يكن هناك استعداد ومناعة للحضارتين المتداخلتين في تقبّل الآخر، والدفاع عن الذات في الوقت نفسه. ثمة خرافة مضمرة في دخيلتي تقول إن المشكلة في بلدي لم تكن يوماً دينيّة أو سياسيّة، بل هي إثنية. جانبا قاعة الدرس ينحدران من حضارتين متجاورتَين ومتعاديتَين هما الآشوريّة والبابليّة، دارت بينهما حروب طاحنة في الماضي، وانتصر من انتصر وانهزم الآخر، وهذا كلام طويل تحفظه كتب التاريخ. الملاحظ أن ظلال الأمم تظلّ تتحارب بعد أفولها، وتصير معارك بين أصداء أسماء أبطالها. هو رأي ضعيف للغاية، وإذا كانت نسبة الصحّة فيه واحداً بالمائة، فهي تستحقّ التأمل من قبل الدارسين. قالوا عن بلدي إنه نهران وولاءان، وأقول ربّما إذا عُرفَ السبب سهلَ الحلّ.
في بعض محطّات العمر يكون معنا أشخاص قريبون منّا ويملكون أنفاساً نقيّة، فهم يشبهون زهرة الألْوَة التي تتفتّح مرّة في العمر، ويبقى ضوعها يمتدّ، ثم يغيب وتبقى ذكراه مثل دمعة مالحة تحرق القلب. إننا نتذكّر لنكتشف جوانب من الحياة ما كنّا لننتبه لها، لأنها عيشت في زمانها إلى أقصاها، وحين تستدعيها الذاكرة تحلّ في صورة عالم جديد وغريب من الألوان والأحاسيس، دنيا إضافيّة فيها إيقاع آخر. للشاعر ت. س. إليوت قصيدة تحمل بعضاً من هذا المعنى:
«في الذاكرة صدى لوقع خطى
في الممر الذي لم نخطُ فيه
باتجاه الباب الذي لم نفتحهْ قطّ
إلى جنينة الورد».
ويحدث هذا الأمر مع أصدقائي في تلك الرحلة، أسير معهم في الزمن الحاضر في شوارع غير موجودة، ونفتح أبواباً لم تكن مقفلة ذات يوم، وكذلك الورد يثبتُ شذاه في الذاكرة، ولا يغيب عنها لأنه صار ميسماً. المآثر الأكثر نصاعة في الحياة تفقد بريقها ما لم تُسكَّ في كلمات منغمّة. كتبتُ، في ساعة تأمّل، هذه القصيدة عن سحر تلك الأيام التي رغم كونها لن تعود، لكنّها تعيش معي مثل ظلّ نجمي المستحيل، أي الأسعد، وأعطيتُ قصيدتي عنوان المقال:
«هل هو حنين؟
أم هي حياة تعيش معناً على الدوام
ونستعيدها جميعاً
بقوّة،
قد أمسك بها قلبٌ فتيّ
فكيف تضيع منها ساعةً
أو هنيهة...
نحن مجبولون من تلك المشاعر
ونعيشها الآن من جديد
ودائماً من جديد
وأبداً من جديد...
زهر القطن بدأ يتفتّح،
يا صديقاتي وأصدقائي في كلية الطب/ جامعة بغداد 1985
أسألكم، وأسأل نفسي دائماً،
ولا أملّ من السؤال، أو أتعبْ:
هل هو حنينٌ؟
أم هي حياةٌ تعيشُ معنا على الدوام
في الليل والنهار، في النوم واليقظة
وسوف تمتدُّ ظلالُها
أبعدْ».
كانت البلاد تسيرُ بخطى ثابتةٍ باتّجاه صناعة ديكتاتور سوف يُذيق العراقيين جميعاً أنواع العذاب