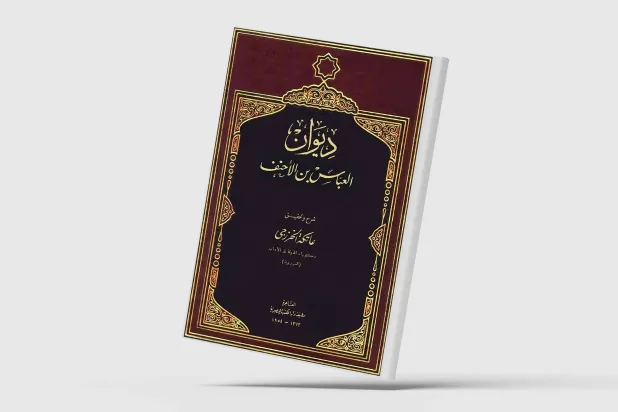في كتابها «حياتي كما عشتها: ذكريات امرأة سعودية من عنيزة إلى كاليفورنيا»، الصادر أخيراً عن دار «الكرمة» للنشر بالقاهرة، تطرح الدكتورة ثريا التركي سؤال الهُوية والثقافة من خلال اقتفائها للجذور التي تتواصل معها ببصيرة مشهدية فائقة، تحكي من خلالها سيرتها الذاتية كأول سعودية تتخصص في مجال الأنثروبولوجيا بعد دراستها لها في أميركا، وتدريسها لها فيما بعد في جامعاتها العريقة مثل هارفارد وكاليفورنيا وجورج تاون وبنسلفانيا، لتصير من أوائل السيدات اللواتي حصلن على شهادة الدكتوراه في بلادها وسط سياق مجتمعي كان يتحفظ على تعليم الفتيات، لا سيما التعليم العالي.
تبدأ ثريا التركي الحكاية من سيرة الطفلة «ثريا» التي كانتها، وتفتحت عيناها على الحياة بوصفها: «الابنة الصغرى لشيخ نجدي وربة منزل حجازية»، ورغم الوجهات الجغرافية المتباعدة التي تتوالى في كتابها المكرس لرحلتها الممتدة بين الثقافات والمدن والمؤسسات التعليمية، فإن مدينة «عنيزة» السعودية تظل البؤرة المركزية بين تلك الوجهات، ففيها ولد الأب «محمد السليمان التركي»، الذي تستهل الكتاب بتحية له، فلولاه ما استطاعت اعتلاء سلم التعليم الذي امتد بها لتصبح أستاذة جامعية في مجال الأنثروبولوجيا. تقول: «إذا كان الكثيرون يعتبرون أنني كنت استثناءً في الانتصار على التقاليد السائدة في مجتمع شبه الجزيرة غير المتحمس لتعليم الفتيات حتى العقد السابع من القرن العشرين، فإنني أعتبر أن الاستثناء الحقيقي هو أبي بسماحه لي بالانخراط في التعليم، سواء في مدارس لبنان أو مصر ثم دخولي الجامعة الأميركية في القاهرة».
تتقاطع السيرة الشخصية للمؤلفة مع محطات مفصلية في الخريطة التاريخية والثقافية على المستويين السعودي والعالمي ليبدو صوتها هو ابن السياق التاريخي والمجتمعي والثائر عليه في آن واحد، فهي ابنة لأسرة تقليدية لأب وأم اختارت أن تُخصص عن سيرتهما الفصل الأول من الكتاب الذي أطلقت عليه «نبتدي منين الحكاية؟» بما يحمله العنوان من نوستالجيا غنائية يمكن سماع أصدائها على مدار الكتاب.
وُلد الأب محمد السليمان التركي في مدينة «عنيزة» التابعة لمنطقة القصيم وسط شبه الجزيرة العربية التي كانت في سنوات القرن العشرين الأولى تتبع ما يُعرف بسلطنة نجد، وتتبع الكاتبة سيرة والدها إلى أن يقرر الهجرة إلى الحجاز (جدة) تحديداً. وهي هوامش تحرص الكاتبة على ذكرها في الربط بين تتبع سيرتها الذاتية وسيرة الوطن السعودي وتحولاته، ليس فقط على المستوى السياسي ولكن على المستوى الاجتماعي، كما تربط الكاتبة بين الانفتاح المبكر على تعليم البنات باعتباره نتاجاً لتعرض بعض الأسر النجدية والحجازية لثقافة حواضر مصر والشام، ما بدأ يسفر عن إرسال أوائل البنات السعوديات للالتحاق بالمدارس في أواسط أربعينات القرن الماضي، في وقت كانت جدة لا تعرف سوى بعض المدارس غير الرسمية «الفقيهة» لتعليم البنات قراءة القرآن وأعمال الخياطة والتطريز.
مشاعر مُركبة
ساهم هذا الانفتاح النسبي على الخارج وما شهده من بداية تعليم الفتيات، في أن تُرسل الأسرة ثريا إلى مدرسة داخلية إنجليزية في لبنان تحت رعاية أسرة لبنانية صديقة لأسرتها، وبرغم التعليم المميز الذي كانت تتلقاه في ذلك الوقت، فإنها لمست في تلك الفترة التعامل مع الصرامة، والغربة التي شعرتها مع استماعها للهجة اللبنانية للمرة الأولى، مروراً بتعرفها على الطقوس الدينية المسيحية بوصفها في مدرسة «تبشيرية»، أما ما لم تستطع نسيانه فهو شعورها المبكر بعدم تقبل المعلمات لها، ما راكم داخلها شعوراً بالاختلاف «كنت في أعينهن بدوية همجية، انطلاقاً من نظرة استعلائية نمطية كنت أشعر بها على الدوام من جانبهن»، وهي مشاعر تنفير تدريجية قادتها ذات يوم للانفجار في وجه معلمة أهانتها وأهانت أمها، ما قاد «ثريا» الطفلة في هذا الوقت لصفع تلك المعلمة التي أهانتها، في مشهد من المشاهد التي لا تُنسى في الكتاب، وهي تقول: «كانت هذه هي بدايات لمقاومتي لما تصورته محاولات لقهري».
بوح ومصارحة مع الذات
بصفة عامة، لا تسعى ثريا التركي في كتابها لرسم صورة مثالية عن نفسها بقدر ما تتلمس الصدق وهي تتذكر لحظات بعيدة من حياتها، أو حتى تعيد محاولة فهم مشاعرها المبكرة، خاصة حيال مشاعر الاستعلاء أو عدم التقبل أو التهميش، بما في ذلك علاقتها بأقرب الناس لها، فهي تعترف أن علاقتها بوالدتها كانت «مُركبة»، فرغم حبها الشديد لها فإنها تقول في لحظة مكاشفة خاصة: «أعترف بعد كل هذا العمر وقلبي يعتصره الألم بأنني كنت أخجل من والدتي، لأنها لم تتحصل على تعليم جيد - وكذلك أبي - ولم تكن تجيد لغات أجنبية، فالكثير من أمهات صديقاتي المصريات يُجدن إما الإنجليزية وإما الفرنسية»، تظل ثريا في حالة مراجعة لهذا الشعور وعدم الارتياح له، فتسأل نفسها مراراً: «لماذا فعلت ذلك؟ لماذا كنت أخجل من أمي؟».
تتمسك الكاتبة بروح البوح والمصارحة في محطات الكتاب المختلفة، كالتي تحدثت فيها مثلاً عن مرحلة دراستها الثانوية في مصر في مدرسة «كلية البنات الإنجليزية» بمدينة الإسكندرية، وانفتاحها على جنسيات مختلفة من مختلف العالم، والكثير من روح الشغب أو «الشقاوة» كما تصفها وهي تروي ملامح منها بحس طريف، وسرعان ما تربط تلك الأيام بالأحداث المركزية التي كانت تعيشها مصر من اضطرابات سياسية تزامنت مع فترة تأميم جمال عبد الناصر قناة السويس وما تبعها من عدوان ثلاثي على مصر.
مفترقات الطرق
تصف ثريا التركي أكبر وأصعب تحدٍ واجهته على الإطلاق وهو إقناع والدها بأن يسمح لها بدخول الجامعة، وما كان يصاحبه من تصورات نمطية ترتبط بالانفلات الأخلاقي، فتروي كيف كانت الحياة الجامعية في هذا الوقت ترتبط في صورتها الذهنية بأعمال إحسان عبد القدوس التي تقول إن تأثيرها كان كبيراً على الصورة الذهنية عن الجامعة لدى الأوساط المحافظة في العالم العربي.
تروي ثريا عن الوساطات العائلية التي ساهمت في إقناع والدها، بالموافقة على التحاقها بالجامعة الأميركية بالقاهرة، التي تصف كيف كانت في فترة الستينات قبلة للطلاب العرب، وسط تطلعاتها للشعور بالاستقلال، وهي معركة تظل تقطعها ثريا التركي حتى بعد تخرجها وصولاً لمعركتها الأكبر لتحضير الدراسات العليا في الولايات المتحدة وسط مشاعر متخبطة بالخوف من هذا المجهول الأميركي، وعدم الرغبة في العودة إلى بلادها، بعد إتمام دراستها الجامعية في مصر: «أي أمان في حياتي سيكون في عودتي إلى السعودية والحياة في كنف زوج يتحكم في شؤوني، وأصبح ظلاً لقراراته؟».
تتقاطع السيرة الشخصية للمؤلفة مع محطات مفصلية في الخريطة التاريخية والثقافية على المستويين السعودي والعالمي
تدرس ثريا في جامعة «بركلي» بقسم الدراسات العربية وتنخرط في دراسة الأنثروبولوجيا في مسار أكاديمي يظل يتسع تدريجياً داخل أروقة الجامعات الأميركية فتتعرف داخلها على التيارات السياسية، «منظمة الطلبة العرب» ونقاشات القضية الفلسطينية في مقابل سياسات الولايات المتحدة تجاه العرب وحركة المد الصهيوني، تتذكر ثريا كيف تزامن كل هذا مع نكسة 5 يونيو (حزيران) 1967 وانكسار مصر وقتها، والصدمة القاسية مع توارد أنباء هزيمة الجيوش العربية.
ورغم التعليم الأجنبي الذي تلقته على مدار حياتها والدراسات العلمية والكتب البحثية التي نشرتها بالإنجليزية، فإن سؤال الشرق والغرب يظل حاضراً في وجدانها، فيشغلها مثلاً موضوع ذوبان الهوية العربية في الثقافات الأخرى، وتذكر أنها طالما ما كانت تسأل طلابها: لماذا نكتب باللغة الإنجليزية إذا كان بمقدورنا الكتابة بالعربية؟، تظل تحمل هذا السؤال، كما تحمل داخلها غصة بسبب أمنيتها التي لم تتحقق بأن تعمل بالتدريس في جامعات المملكة العربية السعودية، وتقول: «عندما يعمل الإنسان وينتج فوق تراب بلده الذي وُلد فيه يتضاعف شعوره بالإنجاز والإسهام في بناء وطن يسكنه قلبه»، وتتحدث عن أن عملها بالتدريس بالجامعة الأميركية بمصر والحياة فيها كان تعويضاً عن سنوات الغربة، حيث عاشت في مصر الجزء الأكبر من حياتها، وتصفها: «مصر مكاني وموطني المختار».
تتكئ الكاتبة على قيمة الصداقة التي تتسلل على مدار محطات الكتاب، وتخصص لها فصلاً خاصاً، يقع في 244 صفحة، ويضم مجموعة متنوعة من الصور تظهر فيها في مراحلها العمرية بصحبة أفراد عائلتها وأصدقائها. وتتوقف عند إحداها في مرحلة التسعينات خلال قضائها عطلة مع عائلتها في «سيردينيا» الإيطالية، تقول إن زوجها عندما نظر لصورتها تلك علّق بأنها صورة «ثريا الأصلية»، فتحاول تفسير ذلك قائلة: «هي صورة لسيدة تشعر بالراحة مع نفسها، والرضا تجاه هُويتها».