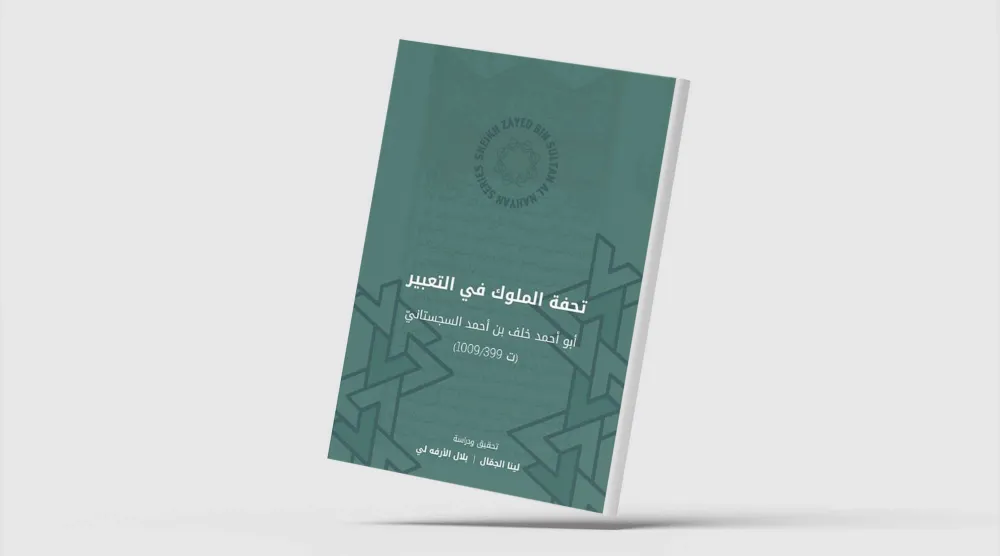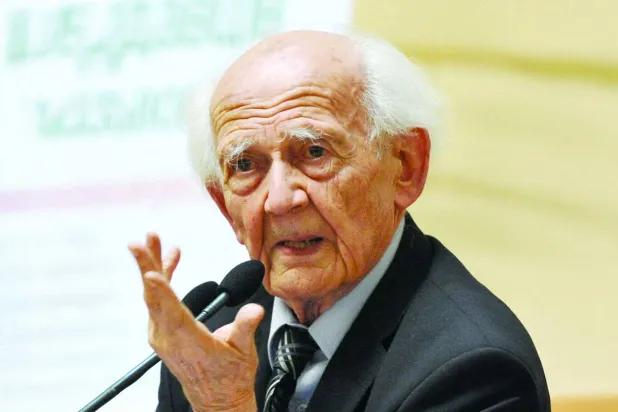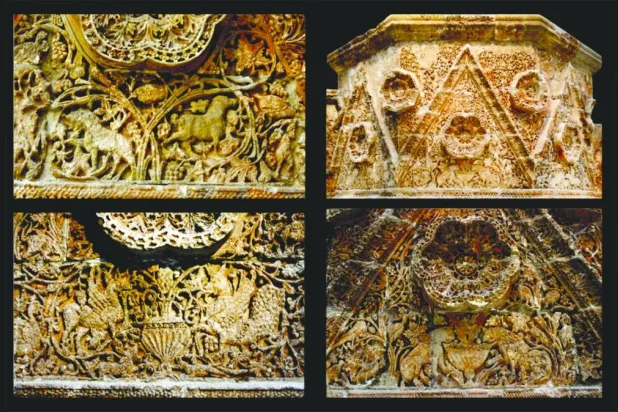يحق البدء في هذه الكتابة، بطرح الأسئلة التالية: هل انتهى زمن الرواية؟ وهل أوفى هذا الجنس المفتوح على التعدد الإحاطة الشاملة بالقضايا كلها؟ وبالتالي، هل الصورة التي كان عليها التلقي الأدبي في مرحلة سابقة لم تعد تحتل ذات المكانة؟
إنني إذ أسوق هذه الأسئلة، أتابع باهتمام عودة كثير من الأدباء والكتَّاب المغاربة إلى جنس القصة القصيرة، وكأني بهم يعودون لبدايات التمرين السردي على الحكي، في محاولة ترسيخ النقلة من القصة القصيرة إلى الرواية. والآن من الرواية إلى القصة القصيرة، وكأن قوس الماضي يعود للانغلاق على الحاضر.
ومن المعروف أن الناقد المصري الراحل جابر عصفور (1944 - 2021)، هجس إلى كوننا نعيش زمن الرواية، حيث أفرد 3 أعداد من المجلة الرصينة «فصول» لهذا الجنس الأدبي، مثلما أقيمت مؤتمرات احتفت بالرواية العربية وخصتها بجائزة، علماً بأن تثبيت مؤتمر للرواية تحقق بالتناوب سنوياً مع جنس الشعر. وعلى امتداد المؤتمرات، دعيت أسماء لمبدعين ونقاد مغاربة وعرب على السواء.

على أن الهجس لم يكن ليتحقق إلا رغبة في تحقيق تراكم في هذا الجنس، إذا ما ألحمنا لكون مصر بالضبط راكمت منذ (1914) تاريخ صدور رواية «زينب»، كماً كبيراً من النصوص المتباينة صيغة ومادة. وإذا كان ذلك لم يتأتَّ لكثير من الدول، وأمثِّل بالخليج تحديداً، فإن كثيراً من المؤشرات أنبأت بأن مستقبل الرواية في كثير من دوله مثلما في المغرب العربي، سيتفرد بحظوة كبيرة ضاعف من وتيرتها خص الرواية بجوائز رفيعة، بعيداً عن التفكير في التقييم النقدي وما إن كانت بعض التجارب الروائية تستحق التكريم أم العكس.
ولم تمثل فورة التراكم هنا وهنالك العامل الرئيسي، وإنما ظهر أن وتيرة التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي عكست نثرية الحياة تستلزم الرهان على جنس الرواية لتشكيل الصورة الأدق، وابتكار القول الأدبي المساير لطبيعة هذه التحولات، حيث استطاع أكثر من روائي التقاط اللحظة في بعديها الزمني والمكاني، وبالتالي، ابتكار وخلق المعنى بالانبناء على خاصية التخييل المباشر، أو الاستعارات التاريخية والتراثية التي تحيل من خلال رمزية الماضي على حاضر ينطبع بكثير من صور التراجع.
وإذا كان الشعر قد لعب دوراً ريادياً في مرحلة سابقة، فإن هذه التحولات، إلى الفقدان المرير لكثير من الأسماء الشعرية، قاد إلى هيمنة جنس الرواية، وأفسح لتداولها وتلقيها الموسع الذي أسهمت فيه إيجاباً الجوائز المكرسة لهذا الجنس، حيث انخرط في كتابته قصاصون وشعراء وسياسيون وصحافيون، على أن العودة للبدايات أو إلى كتابة القصة القصيرة، ما الذي يعنيه مغربياً؟
لقد شكلت مرحلة السبعينات الصورة الحقة للأدب المغربي، حيث صدرت - إذا جاز - التجارب الأولى في كتابة القصة القصيرة، علماً بأن بعض النماذج ظهرت أواسط الستينات مجسدة التأسيس الفعلي للأدب المغربي الحديث؛ فالأستاذ عبد الكريم غلاب (1919 - 2017) أصدر مجموعته «مات قرير العين» في (1965)، والقاص الصحافي عبد الجبار السحيمي (1938 - 2012) «الممكن من المستحيل» (1965)، والأستاذ مبارك ربيع (1935) «سيدنا قدر» (1969). وتعد مجموعة عبد المجيد بن جلون (1919 - 1981) «وادي الدماء» (1947)، و«اللهاث الجريح» (1954) لمحمد الصباغ الأقدم بين هذه التجارب.

على أن ما وسم السبعينات كان تعدد الأسماء التي انخرطت في كتابة القصة القصيرة في بدايات ممارستها الإبداعية، إذا ما أشير إلى أن البعض وازى بين كتابة القصة القصيرة والرواية. ويقتضي المقام أن نشير في هذه المرحلة بالضبط إلى كل من: محمد زفزاف، ومحمد إبراهيم بوعلو، وأحمد المديني، ومحمد برادة، ومحمد عز الدين التازي، ومحمد شكري، وإدريس الخوري، وخناثة بنونة، وأبو يوسف طه، ومحمد صوف، وإدريس الصغير، ومحمد الهرادي، وعبد الرحيم المودن،... وغيرهم ممن يفوتني استحضار أسمائهم في لحظة هذه الكتابة.
وللموضوعية، فإن هذه الأسماء أسهمت بالفعل في كتابة قصة قصيرة حديثة متفردة بناءً وتناولاً للقضايا السياسية والاجتماعية والتاريخية، وخُصت ببحوث جامعية أُنجزت من طرف أسماء وازنة مثل: أحمد اليابوري، ونجيب العوفي، وأحمد المديني، وعبد الرحيم المودن.
على أن ما يستوقفني في هذه الكتابة، مفارقة العودة إلى البدايات، وهي مفارقة تزامن فيها صدور 3 مجاميع قصصية في ظرف زمني يكاد يكون واحداً، ولكتَّاب أبدعوا في جنس الرواية على تباين واضح بين تجاربهم، ولمناسبة تقترن والدورة الجديدة لمعرض الكتاب الدولي (الرباط - 2024). هذه المجاميع هي التالية:
«أحدب الرباط». أحمد المديني، (المركز الثقافي للكتاب - الدار البيضاء - 2024)
«هل أنا ابنك يا أبي؟». محمد برادة، (دار الفنك - الدار البيضاء - 2024)
«الخميس». محمد الأشعري، (دار المتوسط - إيطاليا - 2024)
أصدر أحمد المديني (1947) مجموعته القصصية الأولى «العنف في الدماغ» في (1971) عن دار النشر المغربية بالدار البيضاء. ومحمد برادة (1938) «سلخ الجلد» عن دار الآداب - بيروت في (1979). وأما محمد الأشعري (1951) فبعد مراكمة دواوين شعرية جاءت مجموعته القصصية «يوم صعب» في (1992) عن دار الفنك بالدار البيضاء.
فما الذي تعبر عنه هذه المفارقة؟
1- قد يكون العامل نفسياً أو نفسانياً يتمثل في الحنين لتمرين الإبداع مجدداً في جنس القصة القصيرة، بما أنها هي الجنس الأصعب إبداعاً.
2- العودة إلى التنويع من خلال الموازاة بين الجنسين، إذا ما ألمحنا للتراكم المتحقق في كتابة الرواية بالنسبة للأسماء السابقة، وما حظي به من تلقٍّ نقدي وظفر بجوائز عربية.
3- عامل التقدم في السن، وما يفرضه من ضرورة الميل إلى الكتابات الأدبية المكثفة كالقصة القصيرة، المذكرات أو اليوميات، على العكس من مغامرة الرواية التي تقتضي عمق التفكير صيغة ومادة.
4- إثراء مدونة القصة القصيرة المغربية، إذا ما أشرنا للجوء أغلب المبدعين لكتابة الرواية بحثاً عن جائزة أدبية ما، وهو اللجوء الذي أدى بهؤلاء الأدباء لنشر أعمالهم في كثير من الدور العربية، خصوصاً المصرية والأردنية.
تبقى مفارقة العودة إلى الكتابة في جنس القصة القصيرة، بما أنها هي التجسيد للبداية الأصلية المثيرة فعلاً، وهو ما حاولنا الوقوف على جانب منه.
* ناقد وروائي مغربي