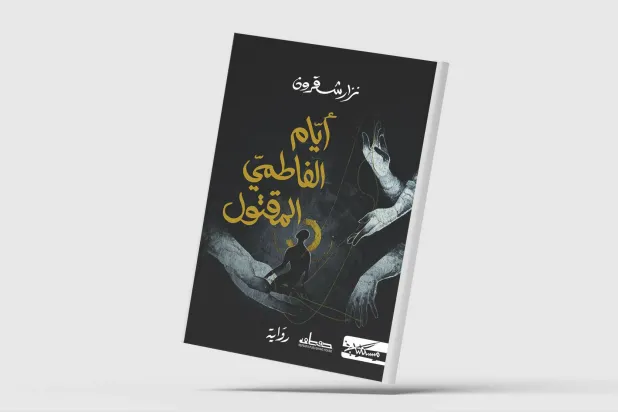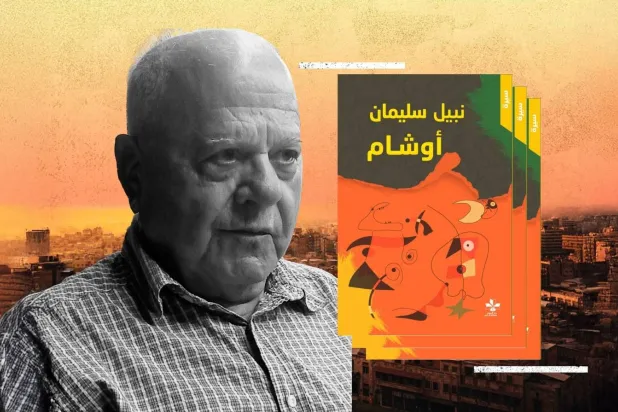قضيتُ الشهر الماضي وبعضاً من أواخر سنة 2023 في رفقة حافلة بالبهجة والإثارة مع كتابيْن: رواية «بطرسبورغ» التي كتبها الروائي والكاتب والشاعر وعالم اللسانيات والفيلسوف والناقد الروسي آندريه بيلي. الرواية مترجمة حديثاً إلى العربية. الكتاب الثاني هو «التفكير القصصي: العلم الجديد للذكاء السردي (Storythinking: The New Science of Narrative Intelligence)» لمؤلفّه أنغوس فليتشر (Angus Fletcher). الكتاب صادر حديثاً عن جامعة كولومبيا الأميركية ولم يُتَرْجَمْ بعدُ إلى العربية.
ذكّرتني البهجة التي استشعرتُها عند قراءة هذين الكتابين بالبهجة السالفة التي كان كثيرون منّا يعيشونها في العقود الماضية وهُمْ يقرأون كتاباً أو رواية. تساءلت: ما الذي حصل لنا... لماذا تضاءلت مناسيبُ بهجة الناس في ما يقرأون ويكتبون (معظمهم وليس كلّهم بالتأكيد)؟ أهي الكثرة التي أفسدت البهجة؟ بلى. سنتذكّرُ (لأغراض المقارنة) حال ذاك المتبطّل الذي لم يعجبه العدس الذي اعتادت أمه إعداده له معظم أيام الأسبوع، ثمّ لمّا اضطرّته الحال للنزول إلى ساحة العمل والعودة إلى المنزل وقد هدّه التعب راح يستطعمُ العدس ويراه أكلاً فاخراً. كنّا من قبلُ نقاتلُ (أكرّر: نقاتل على صعيد الجهد والمال) حتى نحصل على بعض الكتب التي نتمنى قراءتها. واضحٌ أنّ سهولة المنال من كثرة متاحة تُذهِبُ متعة القراءة المتوقّعة بعد كفاح شاق ومال مبذول من أجل اقتناص كتاب نادر. كثرةُ الكتب المتاحة للقراءة - إلكترونياً أو ورقياً – ساهمت في إفساد بعض بهجة القراءة التي كانت متاحة لنا من قبلُ؛ لكنّ هذه الكثرة ليست كلّ الحكاية. الكثرة لن تقتل بهجة القارئ المتمرّس الذي لن يكون فريسة سهلة الاصطياد من جانب كثرة العناوين وإغراءات دور النشر وألاعيب السوق.
الكثرة رحمةٌ وليست نقمة لو شئنا. الكثرة لها امتيازاتها وأفضالها علينا؛ إذْ أتاحت لنا كثرة الخيارات. هنا بدأنا نقتربُ من جوهر المعضلة. مع كثرة الخيارات؛ لا مهرب لنا من أن نختار، والاختيارُ من كثرةٍ عمليةٌ أكثر إجهاداً للعقل والإرادة، من الاختيار من قلّة. أغلبنا يفضّلُ الاختيار من قلّة من الخيارات. هذه حقيقة لا يصحُّ أن نتغافل عنها، وهي ليست مقصورة على خيارات الكتب؛ بل تمتدُّ على نطاق واسع لتشمل مجالات كثيرة في الحياة: الدراسة والعمل والسكن والسفر.

لو تعاملنا مع الأمر بطريقة مُعقلنة؛ فلا بدّ من إعمال الإرادة. لن تمضي حياتنا دوماً والإرادة الذاتية معطّلة. لا بدّ من أن نقتنع بحقيقة أنّ المعروض من الكتب أكثر بكثير من قدرتنا على القراءة، وأنّ تعدّدية خيارات القراءة المتاحة لنا هي امتياز لنا غاب عن كثيرين سبقونا، ويتوجّبُ استثماره بطريقة ذكية. يجب أن نجعل الحقائق الحاكمة التالية حاضرة لا تغيب عن عقولنا:
الحقيقة الأولى: الانتقائية مطلوبة؛ لأنّ الكتب المتاحة للقراءة تزدادُ على نحو أكبر بكثير من قدراتنا على الإحاطة بها أو معرفة حتى عناوينها.
الحقيقة الثانية: ليس من أرقام سحرية لأعداد ما تتوجّبُ علينا قراءته. ليس مِنْ لائحة سلوك تنصّ على فقرة تقول: «عندما تقرأ ألف كتاب فأنت حينها تكون مستحقاً للمباركة والانضمام إلى نادي القرّاء الخالدين».
الحقيقة الثالثة: الكتاب سلعة، ولا يصحُّ اعتباره كينونة متفرّدة بسبب قيمته الفكرية؛ لو وُجِدَتْ له مثل هذه القيمة. عَزْلُ القيمة السلعية عن القيمة الفكرية عملية خرقاء فضلاً عن أنها غير واقعية. دور النشر العالمية تتفنّنُ في عرض الكتاب بوصفه سلعة، بإجراءات معروفة؛ منها: الإخراج الراقي، والعروض المسهبة في الصحف والدوريات ومراجعات الكتب. لا يصحُّ أن نكون أسرى هذه الدور الباحثة عن المال.
الحقيقة الرابعة: عندما لا تكون مضطرّاً إلى قراءة كتاب ما - لسبب دراسي أو مهني – فمعيار المتعة هو المعيار الحاكم والأوحد. القراءة المتكلّفة أو المدفوعة بموضات حداثية أو فكرية شائعة «أقرب للتريندات في مواقع التواصل الاجتماعي» هي إرهاق غير مجدٍ ولا منفعة تُبتغى منه.
الحقيقة الخامسة: للكتاب طغيانٌ وسحرٌ عند بعض الناس «في الأقل». من الأفضل عدم ترك هذا الطغيان الساحر يتغوّلُ إلى حدود منفلتة. تكديس الكتب التي لن نقرأ معظمها قد يستحيل فعلاً هَوَسياً يصعب كبحه إن هو طغى وتجبّر وصار عادة من العادات الاعتيادية المقبولة.
الحقيقة السادسة: كتابُ واحد قد يُغني عن قراءة عشرة كتب أو مائة أو حتى ألف!!. كثرة المعروض من الكتب قد تكون خادعة. زادت العناوين ربما في المبحث الواحد؛ لكنها قد تجعل القارئ يغوصُ في حومة رغوة لغوية متقنّعة بقناع الرصانة والانضباط والصرامة؛ وهنا ستكون الفاعلية الجوهرية لنا هي أن نعرف الكتاب الذي سيغنينا عن قراءة كتب كثيرة أخرى في الميدان ذاته. تنمو هذه الخاصية النوعية فينا مع الخبرة الشخصية والاستشارة الدقيقة من بعض المختصين المعروفين بالاجتهاد والمثابرة، وكذلك بالرجوع إلى القراءات الرصينة في بعض مواقع مراجعات الكتب المشهود لها بالنزاهة المتفرّدة.
ما الذي حصل لنا... لماذا تضاءلت مناسيبُ بهجة الناس في ما يقرأون ويكتبون؟
ترافقت كثرة أعداد الكتب المنشورة، وما يستتبع هذا من كثرة الخيارات المتاحة لنا، مع ظاهرة أخرى مؤذية: ظاهرة «العدّاد (Counter)». لستُ واثقة بأنّ مفردة «العدّاد» هي الترجمة المناسبة. هناك من يترجمها إلى «المعداد». لا بأس. لتكن «العدّاد» فحسب.
تسبّبت كثرة الكتب في نشوء ظاهرة «القارئ العدّاد»؛ القارئ الذي يقرأ كأنّه عدّاءٌ في مضمار سباق. لو كان المضمار لسباق ماراثون ربما كنّا ارتضينا الحال؛ لكنّ «القارئ العدّاد» لا يقبلُ سوى بمضمار السباقات القصيرة. يقرأ وفي باله عناوين أخرى تنتظر القراءة؛ فيخسرُ لذّة اللحظة الحاضرة ولذّة التوقّع المستقبلي المخبوء في كتاب مقبل. ثمّة مَثَلٌ اعتاد آينشتاين قوله لزوّاره: «تمتّعْ بلذّة اللحظة الحاضرة ولا تُفسِدْها بترقيع الثقوب العتيقة»!!
«القارئ العدّاد» تهمّه الأعداد... كم قرأ؟ يبدو كانّه يطاردُ غزالاً في برية. تفاقمت ظاهرة «القارئ العدّاد» مع تنامي وسائل التواصل الاجتماعي عندما راح يوظّفُ هذه المنصّات لعرض قائمة مطوّلة كلّ شهر أو كل سنة بالكتب التي قرأها، وبين هذه القراءات كتبٌ متطلّبة تستلزمُ وقتاً وجهداً كبيريْن يعرفُ القارئ المدقّق حجم كلّ منهما. ماذا يريدُ «القارئ العدّاد»؟ أيريدُ استعراض قائمة مقروءاته التي لا تلبث تتضخّمُ كلّ شهر أو كل سنة؟ لا أراه سوى خادع لنفسه قبل أن يكون خادعاً للآخرين. ما شأن الآخرين سواء أقرأ مائة أم مائتين أم ألفاً من الكتب كلّ سنة؟
مثلما يوجد «قارئ عدّاد» يوجد أيضاً نظيرٌ له في الكتابة. إنّه «الكاتب العدّاد»... يكتبُ كتابه العاشر وهو يسرعُ الخطى لاهثاً نحو كتابه المائة. هل يعيشُ لذّة الكتابة؟ لا أظنّه يفعل ذلك. هو يكتب وفي ذهنه أن يكون منافساً لواحد من المعروفين بكثرة منشوراتهم. ينشغلُ بإلهاءات جانبية أكثر بكثير ممّا يفعل مع ما يكتب. ربما يكتبُ وفي ذهنه جائزة دسمة.
نقرأ كثيراً عن كتبٍ تتناولُ مسرّات القراءة. أتمنّى أن نختبر هذه المسرّات بطريقة شخصية. المسرّة حالة نوعية يستعصي توصيفها في صياغات عددية. الأفضل أن نقرأ ونكتب ونتمتّع من غير هاجس «عدّاد القراءة والكتابة».
كتب الشاعر العراقي الراحل عبد الوهاب البياتي في واحد من دواوينه الشعرية:
وزنتُكَ يا وزّان الشِّعر
فكنتَ خفيفاً في الميزان
أظنُّ أنّ «القارئ العدّاد» و«الكاتب العدّاد» لا يختلفان كثيراً عن «وزّان الشعر». إنّهما يقايضان لذّة الممكن المتاحة في الحاضر، بلذّة مستقبلية مؤجّلة قد تأتي؛ لكنّ الأغلب أنها لن تأتي.