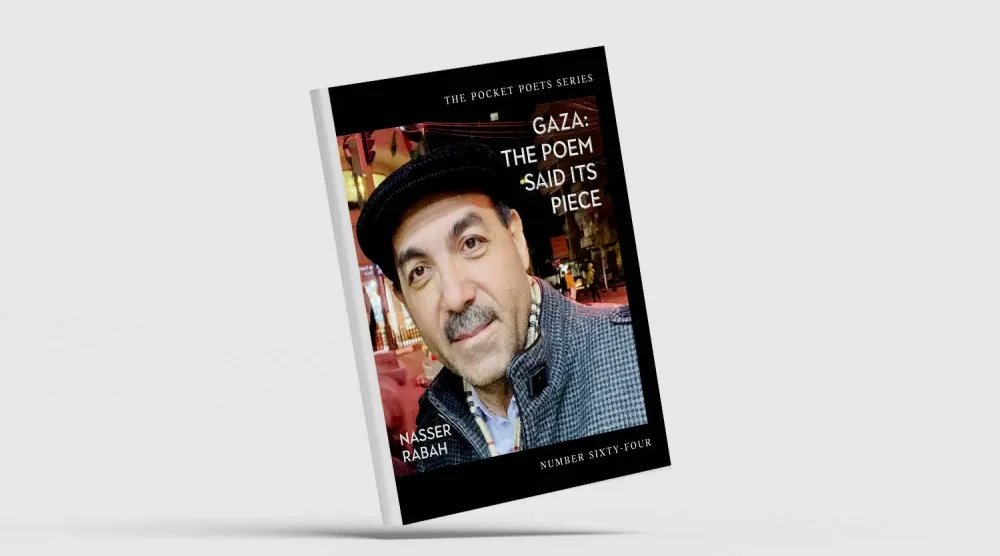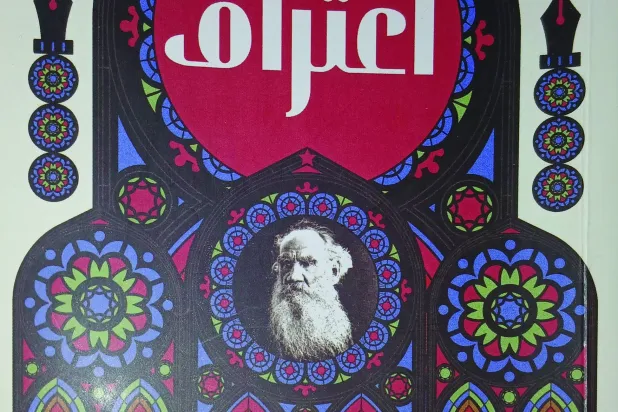تشكل صدف اللقاء بين التفكير في وقائع منتهية، وبين أحداث مطابقة لها في السياق الراهن، من منظور إعادة الصوغ الفني، عامل نكوص وتحول في الآن ذاته، أولاً بالنظر لما يمثله الحدث المستجد من امتحان لعمق الفكرة ودلالتها، وتوليدها أبعاداً مفارقة لحقيقتها، وثانياً باعتبار أن الزمن يمتحن صدق الرؤى ونفاذها، ومن ثم يختبر الجدوى من نقل مكابدات الحياة إلى التخاييل والصور والأساليب، بقصد تأبيدها، وأخذها من حيز العابر إلى المقيم.
في هذا السياق يندرج اشتغال الفنانة التشكيلية زينب بشرى على «تراث الكارثة» (غاليري كانت بطنجة) وهي المنتمية إلى الجيل الأحدث من الفنانين المغاربة، ممن زاوجوا بين مهارات فن القواعد (في اللوحة أساساً)، والولع بالعمق المفهومي للموضوعات؛ بما تقتضيه المزاوجة من عمل بحثي، تتقاطع امتداداته عبر معارف شتى. من هذا المنطلق يبدو عملها (مع الكثير من فناني جيلها) منحازاً في ظاهره للتاريخ وللذاكرة، وللسرديات المتصلة بها، الموزعة بين أنوية مجتمعية صغرى. بقدر ما يتجلى مُنْجَدِلاً بهواجس الذات الفردية المتشظية، في مواجهتها للتحولات المتسارعة للعالم، وللهويات والجغرافيات والقيم. جيل عاصر في وقت وجيز ما كان يتخلل قروناً من الزمن، عبر محطات متباعدة، من حروب وأوبئة، وزلازل وتغيرات مناخية، منذرة بنهايات مرحلة من تاريخ الكون.

ينهض عمل زينب بشرى على قاعدة الاستعادة التخييلية لحدث مُدمّر، وفاجعة إنسانية، تعود إلى ما قبل خمسة عقود، هو زلزال مدينة أغادير المغربية، في ستينيات القرن الماضي. وينطلق الاستحضار البصري، من سردية عائلية، مدعومة بألبوم صور قديمة توثق اللحظة، ومستندة إلى أرشيف عمومي عن الكارثة، نفذت الفنانة إلى مضامينه عبر رحلة بحث ممتد في الزمن عن بقايا أثرها في الذاكرة الجماعية للمحيط المديني. يُوفَّق البحث الوثائقي في لملمة ملامح الخراب المتصل بمسار خاص، لكن الرحلة في حد ذاتها تجعل انتشار البقايا عبر فراغات الماضي، والسعي إلى تصفيتها من اختراقات المتخيل، تصل إلى تقديم محكية بصرية، بديلة، تؤرخ للحدث، ولا تؤرخ له، أي إنها في النهاية لن تكون إلا ذاتها، تحكي عن علاقة عين وذهن، ووجدان بشيء غائب لا وجود له إلا من حيث هو حقيقة رخوة شديدة العطب.
تنمو مفردات أعمال زينب بشرى، عبر متوالية متباينة الصيغ، في رصدها لهيئة الركام المتآكل، والمختزل إلى أشكال متمردة على الطرز الهندسية المكتملة. يخترقها، في كل مرة، تَعْقِيفٌ وتَقْعِيرٌ لحواف الدوائر والمكعبات والمستطيلات، كيما توحي باقتلاعها من جذر أصلي، لأبنية وعمائر، لم يعد لها أثر، وبقائها في وضع الشاهد على التفكك والزوال... لا تتخايل الكتل الملونة، بصباغة الأكريليك على الورق أو القماش، بدرجات الأحمر والقرمزي والأصفر والأخضر والبُنّي، في وضع متشابه، إذ تراوح بين التضَامّ والتنَائِي، أفقياً ودائرياً، مع تدرُّجٍ في جعل التداخل يكتنز بالسواد؛ كأنما البؤرة المتبقية تتخطى الشظايا الفاقدة لحَدِّيَتِهَا، لتكتسي بالسواد الجهنمي، المختصر لسردية الزلزال في ترحُّلها عبر الذاكرات والأخيلة.
وتتخلل أغلب اللوحات كتلة متكررة للبنة من آجُرّ، سليمة أحياناً، إنما مكسوّة الظاهر أو مبتورة الأطراف أحياناً أخرى؛ وحدها تلك القطعة، تَهدي الناظر إلى خريطة الأصل، حيث يتبدى تدريجياً أن الأمر يتعلق بلملمة ما يفضل على شاشة الذهن، من متناثرات بناء مهدم، يختلط فيه الثوب بالمعدن بقطع الخرسانة الرمادية، بالحجر، بمتلاشيات أغراض شخصية من ملابس ولعب أطفال وأوانٍ منزلية وأدوات مدرسية. تعيد رسمها ذاكرة اليد على مساحة الأبيض أو الرمادي، مصطنعةً لها هالات تحتضن اللون المخضب بالجروح السوداء.
والظاهر أن التكوين البصري للأشياء على الحامل، يعارك رهبة تسطيح الهشاشة، في الخطوط والسمات، لإنفاذ كناية عن تساوي جوهر العمائر خارج أحوالها العادية، حين تخرج منها الحركة والأنفاس، فتتحول إلى مجرد سقط متاع. وعندما تلتمع الكتل اللونية مستكينة إلى فراغها، ولاجداوها، وإلى إشراقتها المجتثة من امتدادها، فلبيان مفارقة الواقعة المرعبة لأثرها المحايد، واكتفائها بهيكلها الصلب والوظيفي، وبنائها لماهية مغتربة عن أصولها. لذا تَبرزُ مفردات الركام الملوّن، بما هي تمثيل لالتباس المأوى، في نهوضه وانهياره، وما يتخلل الحالين معاً من تشوهات.

وتصل ذروة الاستعادة البصرية لواقعة الزلزال في أعمال تتلاشى فيها تدريجياً تقاسيم الكتل، في إيقاع تصاعديّ، تتغلغل داخله قطع الهشيم في الحلكة، وتلوّح بما هي مجرد سديم مظلم، تتخلله تدرجات زرقة مموهة، أو فيما يشبه قطع بيضاوية قُدَّت من فحم، يجلل سوادَها لمعانٌ معدنيٌّ. هل هي الانكفاءة النهائية للشظايا في خلايا الذهن؟ حيث تفقد ظاهرها وحسيتها ولونها وترابطاتها، لتكون فقط ما توحي به من إحساس بالفناء؟ هو احتمال من احتمالات شتى، لعل من أقربها أيضاً أن الصلابة خدعة مرهونة بالوقت، وأن هشاشة الأشياء جزء من جبلَّتِها، يتساوى في ذلك الحجر والشجر والجسد والماء؛ الماهيات التي تستوطن قشرة الأرض، قبل أن تغور في عمقها، بفعل الزلازل والحروب والإرادة العبثية للبشر.
في الأيام الأخيرة من عمل زينب بشرى على لوحات معرضها، المستوحى من ذاكرة الزلزال التاريخي لأكادير، وقع الزلزال المدمر لمساحات شاسعة من منطقة الحوز بالمغرب، قبل أن يستيقظ العالم على وقع «طوفان الأقصى»، وما تلاه من عدوان إسرائيلي مدمِّر على قطاع غزة، ليَلْتَهِمَ الخَطْبَانِ الجَلَلَانِ المحكية العائلية القديمة من جذورها. لحسن الحظ أن الأعمال كانت شبه جاهزة للعرض، لكن ما جرى، من دمار في مئات القرى، وما تلاه من تدفق صور تُطل كل ثانية من الإعلام ووسائط التواصل، للمدفونين تحت الأنقاض، وللخراب القيامي، جعل المحكية تَسْطَعُ عبر امتدادات رؤيوية مختلفة، واحتمالات تأويلية مضافة، لتتلوها عشرات الأسئلة التي تحاصر الاشتغال: هل ما يرى الآن بكثافته الفجائية وحِدَّتِه وطغيان تفاصيله، يفكك السردية الشفوية القادمة من أرشيف عائلي؟ أيفقدها طزاجتها، وقدرتها على الاستثارة الفنية للغامض الثاوي في الذاكرة عن العطب القديم؟ لا يمكن الركون إلى قناعة نهائية، بصدد وضع شديد الإلغاز من هذا النوع، بيد أن الشيء الأكيد أن الزمن مرة أخرى، سيضع النوازل الكارثية المستحدثة، في تجاور مع سالفاتها، في أثناء الاسترسال في الاشتغال الفني، كما أن المتلقي لن يكون في معزل عن إيحاءات الماضي القريب والبعيد معاً، لحظة تمثل تحولات التجاور والجدل والانمحاء في الكتل اللونية المطروحة للنظر.
في النهاية يمكن اعتبار المعرض سيرة ذهنية لصاحبته في علاقتها بهروب الوقائع من خاناتها ومراتبها، وقوقعاتها الصورية الثابتة، كما يمكن النظر إليه بما هو عينة عن تعلق الأعمال الفنية بقَدَرِ الاستئناف، في التقنية والأسلوب، واكتساب المرئي أبعاداً غير متوقعة، ومفارقة لسياقاتها الأصلية، تتجلى من حيث هي دليل على هشاشة العالم والفكر والنظر، وسرعة عطب لحظات الاكتمال في الأعمال الفنية.