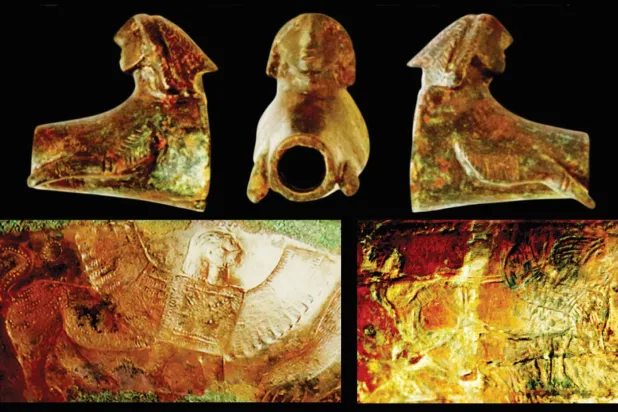عندما طلب الشاعر فهد عافت، من متصل مشارك في برنامج المسابقات «الجمل بما حمل» الذي قدّمَه في رمضان الماضي، أن يجيب عن أحد أسئلة الاختيار المتعدد بتحديد رواية الكاتب أسامة المسلم من بين الروايات الأربع المعروضة عناوينها على الشاشة، تحولتُ على الفور إلى مشاركٍ منافسٍ للمتصل، فسبقته إلى الإجابة الصحيحة بدون تلقي أي مساعدة من مُقَدِّم البرنامج الذي كان، أحياناً، يبسط الطريق سهلةً أمام المشاركين إلى الإجابات الصحيحة. كان المقدم الشاعر كريماً في شهر كريم وكانوا «يستاهلون»؛ وكانت رواية «بساتين عربستان» الاختيار الصحيح.
إجابتي الصحيحة عن السؤال لا تعني إطلاقاً أنني من قُرّاء روايات المسلم؛ ولو أن برنامج «الجمل بما حمل» عُرِضَ في شهر غير رمضان، في شعبان مثلاً، أو في رجب، ما استطعت الإجابة عن سؤال الشاعر عافت. ففي شعبان لم أكن أعرف أن المسلم أصدر ما يزيد على 20 رواية ابتداءً من عام 2015. لم أكن أعرف من رواياته قبل رمضان سوى روايته الأولى «خوف»، بالتحديد الجزء الأول من السلسلة - المسلم صاحب سلاسل من الروايات.
كانت «خوف» المسلم ولا تزال تشغل، ولبضع سنوات، حيزاً على أحد الرفوف فيما أسميها «مكتبتي». كلما امتدت إليها يدي عازماً على «المغامرة» بقراءتها، أعدتها إلى مكانها مؤجلاً ذلك إلى أجل غير مسمى، لأسباب ثلاثة: إمّا لكوني غير جاهز للقيام بتلك «المغامرة» التي ليس لدي أقل تصور مسبق أو توقع لنتائجها، أو بسبب المتبقي في داخلي من الجدار، أو ببساطة لأنها تخفق في منافسة الروايات والكتب الأخرى على قائمة قراءاتي، أو لكل هذه الأسباب مجتمعة. تكرر امتداد يدي إليها بمرور الأيام، وتكررت إعادتها إلى مكانها. وظلت «خوف» بجزئها الأول رواية المسلم الوحيدة التي أعرف إلى شهر رمضان الماضي.

كان رمضان شهر ما يمكن أن أسميها «مغامرة» الدخول في عوالم المسلم السردية بعد اتخاذ القرار بشراء وقراءة أربع من رواياته الصادرة في 2022: رواية طويلة بعنوان «هذا ما حدث معي»، وثلاث روايات قصيرة (نوفيلات): «جحيم العابرين»، و«أرض القرابين» و«شبكة العنكبوت». كنت قد تزودت قبل شرائها بمعلومات عن سيرة وإصدارات المسلم من الموسوعة الإلكترونية «ويكيبيديا».
فما الذي حدث؟ ما الذي جعلني أتغلب على ترددي عن قراءة رواية واحدة، إلى اقتناء أربعٍ من روايات المسلم، والعزم على قراءتها؟ الإجابة تبدأ من معرض المنطقة الشرقية للكتاب، من ذلك المساء الذي شكّل فيه قُرّاء المسلم طابوراً طويلاً، كل قارئ يتنظر الحصول على توقيعه على الرواية التي يحملها. بسبب الذهول من مرأى الحشد الكبير في المساحة أمام «مسرح إثراء»، حيث تقام الفعاليات الثقافية والأدبية، لم أهتم بمعرفة الرواية أو الروايات التي سيحضر المسلم لتوقيعها. ولم يكن ذلك مهماً. كان المهم معرفة الأسباب التي تدفع ذلك الحشد للوقوف لوقت غير قصير في انتظاره. هذا التزاحم في انتظار وصول المسلم إلى منصة التوقيع يتناقض تناقضاً صارخاً مع العدد الصغير لحضور الفعاليات الثقافية في المسرح. ما الذي يجعل هؤلاء يأتون مجموعات وفرادى للحصول على توقيعه؟ ما الذي يجذبهم إلى شراء وقراءة أعماله وأعمال نظرائه؟ عن أي شيء يبحثون فيها؟ أي تجربة قرائية توفرها لهم؟
كان البحث عن إجابة عن تلك الأسئلة السابقة الدافع الأول لإقبالي على الحصول على رواياته تلك، أما الدافع الآخر فكان الرغبة في هدم المتبقي من الجدار في وعيي، وفي داخلي: الجدار الذي يقسم الثقافة إلى ثقافتين، عليا ودنيا، والقص إلى قصين «قص أدبي» أحد معطيات وعناصر الثقافة العليا و«قص شعبي» منتمٍ إلى الثقافة الدنيا، أو ما يعرف بالقص التجاري أو «genre fiction». إن عزوفي الواضح في إرجائي قراءة «خوف» المسلم هو بلا شك بسبب المتبقي من الجدار الفاصل بين النوعين من القص. وجود ذلك الجدار، أو ما تبقى منه، مؤشر على تناقض، أو التناقض في داخلي.
عزوفي عن قراءة رواية المسلم ونظيراتها من الروايات المحلية والعربية هو الدليل الملموس على ذلك التناقض. فلماذا أرى عزوفي كاشفاً لواحدٍ من تناقضاتي، أقول تناقضاتي لأنني لست متأكداً من عدم وجود تناقضات غيره؟ لإيضاح هذه النقطة، إنني لا أتردد عن قراءة رواية من القص الشعبي (popular fiction) البريطاني والأمريكي على وجه التحديد، ومن أي «نوع/genre» تكون: رومانس، وخيال علمي، وبوليسية، وأكشن، ورعب، وإثارة. وعلى نحو متقطع، تتوازى قراءتي للقص الشعبي أو الرائج أو القص التشويقي كما يسميه آخرون أيضاً، مع قراءتي ودراستي للقص الأدبي. ولا أكتفي بقراءة النصوص فقط، بل يمتد اهتمامي إلى ما يقع في متناول يدي من قراءات نقدية ودراسات أدبية عن القص الشعبي، خصوصاً في العقدين الأخيرين. فابتداء من تسعينات القرن الماضي، تسارعت وتيرة التغير في الموقف من القص الشعبي على صعيد النقد والتنظير والدراسات الأدبية، وازداد الإقبال على نقده ودراسته زخماً بمرور الأيام. لم يعد يُنظرُ إليه باستعلاء واستهانة معاً، وأنه لا يستحق التفات النقد أو الناقد إليه. لقد أطاح النقد بالجدار الفاصل لقرون بين القصين، وانفتح على ما كان مهمشاً ومهملاً. بالإضافة لذلك، انفتح المنهج الدراسي في الثانوية والدراسة الجامعية بمستوياتها المختلفة لتدريس القص الشعبي في المملكة المتحدة وآيرلندا والولايات المتحدة، وفي أنحاء أخرى من العالم، حسب ما تذكره بيرنيس ميرفي وستيفن ماتِرسَن في مقدمة الكتاب الذي جمعا وحررا المقالات التي يحتويها وصدر عن مطبعة جامعة أدنبرة بالعنوان «القص الشعبي في القرن الواحد والعشرين، 2018».
وكما انفتح المنهج الدراسي للأدب القصصي الشعبي، مُهِدَّت الطريق أمامه بشكل غير مسبوق إلى الجوائز الأدبية المرموقة. ففي عام 2017، فازت الرواية «السكة الحديدية تحت الأرض» لكولسون وايتهيد بجائزة «بوليتزر»، ووصلت إلى القائمة القصيرة أيضاً لجائزة آرثر سي كلارك البريطانية للخيال العلمي. ورشحت رواية جيليان فلين «الفتاة المفقودة/ Gone Girl» لجائزة «بيلي» للقص النسائي البريطانية 2013.

لم تفز رواية جيليان بأي جائزة لكنها حققت رواجاً كبيراً وحظيت باهتمام نقدي لافت، وعدها البعض إضافة متميزة إلى أدب الجريمة والإثارة الذي أطلقت عليه الروائية جوليا كرواتش مصطلح «Domestic Noir». تشرح كراوتش أن هذا النوع من رواية الإثارة تقع أحداثه في المنازل وأماكن العمل، ويهتم بشكل كبير بالتجربة الأنثوية، منطلقاً من رؤية نسوية واسعة بأن الفضاء المنزلي قد يمثل تحدياً وأحياناً مصدر خطر لسكانه.
الملايين من الناس عبر العالم لا يقرأون الروايات الشعبية لأنها من أدب الثقافة الدنيا، لكنهم يشاهدون المئات من الأفلام والمسلسلات المستوحاة منها
ويلفت الفيلم «الفتاة المفقودة» بتقنيته السردية انتباه الناقد وارِن بَكْلاند فيختاره إلى جانب «غوراسيك بارك» موضوعاً للفصل الثالث (السرد/Narration) من كتابه «Narrative and Narration». يركز بكلاند في هذا الفصل على تفحص وشرح عنصرين أساسين من عناصر السرد السينمائي: 1- التقنيات التي تنظم وتتلاعب في تقديم المعلومات السردية لمشاهد الفيلم؛ 2- الفواعل السردية. ويعود بكلاند إلى الفيلم نفسه ومعه فيلم آخر «أورلاندو» ليجعلهما موضوعاً لتنظيره وتحليله في الفصل الخامس من الكتاب المعنون بــ«النسوية والسرد والتأليف».
قد لا يتحقق للقص الشعبي الذي يؤلفه المسلم وآخرون في المملكة ما تحقق للأدب الشعبي أو الرائج أو التشويقي في ثقافات أخرى من اهتمام نقدي وتنظيري أو إلحاق بالمنهج الدراسي، أو يسقط الجدار العازل القديم بسرعة. لكن أتوقع أن وصول مؤلفاتهم إلى الشاشة الكبيرة أو الصغيرة سيكون أسرع على الأقل في الداخل. في الأمس القريب، الأحد 3 سبتمبر (أيلول)، عُرض فيلم «القاتل» في مهرجان البندقية السينمائي الدولي (80). الفيلم إخراج ديفيد فينتشر، مخرج «الفتاة المفقودة»، ومبني على الرواية المصورة للفرنسي ألكسيس نولنت.
لم أقرأ الرواية، ولن أقرأها، لكن سأشاهد الفيلم «القاتل» عند عرضه عبر إحدى منصات البث التدفقي في نوفمبر (تشرين الثاني). هذا ما يحدث طوال الوقت، هذا ما يفعله الملايين من الناس عبر العالم. قد لا يقرأون الروايات الشعبية لأنها من أدب الثقافة الدنيا، ولكنهم يشاهدون المئات من الأفلام والمسلسلات المستوحاة منها. لكن على المسلم أن ينظر بعين ناقدة إلى ما يكتبه وكيف يكتبه و«كمية» ما يكتبه.
- ناقد وكاتب سعودي