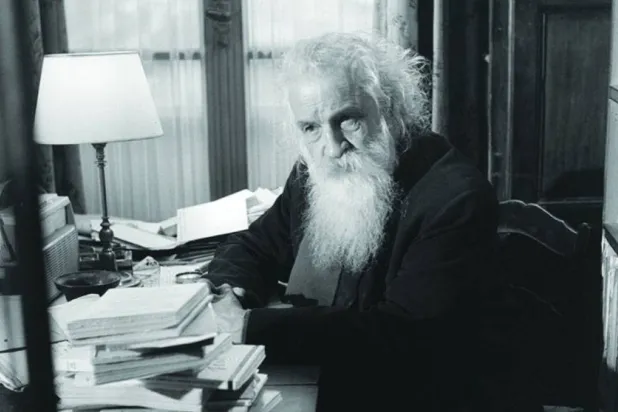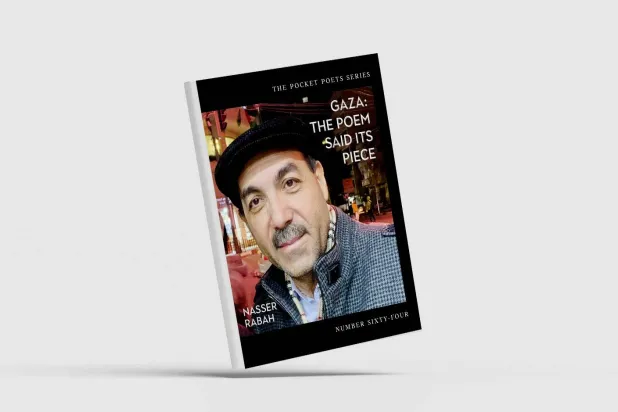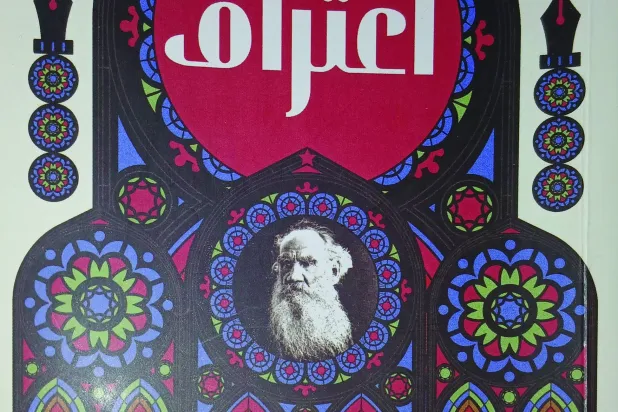حينما يرد اسم أيّ جائزة تكريمية في العلوم والآداب والفنون والاجتماع، دائماً ما يحضر اسم السويدي ألفريد نوبل وجائزته العالمية لـ«السلام»! وقد أوصى قبل وفاته بإنشائها سنة 1890 «تكفيراً» عن صناعة المتفجرات التي ورثها عن أبيه وأسرته، ففي سن الرابعة والعشرين، شرع في العديد من المشروعات التجارية مع عائلته، أبرزها امتلاك شركة «بوفورس»، وهي شركة لإنتاج الحديد والصلب، التي طوّرها لتصبح شركة رئيسية لتصنيع المدافع والأسلحة الأخرى. وكان استخدام اختراعه الديناميت أحد أسباب الدمار البشري في حرب القرم، وغيرها من حروب لاحقة في أوروبا.
كان نوبل قد انتقل مع أسرته، قبل اندلاعها، من استوكهولم إلى سانت بطرسبرغ في روسيا القيصرية، منتصف القرن التاسع عشر، وقد تفوّق في دراسة العلوم، خصوصاً الكيمياء، وإتقان اللغات.
ويؤرّخ بعض كُتّاب سيرته أن وفاة شقيقه لودفيغ في باريس، كأنها تسببت خطأً في نشر العديد من الصحف نعياً لألفريد نفسه، فأدانته بعض الصحف الفرنسية لاختراعه الديناميت، فوصفته بـ«تاجر الموت»، مما كان له الأثر في وصمه بتاجر حروب. فهل كان ذلك مدعاة إلى قراره العمل على أن يتحلّى بسمعة حسنة بعد وفاته؟ وهو ما دفعه إلى التبرع بأغلب ثروته بعد وفاته لتأسيس جائزة تحمل اسمه.
بينما سلطان العويس، المولود بعد نوبل بقرابة ربع قرن سنة 1924، وافق أن تحمل جائزته الثقافية اسمه كاملاً، بعد ضغط من أصدقائه ومحبيه. وهو في سيرته، على النقيض من نوبل، حيث وُلد في أسرة تمثّلت فيها قيم الإحسان والتكافل الاجتماعي والتربية والمعرفة والشعر، ممتهنة العمل في البحر بالغوص على اللؤلؤ في أعماق الخليج العربي، حيث بدأ العمل مع والده «الطواش» وهو بين نهاية الصبا ومطالع الشباب، ماخراً البحر إلى «هيرات»، أي مغاصات اللؤلؤ يستلمها بدل أبيه.
وفي العشرين من عمره، ركب البحر بأهواله المرعبة وتقلباته العاصفة إلى الهند، التي كان مهراجاتها يتطلّعون إلى الحصول على لآلئ الخليج العربي ومنتوجات نخيله ومزارعه. وفي الهند تجلّت صدمة سلطان الحضارية، حين كانت محتلة من قبل بريطانيا، منبهراً بمآثرها الحضارية، وتخطيطها العمراني بشوارعها المضاءة ومدارسها الحديثة، متفاعلاً مع حياتها المدنية وحراكها الوطني ولغاتها المختلفة.
في حيدر آباد، انضم سلطان إلى مجتمعها التجاري العربي، ممن كان أفراده يمكثون فيها وقتاً طويلاً لإدارة شؤونهم المعيشية وأعمالهم الاقتصادية. ومحافظةً على هويتهم القومية، أنشأوا فيها مطبعة عربية، صدرت منها كتب وصحف، تأثّر بها الكاتب والسياسي المصري حافظ وهبة، والشاعر السعودي الكويتي خالد الفرج، قبل سلطان العويس، وغيرهم ممن ارتاد الهند وقتذاك.
هذه الصدمة الحضارية كانت إيجابيةً لدى صاحب هذه الجائزة، الذي يصرّ في أحاديثه لمن قابله وكتب سيرته، أن جائزته وُلدت في حيدر آباد، حينما قرر أن ينشئ في مسقط رأسه قرية الحيرة، الواقعة بين الشارقة وعجمان، مدرسة يتلقى فيها أبناؤها وسائل التربية والتعليم. فبدأها بـ20 طالباً، تمكّن من إقناع أهاليهم بالانضمام إلى فصولها الابتدائية، عبر تعهّده بمساعدتهم مالياً ومعيشياً، وهو ينتزع أبناءهم من العمل في البحر وتربية الماشية في البر، إلى أتون مبادرته الجريئة... وهكذا سارت تجربة سلطان العويس في نقل أبناء قريته إلى آفاق التعليم الحديث، بإنشاء مدرسة أخرى في الشارقة بمئات الطلبة، موفّراً لهم اللوازم المدرسية، ومستقدماً إليها المعلمين من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت، والعراق فيما بعد، رغم امتناع نوري السعيد، رئيس وزرائه الخانع لعلاقة بلده مع بريطانيا المستعمرة.
لم يقف طموح العويس عند هذا الحد، بل إنه، مع توسع ثروته في تجارة اللؤلؤ وغيرها من أعمال، راح يبتعث بعض طلاب وطنه إلى جامعات القاهرة وبيروت، مع بناء الجسور، وإقامة معاهد مهنية، ومساعدات لجامعات داخل الإمارات وخارجها في دول خليجية وعربية، يحدوه في ذلك إيمان ديني مستنير، ونَفَس قومي صادق.
هذا الاهتمام الواعي بقيمة العلم وأثر المعرفة في تطور المجتمعات العربية لم يأتِ عفو الخاطر، وإنما جاء بسبب انتمائه إلى أسرة تعاطى بعض أبنائها الأدب والشعر، حيث كان الكتاب والمجلة والصحيفة تأتيهم - وقتذاك - من القاهرة وبيروت من وراء البحار، مستغرقاً وصولها إليهم شهوراً عدداً.
كما أن هذا العامل الثقافي هو الذي حفّز في سلطان العويس السفر مبكراً إلى بعض دول الشرق العربي... وربما بسبب قراءاته لأدبائهم وتأثره بشعرائهم، أصبح يكتب الشعر بلغة بسيطة، متحرّرة من أثقال الألفاظ البلاغية والصور النمطية في الشعر العمودي، متمحورة قصائده حول الغزل والوصف والحكمة والتغني بالوطن، واعياً كل الوعي بدور رجال المال والأعمال في خدمة المجتمع، والمساهمة في نشر الثقافة، مبادراً إلى بناء برج من أربعة أدوار يضم مكتبة ومسرحاً وصالات معارض للفنون بخدماته الإدارية، داعماً هذا الصرح الثقافي ببرج تجاري من تسعة طوابق، مخصص لاستثمار عوائده المالية في تمويل المشروعات الثقافية والخيرية.
وكأنه، بمبادرته الرائدة في تعليم أبناء قريته، ودعم المشروعات الثقافية والجامعية والتنموية داخل وطنه وخارجه، قد لمس التبخيس المُخِلّ لقيمة الثقافة والمعرفة والإبداع، وعدم تمكينها في العالم العربي، بوصفها العامل المؤثر في نهضة المجتمعات ووعي الشعوب. تقابلها صورة نقيضة في مجتمعات أميركا وأوروبا، كشف عنها تقرير نشرته شركة «ويلث إكس» سنة 2018، عن تتبّع رؤوس الأموال في العالم، في تبرعات الخيّرين من الأثرياء الذين تبلغ ثروة الواحد منهم 30 مليون دولار، إذ منحوا - وقتها - نحو 153 مليار دولار للأعمال الخيرية في العالم. ويؤكد التقرير أن ما قدّمه هؤلاء الأثرياء يعادل إجمالي إنفاق الحكومة الفيدرالية الأميركية على الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، بينما لم يتجاوز ما قدّمه أثرياء منطقة الشرق الأوسط، بما فيهم أثرياء العالم العربي، 5 في المائة من إجمالي تبرعات الأثرياء في العالم! مكدّسين ثرواتهم دون جني أي طائل معنوي، أو ربح رمزي، أو احترام اجتماعي يخلّد ذكراهم.
من هنا، تكمن أهمية ما قدّمه عبد العزيز البابطين من دعم للتعليم والثقافة والإبداع الشعري، وكذلك بعض من أثرياء العرب الخيّرين، أمثال رجل الأعمال السعودي عبد المقصود خوجة، والكويتية الدكتورة سعاد الصباح، والفلسطيني عبد المحسن القطان، والفلسطيني الآخر عبد الحميد شومان، عبر مجالسهم، ومطبوعاتهم الثقافية، وجوائزهم العلمية والأدبية.
هؤلاء هم من أصبح يشملهم مصطلح «رأس المال الثقافي»، وقد صكّه بيير بورديو، عالم الاجتماع والمنظّر الثقافي الفرنسي، على أنه «رأسمال رمزي» يحصل عليه الأفراد والنخب الثقافية أو المؤسسات. وهذا الرأسمال الرمزي أو الثقافي هو مجموع القدرات والمواهب المتميّزة للحائزين عليه من الأثرياء، بتفوقهم وحضورهم، إضافة إلى ما يحصلون عليه من مكاسب مادية. وبذلك، يحظون بالمكانة الاجتماعية داخل الحقل الثقافي، وبهذا يحصلون على رأسمال اجتماعي، يتمثل في مدى تأثير الثري المحسن في المجال العام، وهو بهذا يحصل في نهاية المطاف على رأسمال رمزي، من شهادات وأوسمة وألقاب، نظير ما اقتطعه من رأسماله المادي في دعم المشروعات التنموية المختلفة. يقول بيير بورديو في آخر فصل من كتيّبه «الرمز والسلطة» المعنون بـ«الرأسمال الرمزي والطبقات الاجتماعية»: «أن تكون نبيلاً معناه أن تُبذِر، محكومٌ عليك بالرفاه والبذخ، وقد احتدّ الميل إلى التبذير رداً على الارتقاء الاجتماعي للأثرياء الجدد... في قرون مضت، فما الذي يميّز الفارس الأصيل عن حديث النعمة؟ ذلك أن الثاني بخيل، أما الأول فهو نبيل؛ لأنه يصرف كل ما لديه بكامل الانشراح، وإن كان مثقلاً بالديون».
هل لهذا، تبدّى سلطان العويس فارساً شهماً نبيلاً أمام من أحبّها، وهو يقول:
إِلَيْكِ مَالِي فَمَا مَالِي سِوَى وَرَقٍ
لَنْ يُؤَثِّرَ الْمَالُ قَلْباً قَدْ سَكَنْتِيهِ
لِي مِنْ عُيُونِكِ أَمْوَالٌ أُكَدِّسُهَا
وَمِنْ حَدِيثِكِ دُرٌّ لَسْتُ أُحْصِيهِ
بهذه الروحية، انطلقت جائزة سلطان العويس الثقافية عبر اتحاد الكتّاب والأدباء في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1987 بأمانتها العامة، مستقلةً بمؤسستها الثقافية، كما أوصى نوبل قبل ذلك بقرن من الزمان، بأن يكون النادي السويدي النرويجي منطلقاً لجائزته، مكرّساً الجزء الأكبر من ثروته لقيام جائزة نوبل التي أصبحت عالمياً ملء السمع والبصر... غير أن ما تفوّقت عليه جائزة هذا العربي الخليجي، هذا البدوي البحّار، هو معيارها الأكاديمي الموضوعي في اختيار الفائزين دون «أدلجة» أو انحياز... وهو ما اعتادت عليه جائزة نوبل، التي لم يفز بها أحد من العرب - مثلاً - سوى الروائي المصري الكبير نجيب محفوظ، الذي كان يستحقها، بغير وصول ضوء موافقة ممن اهتم بأدبه (سان سوميخ اليهودي العراقي)، إثر دعوة محفوظ المبكرة إلى التطبيع الثقافي مع إسرائيل.
هذه الأدلجة السياسية وخلفيتها (الديناميتية) هي التي جعلت بعض من فاز بجائزة نوبل يرفضون استلامها، ومن أبرزهم جورج برنارد شو، الأديب والروائي الآيرلندي، وذلك سنة 1925، محطّاً من قدرها وساخراً من سيرة نوبل، وكذلك الفيلسوف والأديب الفرنسي جان بول سارتر.
وكان فوز السياسي الفيتنامي لي دوك تو، أوائل السبعينات، مناصفة مع هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركي، محل استياء داخل لجنة اختيار الفائزين بها، ضد منحها عرّاب التفاوض لإخراج واشنطن من مأزق حربها المذلّة في فيتنام، حيث كرت السبحة فيما بعد، لتكريم الإسرائيلي مناحيم بيغن، سفّاح دير ياسين، وغيره من السياسيين الغربيين الذين خدموا المشروعات الاستعمارية.
لذلك، تأتي جائزة سلطان العويس، منذ بدأت سنة 1990 حتى يومنا هذا، وكأنها ردٌّ عربي ساطع و«قوة ناعمة» على مخرجات جائزة نوبل المنحازة، وقد منحت لأبرز المفكرين والأدباء والشعراء العرب، ممن تبنّى قضايا الأمة والإنسانية والحق والعدل والسلام، متمنياً لو أن جائزة العويس فتحت الباب لبعض الكتّاب العالميين ممن نصَر العرب والمسلمين وساند قضاياهم.