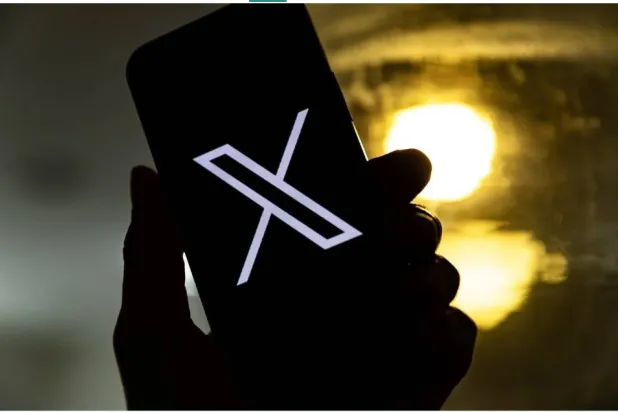خلال أقل من 24 ساعة على إطلاق تطبيق «ثريدز» الجديد المنافس لـ«تويتر» التحق به ثلاثون مليون مشترك يعتقد أن غالبيتهم الساحقة من مشتركي تطبيق «تويتر» أصلاً. وتطمح شركة «ميتا»؛ صاحبة التطبيقات الشهيرة «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، إلى إزاحة تطبيق «تويتر» عن عرشه الذي بقي عليه دون منافس جديّ بعدد مشتركين يصل اليوم إلى نحو 370 مليوناً.
ولعّل اللافت في هذا الإقبال الهائل أن التطبيق الجديد لا يقدّم أي ميزات نوعيّة عن تطبيق «تويتر»، فيبدو كأنه نسخة مقلدّة من موقع التغريد الأزرق، ولا يمنح مشتركيه منصّة أقل انحيازاً بحكم خبرتنا الطويلة مع «فيسبوك» الذي يماثل؛ إن لم يفق، «تويتر» في الفجاجة في مصادرة الآراء؛ بل والصور أحياناً، كما أن أحداً لم يترك «تويتر» فيما يبدو ليلتحق بـ«ثريدز»؛ بل استمر التطبيقان؛ كل إلى جوار الآخر، على الأجهزة الذكيّة لملايين البشر. ولذلك يحق لنا التساؤل عن دافع هذه الملايين لإضافة «تويتر» آخر جديداً إلى جانب «تويتر» الأصلي؟ لقد أحدث ظهور الإنترنت وما لحق بها من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي ثورة معرفيّة عبر تعميم وسائل استعادة المعلومات إلى أعداد غير مسبوقة في التاريخ البشري وتسهيل صيغ التواصل فيما بينهم؛ الأمر الذي دفع ببعض المتفائلين منا لتوقع قيام «يوتوبيا رقميّة»، تعوض أحلامهم المنكسرة بعدما تعثرت كل المحاولات لتأسيس «يوتوبيات ماديّة» على الأرض، فتكون بمنزلة فضاء معولم للحريّة والمساواة. لكن هذه التوقعات الساذجة لم تلبث - خلال وقت قصير لا يتجاوز عمر جيل أو جيلين - أن تحطمت على جدار «ديستوبيا مريرة ساخرة»؛ إذ إن عدداً محدوداً من شركات التكنولوجيا المتطورة عززت هيمنتها على العالم السيبراني، وحوّلت منصاتها إلى آلات لانتزاع الأموال من المستهلكين؛ إنْ ليس مباشرة، فمن خلال بيع معلومات الاستعمال لمن يرغب من الشركات والحكومات، بل ولمنظمات مشبوهة أيضاً، في اعتداء سافر على خصوصية المشتركين، ومعلوماتهم، ووقتهم. وتآكلت لاحقاً الآمال في إنترنت مجانيّ يتيح للبشر التلاقي على صعيد واحد بغض النظر عن قدرتهم الماليّة، بعدما أصبح الوصول إلى كثير من التطبيقات والمواقع متعذراً دون دفع بدل ماديّ، فيما يتطلّب بعضها مقابل الاستعمال المجانيّ التعرّض الطوعيّ لغسل دماغ من قبل شركات الاستهلاك، ومشاهدة دفق إعلانات متكرر بين الفينة والأخرى.

لكن ذلك لم يكن كافياً لتنفير مستخدمي هذه المواقع والتطبيقات التي أصبح بعضها عملاقاً مؤثراً أكثر بكثير من حكومات أغلب دول العالم، حتى بدا خلال أقل من عقدين كأن البشر مشوا بأقدامهم نحو عبوديّة رقميّة، فتقبلوها دون مقاومة تذكر، وأدمنوا عليها، فأصبحت سيّدة أوقاتهم، وخصوصاً نشاطهم، وأول ما يبتدئون به نهاراتهم، وآخر ما ينهونها به. وهكذا يمكن لشركة «ميتا» أن تطلق تطبيقاً يلتحق به عشرات ملايين البشر خلال ساعات، ولشركة «أبل» أن تستقطب صفوفاً طويلة أمام محلاتها من الساعين لشراء أحدث تكنولوجياتها...
إن هذا الزحف نحو العبودية الرقمية؛ في موازاة سقوط مجانيّة الإنترنت، ستكون له تداعيات طويلة المدى على صحة الأفراد العقليّة، وضغوط إضافيّة على ميزانياتهم، ولا بدّ من أنه سيخلق نوعاً من تفاوت طبقي في القدرة على الوصول للمعلومات بين الشعوب وداخل المجتمعات السكانيّة أيضاً، مما قد يعوق تشكيل ثقافات منسجمة على المستوى الوطني، لمصلحة ثقافات بديلة افتراضيّة عابرة للحدود تجمع بين فئات الميسورين دون غيرهم.
هذا الفصل الرقمي سيدفع بالمتضررين إلى محاولة عبور الأسوار عبر المواقع والبرامج المقرصنة التي تحمل في طياتها غالباً مخاطرات التعرض إلى الفيروسات والبرمجيّات الضارة، وربما تتسبب لهم في خسائر مادية تضاعف من الفجوة الرقميّة، وتكرّس تهميش الذين يقفون على الجانب الخاسر من الصحراء السيبرانيّة الممتدة. وتهدد تكنولوجيات الذكاء الاصطناعيّ اليوم، مع تسارع اندماجها في مختلف جوانب الحياة، بتوسيع تلك الفجوات الرقميّة بشكل أكبر، وربما خلق أشكال أكثر جبروتاً مما عرفناه حتى وقتنا الرّاهن من عبوديّة رقميّة.
ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أن كل تعاطٍ لنا مع الإنترنت وعبر مختلف التطبيقات يعني تسليم مزيد من المعلومات عنّا لهذه الشركات الكبرى؛ حيث جميع محادثاتنا ومراسلاتنا الإلكترونية، ومعاملاتنا التجارية والبنكيّة، والصور التي نتشاركها، ومجمل تعاملنا مع مواقع التواصل الاجتماعي، تتم إضافته إلى تجمّع هائل مما تسمى «البيانات الكبيرة»، التي عندما تتوفر للذكاء الاصطناعي فستمكنه من لعب دور «الأخ الأكبر» الذي يتربع على قمة الهرم، ويسيطر على أقدار البشر.
سبق الروائيون غيرهم إلى التحذير من «ديستوبيا» تقودنا نحوها مثل هذه التكنولوجيا؛ فبين «1984» لجورج أورويل، و«عالم جديد شجاع» لألدوس هكسلي، تسيطر على العالم طبقة معينة من الميسورين الذين يُسقطون القوميّة والسيادة الوطنية ونظام العائلة من حساباتهم، ويستعينون بتكنولوجيّات متقدمة لتكريس هيمنتهم على بقيتنا، مع فرق شكلي ربّما بين الصيغتين المقترحتين؛ فيتم استعباد الناس قهراً عند أورويل، بينما هم يحبّون عبوديتهم وفق هكسلي.
فأي إنسان جديد ينشأ في ظل هذه العبوديّة؛ قسرية كانت أم طوعيّة، في أغلب الأحوال سينتهي بمنزلة رقيق رقميّ عند الشركات والجهات الأخرى التي تمتلك أي جزء من هويتنا الرقمية؛ إذ إن نظامها التشغيلي قائم على أساس إساءة استغلال خصوصيتنا واهتمامنا... فلا نحن نمتلك هوياتنا الافتراضية، التي يمكن لأصحاب الشركات إلغاءها في أي وقت، ولا نحقق بصفتنا أفراداً أيّ فائدة تذكر من تراكم مشاركتنا بياناتنا الشخصية وعلاقاتنا واهتماماتنا، فيما تتحول هذه إلى مادة خام ذهبيّة يبيعها عمالقة التكنولوجيا لمن يرغب من التجار والحكومات. فبينما نحن أحرار جسدياً، فلسنا كذلك رقمياً؛ إذ نتعرّض لشكل قاسٍ من العبوديّة الافتراضيّة.
العبودية الرقمية في موازاة سقوط مجانيّة الإنترنت ستكون لها تداعيات طويلة المدى على صحة الأفراد العقليّة
ولعل الأخطر في هذه العبوديّة أننا نسقط فيها رويداً رويداً دون أن ندرك، تماماً مثل الضفدع الذي يوضع في دورق ماء وتوقد تحته النار، فيقضي دون أن ينتبه إلى أن درجة حرارة الماء تزداد حوله باطراد... فنحن مستمرون في إثراء بصمتنا الرقميّة على الإنترنت يوماً بيوم لمصلحة «الأخ الأكبر»، بينما ليس لدى أغلبنا أي خطط للتحرر، ولا حتى الرّغبة فيه.
وبالطبع؛ فإن واقع الحال يشير إلى أن معظم الأفراد لا يتوقع منهم إدارة مواجهتهم مع هذا «الأخ الأكبر» وحيدين، إذ لا بدّ من هيئات عامّة توعيهم، وتسندهم، وتتولى المهمة عنهم، أقلّه في الحدود الدنيا. لكن التجارب الحاليّة في هذا الإطار - وربّما باستثناء محاولات أوليّة عند الاتحاد الأوروبي لحماية مواطني دوله الأعضاء من التغوّل الكليّ لشركات التكنولوجيا - تبدو إلى الآن غير مبشّرة، بعدما تحوّلت أنظمة الحماية التي بنتها الدول الكبرى، مثل روسيا والصين وإيران، إلى مجرد «تطبيقات تويترات أخرى» بنسخ رديئة أحياناً، مع انعزال مستخدميها فيما تشبه «غرف صدى» ضخمة نسبياً على وسع البلد الواحد، لكنها أقرب إلى سجن جماعي لا يسهل لأبناء الثقافات الأخرى؛ بمن فيهم الأصدقاء والمتعاطفون، عبور أسواره.