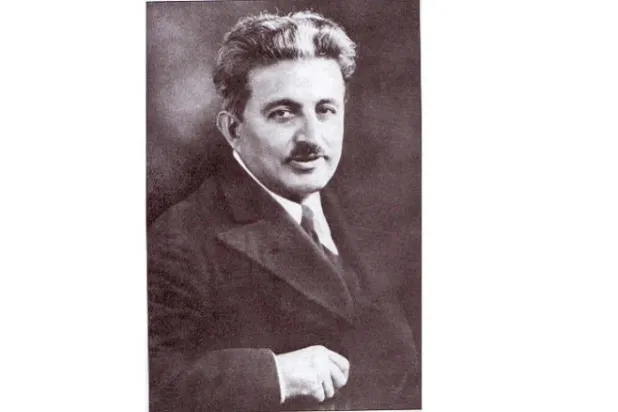أكدت ندوة «التشكيل المغربي والتداول النقدي»، التي نظمت، أخيرا، بأصيلة، ضمن فعاليات الدورة الصيفية لموسمها الثقافي الدولي الـ44، وجود «اختلالات راهنة تشوب مسألة التداول النقدي للأعمال التشكيلية بالمغرب».
وسعت الندوة، وهي الثالثة خلال دورة هذه السنة، بعد ندوة أولى تناولت «الفن المغربي المعاصر والسؤال الثقافي»، وثانية شهدت تكريم الفنان المغربي عبد الكبير ربيع، إلى تسليط الضوء على طبيعة التداول النقدي للتشكيل المغربي في الآونة الأخيرة، والوقوف عند أعطابه، وإبراز مقومات إنضاجه، بعد تواتر سنوات من «اجترار الصيغ المستنسخة». ومن ثم، كما ذهبت إلى ذلك الورقة التقديمية لهذه الندوة التي نسقها الناقد شرف الدين ماجدولين، بيان «صيغ الخروج من مفارقات التحليل إلى وظائف التقييم»، بما سعت إلى تكريسه من «مرجعية مفهومية وبيانية دقيقة وواضحة»، من شأنها «تعزيز الثقة باختراقات التشكيل المغربي بما هو أحد أهم منجزات الثقافة المغربية المعاصرة».
وشددت الورقة على أن «الخطاب النقدي المواكب للمعارض الفنية ليس مجرد خطاب شارح»، بل «يشكل متنا جوهريا في عملية العرض للأعمال الفنية»، بما يجعل منه «تكملة للخطاب البصري واختراقا بلاغيا له، يترجم الرموز والمفاهيم والكتب البصرية عبر مفردات».
وتوزع برنامج الندوة بين جلستين، صباحية ومسائية، شارك في أولاها، فضلا عن منسقها ماجدولين، كل من محمد بن عيسى، أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة، والكاتب والفنان التشكيلي فؤاد الشردودي، والناقدة الفنية ومنظمة المعارض، دنيا بتقاسم، والناقد الفني وأستاذ التعليم العالي عبد الكريم الشيكر، والفنان التشكيلي والناقد الفني عزام مدكور. فيما شارك في الجلسة الثانية، كل من الفنان التشكيلي والشاعر وأستاذ التعليم العالي عزيز أزغاي، ومنظم المعارض وأستاذ التعليم العالي أحمد مجيدو، والناقد الفني والفنان التشكيلي بنيونس عميروش، والناقد الفني أحمد لطف الله، الناقد الفني.
وتحدث ماجدولين عن «تصريف نقدي» لفضاءات يشتغل عليها الفنان التشكيلي ولها صلة بالفن التشكيلي، تكون فيها للمشتغل قدرة على أن يضع على كل هذه الفضاءات لمسته. ورأى أننا نتحدث عن النقد من دون أن نعده خطابا؛ وأن الذي لدينا اليوم، بوصفه نقدا، هو مجرد وصف للأعمال وإعادة تدوير لمفردات تشتغل في نفس المقالات على نفس الأعمال؛ بينما الغائب في ما جرى هو لفظة ناقد، مع تشديده على أن النقد الفني شبه غائب، ولذلك بات من الضروري صياغة مساحة للتلاقي بخصوص ما ينتج داخل المشغل والمعاهد والمختبرات.
من جهته، رأى بن عيسى أن الحديث عن التداول النقدي ليس سهلا في التجربة المغربية. واستحضر، في هذا السياق، التجارب التي شهدها المغرب بداية من ستينات القرن الماضي، مع تركيزه على الأدوار التي لعبتها جماعة الدار البيضاء، مع محمد المليحي وفريد بلكاهية ومحمد شبعة، وآخرين. كما تحدث عن علاقة النخب بالفنون التشكيلية، وغياب ثقافة التصوير في الحضارة الإسلامية، مقدما ملاحظات عامة، همت علاقة السياسة بالثقافة في التاريخ المعاصر للمغرب.
وخلص بن عيسى إلى أن من شأن ندوة التداول النقدي أن تفتح العين والذاكرة على أهمية الفنون التشكيلية، معربا عن أمله في أن يستدرك الجيل الجديد النقص المسجل في هذا المجال.
وسارت مداخلات باقي المشاركين في نفس التوصيف الذي طرحته الورقة التقديمية، خصوصا في ما يتعلق بالأوضاع التي يعيشها راهن التداول النقدي للتشكيل المغربي.
وقدم الشردودي «تأملات في راهن النقد الجمالي بالمغرب»، استحضر في بدايتها، ما راكمه الخطاب النقدي على امتداد عقود من الإنجاز والمتابعة والمحاورة لسيرورة الخطابات التشكيلية وإبدالاتها، مشددا على أن «محور النقد عامل أساس في بناء أي فاعلية تشكيلية وجمالية كيفما كانت صيغها واعتمالاتها»، مع إشارته إلى «ما حفلت به الكتابات النقدية المنجزة في أواخر القرن الماضي من أسئلة جوهرية وخلاقة ساهمت في محطات عدّة في بلورة حالات ثقافية خصبة ولدت انسجاما ملحوظا بين حركيتي المنجز الإبداعي البصري والكتابات المحاورة أو المجاورة له، وناقشت قضايا فكرية وثقافية شغلت حيزا كبيرا من اهتمام الفنانين وكذا المتتبعين للحقل التشكيلي بالمغرب».
ولاحظ الشردودي أن المتأمل في الراهن التشكيلي المغربي لا يمكنه إلا أن «يقر بدينامية مهمة ومبشرة عرفتها العقود الأخيرة، تمثلت في الاهتمام المتزايد بالمنجز البصري وبما يحيط به من سياقات انتشاره وتلقيه»، قبل أن يستدرك بالحديث عن «وضع ملتبس»، مرده إلى أن المؤسسات الثقافية «لم تستطع» أن تستثمر الكثير من الإنجازات الفنية التي حققها المجال البصري في المغرب، لتظل «المعادلة مختلة». ليخلص إلى أن كل كتابة في التشكيل وعن قضاياه لا يمكن إلا أن تسهم في «مد جسور التواصل بين العمل الفني ودائرة تلقيه»، مع تشديده على أن «ما راكمه الخطاب النقدي على امتداد التجربة البصرية المغربية يعد أرضية صلبة وخصبة لمنطلقات جديدة تغتني مما تنتجه المعرفة الكونية».
ورأى أزغاي أن التداول النقدي، كما هو ممارس، على الأقل، اليوم في المغرب، يعتريه غير قليل من اللَّبس، مع إشارته إلى أن النقد ظل مرهونا بالحوار أو الجوار، بمعنى عدم قدرته على النفاذ إلى الأعمال الفنية، حيث ظل مجاورا لها فقط.
وفي ما يخص «مسألة انكماش التلقي»، قال إنها تتصل بأربع نقط أساسية، أولها ما سماه «الإهمال التاريخي» الذي تعرض له التصوير في الثقافة العربية، لأسباب رآها «غير مقنعة»، تتصل بالتحريم، بشكل ساهم في تدني الوعي البصري. وثانيها «تراجع وانكماش العلاقات الثقافية والإنسانية بين الفنانين والكتاب». فيما تتمثل الثالثة في دور «المنظومات التعليمية»، مشيرا إلى أنه لا يتصور مجتمعا لا ينتج أطرا تعنى بالصورة والموسيقى. أما الرابعة فتهم «تراجع دور الترجمة».
وقدم عميروش نقط استدلال لمنشأ النقد الفني، الذي لم يكن في معزل عن الدينامية الفنية والثقافية التي عرفتها مرحلة ما بين ستينات وتسعينات القرن الماضي، قبل أن يطرح سؤالا حول ما تبقى من هذه الدينامية الثقافية في الألفية الثالثة؛ ليتحدث، في هذا الصدد، عن «بعض الكتابات النقدية المحكومة بالطلب»، في مقابل «الانتعاش الملحوظ الذي عرفه قطاع الفنون التشكيلية في العقدين الأخيرين من خلال البنيات الجديدة من متاحف وقاعات خاصة جديدة، وتخصيص الدعم للمجال التشكيلي من قبل وزارة الثقافة، وانخراط العديد من منشآت الرعاية التابعة للمؤسسات المالية».