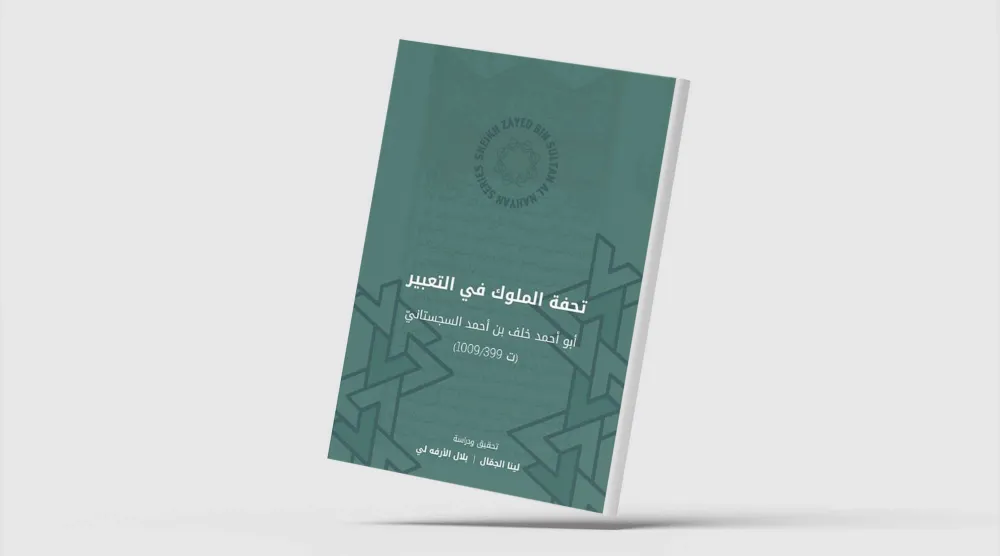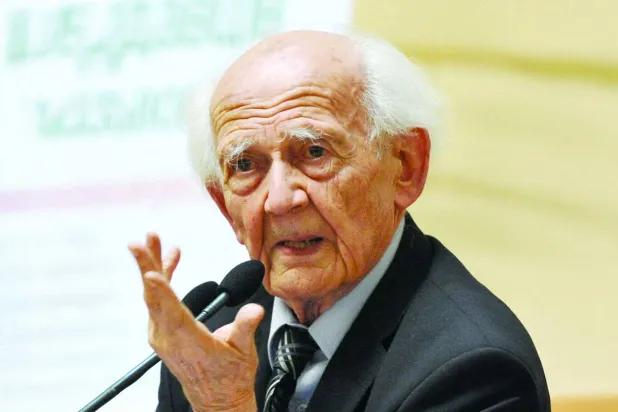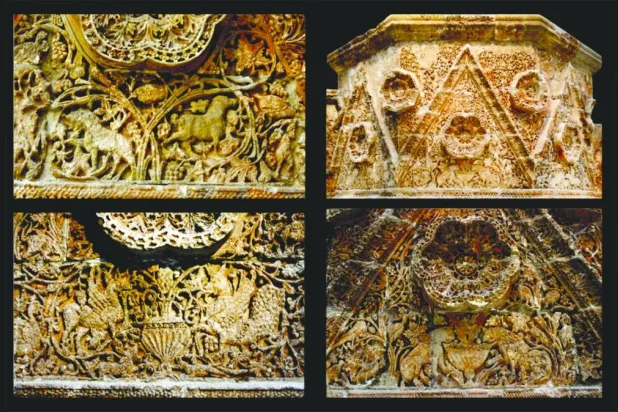برغم قلة ما صدر له من أعمال روائية، فإنه لفت النظر إليه باعتباره أحد أكثر الأصوات الموهوبة من الجيل الجديد في المشهد الثقافي الجزائري. يركز سعيد خطيبي على العودة إلى التاريخ الحديث فهو وسيلته المفضلة لمساءلة الحاضر سياسياً ومجتمعيا. فازت روايته الجديدة «نهاية الصحراء» بجائزة «الشيخ زايد» في الأدب هذا العام، وسبق أن فاز بجائزتي «كتارا» و«ابن بطوطة» كما وصلت روايته «حطب سراييفو» إلى القائمة القصيرة لجائزة «البوكر» للرواية العربية. وهو يحمل شهادة على ماجستير في الدراسات الثقافية من جامعة السوربون، ويعمل بالصحافة والترجمة ويكتب في أدب الرحلة أيضاً... هنا حوار معه حول تجربته الروائية:
* بداية تبدو «نهاية الصحراء» عملاً بوليسياً ينتمي لأدب الجريمة لكن مع القراءة المتعمقة يتبين أن النص يحفر في التاريخ المنسي سياسياً واجتماعياً للجزائر في الثمانينات... هل كانت الحبكة البوليسية مجرد حيلة لاستدراج القارئ؟
- الجريمة الحقيقية وقعت في حقّ التّاريخ. في الرّواية جثتان، الأوّلى لشخصية «زازا»، والثّانية جثة بلد. شرعت في كتابتها بنية الكتابة عن رّبع القرن الأوّل من الاستقلال، وصولاً إلى أحداث 5 أكتوبر 1988، حين خرج الناس إلى الشّارع يشتكون الجوع وخيبتهم مما يحصل. ربع قرن كانت كافية كي نكتشف أعطاب التاريخ. إن الاستعمار خرج لكننا لم نبنِ بلداً، لأننا اشتغلنا بخصومات داخلية وصراعات من أجل السّلطة، بينما الشعب ظل على دكة الانتظار. الشّعب هو الذي قام بحرب التّحرير وهو الذي سوف يفضح فشل مشروع الاستقلال. كيف نكتب عن بلد كان يسير صوب هاوية؟ الحبكة البوليسية فرضت نفسها. كتبت عن ذلك الهامش من الحياة الجزائرية، عن أشخاص نسمع عنهم لكن لا صوت لهم. لم يكونوا من المثقّفين ولا من المقرّبين من السلطة. يعيشون في عزلة. يتكفّلون بالبحث عن الجاني في مقتل المغنية «زازا» قبل أن يتبيّن لهم أنّهم بصدد البحث عمن خنق بلدهم.
* ما الذي استفزك في تاريخ الجزائر في حقبة الثمانينات وأردت الكشف عنه رغم أنك من مواليد 1984 وما علاقة ذلك بما تردده حول وجوب «ترويض التاريخ»؟
- تاريخ الجزائر حقيبة أسئلة. المجهول منه أكثر من المعلوم. ما يحصل في الجزائر يحصل في بلدان عربية أخرى، حيث هناك من يستفرد وحده بكتابة التّاريخ، وصار المؤرّخ موظفاً متنازلاً عن حريته. لذلك أكتب، والكتابة تستدعي ترويض هذا التاريخ الرّسمي، عدم السّقوط في اليقينيات. ولا أدّعي امتلاك الحقيقة، بل أكتب دفاعاً عن حقي في الخطأ. أكتب تخييلاً، وليس شيئاً آخر، مقتنعاً بأن الخطأ يقرّبنا من الحقيقة. لم يعد بوسعنا سوى اللجوء إلى الرّواية قصداً لتحقيق مصالحة تاريخية عجزت عنها المؤسسة الرسمية. حقبة الثّمانينات هي أكثر فترة حرجة من تاريخ الجزائر. مع صعود البرجوازيات الجديدة وما ترتب عليها من صراعات اجتماعية، تراجع السّلطة المركزية عقب انهيار أسعار البترول، وبالتّالي ضعف الدولة، مما أدّى إلى صعود خطابات راديكالية. حقبة الثّمانينات شهدت انقلاباً لم ننتبه إليه، بنهاية زمن (المجتمع) وسطوع فكرة (الفردانية)، هذه الحقبة سوف تنتج عنها عشر سنوات من حرب أهلية في التّسعينات، مع توسّع التّطرف الدّيني، الذي صاغ خطاباً تكفيرياً يبيح الموت والدّم.

* في روايتك «حطب سراييفو» تنتقل إلى جغرافيا ومأساة أخرى، لكن يبدو أنك لم تغادر الجزائر تماماً... فهل كتبت هذا العمل وعينك لا تزال فعلاً على وطنك؟
- كتبت في «حطب سراييفو» عما وقع في البوسنة والهرسك في تسعينات القرن الماضي، وهي أحداث تتشابه مع ما وقع في الجزائر في الحقبة عينها. أقمت في سراييفو – بضعة أشهر - وشغلتني التّشابهات التّاريخية بينها وبين الجزائر، لا سيما في العنف الذي تعرّضت له. كتبت عن بلدين جمعت بينهما ذاكرة ممزّقة. ما وقع في التسعينات لم ينتهِ. لا يزال التّطرّف حاضراً في المدرسة كما في المسجد، في الكتب كما في التّلفزيون. هنالك ابتذال في ممارسة عنف معنوي ضدّ المرأة، وفي تكفير الكاتب أو الفنان لذلك لا أكتب عن التاريخ من موقع المؤّرخ، الباحث عن استعادة كرونولوجيا، بل أستعير منه حكاياته كي أسرد ما يحصل أمام عيني.
* في روايتك «أربعون عاماً في انتظار إيزابيل» ثمة محاولة لإحياء سيرة واحدة من الشخصيات التاريخية الأكثر إثارة للجدل، وهي الكاتبة والرحّالة السويسرية إيزابيل إيبرهارت التي عاشت جزءاً من حياتها القصيرة في الجزائر، ما سبب اختيارك تلك الشخصية؟
- علاقتي بإيزابيل إيبرهارت بدأت في سنّ مبكرة كعلاقة شخصيّة. فقد سبق لها أن أقامت في مدينة بوسعادة، في بيت جنب بيتنا. ولا تزال الألسنة تحكي حكايتها. قبل أن أكتب عنها رواية، طالعت كلّ أعمالها، من قصص ويوميات. كتبت عنها أكثر من مقال واستطلاع مطوّل يقتفي رحلتها في الصّحراء. شعرت أن من المنطقي أن أستعيد سيرتها بشكل متخيل، بالأحرى سيرة موازية لها، لأنّها تمثل تناقضات الزّمن الذي نعيش فيه: أجنبية في مجتمع مغلق، امرأة في مجتمع ذكوري، على سبيل المثال لا الحصر. كانت أول أجنبية تتعلّم العربية في الجزائر ثم تكتب بها. كونها امرأة فقد كانت ولا تزال عرضة للتشويه، من طرف مؤسسات أكاديمية باتت تمارس قراءات دينية للأدب، رغم أن عاشت بين الأهالي ودافعت عنهم. يسعدني أن هذه الرّواية صارت مرجعاً في الدّراسات ما بعد الكولونيالية، في الجزائر وخارجها. لست أدافع عن إيزابيل إيبرهارت، لكن يهمّني هذا النّقاش الذي لا يزال يدور حولها حتى اليوم.

* هل لجوؤك للتاريخ بمثابة هروب من الواقع؟
- أنا لا أهرب من الواقع، بل إنني في اشتباك دائم معه. لا ألجأ إلى التاريخ بقصد الهروب من رقابة أو تفادياً لممارسة رقابة ذاتية على كتابتي، بل التاريخ هو نافذة أطلّ منها على يجري من حولي. في الجزائر أشعر أنه لا يمكننا الحديث عن حاضر ولا عن مستقبل، بحكم أننا نعيش في حلقة من التّكرار. أحداث ووقائع تعيد نفسها كلّ مرّة. نعيش في ماضٍ مستمرّ. لم نتخلّص من علاقتنا المرضية به.
* العام الحالي يشهد مرور 100 عام على صدور أول رواية جزائرية مكتوبة باللغة الفرنسية، إلى أي حد لا يزال «سؤال الهوية» وثنائيتا «الفرنسية والعربية» و«الاستعمار ولاستقلال» عناصر ضاغطة في المشهد الأدبي الجزائري المعاصر؟
- الرواية الجزائرية أقدم من ذلك. بحكم أن رواية «خضرة راقصة أولاد نائل» صدرت عام 1910 (مع أنّها رواية أنثروبولوجية تتطابق في رؤيتها للأهالي مع الرّؤية الكولونيالية). صحيح أننا نعيش انقساماً في الجزائر. لا توجد رواية واحدة، بل نحن في مواجهة روايتين. الأوّلى ناطقة بالفرنسية والثّانية بالعربية لم يتعد عمرها نّصف القرن (بالإضافة إلى رواية جديدة مكتوبة بالأمازيغية). لا يزال سؤال الهوية سؤالاً مركزياً في الأدب الجزائري. ففي ظلّ تغييب العلوم الإنسانية، بات الأدب وحده بديلاً عن هذه الدّراسات في الجزائر. قد يقول البعض إن من أزمات الجزائر فشل الدّيمقراطية، الرّشوة والفساد، وقضايا أخرى مشابهة، لكن برأيي أن أزمة الجزائر ولدت منذ اللحظة التي جرى فيها تحييد العلوم الإنسانية، تزامناً مع الإعلاء من شأن الشّريعة في المدارس والجامعة. في هذا الجو لا يمكن أن نتفاءل بميلاد مواطنين أسوياء. مسألة اللغة أيضاً لا تزال في واجهة الخصومات. كلّما حصل سوء فهم دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، فإن الأدب هو من يدفع الثّمن. يصير كلّ كاتب جزائري باللغة الفرنسية خائناً. هكذا ببساطة، مع أن اللغة الفرنسية حاضرة ولا يمكن محوّها، تحوّلت من «غنيمة حرب» إلى «بارود حرب». من جهة أخرى لا تزال اللغة العربية محتجزة بين ضفتين: بين لغة فقهاء تراوح بين الحلال والحرام، أو لغة ساسة يستغلونها في حملاتهم الانتخابية، برأيي أن مهمّتنا الأخرى في الكتابة هي إعادة اللغة العربية إلى موضعها الطّبيعي، كلغة حوار وانفتاح على الآخر، بعيداً عن تجاذبات الدّين والسّياسة.
تاريخ الجزائر حقيبة أسئلة. المجهول منه أكثر من المعلوم، وما يحصل في الجزائر يحصل في بلدان عربية أخرى، حيث هناك من يستفرد لوحده بكتابة التّاريخ
سعيد خطيبي:
* حصلت على جائزتي «كتارا» و«الشيخ زايد للكتاب»، فضلاً عن جائزة «ابن بطوطة» في أدب الرحلة... هل ترى أن الجوائز يمكن أن تكون سلاحاً ذا حدين؟
- النّاشر هو من يرشح الرّواية، وليس الكاتب. وأشكر ناشري (هاشيت أنطوان/ نوفل) على ثقته. تاريخ الجوائز الأدبية هو تاريخ قصير، مقارنة بتاريخ الأدب العربي. من المنطقي أن يثار نقاش حولها كلّ سنة، وسوف يستمر الحال كذلك في السّنوات القليلة المقبلة. لكن يجب ألا ننسى أن الجائزة الأدبية من شأنها المشاركة فيما يمكن أن نُسميه (الاقتصاد الثّقافي)، فهي ترفع من عائدات سوق الكتاب، والمستفيد هو النّاشر قبل الكاتب. كما أنها تتيح اهتماماً غربياً بالكتاب العربي، على عكس ما كان يحدث في الماضي. من المفيد تنويع الجوائز، وتدشين جوائز للقرّاء والمكتبات، والأهم من ذلك أن نؤمن بديمقراطية الأدب. وبحقّ النّقاد من لجان التّحكيم في التّصويت على كتاب، وأن ذلك لا يعني إنقاصاً من قيمة كتاب آخر. في النهاية هدفنا واحد: إعادة الكتاب إلى قائمة أولويات المواطن العربي.