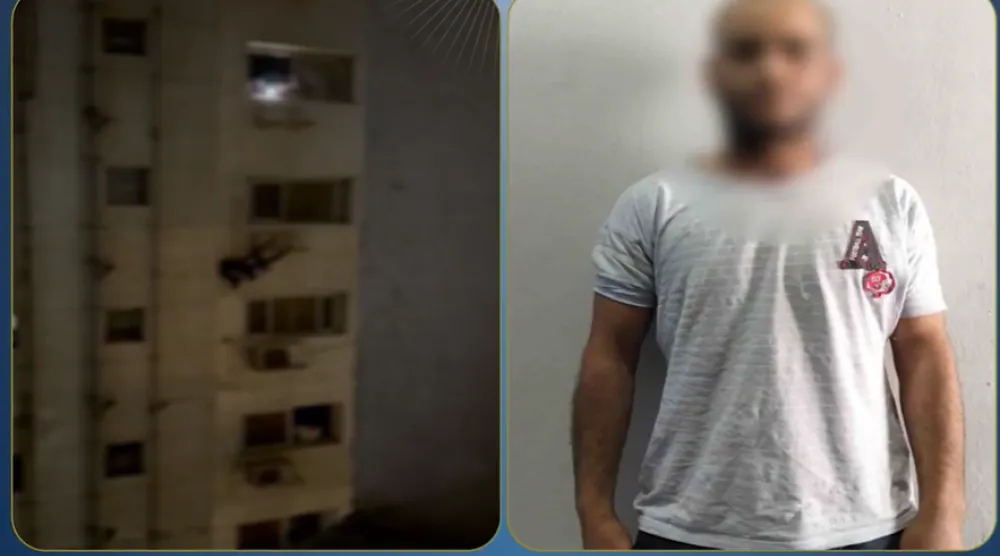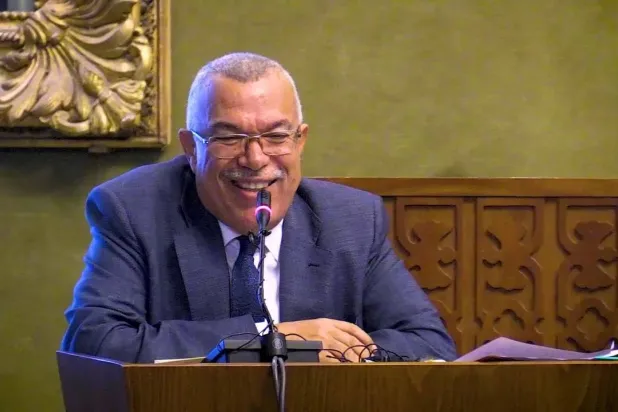والجهل حظك إن أخذت العلم من غير العليم
ولرب تعليم سرى بالنشء كالمرض المُنيم
هذه الأبيات من قصيدة أحمد شوقي الموسومة بـ«أرسطاطاليس» وترجمانه (التي كتبها تهنئة لترجمة الفيلسوف والسياسي والمفكر المصري الكبير أحمد لطفي السيد لكتاب «الأخلاق» لأرسطو). وكأن أمير الشعراء في استخدامه لصيغة المبالغة «عليم» أعطى رسالة مباشرة لأحمد لطفي السيد بأن يتولى المتمكنون من المعرفة فقط تدريس الطلبة بطريقة أرسطو عند تعلمه وتعليمه الفلسفة والمنطق، وإلا تحول الطلبة لجهلة أو نسخ جامدة من الكتب! فيخاطب أمير الشعراء المفكر والمسؤول أحمد لطفي بلغة المفكرين الحاذقين العالية. كيف لا وأحمد لطفي السيد من أهم مفكري مصر الحديثة، وهو الذي تولى وزارة المعارف ثم الخارجية في مصر، وأحد مؤسسي جامعة القاهرة، ومجمع اللغة العربية، والذي يقول عنه العقاد: إنه أفلاطون الأدب العربي.
دعونا نجاري الغرب في نظرته الاستعلائية في ادعائه أن بداية الفلسفة بشكل عام، والعلمية بشكل خاص، كانت على يد اليونان في القرن السادس قبل الميلاد، مدخلاً لنا لفهم الطريقة التي ميزت اليونانيين في نهجهم العلمي الذي فاقوا به الأمم السالفة. وحتى نجد لنا عذراً في مجاملة استعلاء الفكر الغربي - لفهم منطلق حكمه - نأخذ مثالاً بسيطاً لتوضيح الفكرة. فمثلاً صحيح أن البابليين قد سبقوا اليونانيين في إثبات أن مربع العدد الصحيح «س»، مضافاً له مربع العدد الصحيح «ص»، يساوي مربع العدد الصحيح «ع» في حالات محددة من الأعداد الطبيعية الصحيحة، وهي نظرية متطابقة مع نظرية مربع طول الوتر في المثلث القائم الزاوية لفيثاغورث الذي جاء بعد ذلك. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الذي جعل علماء الرياضيات ينسبون هذه النظرية لفيثاغورث اليوناني ويكيلون له المديح على هذه النظرية العبقرية التي تقوم عليها معظم البراهين الرياضية منذ ألفين وثلاثمائة سنة تقريباً، ويتجاهلون عمل البابليين السابق؟ وقس على ذلك تجاهلهم لما قدمه المصريون والسومريون والآشوريون والكنعانيون والفنيقيون والصينيون من نظريات كثيرة قبل ظهور أول فلاسفة اليونان الطبيعيين طاليس (غير أرسطاطاليس موضوع القصيدة) قبل ألفين وستمائة سنة تقريباً.
ما قبل سقراط وبعده
الفلسفة اليونانية تاريخياً تقسم إلى مرحلتين: ما قبل سقراط وما بعد سقراط، حيث تتميز الفترة الأولى بأنها طبيعية ورياضية، ثم تفرعت لفروع علمية وغير علمية في أواخر هذه المرحلة، مع ظهور تحديات سقراط للمسلمات الذهنية في حواراته مع مناظريه، لينتهي به الحال للحكم عليه بالإعدام من قبل أصحاب العقول الأقل شأناً. وهذه المرحلة الأولى من تأريخ الفلسفة هي التي تعنينا في هذا المقال بعيداً عن مثل أفلاطون ومنطق أرسطو في مرحلة ما بعد سقراط. اليونانيون في هذه المرحلة سلكوا مسلك الإثبات العلمي والنقد العلمي في نظرتهم لأي افتراضات علمية، وتدوين العلوم في كتب تحفظها ويدرسها المتمكنون للطلبة الأذكياء دون جعل النظريات العلمية حتمية بل ظنية قابلة للنقد إلا في حالات نادرة. أقليدس - مثلاً - لم يكتف بتدوين النظريات الرياضية في كتابه «الأصول» فقط، بل برهن على صحتها أو نقل براهين صحتها. كما أن اليونان لم يكتفوا فقط بمنهج البرهان والدليل المنطقي والإثبات العلمي والتدوين، بل أضافوا إليه البناء التراكمي للعلوم وتطورها من مرحلة لأخرى وانفتاحهم على علوم الحضارات الأخرى، كما فعل فيثاغورث نفسه الذي هام عدة عقود في طلب المعرفة منتقلاً بين مراكز الحضارات الشرقية في مصر وبلاد ما بين النهرين.
ومن أهم إسهامات اليونان إشاعة العلم وجعله متاحاً للجميع على عكس الحضارات السابقة التي تعاملت مع العلوم كأسرار في أيدي الكهنة، كما فعلت الكنيسة تماماً بالدولتين الرومانيتين الشرقية والغربية حين أغلقت آخر المدارس الفلسفية بحجة نشر الهرطقة ومحاربة الدين في القرن الخامس الميلادي، وحصرت العلوم كلها في أيدي القساوسة والكرادلة خلف أسوار الأديرة المحصنة، وفسرت الظواهر الطبيعية طبقاً لفهم الكنيسة للكتاب المقدس المحرف، فأدخلت أوروبا في ظلام دامس لألف عام.
الابتعاد عن المنهج العلمي الرصين والمنطقي والجري التائه خلف الترف الفكري والميتافيزيقيا الخيالية وهدر المواهب في لغو العقول يسقط أي حضارة، فضلاً على أن يبني حضارة على أسس علمية راسخة. هذا المنهج العلمي النقدي والمنطقي الذي ميز النصف الأول في القرن العشرين في مشهد استثنائي من تأريخ الحضارة البشرية أخرج فيها العقل البشري أعظم ما وهبه الله له.
طرق تعليمية عقيمة
إن الطريقة التي تقوم على أسلوب حفظ المعرفة العلمية فقط أو خلطها بالشوائب غير العلمية تبقى طريقاً عقيمة أمام تطور المعرفة بصورتها الشاملة. فكلما كانت النظرية العلمية أو المنطق العلمي قابلين للشك والتجربة والنقد، ويخضعان لمنهج التصحيح الذاتي، فتحا آفاقاً جديدة من أبواب العلم، وتجاوزا حدوده الآنية إلى حدود ودرجات أرفع. وهذا هو سر حضارة اليونان العلمية الطبيعية العميقة والعظيمة التي لا تزال آثارها إلى اليوم في بطون نظريات وقوانين ومنطق المعرفة. ذلك هو المطلب الأساس في منهج تعليم فلسفة العلوم (الرياضيات والفيزياء والكيمياء بشكل رئيس) لدينا ليصبح المعلم العليم شجاع العقل - كما وصفه شوقي - هو من يفَهم طلبتنا قيمة عقولهم.