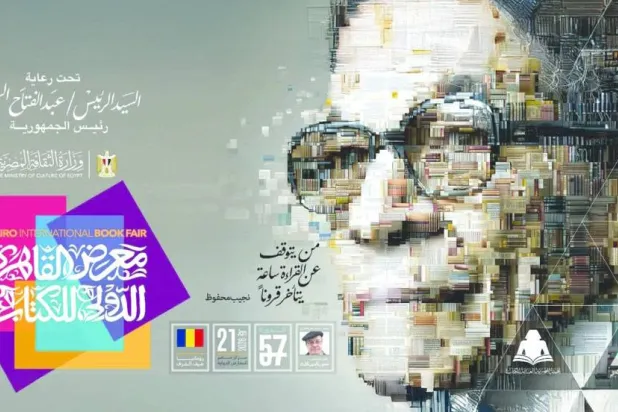تمزج قصة «من الزمن الصعب» للدكتور المعماري نبيل عيسى أبو دية بين أحداث الواقع ومأساويته وسخرية الحياة، لا سيما حين يتعلق الأمر بالهجرة، سواء الشرعية أو تلك التي تتم بطرق مختلفة تتحايل على القوانين المسموح بها دولياً.
يتضمن الكتاب الصادر حديثاً عن «الآن ناشرون وموزعون» في الأردن، بوحاً سردياً متواصلاً لا ينقسم إلى فصول ولا أرقام، وإنما يأتي دفقة واحدة منذ صفحته الأولى وحتى نهاية القصة التي أعقبها المؤلف بجملة «هذه القصة مستوحاة من أحداث حقيقية».
يبدأ أبو دية تمهيد الكتاب قائلاً: «عمان مدينة المهاجرين؛ هاجر إليها الشراكسة في نهاية القرن التاسع عشر بحثاً عن الأمان بدءاً بعام 1878، ثم جاءها الأرمن الناجون من المذابح في الحرب العالمية الأولى عام 1915، وتلاهم الأحرار السوريون واللبنانيون؛ أنصار الثورة العربية الكبرى، بعد هزيمة ميسلون عام 1920، ثم الدروز بعد ثورة سلطان باشا الأطرش ضد الفرنسيين في سوريا عام 1925، وتلاهم أبناء مدينة السلط بعد زلزال 1927 المدمر الذي دمّر أجزاء كبيرة من مدينتهم الجميلة، وسكنوا جميعاً في وسط مدينة عمان».
يكتب أبو دية في التمهيد للكتاب: «(الزمن الصعب) يذكِّرنا بصعوبة الحياة في تلك الفترة، وبخاصة في القرى الأردنية الصغيرة. كل شيء يعتمد على هطول المطر. لا مطر فلا غلال، ومآل ذلك الجوع والفقر. هكذا كانت الأحوال في تلك الفترة، في منتصف العشرينيات من القرن الماضي؛ لا حلَّ سوى الهجرة لمن استطاع ذلك».
ويواصل المؤلف حديثه: «ما زال شبابنا اليوم يحلمون بالهجرة لكنهم لا ينتمون إلى (الزمن الصعب)، فهم يذهبون وبجيوبهم بعض المال وإن كان ضئيلاً، ويسافرون بالطائرات فيصلون إلى وجهتهم بسويعات قليلة، ويجدون في الغالب من يستقبلهم في بلد العمل، وينقلهم إلى أماكن سكنهم، المجهزة والمفروشة أحياناً، وفي الغالب يتحدثون لغة المقصد، أو الإنجليزية على الأقل. شتان بين هذا الزمن وذاك. (الزمن الصعب) ولَّى، ونرجو ألا يعود، ولكن كان للأشياء قيمة عالية وعزيزة، وكانت الفرحة بها كبيرة».
من أجواء الكتاب:
«كان أبوه وأجداده فلاحين مزارعين، واضطرته الظروف إلى أن يجرب حظه في بلاد الغربة، وبعرق جبينه وتعبه، وذكائه الحاد، نجح. واختار العودة إلى موطنه، وأنشأ عائلة، وبنى، وزرع، لكن هذه المرة لحسابه. ولم يكن يحب أن يناقش آراءه في الدين، ففي حين كانت الزوجة مؤمنة متدينة، تعيش باطمئنان ووداعة في عالمها الصغير، كان هو أقرب إلى الفيلسوف، منفتحاً على العالم الواسع الذي شهده في رحلاته وغربته. فكان كالرحالة الأوروبيين في القرن السادس عشر والقرون التي تلت، لحظة اكتشافهم للصين واليابان والمشرق والمغرب العربي، وأفريقيا، وغيرها. عرفوا هم آنذاك أن العالم أكبر بكثير مما عهده آباؤهم وأجدادهم، وأن الحضارة ليست قصراً على الحضارة الأوروبية، وأن هناك حضارات وعوالم أكبر بكثير مما كانوا يتخيلون. كان هو مثل ذلك، وأكسبه ذلك بُعد النظر وسعة الأفق، لكنه، رغم ذلك، لم يتخلَّ عن جذوره، فكان في غير استحياء يقتبس من الإنجيل والقرآن، وكان من عباراته المفضلة اقتباس للسيد المسيح: (ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان)».