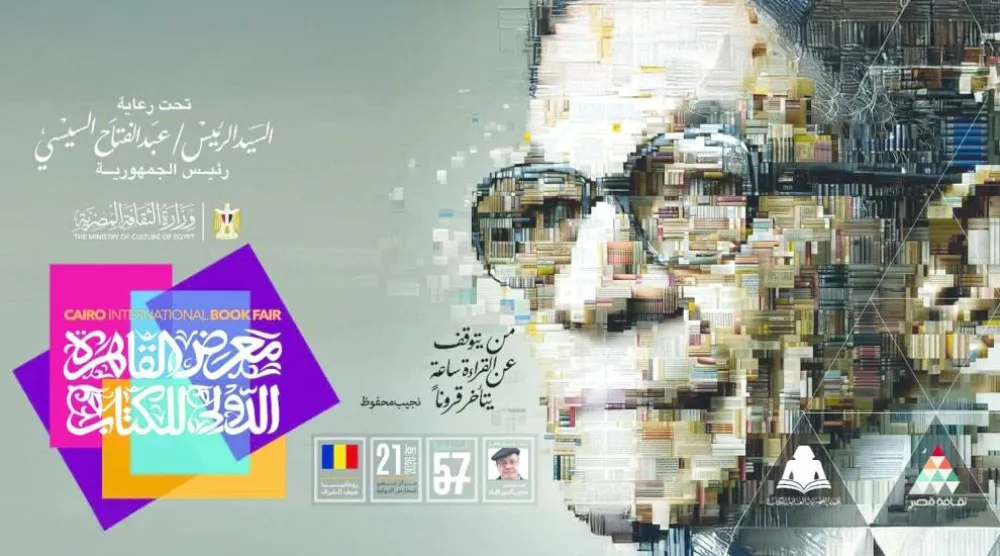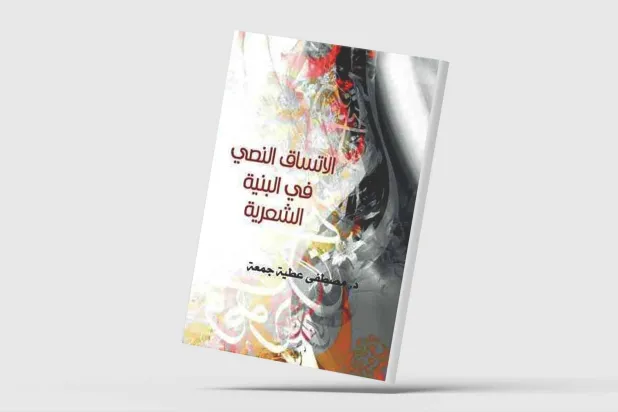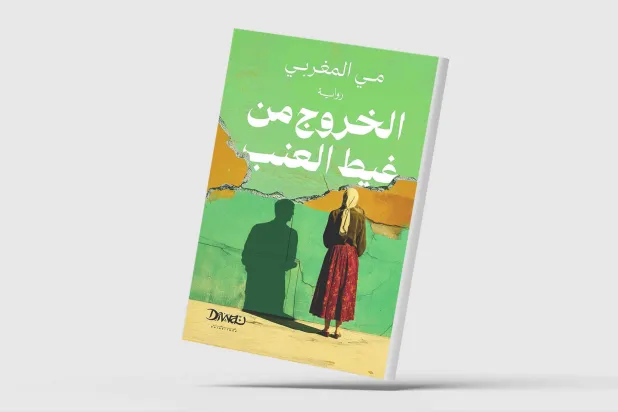أراقب باهتمام كبير عالمنا المتغير هذا. لعلك أنت أيضاً تفعل ذلك. تتمعن فيه وهو يعيد تشكيل ذاته مثل وحش أسطوري، في زمن إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ وما لهما وما عليهما... في زمن الروبوتات المؤنسنة والعقول الذكية الاصطناعية وما لها وما عليها، تحدُث من حين لآخر هزات عنيفة تحلج بعض العقول الهانئة، ذات القناعات القانعة، فتستيقظ بغتة على أسئلة طارئة. مدوِّخة بلْ مكهرِبة.
- ما هذا الذي يحدث؟
تماماً كما حدث في المعرض الدولي للكتاب في الجزائر، حدث ذلك منذ طبعتين في الصالون الدولي للكتاب في باريس، إذ حضر كتاب كبار ذوو شهرة عالمية، كل واحد منهم يركب أعلى ما في خيله، وحطّت رحالَها دورُ نشرٍ لا يشقّ لها غبار. لكن المنظمين والمشاركين والملاحظين والمراقبين والذين يعجبهم العجب، والذين لا يعجبهم العجب، على حين غرة وفي غفلة من أمرهم، فوجئوا بآلاف القادمين من الزوار شباباً وبالغين، كلهم يتجهون صوب طاولة، تجلس خلفها كاتبة في العشرينات، لا تعرفها السجلات العتيقة للجوائز، ولا مصاطب نقاش المؤلفين في الجامعات، أو في القنوات الشهيرة المرئية منها والمسموعة. الكاتبة تلك شابة جزائرية تفضّل أن تظلَّ حياتها الخاصة في الظِّل، اسمها سارة ريفنس، وتُعد مبيعات نسخ رواياتها بعشرات الملايين، أما عدد قرائها فبعدد كتّاب العالم أجمعين.
وكالعادة، وكما حدث منذ سنوات مع الروائية الجزائرية الشابة سارة ريفنس، أثار القدوم الضاج للكاتب السعودي أسامة مسلم ذهول جل المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي، حين حضر إلى المعرض الدولي للكتاب في الجزائر 2024. وقبله معرض الكتاب بالمغرب ومعارض كتب عربية أخرى، وفاجأ المنظمين والزوار والكتاب فيضانُ نهر هادر من الجموع الغفيرة الشابة من «قرائه وقارئاته». اكتظ بهم المكان. جاءوا من العاصمة ومن مدن أخرى أبعد. أتوا خصيصاً للقائه هو... هو وحده من بين الكتاب الآخرين الكثر المدعوين للمعرض، الذين يجلسون خلف طاولاتهم أمام مؤلفاتهم، في انتظار أصدقاء ومعارف وربما قراء، للتوقيع لهم بقلم سائل براق حبرُه، بسعادة وتأنٍّ وتؤدة. بخط جميل مستقيم، وجمل مجنّحة منتقاة من تلافيف الذاكرة، ومما تحفظه من شذرات ذهبية لجبران خليل جبران، أو المنفلوطي أو بودلير، أو كلمة مستقاة من بيت جميل من المعلقات السبع، ظلّ عالقاً تحت اللسان منذ قرون.
لا لا... إنهم جاءوا من أجله هو... لم تأتِ تلك الجموع الغفيرة من أجل أحد منهم، بل ربما لم ترَ أحداً منهم، وأكاد أجزم أنها لم تتعرف على أحد منهم... تلك الجموع الشابة التي ملأت على حين غرة أجنحة المعرض، ومسالكَه، وسلالمَه، وبواباتِه، ومدارجَه، واكتظت بهم مساحاته الخارجية، وامتدت حتى مداخله البعيدة الشاسعة. يتدافعون ويهتفون باسم كاتبهم ومعشوقهم، هتافات مضفورة بصرخات الفرح:
- أووو... أووو... أووو أسامة...!!
يحلمون بالظفر برؤيته أخيراً عن قرب، وبلقائه هذه المرة بلحمه وعظمه، وليس شبحاً وصورة وصوتاً وإشارات خلف الشاشات الباردة لأجهزتهم الإلكترونية. يأملون بتوقيعه على الصفحة الأولى من إحدى رواياته، ولتكن روايته «خوف» مثلاً.
هكذا إذن... الأدبُ بدوْره، أضحى يرفض بيت الطاعة، بل يهدمه ويِؤسس قلعته الخاصة، التي تتماهى مع هندسة ذائقة العصر الجديدة، القابلة للنقاش. إنها الإشارة مرة أخرى ومنذ ظهور الكائن البشري من نحو ثلاثة مليارات سنة، على أن الزمن يعدو بالبشر بسرعة مدوخة، بينما هم يشاهدون - بأسف غالباً - حتف الأشياء التي تعوّدوا عليها، وهي تتلاشى نحو الخلف.
من البديهي أن الكتابة على الصخور لم تعد تستهوي أحداً منذ أمد بعيد، سوى علماء الأركيولوجيا الذين لهم الصبر والأناة، وقدرة السِّحر على إنطاقها، وقد أثبتوا ذلك بمنحنا نص جلجامش، أول نص بشري كتب على الأرض، وأما نظام الكتابة فقد تجاوز معطى الشفهية إلى الطباعة، ثم إلى الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي و...!
على ذِكر الذكاء، فليس من الذكاء ولا الفطنة التغاضي عن الواقع المستجد، أو التعنت أمام فكرة أن العالم في تغير مدوّ وسريع، وقد مسّ سحره كل جوانبه ومنها سوق الأدب، ولا بد من الاعتراف أن المنتِج للأدب كما المستهلك له، لم يعودا خاضعين في العرض والطلب لشروط أسواقه القديمة، وإن لم تنقرض جميعها، في ظل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتوفر الـ«بلاتفورم» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«فيسبوك» وهاشتاغ وما جاورها.
لكن الأمر الذي لا بد من توضيحه والتأكيد عليه، أن دمغة الأدب الجيد وسمة خلود الإبداع، لا تكْمنا دوماً وبالضرورة في انتشاره السريع، مثل النار في الهشيم، وقت صدوره مباشرة، وإلا لما امتد شغف القراء عبر العالم، بالبحث عن روايات وملاحم وقصص عبرت الأزمنة، بينما لم تحظَ في وقتها باهتمام كبير، والأمثلة على ذلك عديدة ومثيرة للتساؤل. أسامة مسلم، وسارة ريفنس وآخرون، كتّاب بوهج ونفَس جديدين، على علاقة دائمة ووطيدة وحميمية ومباشرة مع قرائهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي، فلا يحتاجون إلى وسيط. مؤلفون وأدباء شباب كثر عبر العالم، من فرنسا وأميركا وإنجلترا وكندا وغيرها مثل Mélissa Da Costa - Guillaume Musso - Laura Swan - Morgane Moncomble - Collen Hoover - Ana Huang وآخرين وأخريات ينتمون إلى عالم رقمي، تسيطر فيه عناصر جديدة تشكل صلصال الكتابة وجسر الشهرة... لم يمروا كما مر الذين من قبلهم على معابر الأدب، وتراتبية مدارسه المختلفة التي وسمت مراحل أدبية متوهجة سابقة لهم، ولم يهتموا كثيراً بالنّسَب الجيني لأجدادهم من الروائيين من القارات الخمس بمختلف لغاتهم، ولم يتخذوا منهم ملهمين، ولا مِن مقامهم هوى. كتابٌ شباب، أضحت مبيعات رواياتهم تتصدر أرقام السوق، فتسجل عشرات الملايين من النسخ، وتجتاح الترجمات عشرات اللغات العالمية، ودون سعي منهم ترصد ذلك متابعات صحافية وإعلامية جادة، وتدبج عنهم مقالات على صفحات أكبر الجرائد والمجلات العالمية، وتوجه لهم دعوات إلى معارض الكتب الدولية. كتاب لم يلجئوا في بداية طريقهم ومغامرتهم الإبداعية إلى دور النشر، كما فعلت الأجيال السابقة من الأدباء، بل إن دور النشر الكبيرة الشهيرة لجأت بنفسها إليهم، طالبة منهم نشر أعمالهم في طباعة ورقية، بعد أن تحقق نجاحهم من خلال منصات النشر العالمية وانجذب إليهم ملايين القراء. فرص سانحة في سياق طبيعي يتماهى مع أدوات العصر مثل: Wattpad - After Dark - nouvelle app - Creative Commons وغيرها.
ولأن التفاؤل الفكري يرى فرصة في كل عقبة، وليس في كل فرصة عقبة كما جاء على لسان وينستون تشرشل، ولأن الوعي بالحداثة يأتي متأخراً زمنياً، فإن ما يحدثه الكتّاب الروائيون الشباب Bests eller البستسيللر في العالم، من هزات مؤْذنة بالتغيير، ومن توهج استثنائي في عالم الكتابة، ومن حضور مُربك في معارض الكتاب، تجعلنا نطرح السؤال الوجودي التالي: هل ستتغير شروط الكتابة وتتبدل مقاييسها التقليدية، وهل ستنتفي معارض الكتاب أم تتغير. وكيف ستكون عليه إذن في الأزمنة المقبلة؟