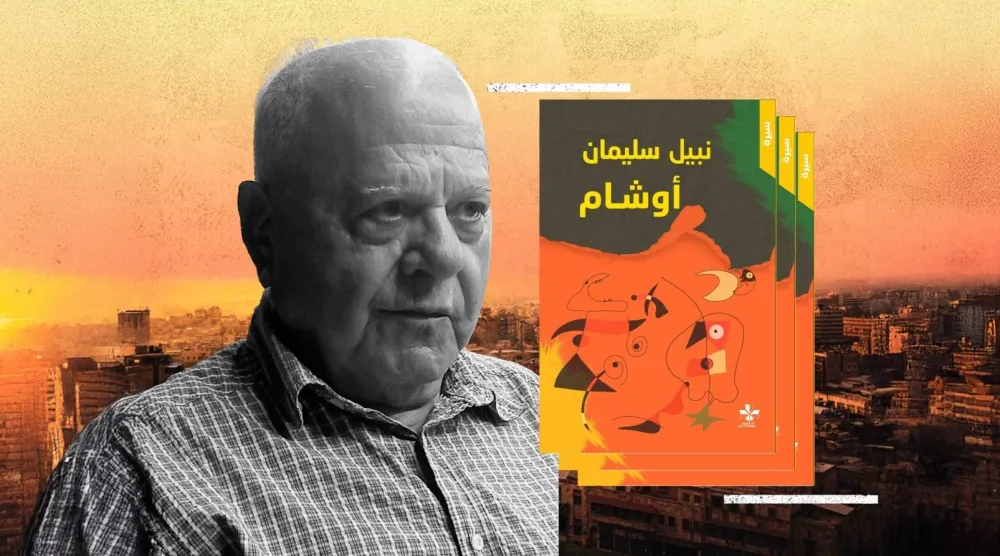تقدم الكاتبة السعودية عائشة مختار عملها «الريح لا تستثني أحداً» بوصفه «مُتتالية قصصية»، ينهض معمارها على فن القصة القصيرة المُكثفة، إلا أن دائرتها السردية لا تكتمل سوى بتوالي الأحداث التي تتشارك فضاء الحدث.
تلعب قصص المجموعة، الصادرة عن دار «حياة»، على رمزية الريح التي تمنحها الكاتبة سلطة غاشمة وسحرية، وفي المقابل يبدو البشر محض هشيم في قبضتها، فتكون «ليلة الريح الأولى» هي الحدث المركزي الذي تظل تبعاته الكابوسية تلاحق أهالي القرية وتجلب معها الأهوال. وأولها أنهم لم يعودوا يتذكرون شيئاً مما جرى ليلتها، في تلميح مبكر لما يحمله تشوّش الذاكرة من لعنة، ثم سرعان ما تستحوذ «الرائحة» بطاقتها الحسيّة على زمام الأمور، فتزيد من غبش الرؤية، بعدما تسود رائحة «طاغية لا مثيل لها» فضاء القرية في أعقاب تلك الليلة، بما لها من خواص غرائبية، فلا تشمها النساء، فيما تُزكم أنوف الرجال، فيكون ظهورها واختفاؤها بعد ذلك دليلاً على ما غيّرته الريح في أجوائها، والسطور التي خطّتها ومحتها، ولا تختفي تلك الرائحة سوى بمولد طفلين بعد 9 أشهر من تلك الليلة، ليكونا طفلي الريح، وحاملي سرّ الأم التي اختفت في سنوات طفولتهما الأولى، وتبدو فصاحتهما المُبكرة وظروف نشأتهما الغريبة كفيلة بأن تجعل أهل القرية يصفونهما بـ«المبروكين»، فيقطعان على مدار المتتالية القصصية دروباً تأملية في اقتفاء الحكمة، وتلمّس النبوءة، وأسرار الكلمات، كما يصبحان قبلة لأهل القرية من «السائلين»، الذين تُخرجهم الريح من رقودهم، لتوقظ داخلهم الألم، والشعور العارِم بالذنب.
قلوب مثقوبة
تتفرع الحكايات عبر 3 فصول رئيسية هي: «الرجل الذي تكلّم ثم صمت» و«الرجل الذي سيُحب التجوال»، و«الفتاة التي لم يعرف أحدٌ اسمها». تواصل الحكايات تقاطعها على مدار المتتالية القصصية مع ثيمات العمل الرئيسية وأبرزها الفقد والانتظار، فـ«الرجل الذي تكلّم ثم صمت» يظّل مع تقدمه في العمر يتوّسل «طيف» أمه التي غابت في طفولته، وتظل حيثيات غيابها مُغبشة ومثيرة لتوالد الحكايات، بما يزيد من عزلته واغترابه، وتظل «الريح» على مدار المُتتالية هي صاحبة السطوة السردية، فالسرد يبدأ بها، ثم تباغت أهل القرية مرة أخرى مع نهاياته، لتترك الحياة بينهما وبعدهما غارقة في الهشاشة، فهي لم تترك البشر عُراة من أسمالهم فحسب، بل كشفت عن ندوبهم الغائرة، لا سيما تلك التي تسكن الأمهات، ويبدو ثمة آصرة بين الرجلين أبناء الريح وبين أمهات القرية المكلومات، الباحثات عن رتق لـ«قلوبهن المثقوبة» بفقد أبنائهن، فتبدو لعنة أمهم الغائبة، أو الأم «الأولى»، وكأنها تُلاحق أمهات القرية من بعدها، متوسلات أن يرشدهم أحد لأبنائهن ويمتص ملوحة قلوبهن. ويصف «الرجل الذي سيُحب التجوال» جرح الأمومة باعتباره الألم الوحيد المستعصي: «أُعد وصفات لأهالي القرية طوال 13 عاماً، وصفات حلّت أحوالهم المعقدة، أعد قلباً صلصالياً، ومسحوقاً للنسيان، ودواءً للحقيقة، أعد أدوية لكل من طلب، لكنه الآن يعجز أمام الأمهات اللاتي أردن استرداد أبنائهن ذوي العيون الرمادية، السوداء، البنية، الزرقاء، الخضراء الصغيرة»، وهي الفكرة التي تتردد على مدار المتتالية، بتراوحات فنية تفيض من رحم الأمومة، وتعود أدراجها له من جديد في قصة أم أخرى.
تشتق المُتتالية القصصية من جماليات اللغة مكونات لبناء مُتخيلها الحكائي الذي ينهل من الحكايات وقوة تأثيرها
اختلاط الزمن
تشتق المُتتالية القصصية، التي حازت جائزة الشارقة للإبداع العربي، من جماليات اللغة مكونات لبناء مُتخيلها الحكائي الذي ينهل من الحكايات، وقوة تأثيرها، واللعب بالكلمات، فنرى رجلاً أصابته لعنة اللغة، ولكنه للمفارقة كلما كان «يفقد حرفاً زادت كلماته وزادت فصاحته»، كما تشتق من مفردات البيئة البدائية دلالات بلاغية، فنجد الكلمات تندفع كـ«العواصف الرملية»، وهو ما يمكن فهمه ضمن اجتراح العمل لإيقاعه وقوانينه الخاصة، فالمكان برغم تأطيره الظاهر بحدود القرية والصحراء فإنه سيّال، يفيض على هامش الواقع وفي عمق المُخيلة، حيث «المنامات» مكان للقاء الأحبة، والصحراء مكان لابتلاعهم، أما الزمن فيُفتته السرد في سعي لتوظيف دلالته وأثره على أبطاله، حيث نجد هناك: «زمن الصمت، زمن الكلام، زمن الانتباه، زمن الانتظار...»، فالزمن يختلط كالكوابيس، ويفقد أفقيته المنطقية وواقعيته وهو يعود أدراجه معكوساً، كما نرى الأبناء الذين يعودون أجنّة، والعيون تتحوّل لحُفر فارغة، وحتى نمش الوجوه يكبر ويصغر، وكأنه يحوم في مدار زمني معزول يخص سيرة أصحابه وحكاياتهم.
وفي حين تنحاز الكاتبة عائشة مختار للنزعة السحرية في بناء عالمها السردي، فإنها في الوقت نفسه تتلمس هُوية ذاتية تتقاطع مع الموروث الشعبي في كثير من محطات المُتتالية، فالشخصيات تنتظر «الكرامات» في مناماتهم، وتقطع المسافات من أجل الحصول على مشروب سحري يضمن لهم الحب، في استثمار لطاقات الغرابة في قواميس الوصفات السحرية الشرقية، التي تفيض برائحة «الأبخرة والأهازيج والتمائم»، في توسّل لأسئلة وجودية مؤرقة لدى أبطال المُتتالية، بداية من الموت، وحتى الحب، والنوم، والأحلام، والاستبدال، وأهوال الخطيئة، وهو الأرق الذي وجد مُتنفسه في طرح الأسئلة التي لا تخلو من غضب، فالراوي يتقمص صوت «الفتاة التي لم يعُد يعرف أحد اسمها»، ويسأل: «أما جمالها فما المغزى منه إذا كان قد حُكِم عليها بالتعاسة؟ والطيور التي حاولت أخذها إلى المجهول لماذا لم تُحاوِل مرّة ثانية؟ والعدل أين اختفى!».