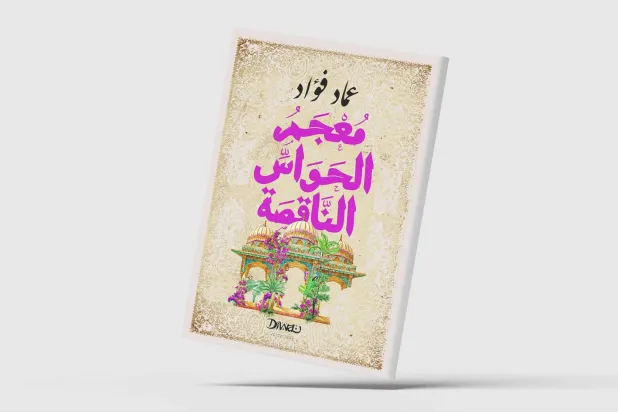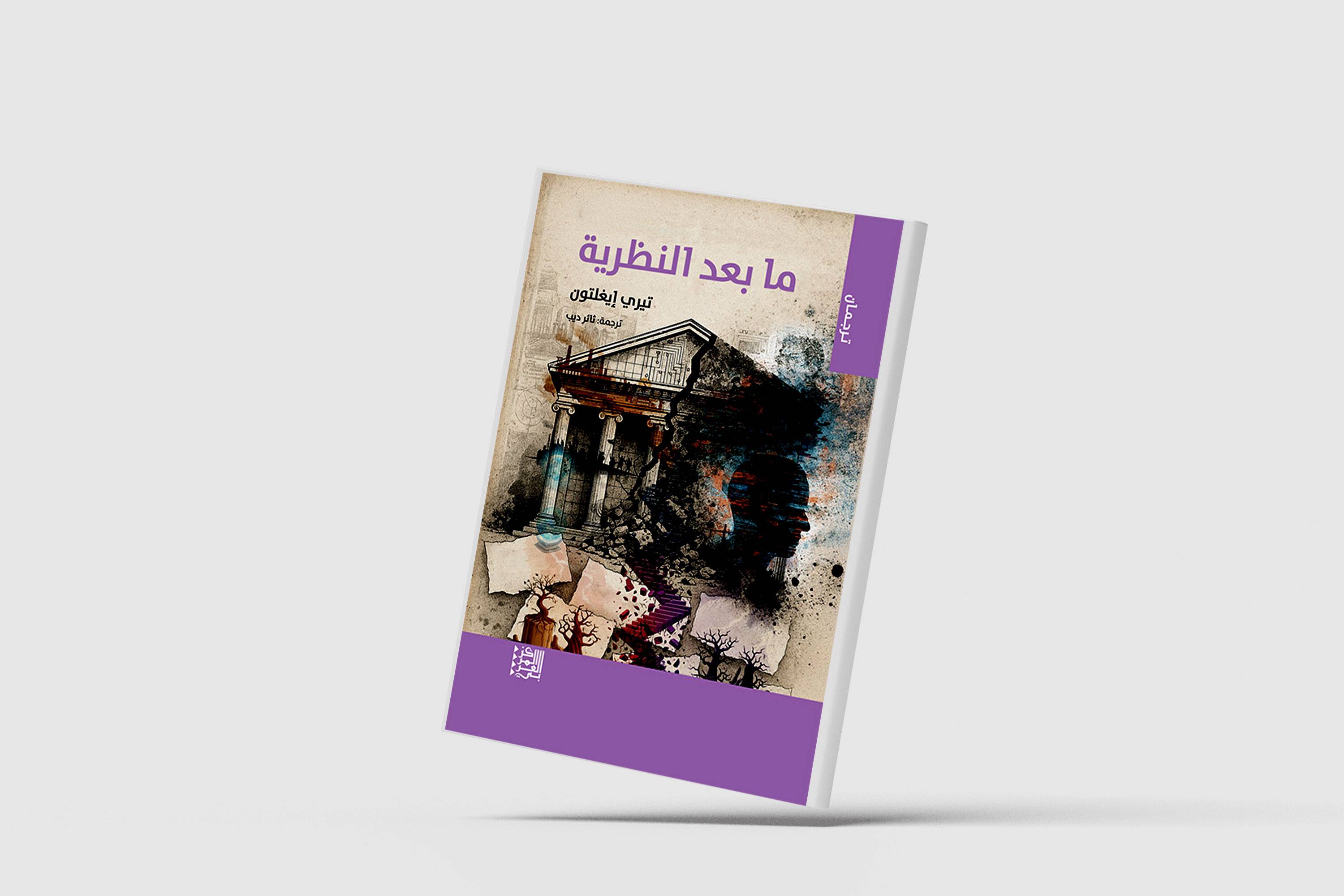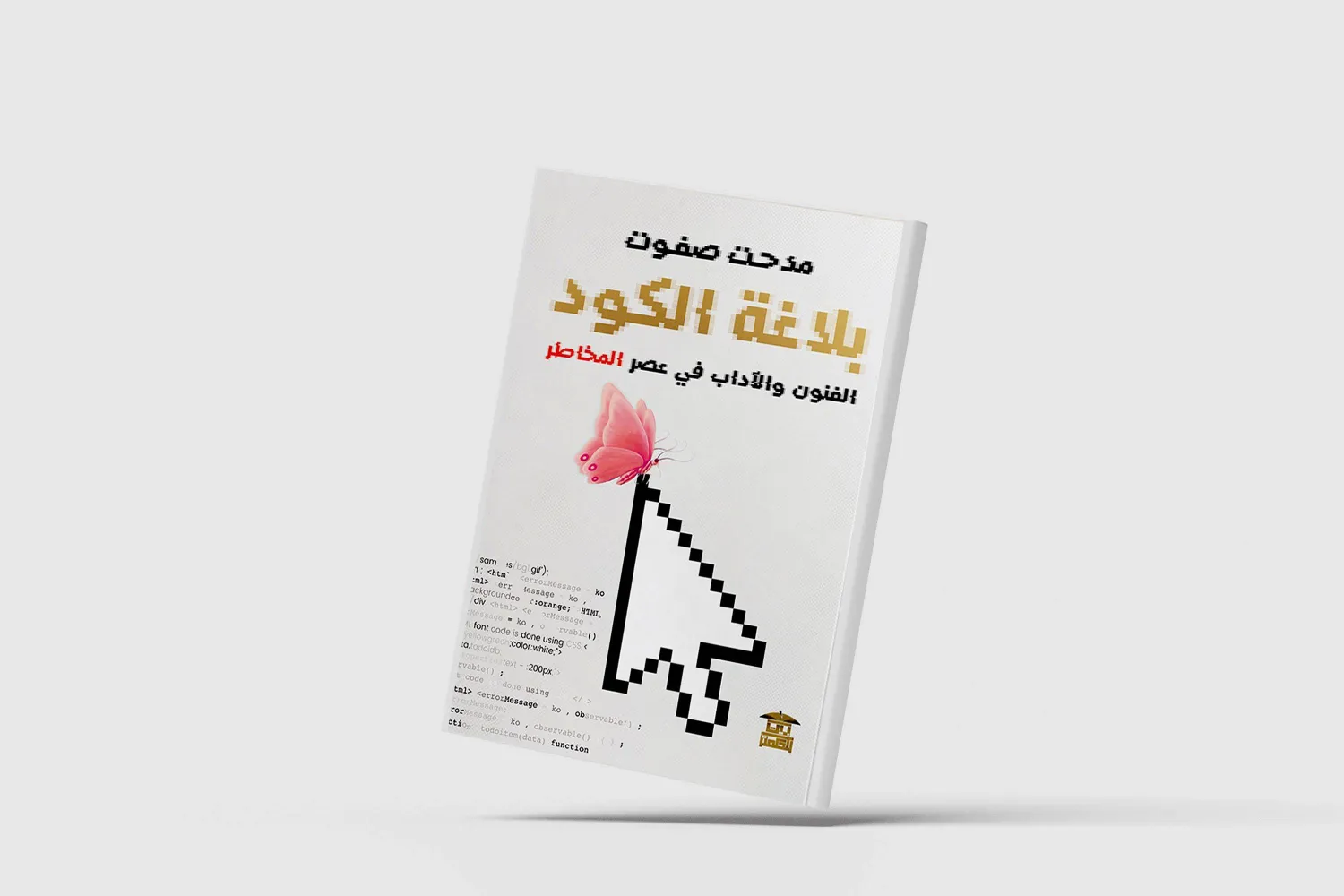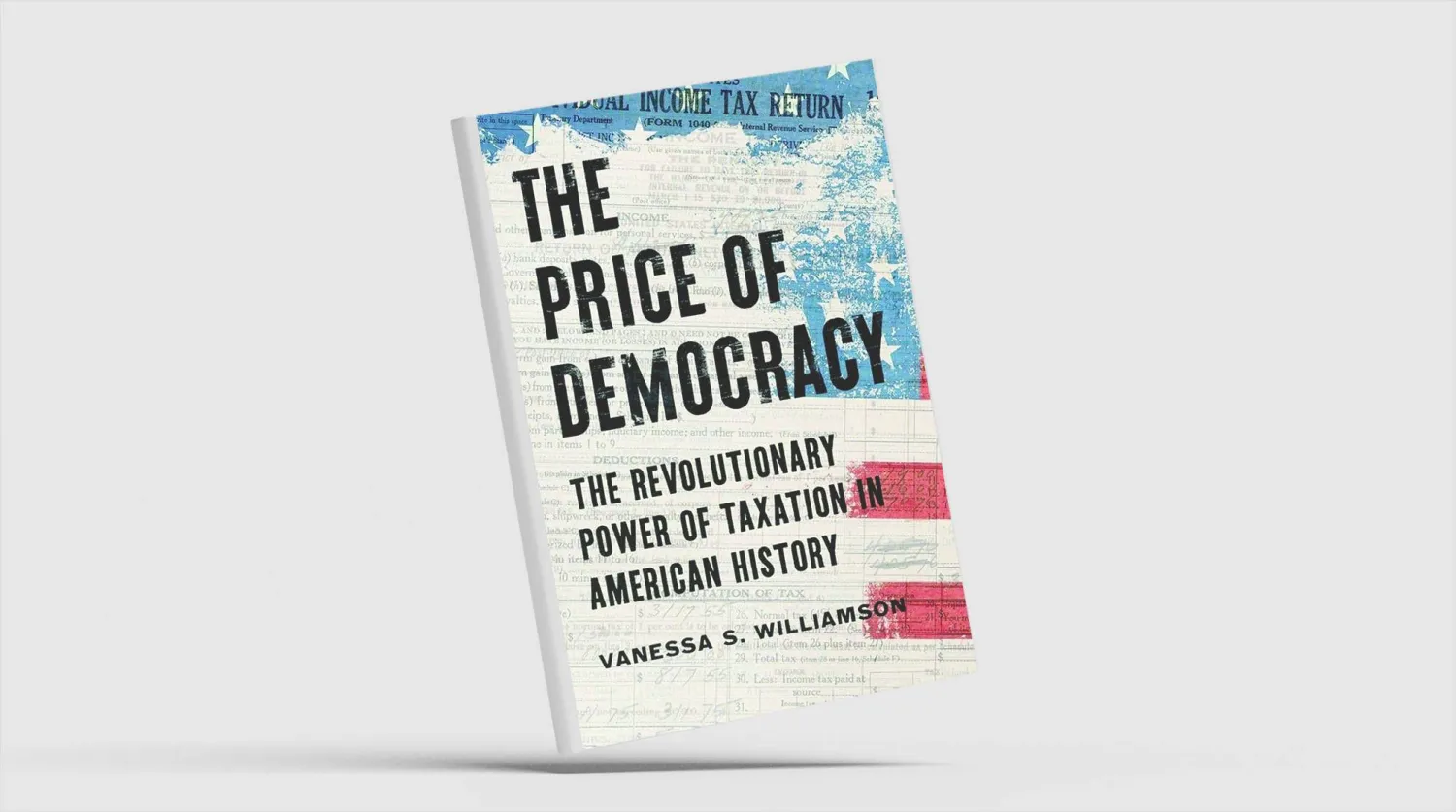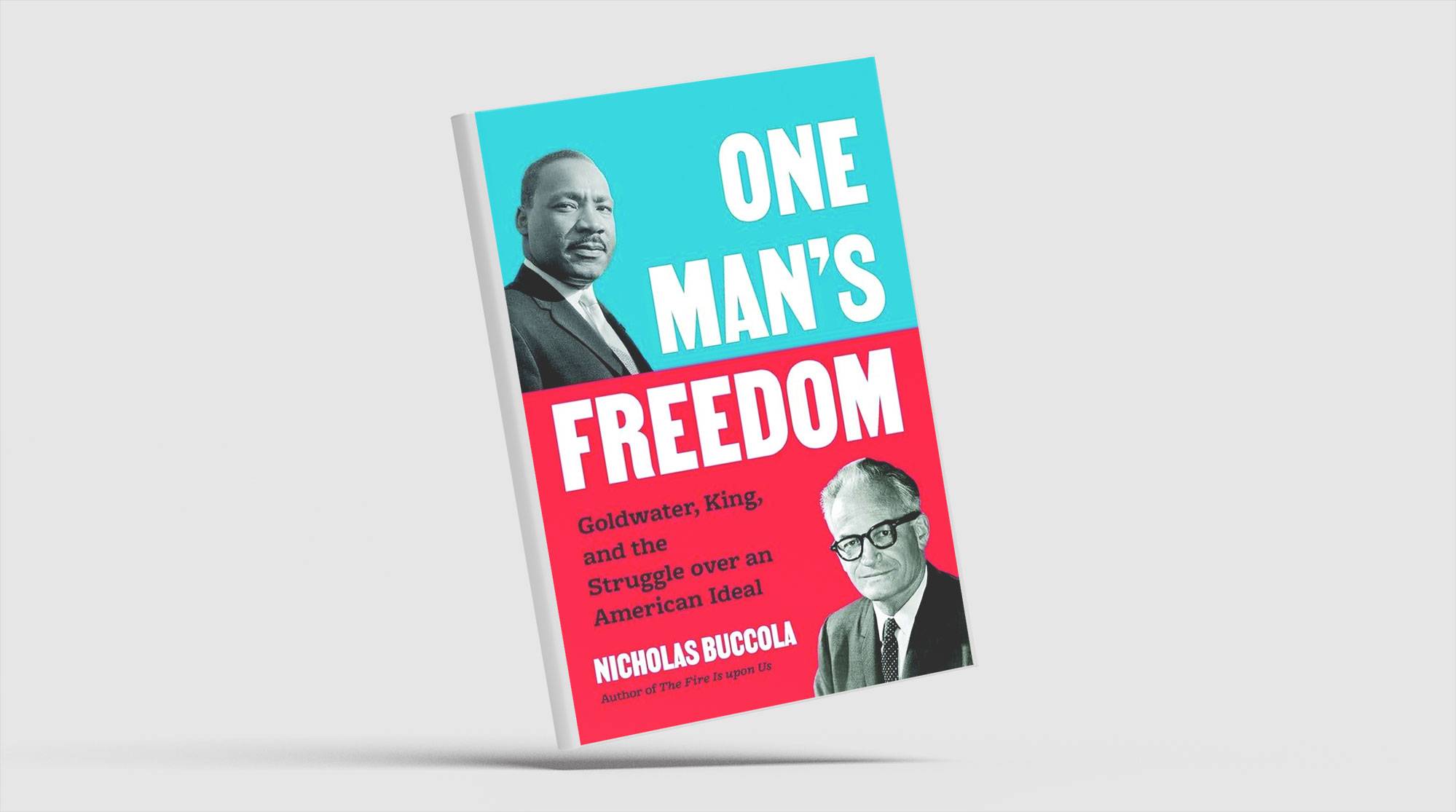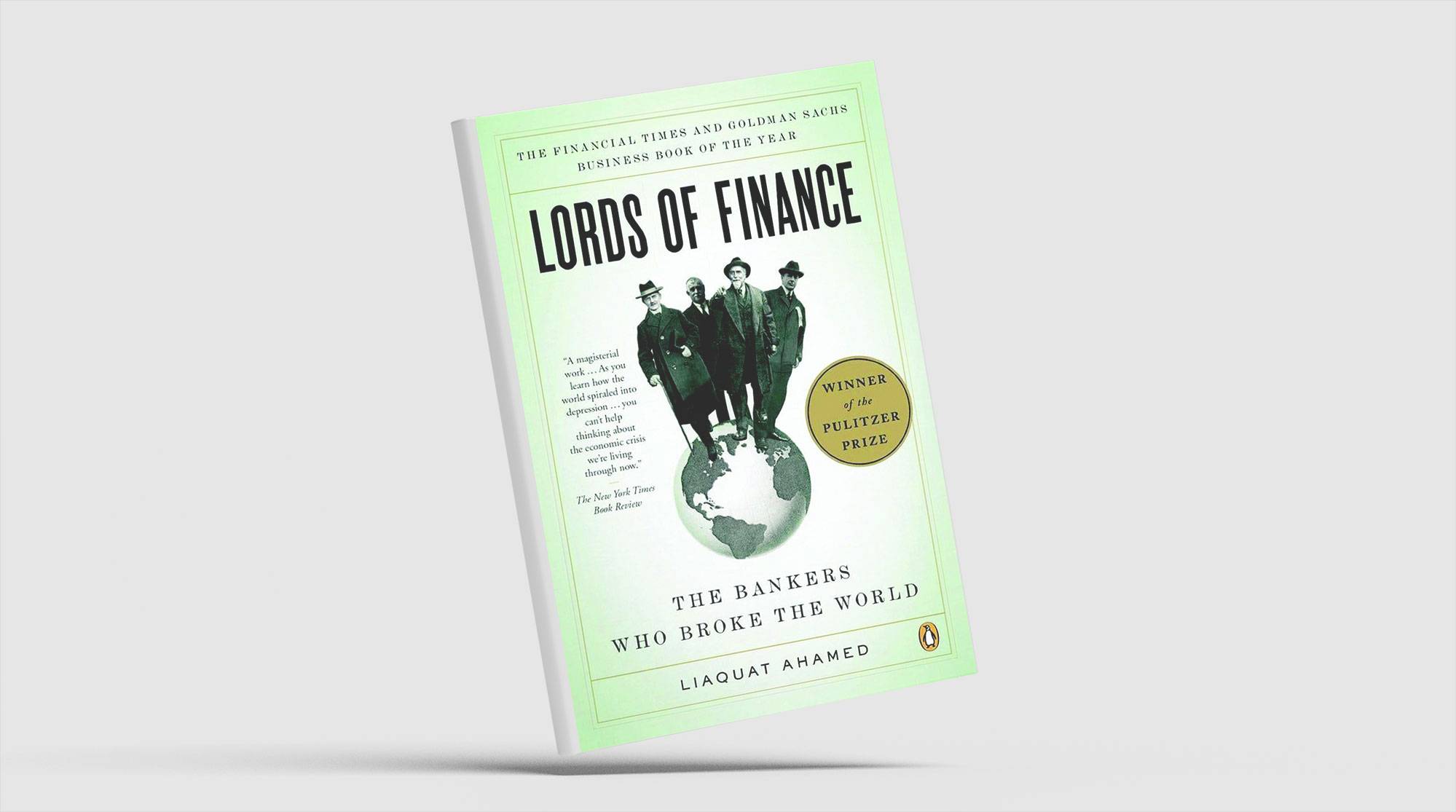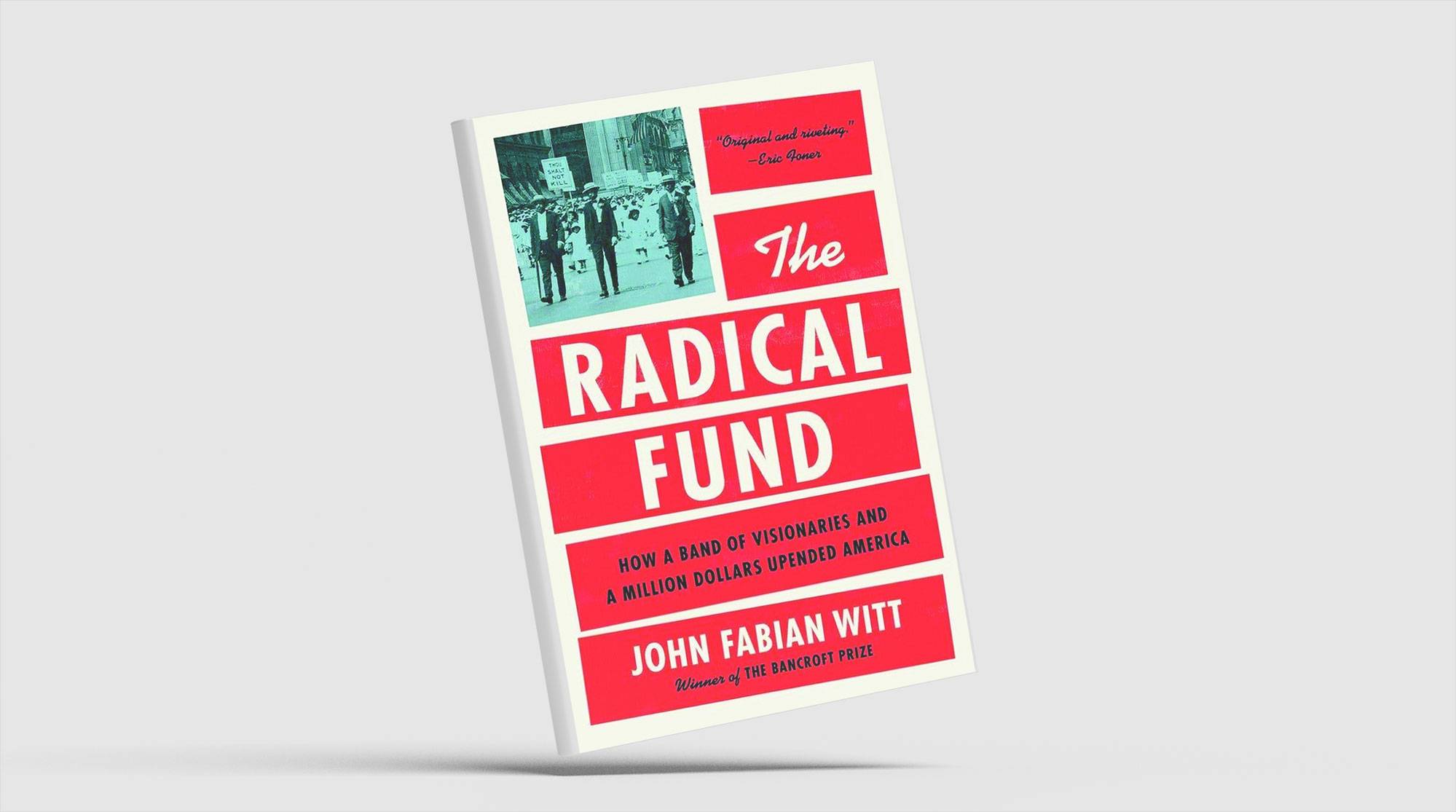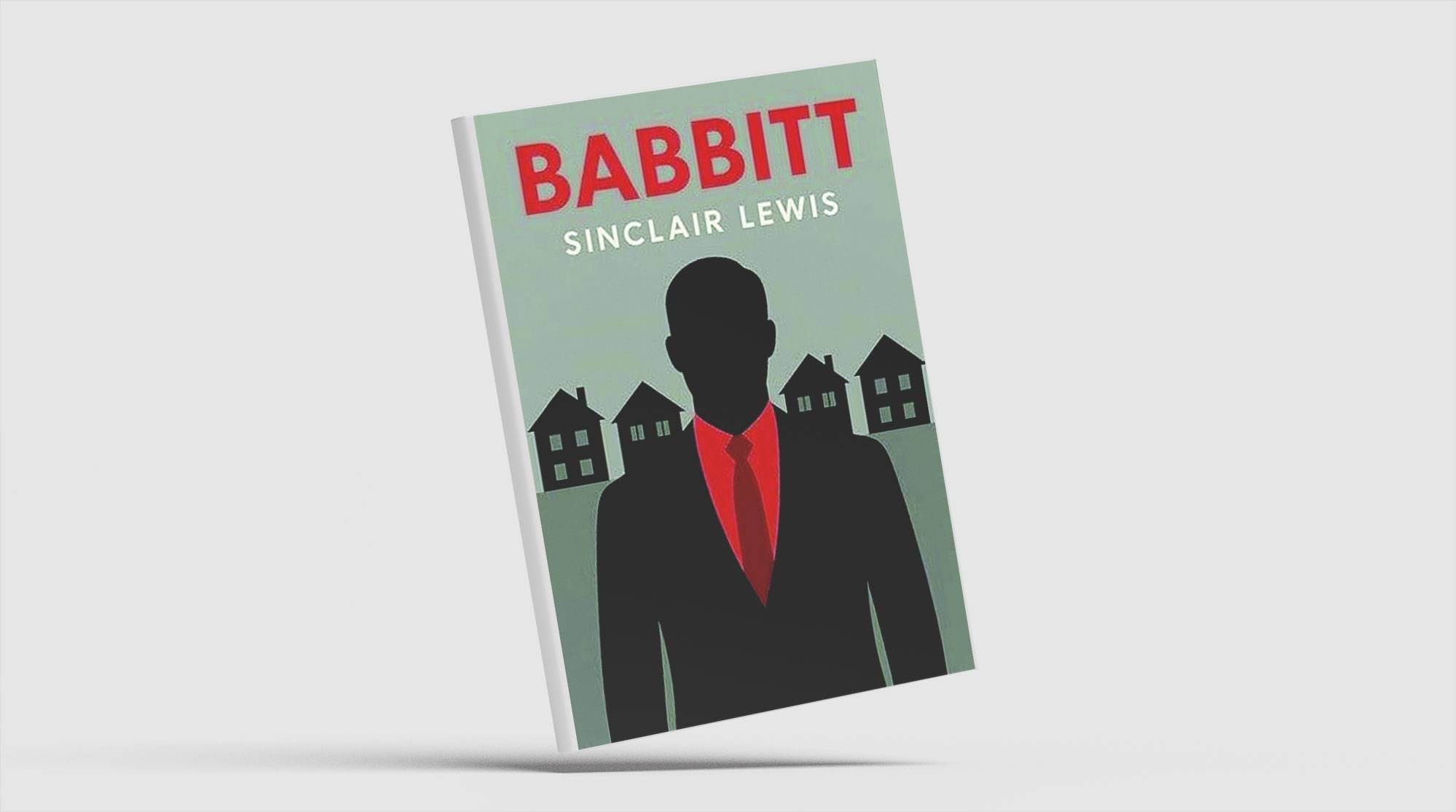إذا كنا نعرف فرجينيا وولف الروائية الكبيرة وصاحبة الأعمال الخالدة كـ«السيدة دالوي» و«غرفة جاكوب»، فإن فرجينيا الصحافية مجهولة عند الكثير. مشوارها مع الصحافة بدأ منذ 1904، حيث كتبت فيه أكثر من 500 مقال، لكن مساهمتها الممتازة في الصحف والجرائد بوصفها ناقدة وكاتبة مقال لم تجد صدًى كبيراً عند الباحثين وكتّاب سيرتها الذاتية.
أولى التجارب الصحافية عند الكاتبة البريطانية بدأت وهي ابنة التاسعة، حين كانت تكتب برفقة الشقيقين فانيسا وتوبي منشورة أسبوعية بخط اليد، عبارة عن صحيفة عائلية تضم أخبار الأهل وحكايات من وحي الخيال، وكانت تحمل عنوان: «هايد بارك جات نيوز» باسم الحي الذي كانت تقطن فيه العائلة. واستمرت 4 سنوات إلى تاريخ وفاة والدة فرجينيا، حيث كانت وقتها في الثالثة عشرة. الباحثة الفرنسية أديل كاسينيول تشرح في كتابها «قصّة في غنى عن الكلمات أو الكتابة عن الطفولة في الهايد بارك جات نيوز» أن صحيفة الطفولة كانت بمثابة مدرسة للكتابة، والفضاء الذي سمح لفرجينيا الطفلة بتحقيق ذاتها عبر الكتابة. كان والداها هما أول قرائها حيث كانت تستيقظ مع الفجر، وتضع المنشورة تحت باب غرفة النوم، مترقبة ردود أفعالهما على المقالات.
لقاء فرجينيا وولف الفعلي بالصحافة كان بعد فترة صعبة من حياتها عرفت فيها سلسلة من المحن: موت والدها في فبراير (شباط) 1904، وإصابتها بالاكتئاب، ومحاولتها الأولى للانتحار، ثم دخولها المصّحة النفسية. صديقتها عالمة النباتات والمستشرقة فيوليت ديكنسون تعلم أن الكتابة لها مفعول المهدئ لفرجينيا، فتقوم بتقديمها لرئيسة تحرير ملحق المرأة بصحيفة «الغارديان» مارغريت ليتلتون، ليثمر اللقاء تعاوناً مع الصحيفة، وكان أول مقال يُنشر لها في 21 من ديسمبر (كانون الأول) 1904 بعنوان «الحج إلى هاوورت» وصفت فيه لقّراء الصحيفة العريقة زيارتها لدير الراهبات الذي كانت تسكنه الأخوات برونتي: شارلوت، وإيميلي وآن، وبذلك أصبح هذا المقال أول نص يُنشر لفرجينيا، والصحافة أول مهنة لها وهي في سن الـ22 أي أكثر من 10 سنوات قبل أن تكتب أول رواياتها «رحلة المظاهر» عام 1915.
كتبت فرجينيا طيلة مشوارها الصحافي أكثر من 500 موضوع، وتعاونت فيها مع صحف بريطانية وأميركية ذائعة الصيت، مثل صحيفة «الغارديان» و«التايمز» و«نيويورك إفنينغ بوست» و«أكاديمي أند ليتيراتور» و«فوغ» وصحف أخرى. وكتبت بشكل أساسي في النقد الأدبي: مراجعات نقدية للإصدارات الجديدة وبأسلوب أكثر عمقاً سجلت فيها تأملاتها في الأدب والعملية الإبداعية، فاتحة فيها حواراً مباشراً مع القرّاء، كما كتبت أيضاً عن السّير الذاتية لكبار الكتّاب، وفي المقام الأول الكتّاب الروس والفرنسيون الأقرب إلى قلبها: دوستويسفكي، تولستوي، مونتان، وبالطبع، الإنجليز مثل جين أوستن وكيبلنغ. وفي مقال بالملحق الثقافي لجريدة «التايمز» نُشر في 13 من يناير (كانون الثاني) 1924 كتبت بخصوص الكاتب الفرنسي مونتان الذي كانت تعشقه وتقرأ مؤلفاته باللّغة الفرنسية: «هذا الأسلوب الذي كان يتم به الإفصاح عن الذات، وفقاً للإلهام، بمنحنيات وثقل ولون ومقاس للنفس بكل اعترافاتها وتنوعها وعيوبها... هذا الفن يعود لرجل واحد فقط هو: مونتان...». وقد يكون توجه فرجينيا وولف إلى مقالات السّير الذاتية هو سير على خطى والدها سور ليسلي ستيفن الصحافي والكاتب ورئيس تحرير «القاموس الوطني للسيرة الذاتية»، هذا الأب المثقف الراقي، الذي كان متشّدداً مع بناته لدرجة أن فرجينيا اعترفت في مذكراتها بأن موته قد حررّها؛ حيث كانت في بداية انطلاقها في الكتابة تعترف بما يلي: «اليوم ذكرى ميلاد والدي، كان سيكمل الـ96 سنة، ولكن شكراً لله لم يَصِلْها، حياته كانت ستبتلع حياتي، ماذا كان سيحدث؟ لم أكن لأكتب ولا كتاباً واحداً... شيء لا يمكن تصوره».
كتبت وولف أيضاً مقالات سياسية تناولت فيها انشغالات تلك الفترة، كحقوق المرأة والسلام، وعن دعمها للجمهوريين في الحرب الأهلية في إسبانيا. وفي موضوع بمجلة «يال ريفيو» نُشر في سبتمبر (أيلول) 1930 بعنوان: «مذكرات عاملات في التعاونية» كتبت عن تدّني الأوضاع المعيشية للنساء العاملات، ونشرت شهادات مؤثرة لمعاناة النساء من الفقر رغم العمل الشّاق، مناشدة المسؤولين تغيير الأوضاع. وفي فقرة من المقال تحدثت أيضاً عن حق النساء في التصويت، حيث كتبت: «في هذا الجمهور الواسع، من بين هؤلاء النساء اللواتي يعملن واللواتي لديهن أطفال، اللواتي ينظفن ويطبخن ويساومن على كل شيء ويعرفن كيف يصرف كل قرش، لم يكن لأي واحدة منهن الحق في التصويت».
لقاء فرجينيا وولف الفعلي بالصحافة كان بعد فترة صعبة من حياتها عرفت فيها سلسلة من المحن: موت والدها، وإصابتها بالاكتئاب، ومحاولتها الأولى للانتحار، ثم دخولها المصّحة النفسية
استخدمت فرجينيا وولف نشاطها الصحافي أيضاً منبراً دعت من خلاله إلى إنهاء الحروب والعودة إلى الأمن والسلام، فبينما كانت لندن تحت قصف الطيران النازي كتبت في مجلة «نيو روبوبليك» النيويوركي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1940 مقالاً بعنوان «اعتبارات حول السلام في زمن الحرب» جاء فيه ما يلي: «حلّق الألمان فوق منزلنا خلال الليلتين الماضيتين وهاهم يعودون. تجربة غريبة أن تستلقي في الظلام، وتستمع إلى صوت الدبابير وهي تقترب منك وتقول إن لدغتها قد تكلفك حياتك في أي لحظة. إنه صوت يمنع كل تأمل متماسك ومنسجم قد يكون لدينا بشأن السلام، ومع ذلك فهو أكثر من الصلوات، صوت يجب أن يشجعنا على التفكير في السلام».
وإضافة إلى أن الصحافة كانت الفضاء الذي سمح لها بتشكيل أسلوبها وتوسيع دائرة تجاربها وتفكيرها، فقد شكلّت بالنسبة لفرجينيا مصدر دخل رئيسياً ووسيلة لتحقيق ذاتها بوصفها امرأة حرّة مستقلة بذاتها، في نصّها المشهور «غرفة تخّص المرء وحده» عام 1929 ذكّرت الكاتبة البريطانية بأن «المرأة يجب أن يكون لديها المال وغرفة خاصة بها إذا أرادت التفرع لكتابة القصص»، وقد كان عملها في الصحافة ما سمح لها بالحصول على هذا الاستقلال المادي.
وفي محاضرة عن «المهن الخاصة للمرأة» نظمت بإشراف الجمعية الوطنية للمرأة في لندن في 21 من يناير 1931، استشهدت الكاتبة بتجربتها الخاصة بوصفها صحافية، حيث قالت: « فلنعد إلى قصّتي، الأمر بسيط يكفي أن نتخيل فتاة شابة جالسة وبيدها قلم رصاص، كل ما عليها فعله هو جرّ هذا القلم من اليسار إلى اليمين من العاشرة صباحاً حتى الواحدة، ثم تأتي فكرة القيام بشيء بسيط وغير مكلف، ثم وضع بعض الصفحات في ظرف ورميه في صندوق البريد في زاوية الشارع وهكذا... أصبحت صحافية... وكوفئت جهودي في الأول من الشهر التالي، ويا له من يوم سعيد بالنسبة إليّ حين فتحت رسالة مدير المجلة وفيها شيك بمبلع جنيه و10 شلنات...»!!!