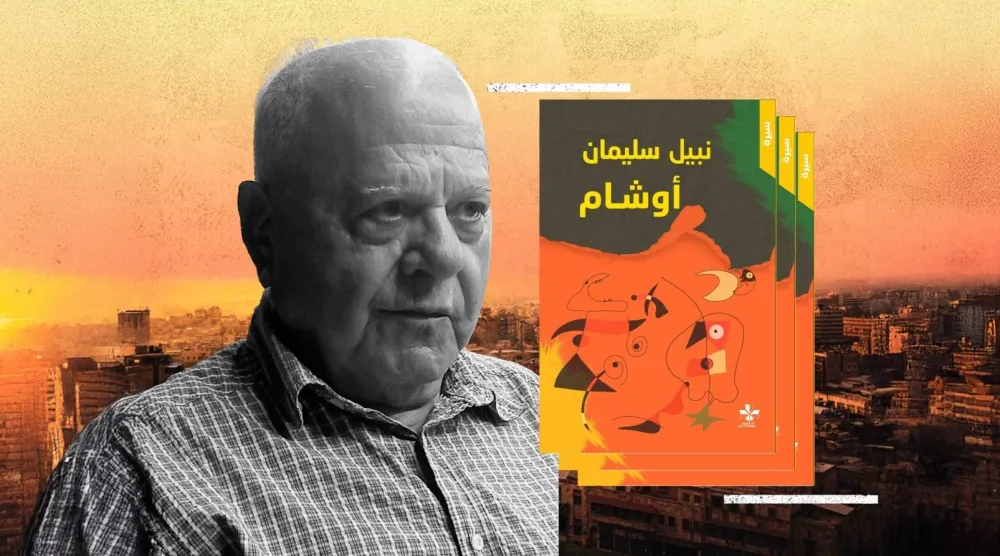ثلاث سنوات على تهشّم بيروت بالمواد المتفجّرة في الرابع من أغسطس (آب) 2020. مرَّ العام الأول، فوجدت الكاتبة والإعلامية اللبنانية المقيمة في باريس دلال معوض، أنّ الوقت حان لسردٍ يأبى طمس الذاكرة. كتابها «كل ما خسِرَتْ»، الصادر بالإنجليزية عن «منشورات بلومسباري» البريطانية، يروي شهادات عشرين امرأة ضحايا الانفجار، وضحايا قوانين التمييز أيضاً. لماذا جمعت دلال معوض هذه الشهادات، ولماذا حصرتها بالنساء ولماذا بالإنجليزية، وما الهدف من كتابها هذا؟ هنا حوار معها:
• أي مشاعر اختلطت في داخلك وأنتِ تجمعين الشهادات؟
- كتبتُ لثقل إحساسي بذنب أنني نجوتُ ونجا مقرّبون مني. شعوري بأنني محظوظة ترافق مع هذا الذنب القاسي. أنهكني سؤالُ لِمَ مات بعضٌ ولم يمت بعضٌ آخر؟ مشاعر الذنب مرتبطة أيضاً بهجرتي من لبنان. البعض يقول لي، كُفّي عن السماح لهذا الإحساس بالتمادي، لقد قُمتِ بما يجدر فعله. والذنب على صلة شديدة بالغضب. قَلَبَ ذلك اليوم حياتي، بسببه غادرتُ مُحاولةً النجاة. الغضب كبير جراء عدم المحاسبة. خلال جلساتي مع السيدات، وطوال عملية الكتابة، خيَّم الحزن. الحكايات مؤلمة، فشعرتُ بعدم كفاية أن نجلس معاً وأستمع إلى القصص لأكتبها. أحتاج إلى المزيد. ثم تذكّرتُ أنّ دوري الصحافي يقتضي القيام بذلك فقط. أنا هنا لإيصال الصوت.
• في الكتاب هو الكثير منكِ رغم أنكِ لستِ بطلته الوحيدة. لِمَ حصرته بالنساء؟
- لم أقصد ذلك. لاحظتُ، خلال عملي الصحافي، أنّ أقوى القصص مصدرها النساء. كأنهنّ يبحثن دائماً عن مساحة للبوح. وتنبّهتُ إلى أنّ التاريخ العربي والغربي قلّما كتبته امرأة. التاريخ يُكتب من منظار الرجال، علماً بأنّ للنساء دوراً أساسياً في مجرى الأحداث. لا ندرك بالفعل دورهنّ في التاريخ اللبناني القديم والحديث لأنّ المرأة لم تُدوِّن. أردتُ أن يمتلكن هذه السردية ضمن مساحة خاصة.
• المسألة تتعلق بالناجيات، وتتصل أيضاً بالهوية والانتماء وازدواجية القوانين. كيف حوّلتِ أصوات النساء إلى صرخة كبرى ضدّ أشكال الموت اللبناني؟
- الكتاب ليس عن الرابع من أغسطس فقط. هو حكاية انهيار لبنان الحديث من خلال قصص نساء يجسّدن الألم الجماعي؛ ألم كل الشعب. «كل ما خسِرَتْ»، لا تعود للنساء فقط. المؤنث ينطبق على لبنان الدولة، وعلى بيروت المدينة. تتحدّث السيدات عن الانهيار الاقتصادي، وعن وضع المرأة لجهة الأحوال الشخصية والقوانين المجحفة. إنهنّ ضحايا حقبات عنف، والتاريخ يعيد نفسه لحتمية غياب المحاسبة. تبدأ الحوارات من الانفجار، ثم أدخل وكل سيدة في منعطفات.

• يبدو كأنكِ خشيتِ من أن تُنسى الفاجعة، فسارعتِ إلى التدوين كفعل اعتراض على الإفلات من العقاب؟
- أحد أهداف الكتاب هو التوثيق من أجل المحاسبة. أردته بمثابة ذاكرة جماعية تحتضن أوجاع اللبنانيين. ليس السياسيون ولا موثّقو التاريخ أو الخبراء هم مَن يدوّنون. العمل على الذاكرة الجماعية من خلال حفظ الشهادات، خطوة ضرورية في مسار المحاسبة. جزء من هذا الكتاب هو أيضاً صرخة للالتفات إلى لبنان. كتبته بالإنجليزية ليصل بعيداً. المجتمع الدولي ينسى الانفجار، كذلك جزء من اللبنانيين. أريد العالم أن يتذكّر.
لم تنتهِ الحرب الأهلية ولا يزال التاريخ اللبناني يعيد نفسه لانتفاء العمل على الذاكرة الجماعية. الكتاب يحاول إعادة تشكيلها بأصوات الموجوعين، لعلّ العدالة تتحقّق. لا أخفي أنني خشيتُ من تبدُّد ذاكرة النساء وتلاشي التفاصيل. شعرتُ، بعد عام من الدمار، أنّ الوقت مناسب لطرق الباب. يُقال إنّ المرء يبدأ باستيعاب الصدمة بعد ستة أشهر من المأساة. وفق علم النفس، هذه فترة زمنية ملائمة للحديث عما حصل. نساء كثيرات تكلّمن للمرة الأولى وأخرجن التفاصيل والمشاعر والوجع.
لاحظتُ، خلال عملي الصحافي، أنّ أقوى القصص مصدرها النساء. كأنهنّ يبحثن دائماً عن مساحة للبوح
• كيف اكتملت القصص؟
- عرفتُ بعض النساء من عملي الصحافي، وواحدة قادتني إلى أخرى. قابلتُ أكثر من 30 امرأة قبل التوصّل إلى الشهادات العشرين. قلّة فقط رفضت الكلام. أذكر امرأة طاعنة في السنّ لم تُرد التذكُّر. معظم النساء فتحن قلوبهنّ، فدامت بعض الجلسات ساعات. تركتهنّ يتكلّمن بحرّية ويتولّين إدارة الحوار. زرتُ سيدة خسرت ابنتها في الانفجار. تحدّثنا فأخبرتني عن تعرّضها للعنف المنزلي. حقوق المرأة في لبنان تصدّرت موضوعات كثيرة. تحوّلت المقابلات إلى جلسات علاج. بكين كثيراً، فارتبكتُ حيناً وبكينا معاً أحياناً. الأكيد أنهنّ لم يكنّ قد تخطّينَ بعد.
• أكثر القصص التي أثرت فيكِ...
- تردُ في الفقرة الثالثة من الكتاب، وهي قصص نساء ضحايا الانفجار، وفي آن، ضحايا قوانين التمييز. قصة ليليان شعيتو (دخلت في غيبوبة طويلة وحُرمت من رؤية ابنها). هذه التراجيديا لم تفارقني.
• كم هو شاق، نبش الجروح!
- لم أنبش جروحهنّ، بل فعل الجرح ذلك من تلقائه. لم يكن صعباً الولوج إلى الأعماق. شهادات نساء لبنانيات وأخرى لعاملة منزل ولاجئات سوريات، جعلتني ألمس معاناة المرأة، أكانت لبنانية أم أجنبية.
• هل تشعرين براحة بعد الكتابة؟
- الكتاب جزء من مسار البحث عن الراحة، وهو يساعد في الشفاء. تجعلني القصص وعملية الاستماع إليها وكتابتها، كما كتابتي جزءاً من قصتي، في حالة أقرب إلى الركود النفسي. لكنها غيرها الراحة. رغم أنني لم أفقد عزيزاً ولم يُجرح جسدي، فإنني أسوة بهؤلاء النساء، أبحث عن العدالة. لا أحد يبلغ السكينة والحقيقة لم تُعرف بعد.