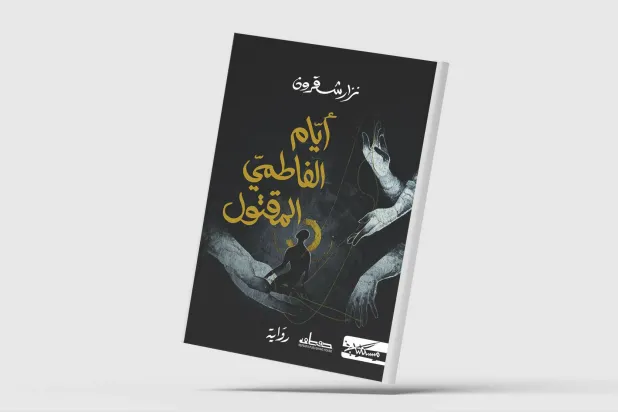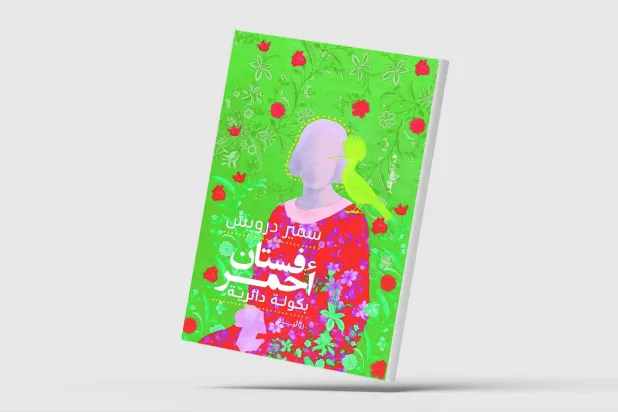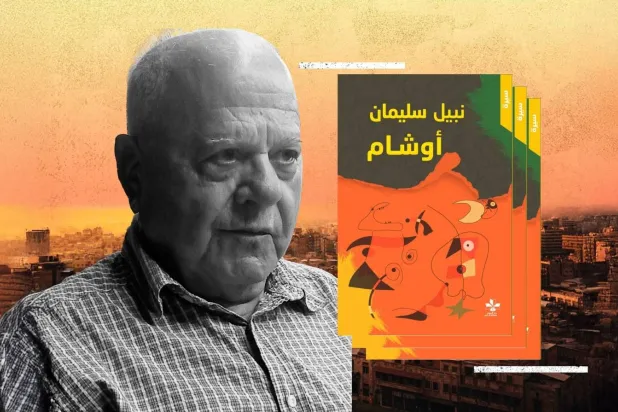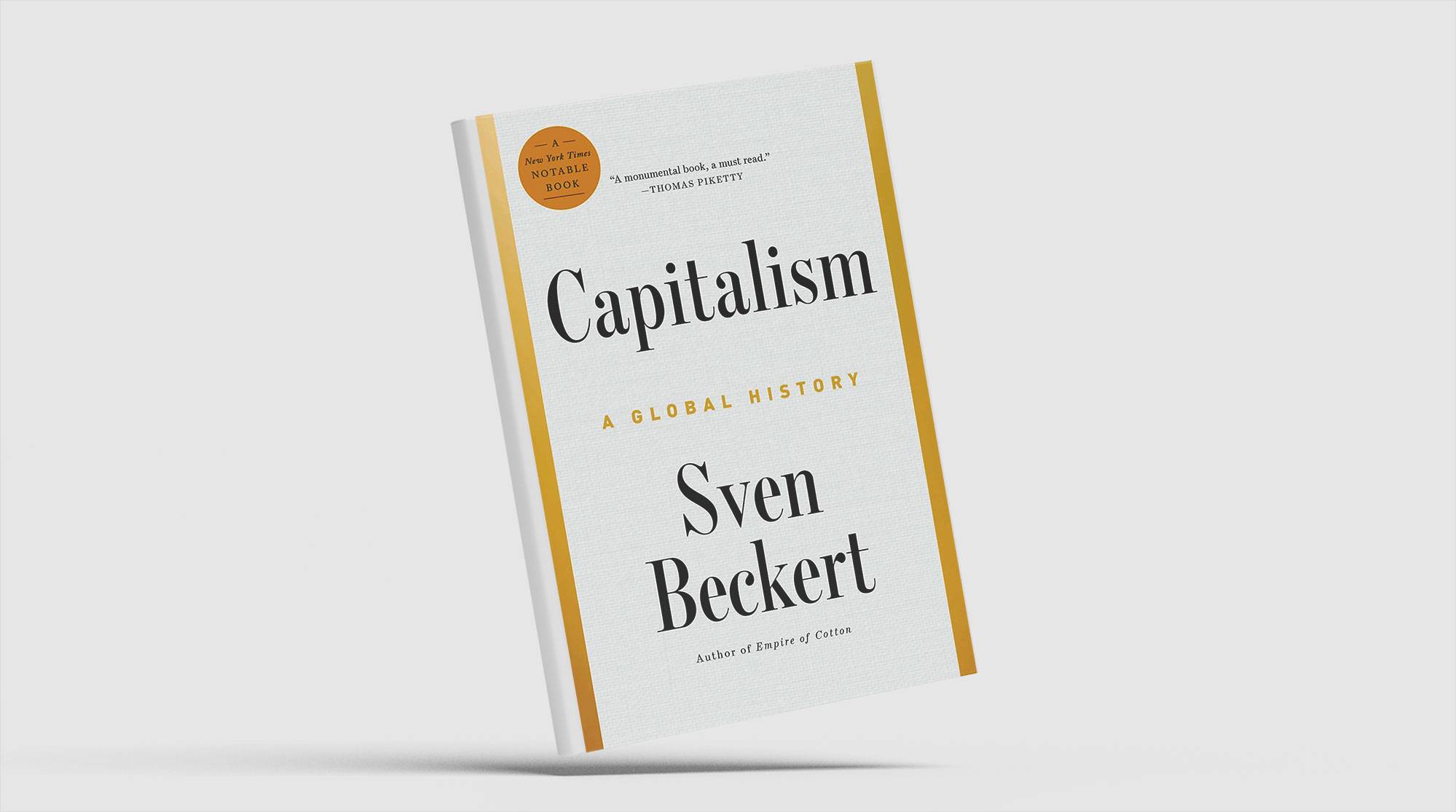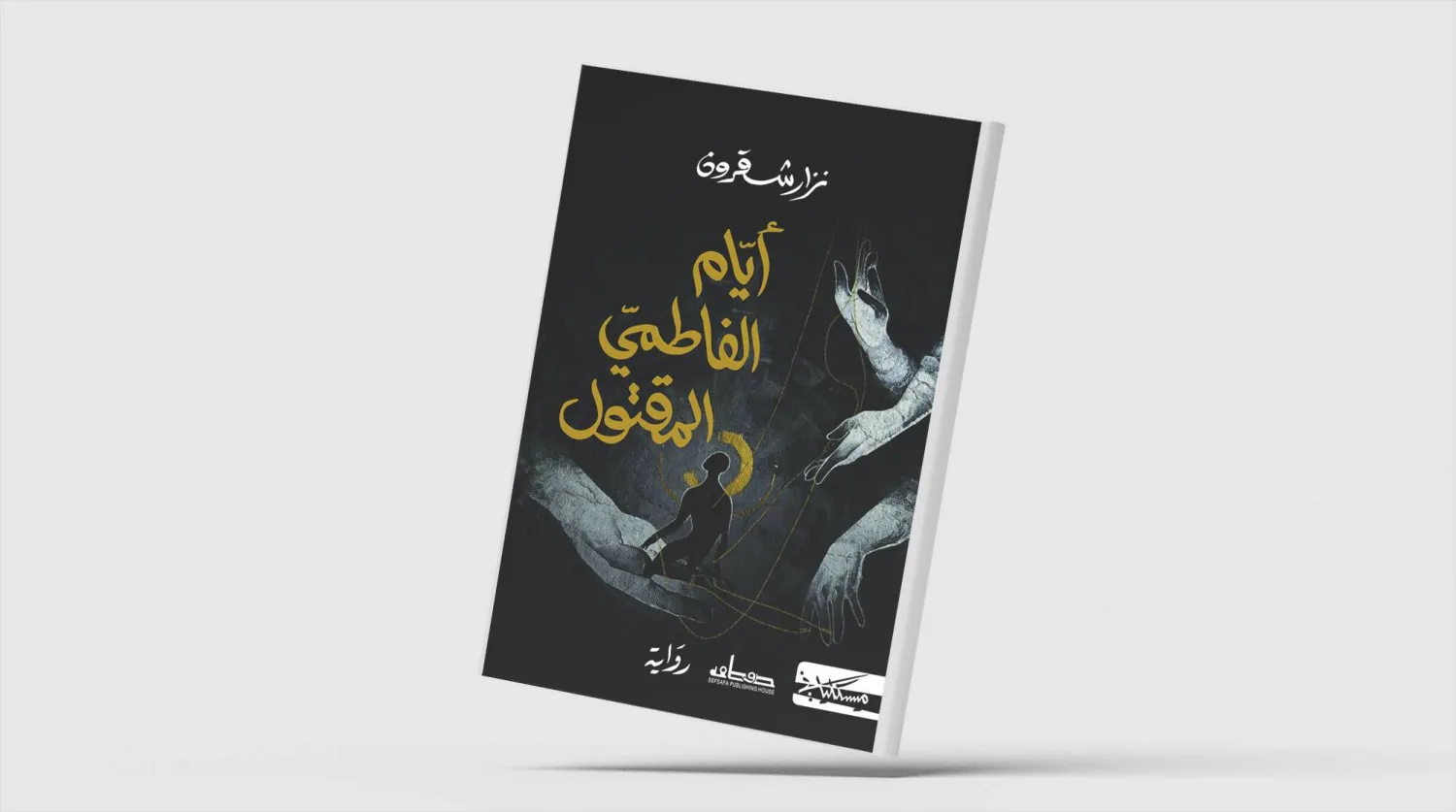يستند كل سرد لتاريخ البشرية إلى موقف نظريّ آيديولوجيّ يحكم نظرة المؤرخ لتعاقب الأحداث وتقلبات الأزمنة: فمنهم من يراه تعاقباً لسير الرجال العظماء الذين تسيدوا أقوامهم ودفعوا بهم نحو المجد أو إلى الدّمار، فهذا تاريخ الإسكندر، وتلك أيّام بني عثمان وهكذا، ومنهم من اعتبر أن التاريخ هبة الأفكار، حلقاته تدفعها أساساً تحولات الاعتقاد الكبرى، فهذا تاريخ الطوطميّة، وتلك مرحلة المسيحيّة، وأننا نعيش اليوم عصر الليبرالية الرأسماليّة، فيما قرر آخرون أن تاريخ البشر يحدث على هامش التطور التكنولوجي ونظم الإنتاج المرتبطة بها من استخدام الأدوات الحجريّة إلى الزراعة، ومن استخلاص المعادن إلى الثورات الصناعية المتعاقبة التي غيّرت من الأقدار والأعمار. لكن جوناثان كنيدي، مدير برنامج الصحّة العامة في كليّة الطب بجامعة لندن، يرى أن كل هذه التصورات حول تشكّل التاريخ تغفل النظر إلى فاعل أساس تأتي الشخصيات والأفكار والتكنولوجيات بعده، وربما نتيجة له: الجراثيم والفيروسات، والتي عبر سلسلة من الأمراض والأوبئة صنعت فضاءات تبلور الحالة البشرية، وأدارت مسار تطورها عبر الأيام. فالأمراض المعدية منذ طاعون صور الذي بدأ منه هوميروس إلياذته إلى« كوفيد-19» في راهننا، ليست عنده مجرد حالات من الوهن البشري وسوء الحظ الفرديّ، بل هي جزء أساسي من هويتنا الإنسانية، وبالتالي من تاريخنا الجمعي بوصفنا بشراً.

يضمّن كيندي في كتابه الصادر حديثاً بالإنجليزية «الأمراض: كيف صنعت الجراثيم التاريخ؟ - 2023» رواية مغايرة للمعتاد حول مسارات التحضر البشري بداية من الإنسان الأوّل، وعبر آلاف السنين لإظهار كيف أن تفشي الأمراض المعدية قد قضى على ملايين الأرواح في المراحل المختلفة فدّمر حضارات بأكملها، وأعاد صياغة المجتمعات التي نجت، فيما توّلت موجات الهجرة الهائلة تغيير النوع العرقي لمنطقة ما بالكامل أو تحصينه، وذلك عندما جلبت قوافل القادمين معها أمراضها المعدية التي لم تعرفها مجموعات السكان الأصليين، ولم تطور أجسامهم مناعة ضدّها إلى حد ما، فقضت عليهم نهائياً، أو أنّ المهاجرين وجدوا أمراضاً لم تختبرها مناعتهم من قبل فمسحوا عن وجه الأرض التي هاجروا إليها، فكأنّهم لم يأتوا يوماً لولا بعضٌ من لقى ماديّة تركوها.
يجادل كينيدي بأن وجودنا ونجاحنا في البقاء كنوع قد حسمته بداية البكتيريا والفيروسات، فيما انقرضت جميع الأنواع الأخرى من البشر. ففي وقت سحيق، شارك الإنسان العاقل المبكر (الهوموسيبيان) الذي انطلق من أفريقيا الأرض (وتزاوج مع) إنسان نياندرتال الأوروبيّ الأقوى ذي العيون الزرقاء والأكبر دماغاً، بالإضافة إلى إنسان دينيسوفان الشبيه بالهوبيت (كما في الرّواية الشهيرة). فماذا حدث لهذه الأنواع الأخرى؟ بعض النظريات تقول إننا قتلناهم جميعاً، أو أنهم كانوا بطريقة ما أقل قدرة على التكيف مع تغيرات كبرى في المناخ. لكن كينيدي يستكشف احتمال أن يكون الإنسان العاقل المتجول من أفريقيا، الذي اكتسب مناعة قوية خلال الرحلات الطويلة، قد أصاب ببساطة إنسان نياندرتال بالفعل في أوروبا بمسببات أمراض جديدة لم تستطع أجسام أولئك المستقرين محاربتها، فانقرضوا تماماً كما قضى المستعمرون الأوروبيّون، بعد عشرات الآلاف من السنين، على سكان الأزتك بنقلهم مرض الجدري لمن نجا من الهلاك بالأسلحة.
وهو يرى أن نقلة نوعيّة لقدرة الأمراض المعدية على صياغة المجتمعات البشرية حدثت عندما تحوّل الصيادون الرّحل إلى الزراعة، حيث كان الاستقرار والعيش في مستوطنات، ولاحقاً في مدن مكتظة، سبباً في تسهيل نقل مسببات الأمراض بين البشر. وهنالك أدلة من المومياوات المصريّة القديمة عن تفشي الجدري، وشلل الأطفال وأيضاً الأمراض التي ينقلها البعوض كالملاريا في التجمعات الحضريّة المصريّة. وهذه الديناميّة تكررت مرات ومرات في التاريخ، ولذلك فـ«الأوروبيون المعاصرون لا يمكن أن يكونوا (أنقياء) وراثياً، ولا هم حتى السكان الأصليين للقارة». ويظهر التحليل الجيني الحديث أن السكان الذين بنوا حضارة ستونهنج في بريطانيا تم القضاء عليهم تماماً، وتم استبدالهم بموجات من المهاجرين.
يمكننا أن نكون أكثر ثقة بالطبع بشأن التأثيرات الجيوسياسية للمرض بمجرد دخولنا عصر التاريخ المكتوب. فيذكر كينيدي أن إلياذة هوميروس - أحد أقدم النصوص التاريخية التي تتوفر لدينا من العصر الإغريقي - تبدأ من لحظة انتشار الطاعون في المعسكر اليوناني خارج طروادة. واجتاح وباء التيفوس أو الجدري أثينا من عام 430 قبل الميلاد، ما قوض قدرة أثينا على القتال ضد الأسبارطيين، وكان له تأثير حاسم على مسار ونتائج الحرب البيلوبونيسية.
كانت روما القديمة مكاناً قذراً على الرغم من حماماتها العامة الشهيرة (حيث كان الآلاف يستخدمون نفس المياه) وعرفت ارتفاعاً في معدلات وفيات الأطفال. ويقول كينيدي: «أي شخص نجا حتى سن الرشد كان سيكتسب مناعة للعيش في روما، لكن الأشخاص الذين جاءوا من الخارج، بمن فيهم أولئك الذين قدموا لغزو المدينة، كانوا معرضين لخطر كبير»، وهذا ما قضى في النهاية على هينبعل وجيشه الذين أنهكتهم الملاريا المتوطنة في إيطاليا. وتعاقبت على عاصمة الإمبراطوريّة سلسلة من الأوبئة التي بدأت في عام 165 بعد الميلاد، ويبدو أنّها انتقلت عبر خطوط التجارة مع الأقاليم، فأضعفت الإمبراطورية الرومانية، وقلّصت قدرتها على التجنيد وأنهكت الاقتصاد، وساهمت إلى حد كبير في سقوطها نهاية المطاف.
وفي عام 541 قبل الميلاد، ضرب طاعون جستنيان فقتل نصف سكان العالم المعروف آنذاك واحتدم لعدة قرون. ويقترح كينيدي أن: «صعود الدين المسيحي يبدو منطقياً لأنه قدم طرقاً أكثر جاذبية للتعامل مع الحياة والموت مقارنة بالديانات الوثنية الرومانية خلال مرحلة الأوبئة المدمرة التي ضربت الإمبراطورية الرومانية في القرنين الثاني والثالث الميلاديين».
الوباء الأكثر فتكاً الذي تم تسجيله على الإطلاق كان الموت الأسود في القرن الرابع عشر، حيث حصد الطاعون أرواحاً تقدّر بمائة مليون نسمة - أي أكثر من 60 في المائة من مجموع سكان القارة الأوروبيّة - وتسبب في نيل العصور الوسطى لقب أزمنة الظلام، إذ انهارت الأعراف الاجتماعية، وجاع الناس، واندثرت المباني، ولوحق اليهود وذبحوا كسبب محتمل للعنة الإلهيّة التي جلبت المرض كعقاب. وقد تكررت جولات الطاعون عدة مرّات بعدها وضربت مراراً وتكراراً في جميع أنحاء أوروبا، فقتلت مثلاً نصف سكان نابولي وجنوة في عام 1656، وسمحت لاحقاً بصعود قبائل العثمانيين، الذين جعلتهم حياتهم البدوية أقل عرضة للخطر من أولئك الذين يعيشون في المدن المكتظة. وعن ذلك يقول كينيدي إنه «من دون الطاعون، لم يكن من المعقول أن يتمكن العثمانيون من فرض سيطرتهم بسرعة على مثل هذه المناطق الشاسعة». وفي بريطانيا الثورة الصناعية، انتشرت الكوليرا في الأحياء الفقيرة المزدحمة، مما أجبر الدّولة على تولي إدارة الصحة العامة. ويجادل بأن تدابير الحجر الصحي وتعميم استخدام المطهرات في تلك المرحلة يمكن أن ينظر إليهما على كونهما علامة فاصلة لبداية الدولة الحديثة التي امتد نفوذها على الحياة البشرية العادية تدريجياً بطرق غير مسبوقة. وفي الوقت نفسه، يزعم أن النقص في العمالة الزراعية الماهرة الناجم عن التكرار في تفشي الطاعون كان مفيداً في انهيار منظومة الإقطاع لصالح نظام للعمالة المرنة لدى مصانع الرأسماليين. في وقت لاحق، فإن قابلية الجنود الشماليين للإصابة بالملاريا خلال الحرب الأهلية الأميركية، «ربما أخرت النصر لأشهر أو حتى سنوات»، ما منح لينكولن الوقت الكافي للتوصل إلى فكرة إلغاء العبودية في 1862، وتجنيد العبيد السابقين في الجيش. وكتب لينكولن لاحقاً: «إن النظرة المجرّدة لخمسين ألفاً من الجنود السود المسلحين والمدربين على ضفاف نهر المسيسيبي ستُنهي التمرد في لحظة واحدة»، وبحلول نهاية عام 1863م، تضمن الجيش 20 فوجاً من السود الذين كان لهم دور حاسم في تحقيق الانتصار النهائي للولايات الشماليّة.
الوباء الكبير التالي بعد «كوفيد-19» سيكون من بكتيريات عصيّة على العلاج بسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية
ينتهي كتاب كينيدي إلى استنتاجات مهمّة؛ إذ يرى أن الوباء الكبير التالي بعد «كوفيد-19» - الذي قتل سبعة ملايين شخص فقط - سيكون من بكتيريات عصيّة على العلاج بسبب الإفراط في استخدام البشر المضادات الحيوية. وهو يشير إلى أن التحسن الكبير في الصحة العامة لم يأت في التاريخ من «العلاجات» بقدر الاستثمار في أنظمة الصرف الصحي المناسب وتوفير ظروف معيشية أفضل للسكان، ولذا فإن أفضل أمل لنا هو معالجة الأسباب الجذرية لاعتلال الصحة اليوم، والتي ينبع معظمها - مثل السكن السيئ وسوء التغذية وظروف البيئات الملوثة - من الفقر. وكتب أن «الحد من التفاوتات الطبقية الصارخة سيكون بداية ممتازة للغاية لمواجهة الأوبئة المستقبلية».