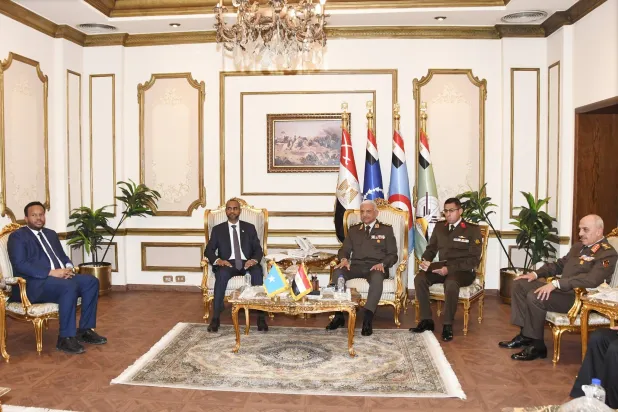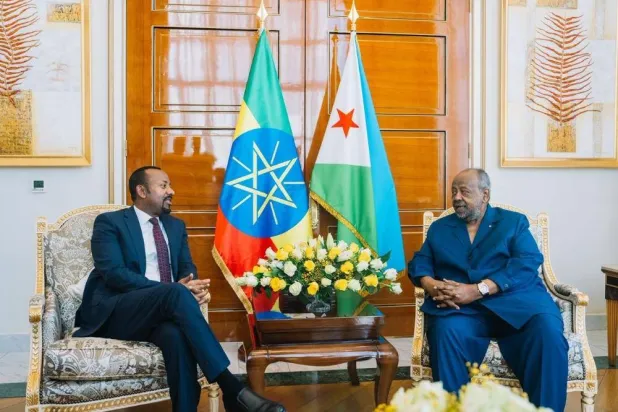يشهد الصومال جدلاً متصاعداً بشأن حزب «العدالة والتضامن» الجديد الذي يرأسه رئيس البلاد حسن شيخ محمود، وبات مرشحه لرئاسيات 2026، مع رفض شخصيات معارضة ورئيسي ولايتي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي لذلك المسار الجديد.
ذلك الجدل المتصاعد الذي جاء بعد نحو أسبوع من انتهاء اجتماع «المجلس الاستشاري الوطني» الذي عقد بمقديشو لمناقشة أزمة الانتخابات المباشرة المقررة في 2026، وسط غياب دني ومدوبي، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه يقود إلى سيناريوهين؛ الأول تهدئة وحوار ومصالحة تحت ضغوط دولية، والثاني انهيار العملية الانتخابية المقررة في 2026، وزيادة الاستقطاب السياسي والقبلي، وتزايد خطر انهيار الدولة.
و«المجلس الاستشاري الوطني» يعد أعلى هيئة تنسيقية سياسية في البلاد، ويُشكل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس: غوبالاند، جنوبي غرب، هيرشبيلي، غلمدغ، بونتلاند، وغاب عنه دني ومدوبي إثر خلافات بشأن العودة إلى الانتخابات المباشرة بعد 57 عاماً من آخر اقتراع، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس والتي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية».
ودشن الرئيس الصومالي، الثلاثاء الماضي، «حزب العدالة والتضامن» يضم قيادة الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الإقليمية باستثناء رئيسي بونتلاند وغوبالاند، وانتُخب زعيماً للحزب ومرشحاً له في الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد 2026.
ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن الجدل الدائر بشأن الحزب الجديد يثير مخاوف بشأن «نزاهة الانتخابات وسيادة القانون واستغلال الدولة لتحقيق مكاسب حزبية».
أما المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فيعتبر أن «الجدل المتصاعد حول ما يُعرف بـ(حزب الرئيس) في الصومال يعكس أزمة ثقة سياسية متجذرة بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة، ويثير مخاوف بشأن مستقبل النظام الفيدرالي وتوازن القوى بين المركز والولايات».
و«حزب الرئيس» الذي تسعى الحكومة الفيدرالية إلى بنائه يُنظر إليه من قبل المعارضة والولايات الرافضة خصوصاً بونتلاند وغوبالاند على أنه محاولة للهيمنة السياسية على العملية الانتخابية، وتفريغ الفيدرالية من مضمونها، بحسب بري، وهذا الجدل قد يؤدي إلى تصاعد الانقسام السياسي، وتقويض التوافق الوطني حول الانتخابات القادمة، وتهميش دور الولايات في صنع القرار الوطني.
فيما وصف رئيس ولاية بونتلاند، مؤتمر إعلان الحزب بـ«الباطل»، مشدداً على الحاجة إلى مصالحة حقيقية، متهماً الحكومة الفيدرالية الصومالية بالسير في طريق مغلق، بحسب ما نقله موقع «الصومال الجديد الإخباري»، الخميس. كما أدان بيان لرئاسة غوبالاند خطوة الرئيس الصومالي، ووصفها بأنها «غير دستورية ومدمرة للوحدة الوطنية»، داعياً الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بالدفاع عن البلاد، وعقد مؤتمر تشاوري عاجل.
ويستبعد بري وإبراهيم إقدام بونتلاند وغوبالاند على خيار الانفصال حالياً رغم تحفظاتهما، فيما أرجع الأول سبب ذلك إلى أن «الواقع الإقليمي والدولي لا يدعم تفكك الصومال، وأن الولايات تعتمد اقتصادياً وأمنياً على التعاون مع الحكومة الفيدرالية»، مضيفاً: «لكن تعليق التعاون السياسي أو مقاطعة الانتخابات أو الإدارة الذاتية الموسعة وارد جداً، وهذا سيعمق الأزمة».

ولم تكن الولايتان فقط الرافضتين، حيث أصدر 15 من الشخصيات السياسية البارزة في الصومال، بينهم الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ آدم، بياناً أكدوا فيه أن المجلس الاستشاري الوطني «كأن لم يكن» بعد الإعلان عن الحزب الجديد، داعين إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد، وشددوا على دور المجتمع الدولي في دعم بناء الدولة الصومالية.
ويعتقد إبراهيم أنه «لا يوجد معارضة رسمية في البلاد في ظل نظام البلاد الفيدرالي والبرلماني، والمعارضة القوية هي التي تأتي من إقليمي بونتلاند وغوبالاند»، ويعول على دور المجتمع الدولي حتى لا تصل الأمور للأسوأ، خاصة أن خطوات الرئيس الصومالي قد لا تنجح، متوقعاً أن تكون هناك ضغوط لتعيين رئيس وزراء جديد لإدارة مرحلة انتقالية تقود لانتخابات وإيصال البلاد لبر الأمان.
وبشأن مستقبل الأزمة السياسية، يعتقد بري أنها تعتمد على سلوك الحكومة والمعارضة، ويُمكن تصور سيناريوهين؛ الأول: تصعيدي عبر استمرار الخلافات، وانهيار العملية الانتخابية، وزيادة الاستقطاب السياسي والقبلي، والثاني: التهدئة عبر انطلاق حوار وطني تقوده أطراف محلية أو بوساطة إقليمية ودولية، يفضي إلى خريطة طريق متفق عليها.
ولم يستبعد بري تدخلاً دولياً محتملاً، خاصة من الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية (IGAD)، لحماية استقرار الصومال، كما أن القوى الغربية قد تمارس ضغوطاً سياسية وتشترط الدعم المالي بالتزام الحكومة بالإصلاح السياسي والتوافق.
ويخلص المحلل السياسي الصومالي إلى أن «مقديشو تقف عند مفترق طرق سياسي حساس، وأي إصرار على المضي قدماً بمسارات أحادية من دون توافق وطني قد يؤدي إلى نتائج خطيرة»، مؤكداً أن «الحل يكمن في مصالحة وطنية شاملة تضمن تمثيل الجميع، وتمنع تفكك الدولة».