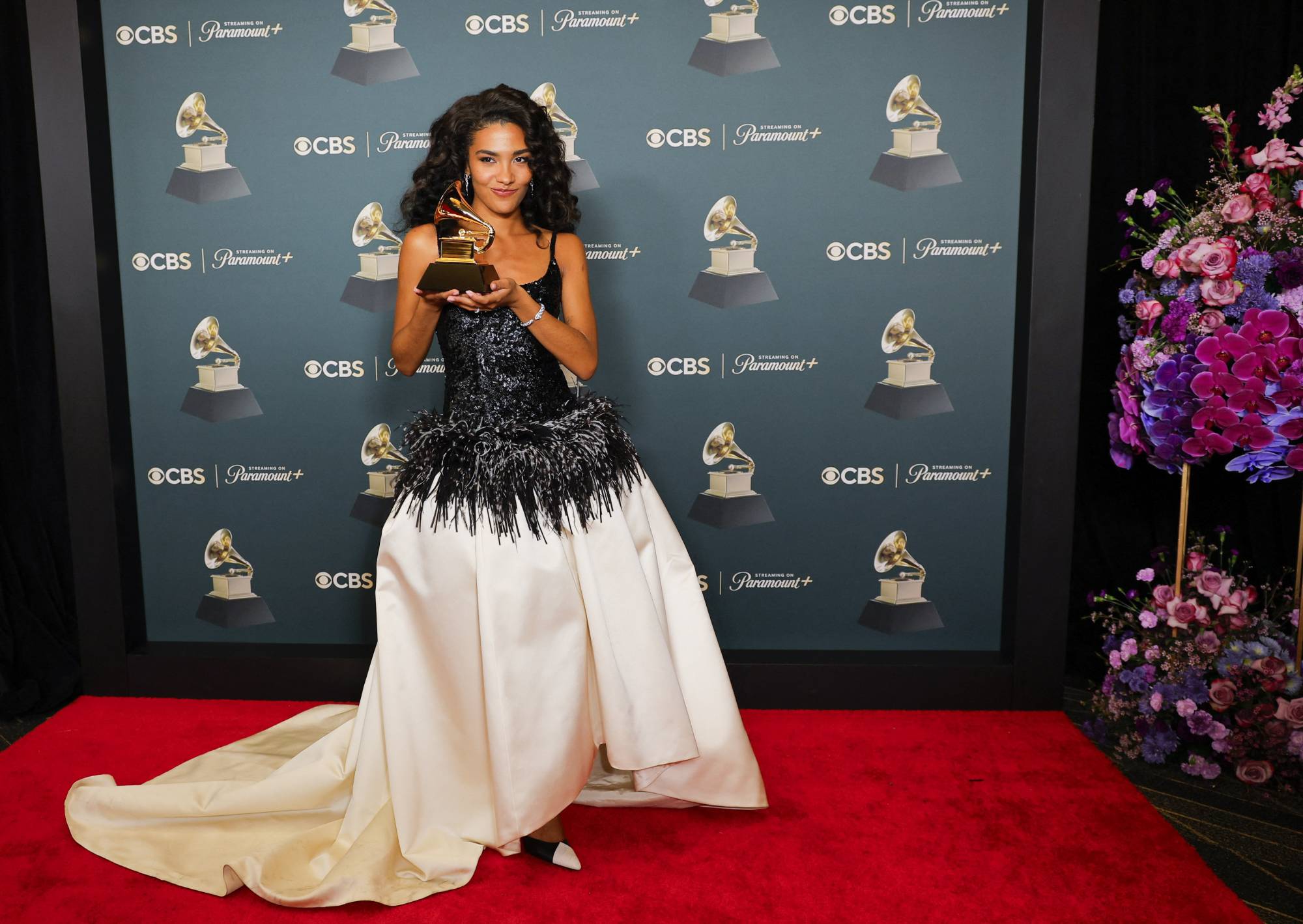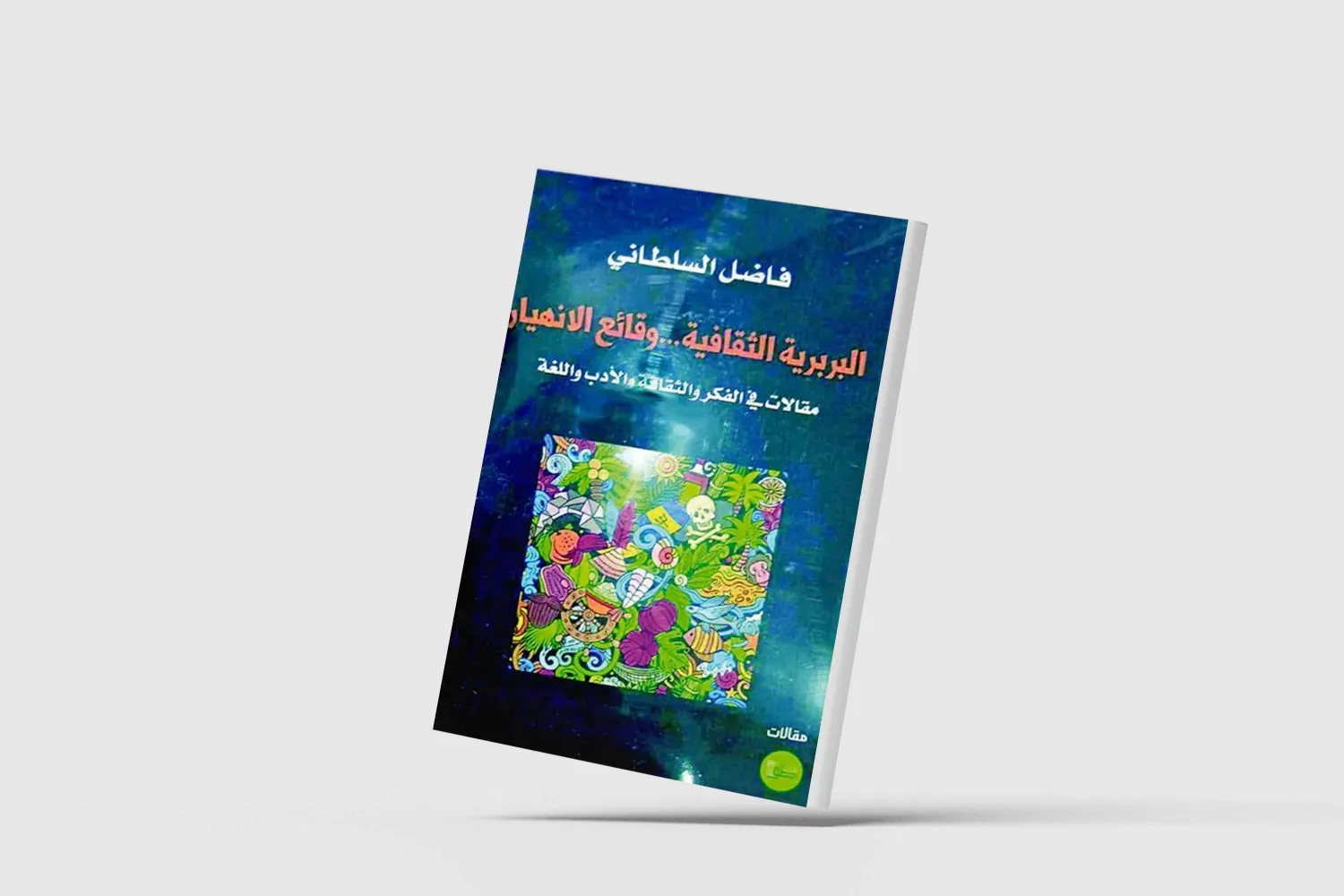شهدت ندوة «النص التراثي التاريخي: تقاليد الكتابة وطرق التعامل» حضورًا لافتا مِن أساتذة الجامعات المصرية والمعنيين بالشأن التاريخي، أثاروا كثيرًا من القضايا والأسئلة الشائكة من خلال مداخلاتهم على الطروحات التي قدمت في الندوة. وكان معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، نظم هذه الفعالية يوم الثلاثاء الماضي مستهلاً بها برنامجه الثقافي للعام الحالي. وذلك في إطار ما التزمه المعهد منذ ثلاث سنوات بإقامة أربع منتديات تراثية في العام الواحد، لمناقشة بعض القضايا التراثية الشائكة التي تهمُّ المثقَّف العربي المعاصر.
استهلَّ د. فيصل الحفيان مدير المعهد الندوة بالقول إن النصَّ التراثي عمومًا هو نصٌّ تاريخي في الدرجة الأولى، إذ إنه قادمٌ مِن حقبةٍ تاريخية لم نكن فيها، ولفت إلى أن المؤرخين المسلمين الأوائل قد بذلوا جهدًا كبيرًا في تدوين التاريخ، وليس صحيحا أنْ نعدَّهم قصَّاصًا ونقلةً فحسب، فكل منهم قد أضافَ لبنةً في صرحِ التاريخ الإسلامي، حتى استوى هذا البناء على سوقه في هيئة نظريات تعلِّل وتنقد وتستخلص التاريخ.
وتحدث الدكتور أيمن فؤاد سيد، مدير مركز تحقيق النصوص بجامعة الأزهر، عن طرق الكتابة التاريخية وتقاليدها عند المؤرخين المسلمين، مشيرًا إلى أن الكتابة التاريخية بدأت في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري مع مدرسة المدينة ثم مدرسة العراق، وأن البداية الأولى كانت مرتبطة بمقتضيات دينية محضة، فكان الانطلاق بتدوين مغازي الرسول الكريم، الأمر الذي عده يوسف هوروفيتس صاحب كتاب «المغازي الأولى ومؤلفوها»، امتدادًا لأيام العرب في الجاهلية، ثم تدوين السيرة النبوية الشريفة، التي كانت بمثابة النواة الأولى للروايات الإخبارية، وشكَّلت العنصر الأهم في تطور علم التاريخ عند المسلمين.
وقال إنَّه في مقابل هذا الاتجاه (اتجاه أهل الحديث) الذي كان سائدًا في مدرسة المدينة، كان هناك اتجاه آخر أوجدته الصراعات والفتن المبكرة في الدولة الإسلامية، وهو اتجاه الحاميات القبلية، الذي كانت تمثله الكوفة والبصرة (مدرسة العراق).
وذكر أن التاريخ الإسلامي شهدَ أنساقًا تأليفية كثيرة، ككتب الحوليات، والتراجم العامة، والطبقات، والتاريخ العام، والرجال، والجرح والتعديل، وللأسف لم يُنشر منها إلا القليل.
أمَّا الدكتور بشَّار المؤرخ الإسلامي والمحقق المعروف لدواوين كتب التاريخ والحديث الشريف، فقد وقف عند طرق التعامل مع النصِّ التاريخي وآليات نشره نشرًا نقدياً، وما ينبغي أنْ يكون عليه محقق هذه النصوص مِن اشتراطات علمية، وصفاتٍ أخلاقية.
وأثارت المحاضرتان مداخلات وتعليقات مهمة لعدد من الحضور، تمحورت حول:
أهمّ كتبِ التاريخ الأولى، ككتب الطبري، والمسعودي، واليعقوبي، وابن الأثير، والبلاذري، وغيرها التي حقَّقها المستشرقون وسبقونا إليها، طبعها المحققون العرب بعد ذلك على طبعات المستشرقين، ووقعوا في الأخطاء نفسها التي وقع المستشرقون فيها مِن قبل، وأجدر بهم أنْ يعمدوا إلى جمع النسخ الخطية المعتَبَرة.
كما أكدت المداخلات أن بعض كتب التاريخ لم تسلم مِن زيادات هي مِن وضع الرُّواة لها، ولم يفطن المحققون العرب إليها، مشيرة إلى أن أعظم مؤرِّخ أنتجه الإسلام هو محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، استخدم منهج المحدِّثين في التاريخ، وهو منهج يقوم بحصر الروايات المتعددة للخبر الواحد، ثم ينقد أسانيدها المختلفة ليصل بذلك إلى حقيقة الخبر. واعتبرت بعض المداخلات أن كتب الناقلين عن النصِّ الأول هي بمثابة نسخٍ ثانية للنصِّ، يُركن إليها لإقامة النص الأول وتقويم عوجِه، لافتةً إلى أن ابن خلدون دون المتوسط في الكتابة التاريخية، فهو غير مشتغل بالتاريخ، وقد نقلَ كتابَه مِن نسخة رديئة من كتاب «الكامل في التاريخ» لابن الأثير.
7:28 دقيقه
ندوة «النص التراثي التاريخي»... قضايا وأسئلة شائكة
https://aawsat.com/home/article/863466/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%C2%BB-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9



ندوة «النص التراثي التاريخي»... قضايا وأسئلة شائكة
نظمها معهد المخطوطات التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة

ملصق الندوة

ندوة «النص التراثي التاريخي»... قضايا وأسئلة شائكة

ملصق الندوة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة