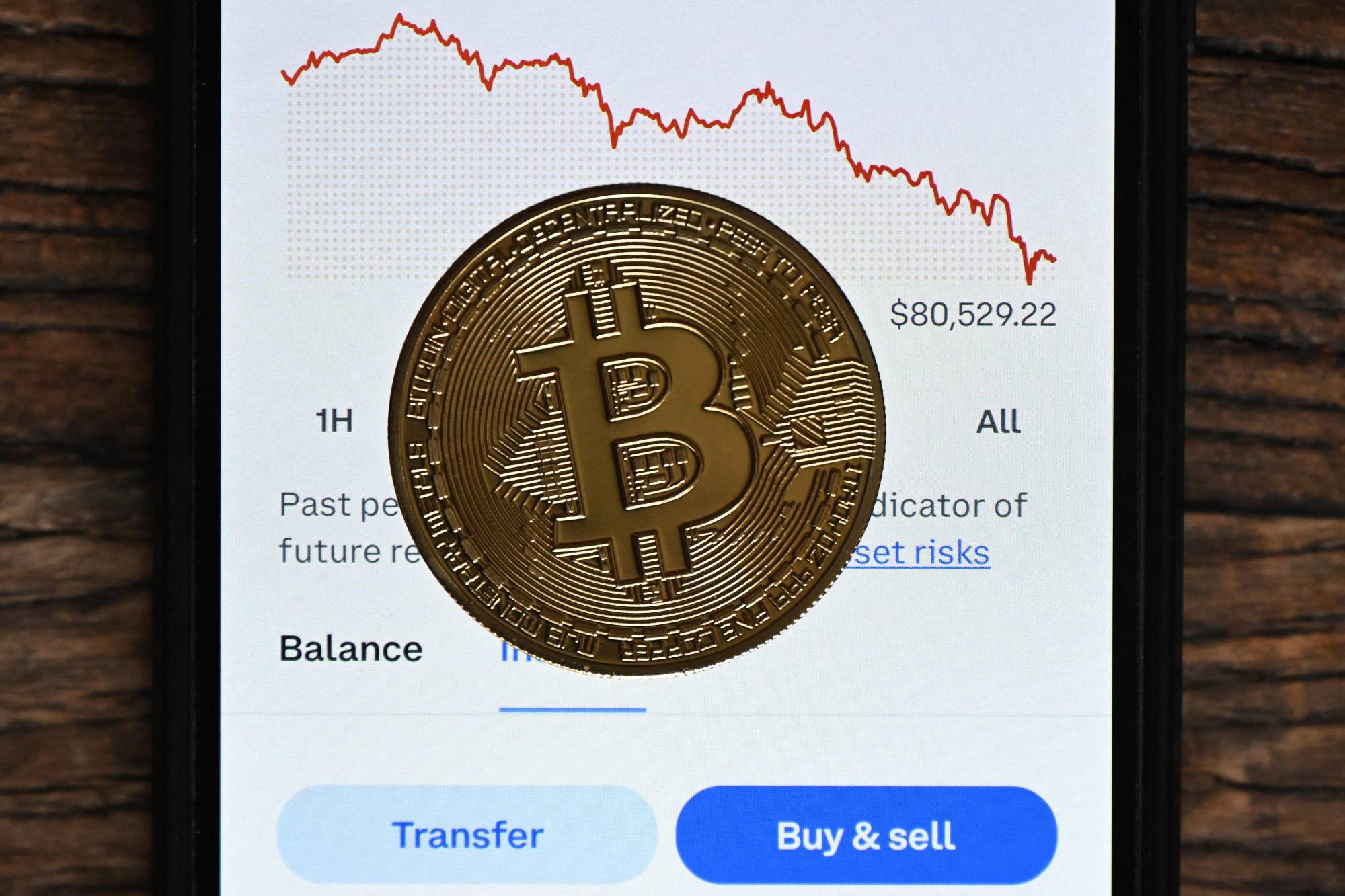استمرت المقابلة الشخصية لما يزيد على الساعة عندما بدأ «تيم»، الصبي النحيف ذو العينين السوداوين في التململ. وطلب الصبي الصغير البالغ من العمر ثماني سنوات ورقة بيضاء واعتدل في جلسته على كرسي الفندق الضخم ثم شرع في الرسم من ذاكرته.
وكانت الصورة التي رسمها بخربشة طفل جريء تعبر عن مشهد من حديقة صغيرة بالقرب من منزله، وهي المكان الذي اعتاد أن يلعب فيه في الأيام التي سبقت على احتلال الرجال ذوي اللحى السوداء للمدينة. وهناك في الحديقة كان جمع من الناس قد احتشد حول شخصين جالسين، وكان تيم يتذكرهم بكل وضوح، كان هناك رجل بعين واحدة، وآخر أصلع وكان يبدو مستاء من أمر ما.
يقول تيم: «كان يبدو غاضبا للغاية»، مفسرا لصورته التي رسمها عن الرجل الأصلع. «كان يمسك بالرجل الآخر كما كان ممسكا بشيء ما في يده اليمنى».
قال تيم مشيرا إلى الرجل الثاني: «كان الرجل الآخر بعين واحدة فقط، لقد اقتلعوا عينه لتوهم، ألا ترى؟ ثم وقف الرجل الآخر خلفه، ثم سقطت رأس الرجل ذي العين الواحدة فجأة».
أشار الصبي الصغير بأصبعه النحيف إلى الورقة التي أمامه حيث رسم رأس الرجل المقطوعة كما يتذكرها.
كرر تيم كلامه قائلا: «لقد سقطت رأسه فجأة».
ثم أغلق الطفل عينيه، كما لو كان يحاول إبعاد المشهد الأليم عن ذاكرته.
ثم نطق أخيرا ليقول: «كلا. لا أريد أن أتذكر ذلك».
خلال العامين الماضيين، ومنذ تأسيس الخلافة المزعومة في العراق وسوريا، عاش ما يقدر بستة ملايين نسمة تحت حكم تنظيم داعش الإرهابي. وما لا يقل عن ثلث هذا الرقم - نحو مليوني نسمة - هم دون سن الخامسة عشرة.
وهم، بالمعنى الحقيقي، ما يُطلق عليهم «أطفال الخلافة» وإجمالا، كما يقول الخبراء الذين عكفوا على دراسة أحوالهم، ذلك الجانب من السكان الذين تعرضوا لصدمات شديدة الألم وعميقة الأثر: العقول سريعة التأثر التي تعرضت ليس لويلات الحروب فحسب، ولكن لأعمال من الوحشية والعنف لا تعد ولا تحصى، من الجلد العلني، وبتر الأعضاء البشرية، وحتى الإعدام الوحشي، وعمليات الصلب وقطع الرؤوس التي كانت ولا تزال من العلامات المميزة لشهرة تنظيم داعش الإرهابي عالميا.
أجرت صحيفة «واشنطن بوست» المقابلات الشخصية مع خمسة من الصبيان الذين تمكنت عائلاتهم من الفرار من أقاليم تنظيم داعش، ومن بينها عائلة الصبي تيم، وهو من اللاجئين السوريين الذين أجرت الصحيفة المقابلة الشخصية معه بالقرب من منزله المؤقت في أوروبا. وبقي موقع منشأة اللاجئين حيث جرت المقابلة محجوبة بناء على طلب عائلة الصبي. كما استعرضت الصحيفة أيضا أفلام الفيديو، والتقارير الإخبارية والنصوص الصحافية التي تحتوي على قصص عشرات الصبيان الآخرين من الفتيان والفتيات الذين بلغت تجاربهم وخبراتهم الحد الذي بلغته خبرات الصبيان في المقابلة.
وبعضهم، على غرار تيم، انتهى بهم الحال في مدرسة من مدارس الجماعة الإرهابية ومعسكرات التدريب العسكرية، حيث كانوا يُجبرون على اتباع النظام الصارم لأفكار ومعتقدات التنظيم الإرهابي ومتابعة أشرطة الفيديو المروعة.
وبعزلهم عن عائلاتهم، كانوا يتعلمون إطلاق الرصاص وقذف القنابل اليدوية، كما كانوا يشجعونهم على التطوع في تنفيذ العمليات الانتحارية، وهو الدور الذي كان محل الإشادة العظيمة من قبل معلميهم كونهم أعلى دعوى لكل شاب مسلم تقي وورع. ووُصف كثير منهم بأنهم كانوا يجبرون على شهود، وربما المشاركة في عمليات إعدام السجناء.
ويصف عمال الإغاثة، الذين كانوا يتواصلون بانتظام مع أولئك الصبيان، الجراح النفسية العميقة التي من المرجح أن تكون من بين الموروثات الأكثر استدامة لنظام حكم «داعش»، مما يمهد الطريق لحلقات مزيدة من العنف والتطرف لسنوات مقبلة بعد انهيار الخلافة ذاتها ومحوها من الوجود. ولكن منظمات الإغاثة تحاول بذل ما في وسعها من أجل تقديم المشورة، حتى المحدودة منها، للأطفال في مخيمات اللاجئين المكتظة بهم في المنطقة، ويقول المسؤولون إن القليل للغاية من الموارد متاحة لأولئك الذين يقطنون المدن العراقية والسورية التي تم تحريرها في الآونة الأخيرة من حكم الإرهابيين.
يقول كريس سيبل، الرئيس الفخري لمعهد المشاركة العالمية، وهو من المؤسسات الخيرية التي تعمل مع العائلات التي تفر من حكم تنظيم داعش: «لقد تعرض الجميع هنا لصدمات شديدة». وحول جلسات الإرشاد التي تنظمها المنظمة في شمال العراق، قال السيد سيبل: «يمكنكم ملاحظة كيف يحاول هؤلاء الأطفال البدء في العمل سويا من خلال هذه الأعمال»، وفي بعض الأحيان من خلال الكلمات، ولكن في كثير من الأحيان من خلال الرسم الذي يبدو أنه يستحضر من ذاكرتهم الكوابيس المرعبة نفسها.
ويضيف السيد سيبل قائلا: «نرى الأطفال يرسمون صورا من مشاهد قطع الرؤوس لدى (داعش)، مستخدما الاسم المختصر للتنظيم الإرهابي: «ما الذي يمكننا فعله مع ذلك، إلى جانب البكاء؟».
كان تيم يبلغ السادسة من عمره عندما اجتاح المسلحون ذوو الرايات السوداء مدينة الرقة الواقعة في شمال وسط سوريا. وكانت شوارع المدينة، التي ستكون مقرا للخلافة المزعومة، قد شهدت بالفعل معارك متقطعة بين مختلف الفصائل المتناحرة منذ بدء الحرب الأهلية في البلاد في أواخر عام 2011. والآن، ومع الإرهابيين في مواقع الحكم، فقد تهدأ حدة القتال، ولكن سفك الدماء يتفاقم ويزداد سوءا.
تعرض تيم، من بين الصبيان الذين تقابلت معهم الصحيفة، إلى مجموعة واسعة من التجارب خلال عامين تقريبا في الوقت الذي كانت عائلته تعيش في «أراضي الخلافة» المزعومة، من الالتحاق بالمدارس التي يشرف عليها المعلمون المنتمون لـ«داعش» إلى الخضوع للتدريبات العسكرية في المعسكر بهدف تحويل الصبية الصغار إلى مقاتلين وانتحاريين. ومن نواح أخرى، فإن قصته تشبه بشكل لافت للنظر قصص الصبيان الأربعة الآخرين، الذين تحدثوا جميعا عن الظروف القاسية والمعاملة الوحشية للمواطنين العاديين، بما في ذلك أفراد العائلات. ووافقت صحيفة «واشنطن بوست» على عدم نشر هوية الصبيان، أو تصويرهم، من أجل حماية خصوصيتهم والحيلولة دون محاولات الانتقام منهم من قبل أنصار تنظيم داعش في الخارج. ولقد حجب اسم عائلة تيم بناء على رغبة والديه.
بدأ تيم، الفتى ذو الوجه المشرق والابتسامة الخجولة، يحمل أمارات الحزن العميق عندما سئل عن ذكريات الأسابيع الأولى بعدما سيطر الإرهابيون على المدينة. فقبل تنظيم داعش، كانت الأسرة تمارس حياتها اليومية بشكل طبيعي، حيث كان هناك وقت للمدرسة ووقت للعب، وقال تيم بابتسامة طفولية: «كنت أحب المدرسة كثيرا»، وذكر من بين المواد التي يحبها الرياضيات والفن والألعاب الرياضية.
في بادئ الأمر، أغلق المحتلون الجدد للمدينة المدرسة، وحولوا المبنى إلى قاعدة عسكرية، كما قالت أفراد عائلة تيم. وعندما سمحوا أخيرا للتلاميذ بالعودة إلى المدرسة بعد شهور طويلة، كان المقاتلون لا يزالون هناك، وكان وجودهم ظاهرا في الفصول الدراسية. وكانوا يمنحون الحلوى والجوائز ويشرفون شخصيا على استحداث المناهج الدراسية الجديدة، التي يضعها ويوافق عليها التنظيم الإرهابي.
وقال تيم عن ذلك: «كانوا يعطوننا الألعاب في البداية، ولكن عندما بدأت الدروس، كانوا صارمين للغاية. وكانت كل الدروس تدور حول الإسلام».
وبالنسبة لشباب الرقة، كانت الدروس تبدو وكأنها تحذير وتبرير للعقوبات الوحشية التي كان المتطرفون يوقعونها على سكان المدينة بشأن الانتهاكات التي تتراوح بين الشكوك في التجسس وحتى تدخين السجائر.
ومع مرور الوقت، استبدل تنظيم داعش بالكتب الدراسية التقليدية أخرى جديدة، مؤلفة ومطبوعة بواسطة الإرهابيين أنفسهم. وكانت كثير من تلك الكتب تُجمع وتُدرس خلال العامين الماضيين من قبل المحللين الغربيين، الذين يصفون الأدبيات التعليمية للتنظيم الإرهابي بأنها كمثل الدعاية المقنعة لأفكار التنظيم ومعتقداته.
وبالنسبة للأطفال الصغار، كانت الدروس في الحساب والكتابة اليدوية توضع مع صور للبنادق والأسلحة والقنابل اليدوية والدبابات. وبالنسبة للتلاميذ الأكبر سنا، كانت كتب العلوم والتاريخ تشيد بالشهادة وتصور إقامة الخلافة المزعومة لديهم بأنها أعظم إنجازات البشرية.
يقول جاكوب أوليدور، الخبير في أدبيات الجماعات المتطرفة، الذي عمل على تحليل العشرات من مثل هذه النصوص والكتب، إن تلك الأدبيات تمثل محاولة جادة ومنهجية لتشكيل وصياغة عقول الصغار، بهدف إنتاج ليس مجرد المؤمنين بها ولكن المقاتلين المدافعين عنها.
ويقول السيد أوليدور، وهو الأستاذ في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: «ما نعلمه هو أن التعليم ليس مجرد جزء من ترسانتهم، ولكنهم يعتبرونه ميدانا كاملا من ميادين الصراع. إنهم يحاولون إنشاء جيل من المتطرفين. ولا يتعلق الأمر بمجرد الإيمان بالعقيدة الصحيحة من وجهة نظرهم، ولكن المقدرة على القتال لأجلها والدفاع عنها. إن الأمر يتعلق بإقناع الصبية الصغار أن تصورهم الوحيد للعالم حولهم هو تصور صادق وصحيح، وأن الجميع من الآخرين على خطأ».
وبالنسبة لتيم، بعض من الدروس التي لا تنسى لم تكن واردة في الكتب الدراسية. ففي كثير من الأحيان، كما يتذكر الصبي، كان معلمو «داعش» يحثون الأطفال على العمل مخبرين، ويبلغون على الفور عن أي سلوك من ناحية والديهم يبدو مخالفا لقوانين الدين أو يشير إلى معارضة لحكم التنظيم.
وفي أحد الأيام، كما يقول الصبي، انطلق المدرسون بالتلاميذ إلى حديقة قريبة وجعلوهم يقفون حول حفرة مفتوحة في الأرض، إنه قبر المستقبل، كما قال أحد المعلمين، لأي طفل يسكت ولا يخبرنا بأن والديه يعارضان النظام أو يختبئان منه.
وقال تيم عن ذلك: «إذا لم نخبرهم، فسوف يلقون بنا في هذه الحفرة».
وحتى تحت حكم الإرهابيين، حاولت عائلة تيم المحافظة على بعض أجزاء من الحياة الطبيعية بالنسبة لعائلة صغيرة. كانت والدته ترتدي العباءة الثقيلة والحجاب المزدوج في كل مرة تغادر منزلها من أجل التسوق، وضبطت الأسرة إيقاع حياتها اليومي ليتناغم مع قيود التنظيم الإرهابي من حيث المشاركة الصارمة في الصلوات اليومية.
ولكن في داخل المنزل، كانت الأسرة شديدة القلق من أن الحياة تحت نير هذا التنظيم الإرهابي سوف تؤثر تأثيرا شديد السوء على طفلهم. حيث كانت النزهة إلى حديقة الرشيد القريبة - وكانت من الملاعب المفضلة للعائلة قبل الحرب الأهلية - وتنطوي على مخاطر مشاهدة الجثث مقطوعة الرأس، وهي جزء من العرض الوحشي الذي يعقب عمليات الإعدام شبه اليومية في الساحة الرئيسية في الرقة. ولقد شاهد الصبي بنفسه كثيرا من عمليات الإعدام تلك، وبعد سنوات كان قادرا على أن يصف وبكل وضوح كيف كان الجلاد الملتحي يحمل رأس الضحية في إحدى يديه ويستخدم الأخرى في التشويه والتمثيل بالجثة.
يقول تيم عن ذلك: «كان هناك كثير من الدماء. الكثير والكثير منها».
ولكن الصدمة الكبرى جاءت عندما اندفع تيم إلى داخل المنزل في يوم من الأيام وبدأ في جمع أغراضه، معلنا أنه قد اختير للذهاب إلى معسكر إعداد خاص بالفتيان. وكان الوالدان قد سمعا عن هذا المكان، وهو أشبه بمعسكرات الإعداد لمرحلة ما قبل المراهقة حيث يتلقى الفتيان تعليمات مكثفة في الأسلحة، والمهارات القتالية، وآيديولوجية «داعش» المتطرفة.
وأصر تيم قائلا لوالديه: «إنها إرادته» لمغادرة المنزل والالتحاق بهذا المعسكر، واتهم والديه بإهمال تعليمه الديني، كما قالت والدته. كانت تدرك أنه لا جدوى من معارضة رغبة التنظيم الإرهابي في اشتراك ولدها بتلك الدورة، ورغم ذلك فقد حاولت إثنائه عن الرحيل. وقالت له انتظر معنا وسوف تذهب الأسرة إلى المسجد مرات أكثر.
وتتذكر الأم حديثها حيث قالت: «تعال إلى المنزل وصل هنا، يمكنك الصلاة في المنزل»، فأجابها الصبي قائلا: «أسأل الله أن يحرمك كما تحرمينني».
كان المعسكر الذي التحق به تيم في نهاية الأمر أحد عشرات المعسكرات المنتشرة في جميع أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم بهدف تدريب الفتيان من سن السادسة وأكبر. وبعض من أولئك الفتيان يحملون أسماء وألقاب القادة والزعماء والأبطال في التنظيم، بما في ذلك أبو مصعب الزرقاوي، الأردني الذي أسس الجماعة المتطرفة العراقية التي تحولت في لاحق الأمر لتصبح تنظيم داعش الإرهابي.
وجميع تلك الشخصيات ظاهرة في المواد الدعائية للمتطرفين على الإنترنت، التي تتضمن لقطات فيديو لأطفال صغار يرتدون الملابس العسكرية المموهة، ويطلقون النيران من مختلف الأسلحة، ويساعدون في تنفيذ عمليات الإعدام، والتدريب على تنفيذ الهجمات الانتحارية.
تقول آن سبيكهارد، وهي الخبيرة في شؤون التطرف العنيف والأستاذة المشاركة المساعدة لعلوم الطب النفسي في المركز الطبي الملحق بجامعة جورج تاون: «يستميل تنظيم داعش الأطفال الصغار إلى معسكرات التدريب ويضعون الكثير والكثير من الموارد في برامج التدريب من أجل ضمان الولاء المطلق والطاعة العمياء». وبالنسبة لتنظيم داعش، كما تقول، تعتبر تلك المعسكرات أكثر فعالية من حيث إنتاج المهاجمين الانتحاريين، «لأن الأطفال أسهل في التعامل والسيطرة من أي كوادر أخرى لدى التنظيم».
* «واشنطن بوست»
(خدمة {الشرق الأوسط})
أطفال «داعش» .. تدريبات على الرماية في السادسة.. والانتحار في المراهقة
بعض الفتيان حملوا أسماء وألقاب الزعماء في التنظيم بمن في ذلك الزرقاوي قيادي «القاعدة»

أطفال في سن المراهقة يتدربون على عمليات انتحارية (واشنطن بوست)

أطفال «داعش» .. تدريبات على الرماية في السادسة.. والانتحار في المراهقة

أطفال في سن المراهقة يتدربون على عمليات انتحارية (واشنطن بوست)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة