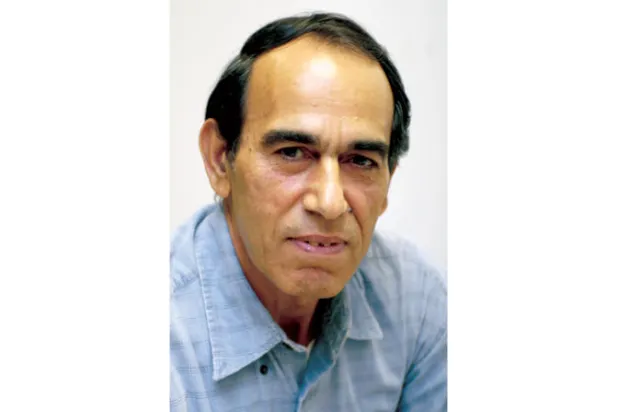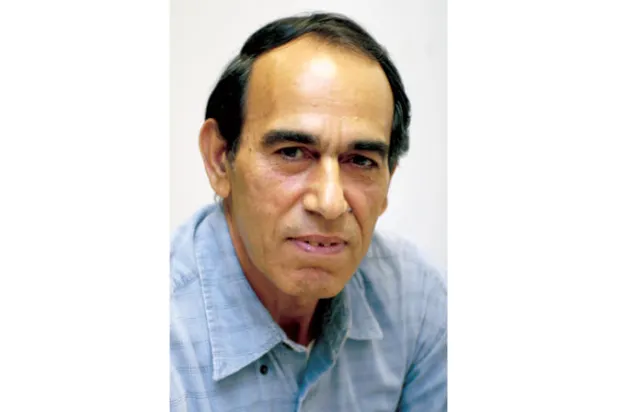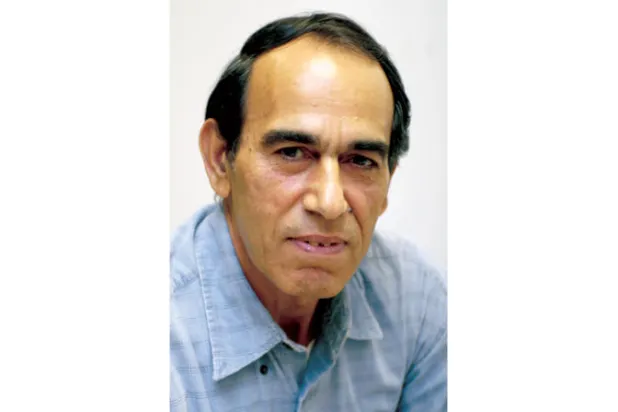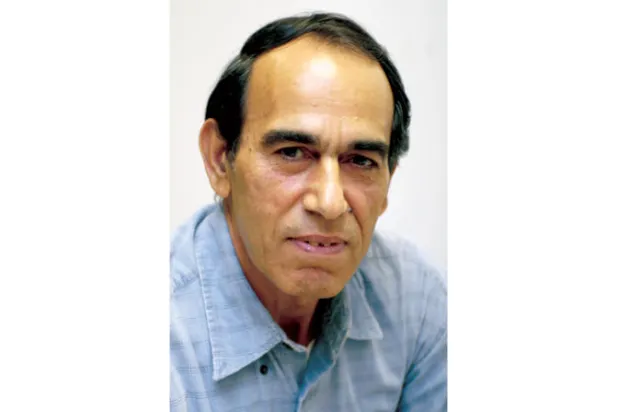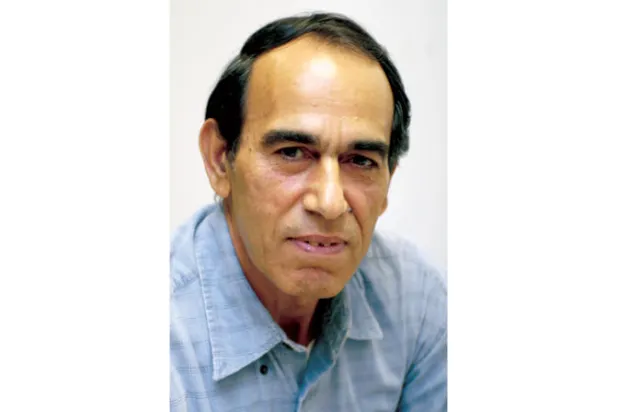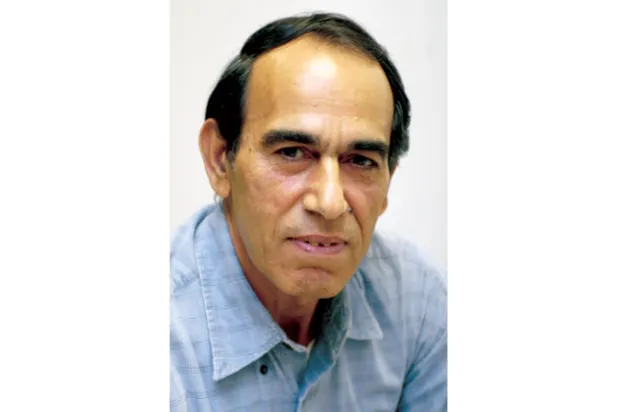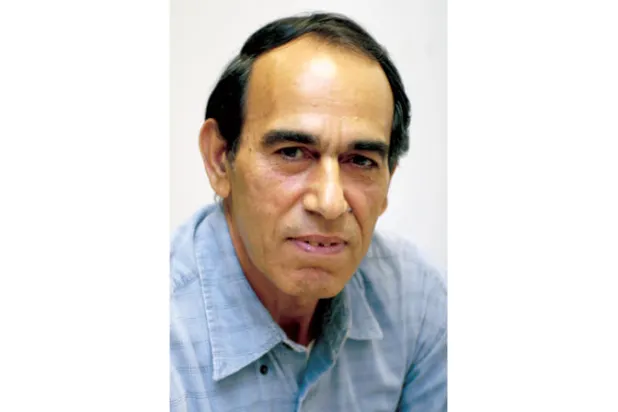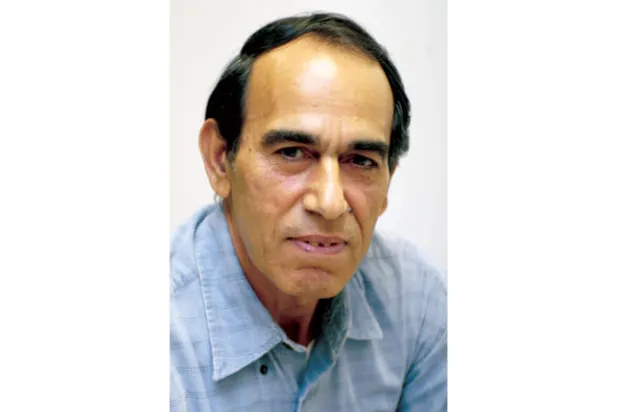فاضل السلطاني
في عام 2007 نظمت مؤسسة المدى، التي كانت الوزارة الحقيقية للمثقفين العراقيين في تلك الأوقات العصيبة، مهرجانا في أربيل، شكل أول وأكبر تجمع لهم، إذ حضره العشرات من الكتاب والشعراء والمسرحيين والتشكيليين من الداخل والخارج، بالإضافة إلى حضور مثقفين عرب. وقبيل انتهاء المهرجان بأيام، دعانا رئيس المؤسسة فخري كريم للقاء مع جلال الطالباني، رئيس جمهورية العراق آنذاك. في ذلك اللقاء، كان لنا مطلب واحد من رئيس الجمهورية، أو سموه رجاء، لأننا كنا ندرك كالجميع استحالة تحقيق شيء في نظام مستند منذ تشكيله الكارتوني على يد بريمر إلى توازنات طائفية وحزبية هي أسباب وجوده واستمراريته.
يستدعي الجمال بالضرورة الحديث عن القبح، ليس باعتباره نقيضا له، بل توأم له، على الأقل منذ عصر الحداثة، وما بعدها، رغم أن التداخل بينهما، أو على الأقل على مستوى المفاهيم قد حصل منذ القرن الثامن عشر، فبتنا نردد مصطلحات مثل «جماليات القباحة» و«القبح الجميل». لكن الإشكالية التاريخية والمعرفية فيما تخص المصطلحين لا تزال قائمة، وخاضعة لوجهات نظر متباينة، واجتهادات تعتمد على ميراثنا، وتربيتنا، وتركيب مجتمعاتنا. من هنا تجيء أهمية كتاب «القباحة... تاريخ ثقافي» للباحثة الأميركية غريتسن إي.
ربما يكون دانتي واحداً من أكبر البكائين في التاريخ، حتى أنه خصص غرفة في بيته، وهو الذي قلما ملك بيتاً، سماها «غرفة الدموع». وكلما تقدم به العمر، كلما ازدادت دموعه. كان يبكي «حتى يجعله البكاء هشاً متهالكاً حتى لا يكاد يعرفه أحد، ومن فرط الحزن يتحرك رأسه كأنه شيء ثقيل لا حياة فيه، وتتعب عيناه من البكاء حتى تعجزا عنه». كان ينسحب فجأة إلى تلك الغرفة، التي لم نسمع بمثيل لها في تاريخ الأدب الإنساني، ليقضي ساعات طويلة فيها... وهو يبكي. على ماذا كان دانتي، أحد أعظم شعراء البشرية، إن لم يكن أعظمهم على الأقل بالنسبة لتلميذه العظيم الآخر، تي. إس. إليوت، يبكي؟
لم تكن نبوءة تلك التي أطلقها جيمس بالدوين، الروائي، والشاعر، وكاتب المقالات، والمسرحي الأفرو - أميركي، في محاضرة له بكلية كمبرج البريطانية عام 1965: «لا مستقبل للحلم الأميركي إذا لم يشارك فيه الأميركيون الأفارقة. هذا الحلم، الذي كان على حسابهم، سيتحطم».
في التحقيق الذي ننشره هنا، يتحدث عدد من الكتاب العرب عن تجاربهم الخاصة، وهذه المرة في مواجهة الانتحار، أو بكلمة أدق فكرة الانتحار، التي قد تراود كثيراً من الكتاب في فترة ما لعوامل متباينة. ولحسن الحظ، إن الكتاب المنتحرين في تاريخنا الأدبي قليلون جداً، لأسباب كثيرة، وربما يكون العاملان الديني والاجتماعي في مقدمتها، فالانتحار فعل حرام، قد يجر على عائلة المنتحر تبعات عائلية واجتماعية كثيرة. وربما يكون «المختفون» الذين كتبنا عنهم سابقاً أكثر عدداً، وهو انتحار بشكل مختلف...
فن الاختباء، أو الفرار من الذات، والعالم في الوقت نفسه، هو جزء من التاريخ الأدبي منذ هوميروس. هو ليس زهداً، ولا عزلة. قد ينتمي إلى العائلة الكبيرة نفسها، لكنه ليس شقيقهما. الزهد والعزلة خياران واعيان إلى حد بعيد، يصدران عن عقل وفلسفة ورؤية، لذلك غالباً ما يأتيان متأخرين في عمر الحكمة والنضوج، كعزلة أبي العلاء مثلاً. الاختباء شيء آخر. قد يهجم فجأة، وفي أي لحظة. نفور لا يمكن تفسيره، أو الوقوف على سبب واحد من أسبابه.
كلما سقطت قامة ثقافية عراقية كبيرة في المنفى، تستيقظ الذاكرة، مصحوبة بغُصّة كبرى تخرج من بين الحشايا على وطن لا يجيد سوى طرد أبنائه، حتى إنه يتفنن في ذلك. لم يتوقف النزف العراقي؛ لا في ذلك العهد الذي سماه العراقيون «العهد البائد»، أو عراق نوري السعيد، والذي رمى رفعة الجادرجي؛ فيلسوف العمارة العراقية، الذي رحل قبل يومين، في زنزانة مشابهة للزنزانة التي رماه فيها صدام حسين، بعد ذلك بأعوام طويلة. يكتب رفعة الجادرجي في كتابه «بين ظلمتين»، عن زنزانة صدام حسين: «لا تَعْدُو سعة زنزانة (26) أكثر من متر وسبعين سنتيمتراً عرضاً، ومترين طولاً. نشعر بثقل الهواء بسبب حَشْر المعتقلين في ذلك الحيز الضيق.
لماذا ننسى كتابنا الراحلين سريعاً؟ استفهام مبتسر بعض الشيء، بالرغم من حقيقته الصارخة. والأجدر أن نتساءل: لماذا ننسى أنفسنا؟ من يقولون إن الماضي ما يزال يسكننا، وإننا مشدودون إليه، وإنه يحجب حاضرنا، ويمنعنا أن نرى ذواتنا الحقيقية، هم ينطقون بنصف الحقيقة. إنهم يتحدثون عن نصف ماضٍ لسنا مشدودين إليه فقط، بل مبهورون به، ونحيي عظامه وهي رميم كل يوم... نصف ماضٍ عتي، راسخ في الأرض، متسربل بتعاويذ سحرية، وخرافات، وأباطيل، نظل نغذيها ونتغذى بها، فكبرت حتى احتلت عقولنا ووجداننا، ونسينا أن هناك نصفاً آخر، بهياً، مشرقاً، ما إن يطل علينا به في لحظات نادرة حتى يسارعوا إلى وأده.
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة