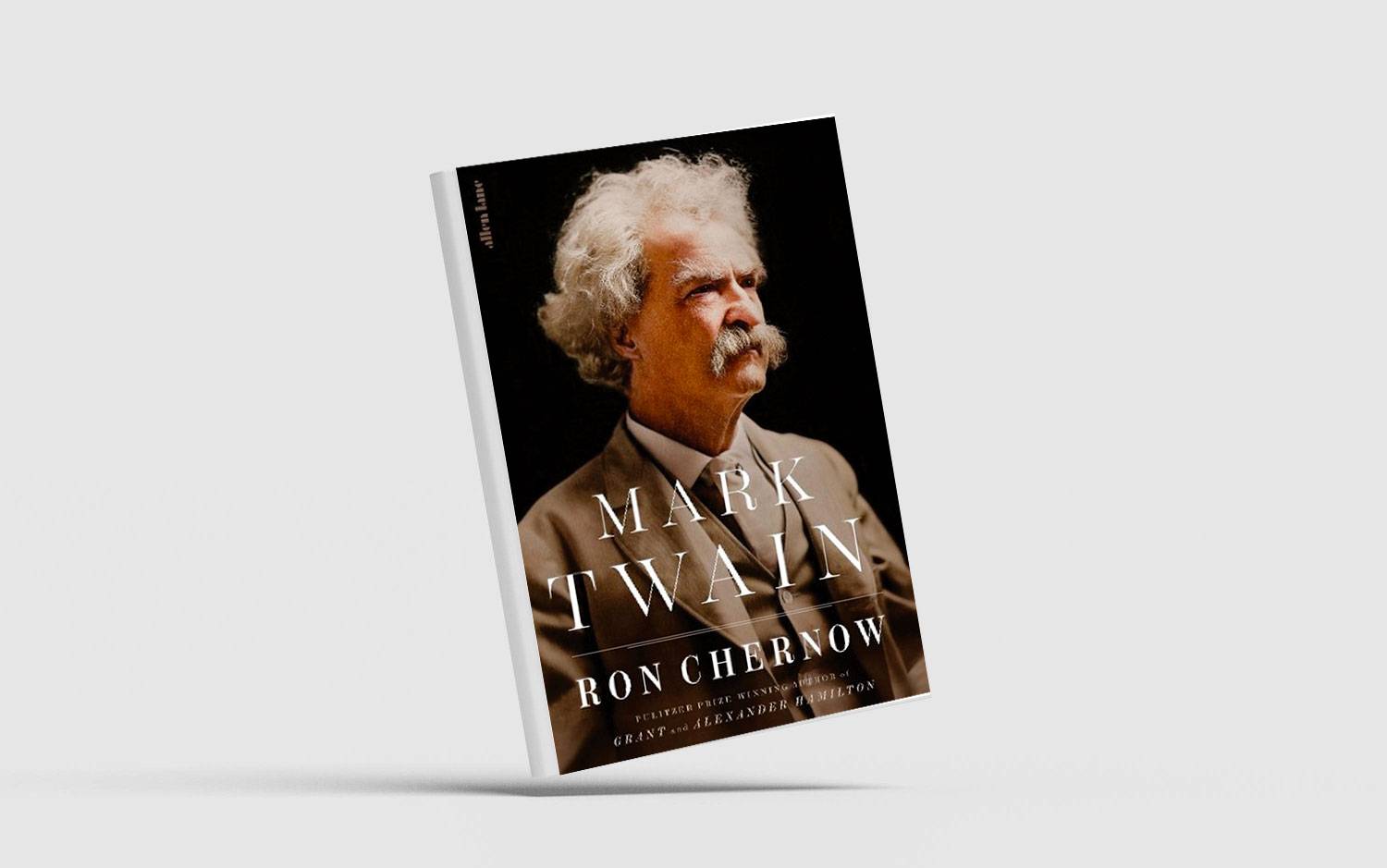حققت العلوم الطبيعية والفيزيائية انتصارات في مجال الكشف عن القوانين المكونة للظاهرة الطبيعية. هذه الانتصارات التي حققتها العلوم الفيزيائية، والطبيعية، مارست إغراء على الفلاسفة والباحثين، دفعتهم إلى التفكير في إمكانية قيام علوم تستطيع دراسة الإنسان عبر المناهج نفسها التي تدرس بها العلوم الطبيعة.
وقد تبلورت هذه النزعة، في البداية، مع الفلسفة الوضعية، كما مثلها روادها المؤسسون، سواء هربرت سبنسر، أو أوغست كونت وإميل دوركايم، ممن دافعوا عن إمكانية قيام علوم إنسانية وضعية، تدرس المجتمع الإنساني وتفسره، وتحلله تحليلا وضعيا، بعيدا عن الذاتية، واستنادا إلى خطوات منهجية، تقوم على الملاحظة الخالصة والتجريب الدقيق. لكن الإشكال المطروح، هو هل يمكن موضعة الظاهرة الإنسانية؟ بمعنى، هل يمكننا عزل الظاهرة الإنسانية التي يتداخل فيها ما هو نفسي واجتماعي وثقافي، ودراستها دراسة موضوعية كما ندرس الموضوعات الطبيعية في العلوم التجريبية؟ هل يمكن أن يكون الإنسان وما صدر عنه من أفعال وسلوكيات وتصرفات موضوعا لدراسة علمية، مع العلم أن منتج هذه الأفعال الذي هو الإنسان يكون دارسا وموضوعا للدراسة؟
بالعودة إلى تاريخ العلوم الإنسانية وتكونها في القرن التاسع عشر، نلمس كثيرا من الدعوات، التي كانت ممتعضة من الثورة الفرنسية، والاضطرابات الاجتماعية، بدأت تفكر في تأسيس علوم تهتم بدراسة الظاهرة الإنسانية، دراسة علمية قصد التنبؤ بها وتوجيهها، والتحكم فيها، وفي هذا الصدد، نجد النظرية الوظيفية كما تبلورت مع مؤسسها أوغست كونت، الذي أكد في كتابه «دروس في الفلسفة الوضعية»، أن دراسة الظواهر الإنسانية دراسة موضوعية ممكنة، شريطة أن يتحرر الباحث من كل التصورات اللاهوتية والميتافيزيقية، لأنها تنتمي إلى مرحلة لم تعمل إلا على عرقلة العلم، وبالتالي فالمرحلة الوضعية تمكن الباحث من خلال مناهجها وتقنياتها، من تفسير وتحليل الظواهر الإنسانية عموما والاجتماعية خصوصا. وفي هذا الصدد، دافع كونت عن تأسيس علم اجتماع يستند إلى مبدأ السببية والملاحظة، وغايته الكشف على القوانين والعلاقات القائمة بين الظواهر. وقد بلغ الإغراء الكبير الذي مارسته العلوم الحقة على رواد العلوم الإنسانية، مرحلة جعلت أوغست كونت يسمي العلم الذي سيهتم بدراسة المجتمع والظواهر الاجتماعية (ثورات - انحرافات - جرائم..)، بـ«الفيزياء الاجتماعية» الذي استبدل، لاحقا، «السوسيولوجيا» به.
في السياق نفسه، سيعمل إميل دوركايم، باعتباره وريث المدرسة الفرنسية في العلوم الإنسانية، على الدفاع عن إمكانية موضعة الظاهرة الإنسانية في علم الاجتماع. لذلك دافع في كتابه «قواعد المنهج السوسيولوجي»، عن أن الظواهر الاجتماعية يجب أن ننظر إليها باعتبارها أشياء ووقائع مادية، توجد في استقلال عن وعي الأفراد، وعن وجودهم المستقل، وتمارس قهرا عليهم، والأهمية العلمية لدوركايم، باعتباره أحد مؤسسي علم الاجتماع، تتمثل في محاولته صياغة قواعد علمية، تكون منطلقا لعلم جديد اسمه علم الاجتماع. وهذه القواعد حسب إميل دوركايم، التي تمكن العلوم الإنسانية من موضعة الظاهرة الإنسانية، تبدأ بالنظر إلى الظاهرة الاجتماعية باعتبارها شيئا له وجوده المستقل عن الوجود الفردي.
وبالتالي، يمكننا ملاحظتها ودراستها دراسة علمية وموضوعية، شريطة أن يقطع الباحث مع تمثلاته وأفكاره المسبقة عن الموضوع المدروس ضمانا للموضوعية، وهي القاعدة الثانية. فمثلا، إذا كنا نرى عالم الطبيعة يستعيض عن الإحساسات الغامضة التي يثيرها لديه الطقس، أو الكهرباء، بملاحظته للذبذبات التي يسجلها كل من الترمومتر - الإلكترومتر - مقياس الكهرباء، فعالم الاجتماع أيضا عليه أن يحترم هذه القاعدة وأن يتخذ هذه الحيطة نفسها. وما يقصده دوركايم هنا، هو استعانة الباحث بتقنيات منهاجية مثل الاستمارات والمسجل الصوتي وكل التقنيات التي تتيح له جمع المعطيات التي يحتاجها في دراسته. أما القاعدة الرابعة فهي خاصة بتفسير الظواهر الاجتماعية. وعلى من يحاول تفسير إحدى الظواهر الاجتماعية، أن يبحث عن كل من السبب الفعال الذي يدعو إلى وجود هذه الظاهرة والوظيفة التي تؤديها، وأن طريق البرهان في العلوم الإنسانية وعلم الاجتماع خاصة، هو طريق المقارنة والملاحظة، وبالتالي فموضعة الظاهرة الإنسانية ممكنة.
إذا كان ظهور العلوم الإنسانية قد جعل النزعة الوضعية والاتجاهات الوظيفية تعتقد بإمكانية موضعة الظاهرة الإنسانية وفصلها، ودراستها دراسة تجريبية وفق مناهج العلوم التجريبية، فإن قيام الإبستمولوجية (فلسفة العلوم) باعتبارها الدراسة النقدية للمعارف العلمية وتوسيعها لمجالها، جعلها تهتم كذلك بالعلوم الإنسانية دارسة ناقدة للمعارف التي تنتجها والمناهج التي توظفها في بناء معرفتها. فمثلا نجد من بين الإبستمولوجيين داخل العلوم الإنسانية، جان بياجيه، رائد الإبستمولوجية التكوينية، الذي أكد أن مشكلة العلوم الإنسانية هي الذاتية التي يصعب التخلص منها، لأن الذات العارفة (العالم في العلوم الإنسانية)، هو نفسه موضوع للمعرفة. كما أن الآيديولوجية لديها تأثيرها وحضورها.
ففي مجال الفيزياء أو الرياضيات، يظل حضور الآيديولوجية غير طاغٍ، لأن العالم يتعامل مع ظواهر مستقلة ومعزولة. بينما في العلوم الإنسانية، يتعامل العالم مع مواضيع حية تنتمي إليه نفسيا أو آيديولوجيا أو عقديا. لذلك تحضر الأحاسيس والانطباعات الشخصية والأحكام المسبقة لتوجه البحث وتؤثر فيه، ما يحول دون تحقيق الموضوعية. فمثلا، حينما يكون موضوع البحث هو الدين أو السياسة أو الانتحار، فإن الباحث قد لا يستطيع الفصل بين أفكاره الخاصة عن الموضوع وخصائص الموضوع المدروس، كما هو في المجتمع.
وفي هذا الصدد يلخص بياجيه هذين العائقين الإبستمولوجيين، اللذين يجعلان تحقيق الموضوعية صعبا، في قوله: «إذا كان هذا الواقع (واقع التزام الباحث)، أقل تأثيرا في الأبحاث الرياضية والفيزيائية، وحتى البيولوجية، فإن تأثيره يبقى كبيرا في دراسة الظواهر الإنسانية من طرف العلوم الإنسانية».
وفق هذا التصور، عمل لوسيان غولدمان في كتابه «العلوم الإنسانية والفلسفة»، على توضيح الاختلاف بين عمل العلماء الفيزيائيين والسوسيولوجيين مثلا. فهو ليس اختلافا في الدرجة، بمعنى من هو الأكثر علمية من الآخر: العلوم الفيزيائية أم السوسيولوجية؟ بل هو اختلاف في الطبيعة. فطبيعة الميدان الذي يشتغل فيه الفيزيائي، ليس هو الميدان الذي يشتغل فيه السوسيولوجي. فالفيزيائي في اشتغاله يصطدم فقط بالموضوع المدروس. بينما الباحث السوسيولوجي يصطدم بأبعاد متعددة، آيديولوجية وسياسية وطبقية ومصالح، ما يجعل العلوم الإنسانية حقلا للصراع الآيديولوجي، ما يفرز تعدد المقولات والمفاهيم.
وهي كلها عوائق إبستمولوجية تسد الطريق أمام الفهم الموضوعي للموضوع المدروس. كما أن الفرق الثاني بين المجالين، هو كون العلوم الفيزيائية والتجريبية قادرة على أن تصوغ قوانينها الخاصة التي تستطيع، من خلالها، تعميم تفسيرات يمكننا، من خلالها، التنبؤ والتوقع متى تحدث الظاهرة. بينما في العلوم الإنسانية، يظل التنبؤ بالموضوع صعبا، ما جعل مشيل فوكو يقول، إن الأفعال الإنسانية مهما أنتجنا حولها من مقولات وتفسيرات تظل رهينة بزمن إنتاجها، لأن الإنسان كائن منتج ومتغير.
يمكن القول إن العائق الإبستمولوجي الذي يحول دون موضعة الظاهرة الإنسانية، هو العائق الذاتي. لأن فصل الذات العارفة عن موضوع المعرفة، هو أساس الموضوعية العلمية في العلوم الحقة. لكن ألا يمكن القول إن الركون إلى هذا المعيار، قد يسقطنا في وهم الانغلاق والمحاكاة للعلوم الطبيعية، فنعيد إنتاج أزمتها داخل العلوم الإنسانية؟ لقد لاحظنا كيف أن العقلانية العلمية في إحدى لحظاتها لم تعد عقلانية منغلقة، بل منفتحة على الذات وعلى الواقع. كما أن الشروط التجريبية يبنيها العالم وفق نموذج معين، ما يؤكد أن الذاتية هي صفة ملازمة لكل نشاط معرفي. لكن يجب التسلح بالحذر الإبستمولوجي حتى نتمكن من تقديم تحليل ودراسة موضوعية، وهنا لن تكون الموضوعية التي تنتجها العلوم الإنسانية شبيهة بالموضوعية في العلوم الفيزيائية. بل ستنتج العلوم الإنسانية تصورها الخاص للموضوعية، الذي يتلاءم وطبيعة المواضيع التي تدرسها. لكن على الرغم من ذلك، يظل الإنسان عصيا على الدراسة والتحكم والتنبؤ بسلوكياته. فمن توقع أن إحراق بائع للخضراوات لذاته في تونس، سيدك نظاما سياسيا برمته ويسقطه؟
* أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي