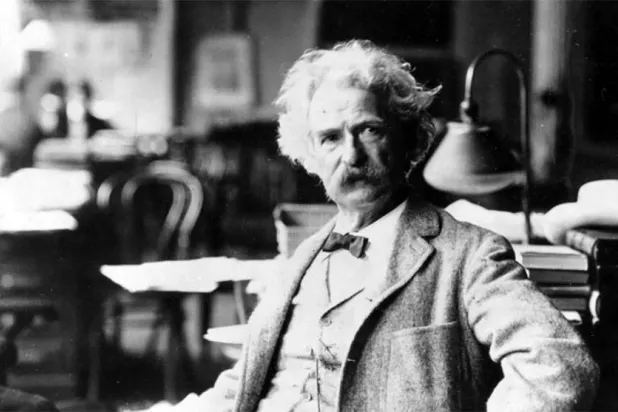ليس من السّهل الكتابة عن البربرية من داخل اللغة التي أنجبت الحضارة، ولا مساءلة الخراب من قلب ثقافة أنتجها التنوير، لكن الشاعر والكاتب فاضل السلطاني، في كتابه «البربرية الثقافية... وقائع الانهيار»، -دار خطوط وظلال، عمان- يفعل ذلك تماماً، فيضعنا أمام مواجهة صريحة مع أسئلة العصر الحرجة، متخذاً المقالة الصحافية جسراً يعبر عليه الفكر من آنية الحدث العابر إلى ديمومة السؤال الفلسفي. نحن هنا بإزاء مدونة فكرية تمتد على مساحة ربع قرن، ترصد، بعين الشاعر وحس المفكر، تلك الارتجافات الخفية التي تسبق الزلازل الحضارية الكبرى. يتجاوز هذا السِفر كونه تجميعاً لنصوص نشرت في الصحافة السيارة؛ بل سيرة عقلية وروحية لكاتب رأى العالم يتغير أمام عينيه، من وعود التنوير والحداثة، إلى عتمة توحش لم يعد يعبأ حتى بارتداء قفازات حريرية.
ينطلق السلطاني من فرضية مُروعة، تستعير نبوءات ماركس ونيتشه، لتؤكد أن البربرية ليست مرحلة تجاوزتها البشرية، وإنما هي احتمال دائم الوقوع، كامن تحت قشرة الحضارة الرقيقة، ويفكك في القسم الأول من كتابه، ملامح هذه البربرية الجديدة: بربرية تتغذى على التقنية، وتنتعل أحذية العولمة، وتمارس طقوس الإلغاء والمحو بدم بارد. رؤيته أن التقدم العلمي والتقني الهائل الذي أنجزته البشرية، سار في خط بياني متصاعد، قابله خط بياني آخر يهوي بالقيم الأخلاقية والإنسانية إلى القاع. وفي هذه المفارقة تكمن مأساة الإنسان المعاصر؛ الإنسان الذي يمتلك أدوات تدمير الكوكب، بينما يفقد، يوماً إثر يوم، بوصلته الأخلاقية التي تمنحه مبرر الوجود.
تتجلى ثيمة «التشظي» كخيط ناظم للمقالات، فتستدعي أصواتاً شعرية وروائية كبرى، من ييتس وإليوت إلى جويس وكافكا، ليقيم معها السلطاني حواراً حول مصير العالم. حين يستحضر قصيدة ييتس «المجيء الثاني»، أو «الأرض اليباب» لإليوت، فإنه يشير إلى تلك اللحظة التي يفقد فيها العالم مركزه، وتتداعى الأشياء، وتُفلت الفوضى من عقالها. هذا التشظي الذي رصده أدباء الحداثة في بدايات القرن العشرين، يراه متجسداً الآن بصورة أشد عنفاً ووضوحاً في القرن الحادي والعشرين. إنه عصر السيولة المطلقة، حيث تذوب الحقائق، وتتلاشى الحدود بين الجلاد والضحية، وبين الثقافة والتفاهة، وبين الحقيقة والوهم.
يذهب الكتاب بعيداً في تحليل ظاهرة «الشعبوية» التي تجتاح العالم، من «بريكست» البريطاني إلى صعود اليمين المتطرف في أوروبا وأميركا. يقرأ المؤلف هذه الظواهر لا بوصفها أحداثاً سياسية منعزلة، وإنما كأعراض لمرض حضاري عضال. إنها عودة «القبلية» في ثياب عصريّة، وانتصار الغريزة على العقل، والخوف على الأمل. ويربط ببراعة بين سيكولوجية الطغيان، مستدعياً نماذج من هتلر إلى نتنياهو، وبين الرغبة المحمومة في التدمير كشرط لتحقيق التفوق الموهوم. في هذا السياق، حتى «العمارة» عند الطغاة ليست سوى محاولة يائسة للخلود عبر الحجر، تعويضاً عن الفناء الذي يزرعونه في البشر.
وفي التفاتة عميقة إلى الواقع العربي، يُخضع السلطاني ظاهرة «الربيع العربي» لمشرط التحليل الثقافي، فيرفض القراءات السطحية التي تكتفي بالنتائج السياسية المباشرة، ليغوص في البنية العميقة للمجتمعات العربية. وهو يرى أن ما حدث كان زلزالاً ضرورياً لخلخلة قيم الطاعة والخضوع التي تكلست عبر قرون. ورغم المآلات الدموية، والانتكاسات، وصعود قوى الظلام، فإنه يلمح في الأفق ولادة عسيرة لفرد عربي جديد، يجرؤ لأول مرة على التحديق في وجه جلاده، ويطرح سؤال الحرية كقيمةٍ وجودية عليا. إنها قراءة تنحاز للمستقبل، وتراهن على «مكر التاريخ» الذي يعمل في الخفاء، ويقود البشرية، عبر مسارات متعرجة ومؤلمة، نحو غاياتها النهائية.
في الكتاب حيز واسع لمناقشة قضايا التنوير، والعلاقة الملتبسة بين الشرق والغرب، ومفاهيم الهوية والمنفى. وينتقد بجرأة «أسئلة التنوير المقلوبة» التي تنشغل بالنتائج دون المقدمات، وتغفل عن دور الحامل السياسي والاجتماعي في إحداث أيّ تغيير ثقافي حقيقي. كما يفكك خرافات المركزية الغربية، ونظرتها الاستشراقية المتعالية، وفي الوقت ذاته، لا يوفر نقداً للذات العربية المستلبة، التي تعيش حالة من الانفصام الفكري والأخلاقي، وتمارس سطواً مسلحاً على الدين والتاريخ، لتبرير عنفها وتخلّفها.
القسم الثاني المخصص لـ«الأدب» يحتفي بالكلمة بعدّها قدرة أخيرة على ترميم ما هشمته السياسة. الأدب هنا لا يقرأ كترفٍ فكري أو ملاذٍ جمالي من واقع مأزوم، بل كمختبر أخلاقي تُطرح فيه الأسئلة التي عجزت الآيديولوجيات والأنظمة عن الإجابة عنها.
يطوف بنا المؤلف في عوالم دوستويفسكي، وتولستوي، وكافكا، ونايبول، وجورج أورويل، ومارغريت آتوود، وشعراء الحداثة العرب والغربيين، ليبحث عن تلك اللحظة التي يصبح فيها الأدب شهادة على الإنسان حين تفشل الدولة، وتتعطل السياسة، ويصمت الخطاب العام.
في هذه النصوص، الأدب ضرورة وجودية، ووسيلة مقاومة صامتة، وشاهد أمين على العصر، يحفظ للإنسان ذاكرته الأخلاقية في زمن تتآكل فيه المعايير، ويُعاد فيه تعريف العنف والشر بوصفهما أمرين معتادين.
يتناول السلطاني قضية الشعر بحساسية عاليّة كما يليق بكاتبٍ يُقيم عند التخوم بين الفلسفة والقصيدة راصداً انحساره في عصر النثر والرواية، ومتسائلاً عن مصير الشعر العظيم الذي تنبأ هيغل بموته. لكنه، في الوقت عينه، يحتفي بالشعراء الذين يولدون بعد الموت، وبالنصوص التي تكسر حاجز الزمن، ويُعيد الاعتبار لأسماء غيبها النسيان أو القمع، ويضيء على تجارب من ثقافات مختلفة، مؤكداً عالمية التجربة الشعرية، وقدرتها على توحيد البشر في مواجهة الألم والموت.
يكتب المؤلف من منطقة نادرة تلتقي فيها صرامة الفكر بأريحية السرد، فتخرج اللغة من أسر الأكاديمية الجافة من دون أن تفقد عمقها المعرفي. إنها لغة «مفكّرة» لا تستعرض أفكارها، بل تعيشها، وتحمل قلقها وأسئلتها داخل نسيجها الجمالي. نصوصه مشبعة بحرارة التجربة، كُتبت بمداد القلق والأمل، وبشغفٍ معرفي يحوّل العابر واليومي إلى بوابة للتأمل في الكلي والمطلق. وفي هذا المسار، لا يُترك القارئ في موقع المتلقي، وإنما يُستدرج ليكون شريكاً في عملية التفكير، وطرفاً في مساءلة العالم ومعناه.
يُعد «البربرية الثقافية... وقائع الانهيار» وثيقة إدانة لعصرنا، وصرخة احتجاج ضد نظام التفاهة الذي يحاول تسطيح الوعي البشري. إنه دعوةٌ ملحةٌ لاستعادة الحس الأخلاقي، والعودة إلى الينابيع الأولى للمعرفة والثقافة، تلك التي تضع الإنسان في مركز الكون، وتؤمن بقدرته على تجاوز شرطه المأساوي. بذلك يمثل في مجمل مقالاته، دفاعاً مستميتاً عن المعنى في عالم يغرق في العبث، وعن الجمال في مواجهة القبح، وعن الذاكرة ضد طوفان النسيان.
إن قراءة نصوص السلطاني تشبه النظر في مرآة صافية، نرى فيها وجوهنا، ووجوه عصرنا، بلا رتوش أو أقنعة، وتضعنا أمام مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية في منع «البربرية» من اقتحام أبوابنا المشرعة.
إنه كتاب يقرأ ليبقى، ولعل أهميته تزداد مع مرور الوقت، بوصفه شهادة حية من عين يقظة على زمن التحولات الكبرى، وزمن الأسئلة التي لم تعد تقبل الانفعالات العابرة.