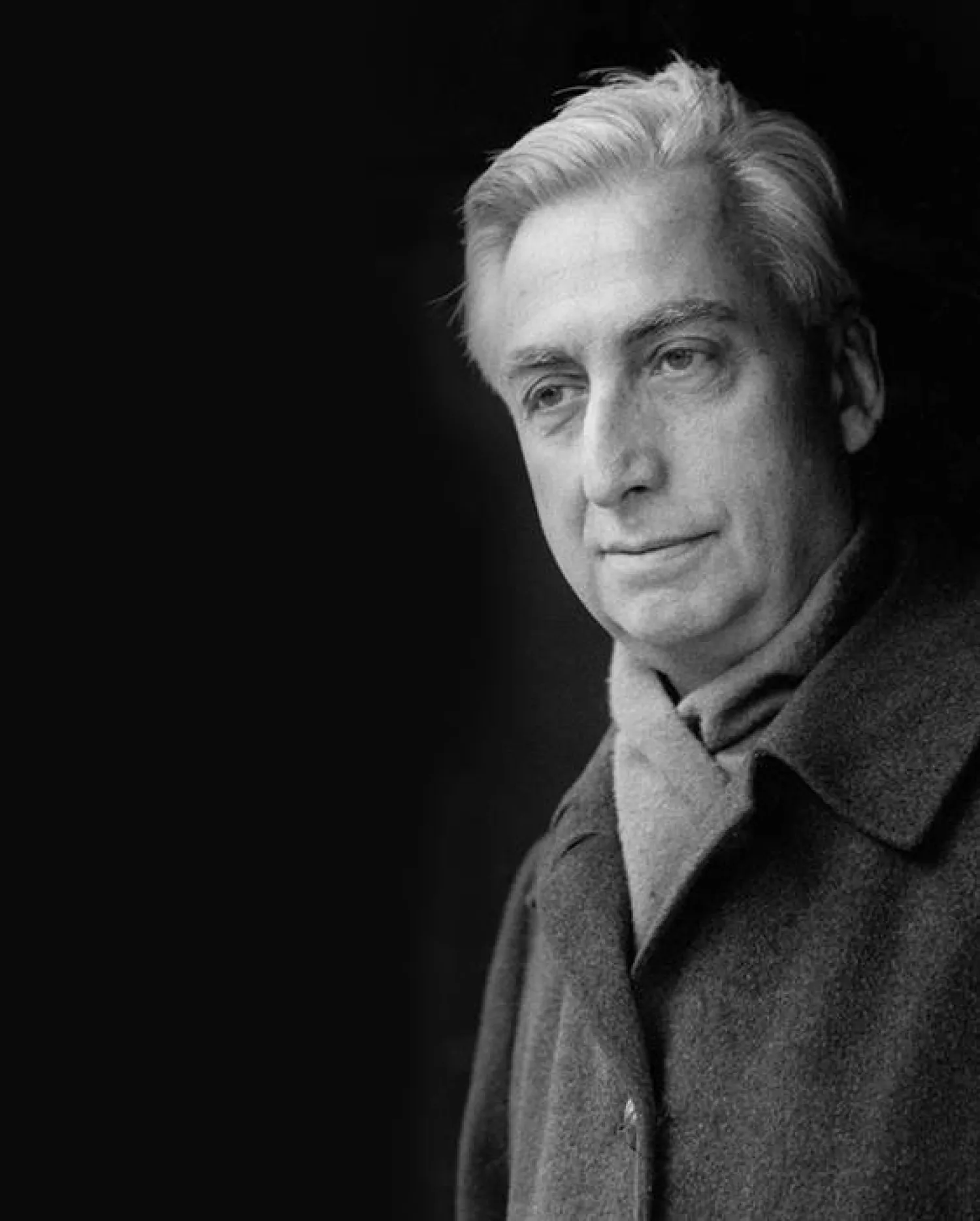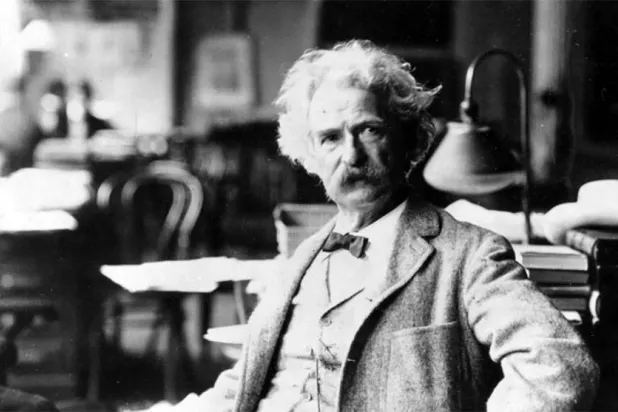وضْع الناقد الأدبي أمام المساءلة خيار يبدو لي صعباً، والتبشير أو الإعلان عن «موته» الرمزي هو موقف يحتاج إلى مراجعة نقدية أيضاً، لأن هذا الناقد ليس بعيداً عن تشكيل هوية المشهد الثقافي الذي تقوض كثير من أبنيته وأطروحاته ومرجعياته، حتى يبدو الحديث عن «موت الناقد» مسوغاً ومقبولاً في التداول.
ما طرحته القاصّة والروائية لطفية الدليمي في عدد جريدة «الشرق الأوسط»، الصادر في 8 يناير (كانون الثاني) 2026، يثير أسئلة مفتوحة عن توصيف موت الناقد، وعن المجاهرة بهذا الموت، مقابل الدعوة إلى حضور القارئ الذي سيملأ فراغات النصّ، بوصفه البديل الأكثر حيوية في تمثيل صانع القوة المعرفية الجديد، أو بوصفه القارئ الفائق، أو القارئ العمدة بتوصيف ريفاتير، وهذه الوظيفة تعني جرّ القراءة إلى رهانات صعبة، لا يمكن ربطها إلا بسياق التاريخ الإشكالي للميتات القديمة التي طرحها نيتشه ورولان بارت وفوكو، وأخيراً رونان ماكدونالد الذي ربط موت الناقد بصعود القارئ غير المتخصص والقريب من وظيفة «المُشغّل الثقافي».
التصريح بموت الناقد لا يعني الحديث عن غيابه، بقدر ما يعني الحديث عن أزمة مساءلة الخطاب النقدي، على المستوى الأكاديمي أو المنهجي، حتى المستوى الآيديولوجي، لأن الناقد سيظل شخصية مشاغبة، في سياق وظيفته، أو في سياق وعيه، وتأهيل دوره في توصيف القراءة يعني توسيع أدواته التي تُعطي لنصّه المجاور حرية فاعلة، وربما طاقة أخرى لمواجهة ما يخفيه المؤلف، خوفاً أو تورية، أو مكراً، وهذا ما يدفع الناقد لأن يكون «خبيثاً» أو فضائحياً، عبر جرّ النص إلى التأويل، وهي محاولة في الذهاب به إلى «فائض المعنى» بتوصيف ريكور، حيث يؤسس عبر هذا الفائض موقفاً قد يتقاطع مع المؤلف الآيديولوجي، ومع تمثلاته ومرجعياته المعرفية والجندرية والتاريخية.
الحديث عن «سلطة الناقد» لا يعني الحديث عن شبح يمكن استئجاره بتوصيف سليم بركات، لكي يدون سيرة مضادة، أو يمارس نوعاً من الاستبداد النقدي، بقدر ما يحضر كون القارئ الفاعل، الذي يدرك أن لعبة القراءة مفتوحة، لكنها ستكون أكثر تعقيداً عبر صناعة نصٍ موازٍ، أو عبر ما تقيمه من حوار مع المؤلف، الحوار الذي يشبه «العصف الذهني» المهيج لحوارات متوالية تتفاعل وتتنامى داخل مجتمع القراءة، لذا لا أحسب أن هذا الناقد سيمارس وظيفة «احتكار المعنى» أو أدلجته، بقدر ما سيكون أركيولوجيّاً يدرك أهمية الحفر في مستويات النص، بعيداً عن أي صلاحية، أو تخويل، وعن أي خرق لخصوصية النص الذي تحرسه الآيديولوجيا، وأحسب أن كثيراً من المؤلفين قد تحولوا إلى نقاد، لأنهم أدركوا أهمية الآخر في القراءة، الآخر الذي يمكن أن ينسلخ عن ذات المؤلف، أو من مرآته ليمارس رقابة أو مراجعة مغايرة للنص المكتوب، أو للذات النرجسية.
السرد وغواية الناقد
القاصة الكبيرة لطفية الدليمي من أكثر الكتّاب الذين انشغل بهم النقد العربي والعراقي، لأهمية وعمق مشغلها السردي، الذي استغرق عوالم غامرة بالصراع النفسي والاجتماعي، وبحيوات عاشت أزماتها الوجودية عبر اشتباكها مع واقع غرائبي، ومع تحولات عميقة في تاريخ العراق السياسي والاجتماعي، فهي لم تكن ساردة جندرية، بقدر ما أنها جعلت قصصها ورواياتها أسئلة فضاءات مفتوحة للقراءة والترميز النفسي والإنثربولوجي، ولا سيما ما يتعلق بشخصية البطل الثقافي - الرجل والمرأة - عبر تمثيل وعيها الحاد إزاء الحرية والحب والسلطة والعنف، وهناك من جعل من سردياتها وثائق لمقاربة «صدمة العراق السياسي» عبر شخصيات جعلت منها الدليمي أقنعة اغترابها، وتعقيدات مأزقها الوجودي، عبر تمثلاتها الرمزية في تاريخ العراق وأزماته الكبرى.
هذه الكشوفات ليست بعيدة عن كشوفات الناقد الذي كان قارئاً استثنائياً، الذي وجد في سرديات الدليمي، مرجعاً لتنشيط «التخيل التاريخي» ولتقويض التاريخ عبر السرد، وربما للكشف عن علاقات تخص النص بالمعرفة والجسد، أو بالاجتماع السياسي، أو بالآيديولوجيا، التي كثيراً ما تتسلل عبر لا وعي المؤلف، ومهمة الناقد تتجلى عبر إثارتها، وليس بالتحوط والتحول إلى كائن مهووس بالأحكام، أو ربما بتأويلات يخشى المؤلف الكشف عنها، لأن النص هو مرآته الشخصية، والناقد هو اللص الذي يتنمر بكشوفات خرق نرجسية المرآة.
عدم مقبولية وظيفة الناقد في «زمن انفجرت فيه سلطة المعنى، وتنوعت فيه أشكال القراءة بذات المقادير التي تباينت فيها هذه الأشكال، وتراجع فيه مركز النص لصالح محيطه الذي غُيّب طويلاً» كما تقول الدليمي، لا يعني عزلاً لمسؤولية الناقد، ولا إحالته لـ«التقاعد الوظيفي»، لأن زمن النص أصبح مكتفياً بذاته، وسلطة القارئ تعمد إلى إعادة صياغة قواعد الاشتباك المعرفي، وممارسة وظيفة سدّ الفراغات وتقبّل صدمة التلقي والتوقع.
أحسب أن هذه المفارقة الوظيفية لا تعني تبادل أدوار، ولا خرقاً لبداهات جعلتها الواقعية النقدية جزءاً من مشروعها، ومن سلطتها ومن مناهجها، بقدر ما أنها أعادت التموضع على وفق تحول القارئ، بوصفه ناقداً، لأن هذا القارئ ليس هامشياً، وحيازته لأدوات القارئ المعرفي تعني أيضاً تبديلاً في عنوانه الإجرائي، وأنه سيكون مشاركاً، ليس في صياغة أخرى للاستبداد النقدي، بل في أن يكون المشارك والمؤوِل الذي يجعل من النص مفتوحاً على قراءات، وعلى مقاربات متعددة، تتجدد مع تجدد تلك القراءات، عبر تعدد مرجعياتها ووسائطها، وعبر مفاهيمها التي تغتني حتماً بالكشوفات الجديدة، ما سيعزز من فاعلية القراءة، بعيداً عن السلطة والآيديولوجيا و«القول الفصل»، كما تذهب الدليمي.
إن تغيّر النصوص، وتنوع اشتغالاتها، وتعدد قراءاتها، وانفتاح سرودها على زمن متشظٍ، لا يبرر عزل الناقد، أو الدعوة إلى إماتته، بقدر ما يعني دعوته لتجديد أدواته، وإلى التخلّص من ذاكرة «الناقد الانطباعي» و«الناقد الآيديولوجي» و«الناقد المسلكي» والانهمام بصياغة «قواعد اشتباك» فاعلة، وحيوية تتسق مع سرعة تشكل وتغاير الأفكار والمناهج، حيث تكون «ديمقراطية التأويل» كما تقول الدليمي سانحة للقبول بالمختلف، ومنافسة المؤلف على حيازة نصوصه التي يتوهم أنه حارسها الوحيد.
ما طرحه رولان بارت عن «موت المؤلف» لا يعني سوى موت المؤلف الآيديولوجي الذي صنعه اليسار التقليدي الستاليني، وأن موته يعني ولادة «النص» الذي يجد في بناه الداخلية ترياقاً للخصب والقوة والاكتفاء، ولأن هذا الموت البنيوي كان خدعة، فإنه سرعان ما تخلى عنه مؤسِّسوه الذين جعلوا من «ما بعد البنيوي» مجالاً لصياغة مفاهيم مضادة، تخصّ الفردانية، و«ما بعد حداثية»، والعودة إلى الكائن المراقب، والعيادي، وصانع الأساطير الصغيرة.
الناقد قد يكون شبيهاً بكائن ميشيل فوكو، الذي يجد هوساً بالرقابة، وبأن النص الذي يكتبه مجالٌ عيادي يحتاج دائماً إلى المشفى، وإلى الجراح كنظير لاستدعاء القارئ والمؤول والباحث الحرّ الذي يجعل من القراءة، أو من القراءات، ممارسة في الحثِّ على التوليد والإغواء والإثارة، وإلى إعادة النظر بسلطة المؤلف ذاته.
موت الناقد... موت القارئ
أجد في هذه الثنائية تلازماً في تغويل إشاعة فكرة الموت الرمزي، وفي زحزحة وظائفهما، لأن موت الناقد أو عزله سيكون باعثاً على موت القارئ الذي يتقنع به، وعلى تجريد النص من مريديه، وتحويل المؤلف إلى كائن مستبد، يروّج لتفوقه، ولسلطته بعيداً عن شغف اللذة التي تستدعي الآخرين إلى ما يحمله النص من إيحاءات، أو من انساق مضمرة، أو من رثاثة لن تكون بعيدة عن المؤلف الذي يرى نفسه وحيداً في المرآة المقعرة، أو المنحنية.
الناقد العمومي ناقد صنعته الصحافة والموضة وأنظمة الاتصال، لكن الناقد المتخصص هو الناقد الذي صنعته «الأكاديميات»، والذي يملك منهجية وفاعلية التجاوز، ويمنح خطابه قوة للتعالي، وللكشف. وأحسب أن من كشف بودلير في «حداثته» وفي نظرته للنص العابر هم النقاد الفاعلون، ومن كشف نيتشه وخرقه الفلسفي هم النقاد الذين خرجوا من زمنه إلى زمن نصوصه، حتى كافكا الذي تحول إلى ساحر سردي كان جزءاً من لعبة النقاد الذين قرأوا نصوصه الغريبة بعد رحيله، بعد أن اتسعت مساحة قراءتها لنقاد آخرين أكثر وعياً بما تحمله من جدة وحساسية وخرق للمألوف السردي.
ما طرحه رونان ماكدونالد في كتابه «موت الناقد» يعيد طرح السؤال حول هوية الناقد، وحول الوعي والصلاحية التي يمكن لهذا الناقد أن يملكها بوصفه قارئاً متعالياً، وليس بوصفه حارساً أو صاحب دكان، بل بوصفه عارفاً بالمقروء، وكاشفاً عن المخبوء، وفاعلاً في تحويل القراءة إلى خطاب مجاور، وإلى دليل يعزز من كشوفات النص، ومن محمولاته المعرفية والجمالية حتى القبحية، كما يقول أصحاب النقد الثقافي.
التسمية لا تهم في هذا السياق، لأنها قد تكون مخادعة، فـ«المشغّل» هو الناقد، و«القارئ العمدة» هو الناقد، ومشغله النقدي لن يكون بعيداً عن النص ومرجعياته، وعن إحالاته التي يتحول الدرس والحفر فيها إلى اجتهاد ثقافي معرفي، له قاموسه ومنهجه، وله أدواته التي تجعله فاعلاً في إثراء النص وفي تأهليه للقراءة الفاعلة.