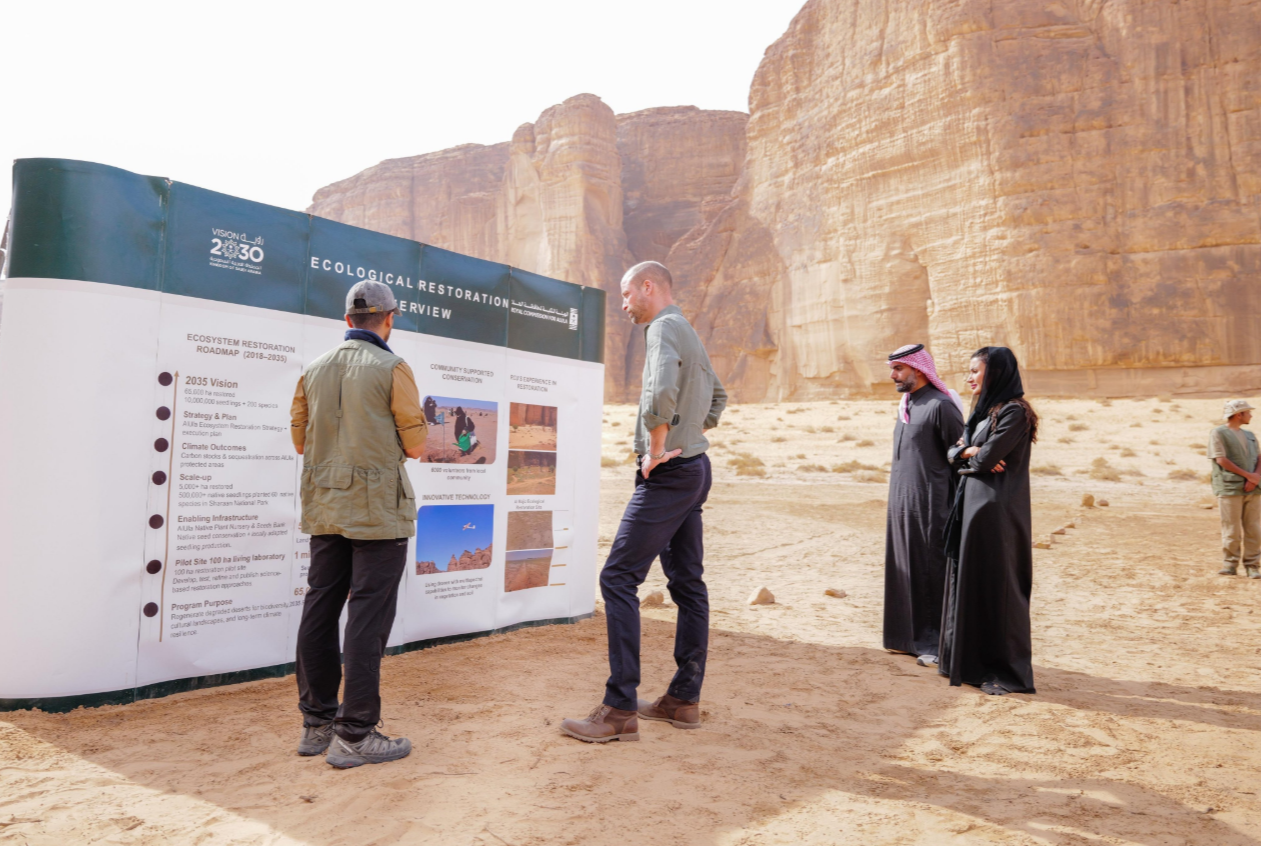في ربيع لشبونة البرتغالية، حيث ينساب الضوء على جدران المدينة القديمة وتغمرها نسمات البحر الدافئة، تنطلق أحداث الفيلم البرتغالي «الحياة المضيئة». يتتبّع العمل مسار حياة «نيكولا»، الشاب البالغ من العمر 24 عاماً، ويعيش مرحلة من التعلّق بين الماضي والمستقبل.
الشاب الذي انفصل عن حبيبته قبل عام، ترك دراسته بلا هدف واضح، ويقضي أيامه متنقلاً بين وظائف مؤقتة لا تمنحه سوى الشعور باللاجدوى. يحلم بالموسيقى، لكنه بالكاد يعزف في فرقة لم تجد طريقها إلى أي جمهور. كل ما حوله يبدو في حركة مستمرة، فيما هو عالق في نقطة ساكنة، يراقب مرور الحياة كما لو أنها تخص آخرين.
في يوم عيد ميلاده، يجد نفسه محاطاً بأصدقاء يحاولون إخراجه من عزلته، فيلتقي فتاة فرنسية تُدعى «كلوي» جاءت إلى لشبونة لكتابة أطروحة عن «هندسة الموت». اللقاء الذي يبدو عابراً في البداية يوقظ داخله شيئاً من الفضول تجاه الحياة من جديد. ومع مرور الأيام، يبدأ «نيكولا» إعادة اكتشاف نفسه من خلال الأشخاص الذين يدخلون حياته بالصدفة: زملاء العمل، والجيران في السكن المشترك، والموسيقيون الذين يشاركونه البروفات الليلية.

كل شخصية تضيف لوناً جديداً إلى عالمه الرمادي، حتى وإن كانت تظهر وتختفي بلا مقدمات. يتولّى في أحد المشاهد عملاً مؤقتاً يُعِد فيه الدراجات العابرة في شوارع لشبونة. وظيفة تبدو هامشية، لكنها تمنحه للمرة الأولى فرصة لمراقبة حركة المدينة من حوله، وفي لحظة سريعة يلمح فتاة تشبه حبيبته السابقة، ومعها يبدأ وعيه بالزمن يتبدّل، كأن الماضي يمد يده للحاضر فيدعوه إلى التقدم ولو بخطوة صغيرة.
تتطور الحكاية ببطء نحو انفتاح «نيكولا» على الآخرين، خصوصاً بعد اقترابه من الفتاة الفرنسية «كلوي»، التي تحمل حضوراً نقيضاً له بشكل كامل منفتحة، خفيفة، تعرف ما تريد، العلاقة بينهما لا تُقدَّم كقصة حبّ تقليدية، بل مرآة تعكس التفاوت بين شخص يبحث عن معنى للحياة وآخر يعيشها كما تأتي.
يقول المخرج البرتغالي جواو روزاس، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما أراده في فيلمه الذي عُرض في النسخة الثامنة من «مهرجان الجونة السينمائي» في مصر؛ تصوير لحظة التكوين الشخصي في العشرينات، عندما يبدأ المرء الخروج من بيت العائلة، ومواجهة العمل، وتكوين صداقات جديدة، والتصالح مع التناقض بين ما يريده الآخرون له وما يحلم به لنفسه.
وأشار إلى أن علاقته بمدينة لشبونة كانت نقطة الانطلاق الأولى في بناء الفيلم. فقد بدأ التحضير عبر جولات طويلة في شوارعها، في تحضيرات وصفها بأنها أشبه بعملية «رسم خريطة وجدانية» للمكان.
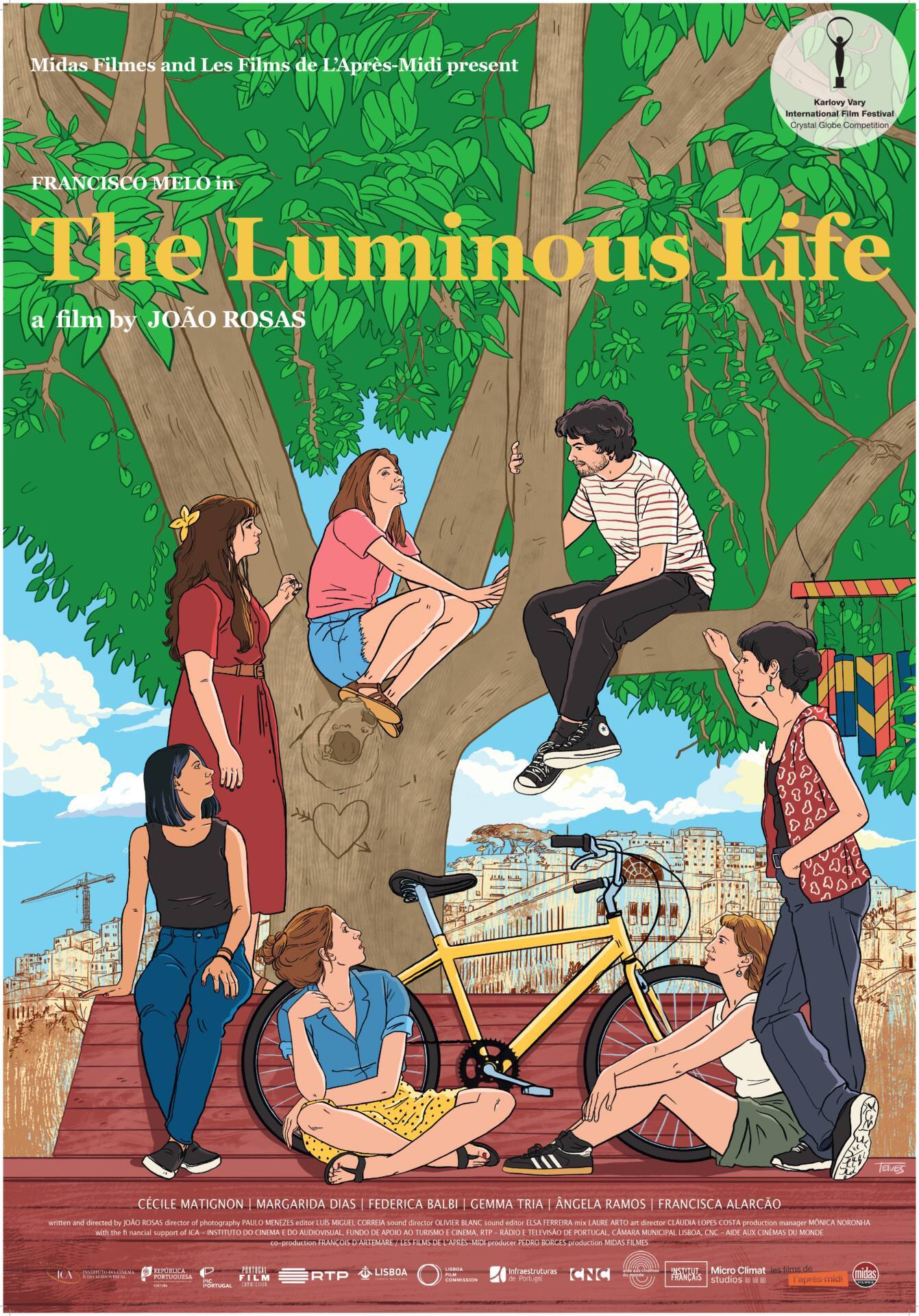
وأضاف أن تلك المسارات قادته إلى تفاصيل صغيرة، وإلى أماكن ترتبط بذكرياته القديمة وحياته اليومية. ومن خلال تلك الجولات، كان يشعر وكأنّ المدينة نفسها تهمس له بالأفكار وتدعوه إلى كتابة مشاهدها، مؤكداً أنه أراد أن يصوّر لشبونة الحقيقية، بعيداً عن الواجهة السياحية التي يراها الآن «مصطنعة ومصنوعة من البلاستيك»، حسب وصفه.
وقال المخرج إن الإيقاع البطيء للفيلم كان مقصوداً منذ البداية؛ إذ أراد أن يعكس الحالة الداخلية لنيكولا، وأن يجعل المشاهد يعيش الزمن كما يعيشه البطل: متثاقلاً، ومتكرراً، ومليئاً بالتفاصيل الصغيرة التي تشكّل جوهر الحياة اليومية. وأشار إلى أنه استلهم عنوان الفيلم من رسالة كتبتها شابة فلسطينية من غزة في الأيام الأولى من الحرب، قالت فيها إن من يعيشون في الخارج لا يستطيعون إنقاذهم، لكن يمكنهم أن يعيشوا حياتهم بصدق، وأن يحبّوا ويضحكوا ويُمضوا وقتاً جميلاً مع أصدقائهم.
وأكد أن هذه الرسالة بلورت فكرة الفيلم، القائمة على أن دور الإنسان في الحياة يتجسّد من خلال علاقاته الإنسانية، ومن خلال محاولة العثور على ما يجعلنا نستمر رغم العتمة.
وأضاف أن «مزيج الكآبة والكوميديا الذي يلوّن الفيلم، فيما يُعرف بـ(الكوميديا السوداء)، جاء من التجارب المشتركة مع الممثلين في أثناء البروفات، ومن ملاحظاته للحياة اليومية؛ فالكوميديا جزء لا ينفصل عن الوجود الإنساني، تظهر في الحركات الصغيرة، وفي طريقة حديث الناس، وفي العثرات البسيطة التي تكسر الجدية».

ويرى المخرج البرتغالي أن «السرد المفتوح الذي يبتعد عن ذروة الصراع يعكس نظرتي إلى الحياة، فهي تظل مفتوحة حتى يأتي الموت ليغلق الستار. ولذلك كان أقرب إلى السرد التأملي الذي يراكم المشاعر والأحداث الصغيرة، بدلاً من الحكايات التي تنفجر في منتصفها بصراع حاد؛ فالتغيّرات الكبرى تأتي من تراكم الأيام، لا من لحظة درامية واحدة»، على حد تعبيره.
وأضاف أن الحب في الفيلم ليس قصة واحدة، بل تجربة غير مكتملة، أشبه بـ«حب قبل النضج» أو «حب بعد الحب»، بمعنى أنه يعكس تلك العلاقات الأولى التي تترك فينا أثراً، لكنها لا تكتمل، مؤكداً أنه «من الطبيعي أن يعيش الإنسان أكثر من حبٍّ واحد في حياته؛ لأن العاطفة نفسها تتطور كما يتطور وعي الإنسان».
ولفت إلى أن «التفاصيل اليومية، مثل المقاهي والدراجات والشوارع، تحمل عنده القيمة السينمائية نفسها التي تحملها المشاهد الكبيرة؛ لأن الكاميرا عندما تلتقط البساطة تلتقط جوهر الإنسان. لذلك صوّرتها كثيراً، وجعلتها تملأ الفضاء البصري كأنها شرايين الحياة التي تسري في المدينة».
وأكد أن ترك بعض المشاهد «غير مكتملة» كان قراراً مقصوداً؛ لأنه «لا يريد أن يفرض معنى على المشاهد»، بل يتيح له أن يملأ الفراغ بتجربته الخاصة؛ فالفيلم، كما يرى، مجموعة من الطبقات: منها ما يظهر، ومنها ما يُكتشف بالمشاهدة والتأمل.