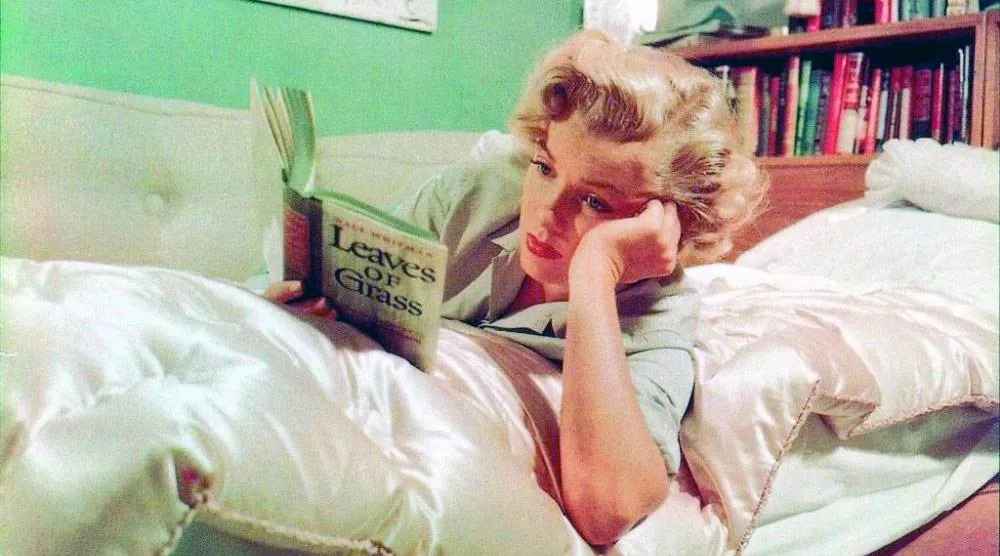للروائية والمترجمة القديرة لطفية الدليمي حرصٌ كبيرٌ على إدامة التواصل مع مستجدات الثقافة الغربية. وعادةً ما تسعى في اختيار موضوعاتها نحو الملاحقة الجادة لآخر إصدارات الكتب النقدية والفلسفية، بخاصة تلك الصادرة عن «دار روتلدج». وهو ما ينمُّ عن توق نحو التزويد (بجرعة معرفية تكفي في الأقلّ لشدّ عضد القارئ) كما جاء في مقالتها «دليلك إلى النظرية الأدبية» المنشورة في صحيفة «الشرق الأوسط» بتاريخ 10-9-2025 وفيها سعت إلى وضع «دليل» للنظرية الأدبية هو عبارة عن مجموعة كتب نقدية لمؤلفين غربيين.
وليس لي إلا أن أعبر عن تقديري لجهدها في طرق موضوع شائك مثل النظرية الأدبية، كما أثني على مسعاها في تنوير القارئ العربي الذي تفترض فيه احتياجه إلى قدر معين من الثقافة الموسوعية. ولا أروم في مناقشتي لمقالتها الاستدراك، وإنما المشاركة النقدية التي تثري ميدان النقاش بما هو مناسب ومفيد.
بدءاً تقوم فكرة المقالة على البحث عن كتب تأسيسية، تنضبط بموجبها عملية «المثاقفة» استناداً إلى «القراءات المنتظمة»، وإيماناً بالحاجة إلى «موجّهات دليلية نظرية». وما بين التأسيس والتوجيه، يصبح التمييز مهماً بين فلاسفة وأدباء - مثل سارتر وإليوت - مارسوا التنظير من منطلق تجاربهم في حقل أدبي، هم فيه مبدعون، وبين مفكرين كرسوا أعمارهم باتجاه التخصص في التنظير لأطروحة نقدية خاصة بالأدب مثل رومان جاكوبسون ورولان بارت ونورثروب فراي وهارولد بلوم.
وإذا كانت كتب «الدليل» متفاوتة في قيمتها المعرفية وفي تباعد أزمان تأليفها ومقدار صلتها بما يجري الآن من مستجدات في ساحة النقد العالمي، فإنها جاءت - باستثناء كتاب نظرية الأدب لرينيه ويليك وأوستن وارين - مشتركة في بعدين اثنين؛ الأول أنها تعليمية، معدة لطلاب المدارس والجامعات. وليست التعليمية هي المعتمد الأدبي بوصفه «مجموعة كتب أصلية، ولها تاريخ لا يمكن تجاهله، وهي ذات صيغ راسخة ولها قيمتها وغير مشكوك في صحة نسبتها إلى مؤلفيها»، والبعد الآخر في كتب «الدليل» أنها لمؤلفين ناطقين بالإنجليزية. وتوجهاتهم ومرجعياتهم واحدة تمثلها المدرسة الأنجلوسكسونية، باستثناء ويليك الذي انتمى إلى النقد الجديد، وكتبه اليوم من أهم مراجع المدرسة الأنجلوأميركية.

وكان لانحياز المقالة موضع التعقيب إلى كتب النقاد الإنجليز والأميركان مع حضور الصيغة التعليمية الإرشادية باستعمال كاف الخطاب، أن جعلا «الدليل» يوحي بحتمية تلاقي «النظرية الثقافية بالنظرية الأدبية أي بمعنى صار هناك توجّه عام لمثاقفة (Acculturation) النظرية الأدبية». والمعروف أن الدراسات الثقافية التي وضعها النقاد الإنجليز هي اتجاه منهجي ليس نهائياً، بيد أن الطابع الإرشادي (دليلك) يجعل القارئ يفهم أن التلاقي بين النظريتين هو توجه حاصل وجارٍ العمل به حالياً على مستوى النقد العالمي. وحقيقة الأمر ليست كذلك، فثمة اتجاهات أخرى كان يفترض بـ«الدليل» أن يتطرق إليها كي يرسم خريطة موضوعية، تضع القارئ العربي في صورة ما يطمح إلى التثقف فيه. وما لا اختلاف حوله أن تتبع تاريخ النظرية الأدبية هو غيره البحث في النظرية الأدبية؛ فالأول لا يقوم به أي باحث بسبب ما يحتاج إليه من نظر نقدي وتكريس للعمر الإبداعي في حين أن التتبع التاريخي أمر يمكن أن يقوم به أي باحث أو دارس يجد في نفسه قدرة على تتبع المسارات ورصد التطورات.
فهل يصح بعد ذلك أن نقارن بين منظرين مثل جاكبسون وجينيت ورينيه ويليك وبين نقاد أكاديميين هم باحثون في تاريخ النظريات وليست لهم أي إضافة نظرية مثل رامان سلدن وهانز بيرتنس. والأخير مغمور على صعيد النقد الغربي، فهو وإن كان أستاذاً فخرياً، وأعيدت طباعة كتابه - وهو على حد علمي الوحيد - عدة مرات، فلا يعني هذا تميزه المعرفي. ولا ذكر لهذا الاسم يرد لدى النقاد العرب المتخصصين وغير المتخصصين لسبب بسيط هو أن كتابه هذا غير مترجم إلى اللغة العربية. ولقد دار نصف مقالة الدليمي حوله، فاستعرضت الفصول الواردة في الطبعة الرابعة ثم عرجت على مميزات هذه الطبعة عن سابقتها الثالثة، علماً بأن الطبعة الأولى كانت عام 2001 ومن الطبيعي أن يضيف المؤلف إليها جديداً، لأن النظريات تتبدل وتتطور باستمرار.
وليس بيرتنس وحده في ميدان كتابة تاريخ النظريات، بل هناك أكاديميون كثر مثل البريطاني تيري إيغلتن بكتابه «نظرية الأدب» والأميركيين رامان سلدن بكتابه «النظرية الأدبية المعاصرة» وجوناثان كولر «النظرية الأدبية: مقدّمة وجيزة»، وليس من العدل أن نصف هذه الكتب بالتأسيسية أو نضاهيها بالكتب المؤسسة مثل «قضايا الشعرية» لجاكبسون، و«لذة النص» و«درس السيمولوجيا» لرولان بارت، و«خطاب الحكاية» لجيرار جينيت و«علم النص» لجوليا كرستيفا، و«بلاغة الخطاب القصصي» لواين بوث، وفيها وضعوا أطروحات نظرية، ساهمت في التأصيل النقدي للأدب. وبسببها تأسست مدارس عتيدة في النقد الأدبي.
ولا يعني تقديم النظرية الأدبية على تاريخ النظرية، التقليل من قيمة ما أُلف في هذا المجال أو انتقاص جهد أصحابها، لكنها فكرة «الدليل» التي تفرض على المتخصص الفصل علمياً بين النظرية والتاريخ، وأيضاً الفصل بين نظرية الأدب والدراسات الثقافية. وهذه الأخيرة عبارة عن اتجاه نقدي لاقى رواجاً منذ أواخر ثمانينات القرن العشرين ثم خفت صيته مع مطلع القرن الحالي بعد أن صعد نجم الاتجاهات التي تبنتها المدرسة الأنجلو أميركية.
ومن المهم أن نشرح بإيجاز دواعي اجتراح النقاد الإنجليز لهذا الاتجاه المنهجي الذي يجمع الأدب بالثقافة، واصطلحوا على تسميته بالدراسات الثقافية (Cultural studies)، وقد يجد القارئ في الدواعي تعليلاً ضمنياً للأسباب التي حملت النقاد العرب على تبني هذه الدراسات والاحتفاء الكبير بها أيضاً. إذ من المعلوم أن الشكلانيين الروس نجحوا نجاحاً باهراً في تأسيس مدرسة لاقت انتشاراً خلال النصف الأول من القرن العشرين. وتوطدت أركانها بإنجازات نقاد أوروبيين في مجال الأسلوبيات والدراسات الألسنية. وكان لظهور النقاد الجدد ثم البنيويين أن سحب بساط النظرية الأدبية من تحت أقدام الشكلانيين. فنشأت المدرسة الفرانكفونية وهيمنت على عرش النقد الأدبي خلال ستينات وسبعينات القرن نفسه. في هذه الأثناء كان النقاد الإنجليز دائمي البحث عن موطئ قدم لهم ما بين الروس والألمان والفرانكفونيين. واستندوا في مسعاهم هذا إلى كتب نقدية تجمع الممارسة بالنظرية، بعضها يعود إلى القرن التاسع عشر مثل كتاب «النقد العملي» لأرمستونغ ريتشاردز وكتب جون ستوارت ميل. وبعضها الآخر يعود إلى أدباء ونقاد ظهروا في حدود النصف الأول من القرن العشرين مثل رايموند ليفز بكتابه «الاتجاهات الجديدة في الشعر الإنجليزي» وت. س. إليوت بكتابه «التقليد والموهبة الفردية»، وكانت مساعي الثقافيين موجهة نحو التقوقع على الفكر الإنجليزي من جهة، واتخاذ «الثقافة» من جهة أخرى منهجاً ونظرية وفلسفة في دراسات تقوم على النقد البنَّاء (رايموند وليامز) والنقد المستهجن والساخر (تيري إيغلتون)، والهدف هو الارتقاء بالمدرسة الأنجلوسكسونية لتكون في مصاف المدرستين الفرانكفونية والأنجلوأميركية، لكن الهدف لم يتحقق. فلقد بقيت الدراسات الثقافية مجرد منهجية، لا يزال النقاد الإنجليز يواظبون على الاشتغال بها من دون أن يضعوا نظرية محددة في «الأدب» يمكن وصفها بأنها نظرية أدبية. واستناداً إلى واقع الدراسات الثقافية البريطانية لا تكون كتب إيغلتون وستوارت هول وهانز بيرتنس تأسيسية ولا دليلاً مرجعياً للنظرية الأدبية.
عربياً كان الدكتور عبد الله الغذامي من أوائل المطبقين لهذا الجمع بين الأدب والثقافة، وفات الأستاذة الدليمي الإشارة إلى كتابه «النقد الثقافي» (2000)، وفيه جهد واع وبأفق نظري في الدعوة إلى النقد الثقافي. ولاقت دعوته رواجاً، وتباينت طرائق استيعابها؛ فكثير من نقاد الأدب العربي فهموا الثقافية على أنها دعوة إلى تجاهل النظريات الأدبية بمفاهيمها وأجهزتها الاصطلاحية. وبرأيهم أن ما داموا يعملون تحت يافطة «النقد الثقافي»، فإنهم في منأى من أي مؤاخذات علمية أو تصحيحات مفاهيمية. ووجد غيرهم في الإنشائيات واللعب على مفردات مثل «الأسئلة، الآخر، السرديات» ما يسهل عليهم تدبيج مقالات، هي في تصورهم نقدية، تغني عن عناء المدارسة المكثفة والتكريس المنتظم وقصدية الإحاطة المستمرة في عالم النقد الأدبي.
وكان من متحصلات القراءة السلبية لدعوة الدكتور الغذامي أن صار لدينا نوعان من الناظرين بانتقاص إلى «النقد الأدبي»: النوع الأول يرى أن النقد الثقافي بديل عن النقد الأدبي، والنوع الآخر يرى علم الأدب بديلاً عن النقد الأدبي. وهذا ما أكدته أيضاً مقالة الدليمي، فالنقد الأدبي كان في زمن ماض «ذا سطوة لا يمكن مخاتلتها»، ثم ذهبت السطوة و«خفت النقد الأدبي كثيراً» إلى أن تلاشى هذا النقد و«ظهر الأدب اشتغالاً عاماً لمختصين بالذكاء الاصطناعي والرياضيات والفيزياء، ولم يعُدْ احتكاراً خالصاً»، وكأن ليس النقد الأدبي حقلاً معرفياً عمره من عمر الفلسفة الإغريقية، وكأن ليس له من التخصص والعلمية والعمق التاريخي والأهمية الجمالية ما يؤكد استقلاليته، ويفنِّد أي محاولة لشطبه.
وأشاطر الدليمي مسعاها في البحث عن كتب عربية تصلح أن تكون «موجّهات دليلية نظرية في فضاء الأدب العربي والثقافة العربية»، لكن بشرط أن تكون مواكبة لمستجدات النظرية الأدبية، لا أن تعود بنا إلى ما قبل ثلاثين عاماً بأطروحتين لعبد الله إبراهيم (1996) وسعيد يقطين (1989) الأولى اتبعت في دراسة السرد العربي المنهج البنيوي، والأخرى اتبعت المنهج البنيوي التركيبي. فهل يصح عدّهما تأسيسيتين وفي مجال الدراسات الثقافية؟ بالطبع لا؛ إذ لم تقدما نظرية أدبية، ولا هما نهجتا منهج الدراسات الثقافية.
وما لا شك فيه أنَّ مشروع د. عبد الله الغذامي في اتخاذ النقد الثقافي بديلاً عن النقد الأدبي، كان واضحاً كل الوضوح. ليكون اسم الغذامي الأول في أي دليل عربي يوضع للدراسات الثقافية - وليس النظرية الأدبية - وبغض النظر عن مدى صحة المشروع أو بطلانه.