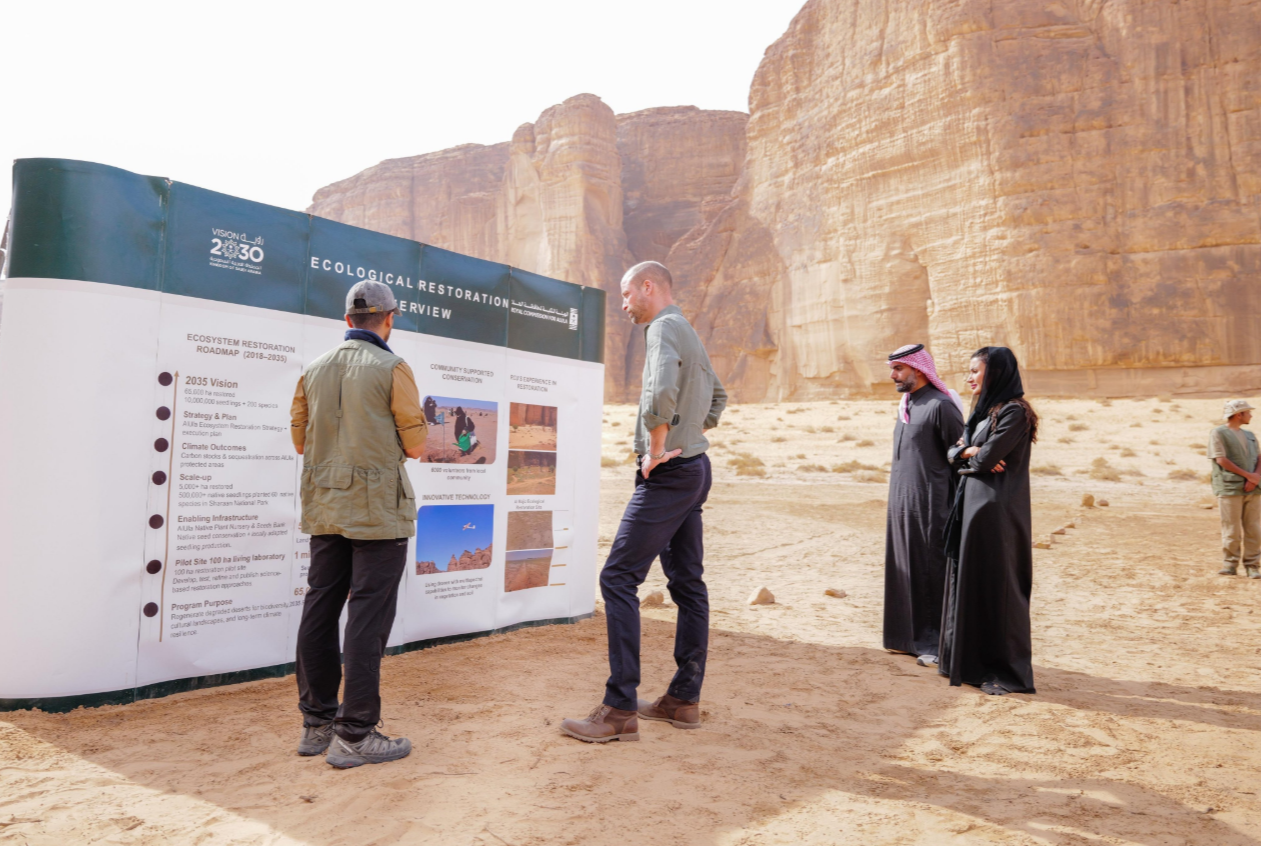قالت المخرجة الفلسطينية نسرين ياسين إنّ صناعة فيلم «عشر دقائق أصغر» كانت حلماً شخصياً ظلَّ يُطاردها، موضحةً أنّ الحلم في صورته الأولى كان أكثر قسوة مما ظهر في الفيلم، لكنها استطاعت عبر السيناريو والمونتاج صَوْغ تجربة بصرية قريبة من ذلك الإحساس مُتجنّبةً الغرق في قتامة مُطلقة.
ويُعرض الفيلم القصير للمرة الأولى ضمن مهرجان «فلسطين للفنون بزيوريخ» من 11 إلى 15 سبتمبر (أيلول) الحالي. وتدور أحداثه حول الطفلين «جولي» و«وليد»، وهما في بداية مراهقتهما، يتسلّلان من أجواء المطعم الخانقة وضجيج السياسة المتواصل في فلسطين معاً، ليذهبا في مغامرة عفوية عبر الطبيعة.
وتحدّثت المخرجة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» عن الفيلم، مؤكدة أنها حاولت أن تستخلص من حلمها نواة لفكرة سينمائية تنقل شعور الزمن الضائع والفرص المهدرة، وهو ما يعيشه كلّ إنسان في فلسطين حين يكبر بسرعة ويفقد طفولته مبكراً أمام قسوة الواقع.
وأضافت أنّ عنوان الفيلم يعكس هذا الهاجس تحديداً، فهو ليس مجرّد وصف زمني، بل إشارة رمزية إلى العمر الذي يضيع شيئاً فشيئاً، وإلى إحساس الإنسان في فلسطين أنه يحاول أن يعيش اللحظات التي سُرقت منه، سواء في الطفولة أو الحاضر. ولفتت إلى أنّ التجربة الفلسطينية تجعل الفرد واعياً لصعوبات الحياة في سنّ أصغر بكثير مما يجب، فيظلُّ دائماً في محاولة لاستعادة لحظات لم تتحقّق، كأنّ هناك فراغاً زمنياً لا يمكن تجاوزه.

وأوضحت المخرجة الفلسطينية أنّ المزج بين الواقع والأحلام كان خياراً جمالياً ودرامياً في آن واحد، لرغبتها في جعل الحرّية في الفيلم غامضة وغير مُكتملة، وأشبه بحلم قصير ينقطع قبل أن يكتمل. ولفتت إلى أنّ الواقع في فلسطين يشبه حلماً طويلاً مملاً ومكرراً، بينما المساحة الحقيقية للتحرُّر تأتي في المخيلة فقط، إذ يمكن للطفلين أن يركضا في الحقول، أو يتخيَّل المُشاهد وجود بديل عن الضيق اليومي والقيود الصارمة.
وأكدت نسرين ياسين أنّ هذا الاختيار انعكس على البنية البصرية للعمل، إذ لم يكن الفيلم معنياً بسردٍ خطِّي للقصة بقدر ما كان معنياً بنقل إحساس محدَّد، لذلك تبدو بعض الصور غير مترابطة أو واضحة، لكنها تحمل شحنة شعورية تصبّ في هدف واحد: الإحساس بمرور الزمن وفقدان السيطرة عليه.
وأضافت أنّ هذا الجانب التجريبي قريب من اهتمامها الدائم بالفيلم بكونه أداة لتصوير ما هو داخلي أكثر مما هو خارجي، مشيرةً إلى أنها حرصت على حضور السياسة بشكل غير مباشر، لأنّ تكرار الصور النمطية لا يضيف جديداً، ولرغبتها في تقديم رؤية مختلفة للحياة اليومية.
وأوضحت أنّ حضور السياسة تجلّى في تفاصيل صغيرة مثل شخصية «وليد» الذي يُجبَر على العمل في سنّ مبكرة بدلاً من أن يعيش طفولته بشكل طبيعي، أو في الجدار الذي يفصل بين الأولاد والبنات ويمنعهم من تكوين صداقات طبيعية في هذا العمر، مشيرةً إلى أنّ إدخال أصوات خطابات سياسية عبر الراديو كان كافياً لإبراز الثقل السياسي الطاغي على المكان، من دون أن يتحوَّل الفيلم إلى شعارات مباشرة.

وأشارت إلى أنّ شخصية «جولي» مستوحاة منها ومن معظم الفتيات الفلسطينيات اللواتي يُواجهن قمعاً اجتماعياً يمنعهن من خوض مغامرات طبيعية في سنّ المراهقة، لافتةً إلى أنها أرادت أن تعكس عبر هذه الشخصية توق الفتيات إلى استكشاف العالم رغم القيود، وإلى اختبار براءة اللقاءات الأولى في مجتمع لا يسمح بصداقات طبيعية بين الجنسين في هذا العمر.
وأكدت ياسين أنّ اختيار النهر والحقول جاء من إحساسها بأنّ هذه الأماكن تمنح الإنسان شعوراً نادراً بالحرّية، مشيرةً إلى أنّ الفارق بين حماستهما في تصوير مَشاهد النهر والحقول، وبين الملل الذي أصابهما في تصوير مَشاهد المُنتزه المكتظّ، ساعدها على إبراز الفرق بين الحرّية المؤقتة والواقع الرتيب.
ولفتت إلى أنّ العمل مع الطفلَيْن كان من أجمل مراحل التجربة، إذ كانا على وعي كامل بحالة الملل والحصار التي أرادت إيصالها بالفيلم. وأوضحت أنّ تعابير وجهَيْهما العفوية والخجل المتبادَل بينهما نقلا صدقاً نادراً لا يمكن افتعاله مع ممثّلين محترفين.
ورأت أنّ التحدّي الأكبر خلال التصوير كان التنقُّل بين المدن يومياً، وهو ما جعل الالتزام بالجدول صعباً جداً بسبب الحواجز ونقاط التفتيش المُفاجئة. وأكدت أنّ هذا الأمر كان اختباراً قاسياً للفريق كلّه، لكنه في الوقت نفسه أضاف إلى التجربة شعوراً حقيقياً بالحصار الذي يعانيه الفلسطينيون؛ كأنّ الفيلم حمل بصمات الواقع ليس فقط في قصته بل في عملية إنتاجه أيضاً.

وقالت إنّ التعاون مع مدير التصوير أشرف دواني كان أساسياً في نجاح الفيلم، لأنه يفهم أسلوبها ورؤيتها بحُكم معرفتهما السابقة ومشاركتهما في أعمال أخرى. وأكدت أنّ التفاهم بينهما سمح بترجمة الحلم البصري إلى صور واقعية، مع الاعتماد على مراجع بصرية مشتركة عزَّزت وحدة الشكل النهائي للعمل.
وأشارت إلى أنّ الموسيقي أليساندرو جيزي انضمّ إلى المشروع بالمصادفة بعدما شاهدت له عرضاً موسيقياً يعتمد على أصوات الطبيعة وأدوات بسيطة، فوجدت أنّ هذا الأسلوب يتناغم مع رؤيتها. ولفتت إلى أنّ الموسيقى في الفيلم صُنعت من أصوات قريبة من الطبيعة مثل الحجارة والماء لتعكس الإحساس بالبساطة والحرّية، بعيداً عن التعقيد الموسيقي التقليدي.

وأكدت نسرين ياسين أنّ الهدف الأساسي من الفيلم لم يكن تقديم قصة مُكتملة أو حلول سياسية، بل نقل إحساس محدّد بالزمن الضائع والحرّية المؤقتة، في صيغة بصرية تجريبية قريبة من الوثائقي. وأوضحت أنّ ردود الأفعال الأولى على الفيلم تباينت بين صمت طويل وتأمُّل حائر في التمييز بين الواقع والخيال، لكن معظم المُشاهدين خرجوا بشعور من السلام والنوستالجيا والارتباط بالطبيعة بعيداً عن ضجيج السياسة، وهو ما كانت تسعى إليه، في مَنْح المُشاهد فرصة للتوقُّف والتفكير في الزمن المهدَر والعلاقة بين الحاضر والخيال.
وأعلنت المخرجة الفلسطينية تحضيرها لمشروع سينمائي وثائقي جديد بعنوان «جذور همجية»، وهو تجريبي يتناول تجربة الهوية الفلسطينية في المنفى وصعوبة الانتماء في أوروبا، مؤكدةً أنّ الفيلم لن يكون عن الحدود المرسومة على الخرائط بقدر ما سيكون عن الحدود الخفية في العقل، حيث يعيش الفلسطيني في الخارج وحشة الاغتراب، وتتشابك ذكريات الوطن والأصوات مع شوارع لا تُشبه البيت أبداً.
وأكدت أنّ هدفها من هذا العمل هو الإضاءة على ما يعنيه أن تكون فلسطينياً في عالم لا يبدو بيتاً على الإطلاق، وكيف يصبح التشبُّث بالهوية أكثر عمقاً كلما ازداد البعد عن الأرض.