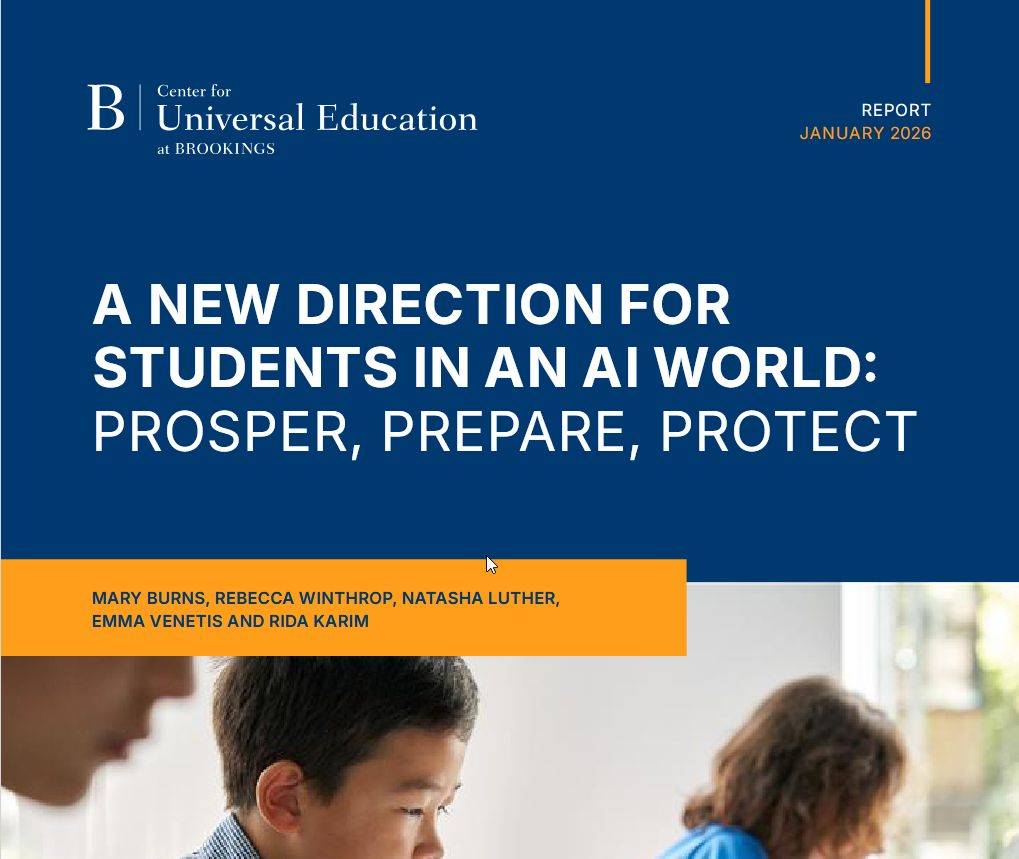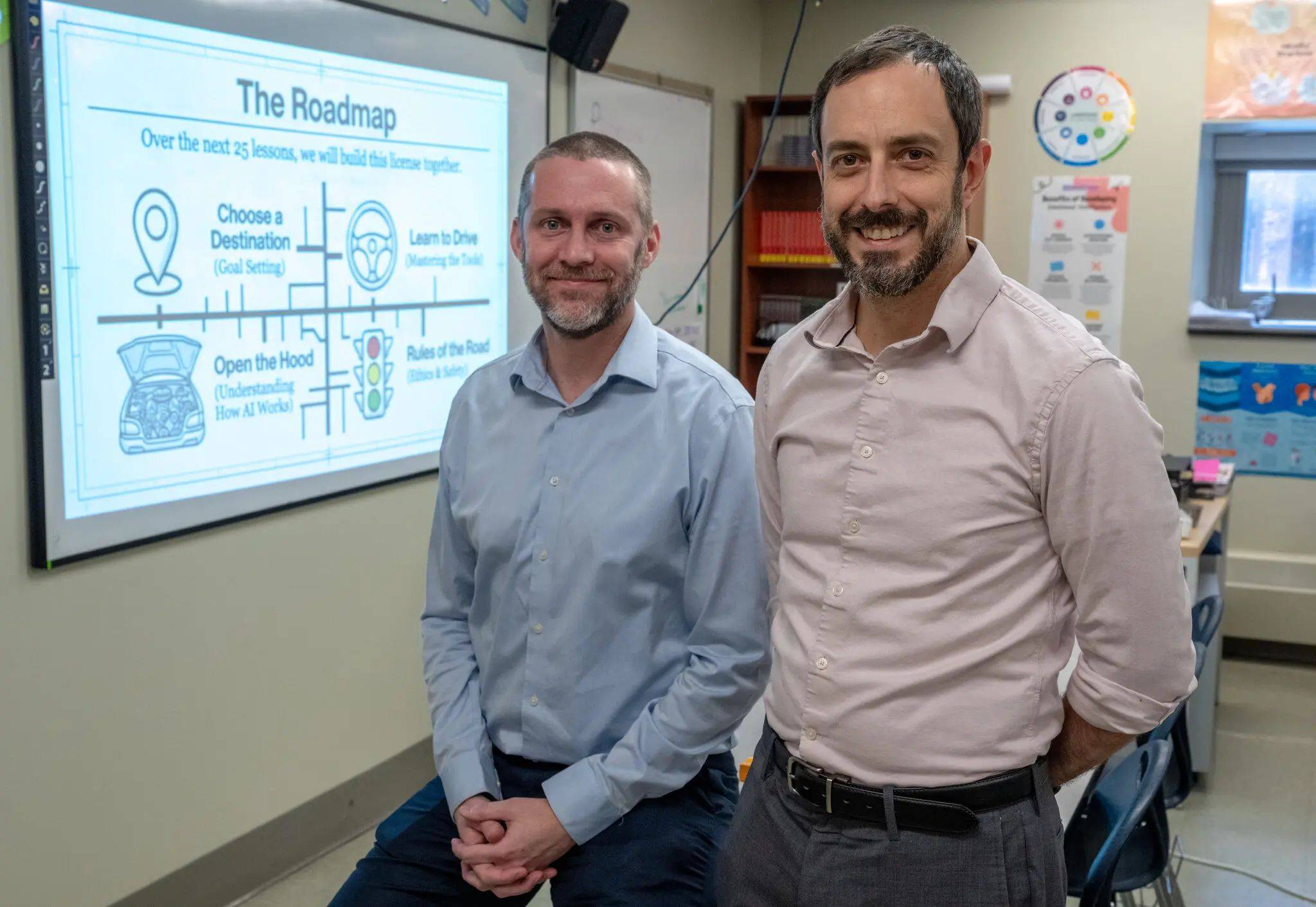الإستروجين سلاحٌ مُتعدد الاستخدامات للهرمونات، ويُعرف بين العلماء بتنوع استخداماته، فإلى جانب دوره الرئيس في تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية، فإنه يقوّي العظام، ويحافظ على ليونة الجلد، وينظم مستويات السكر بالدم، ويزيد من تدفق الدم، ويقلل الالتهابات، ويدعم الجهاز العصبي المركزي.
في هذا السياق، أوضحت روبرتا برينتون، عالمة الأعصاب ومديرة «مركز الابتكار في علوم الدماغ»، التابع لجامعة أريزونا، أن «أي عضو تسميه، ستجد أن الإستروجين يعزز صحته».
تأثيرات الإستروجين على الدماغ
ومع ذلك، فإن تقدير الدور الأوسع للإستروجين تأخر كثيراً. وقد جرى التعرف على هذا المركب لأول مرة عام 1923، ومنذ ذلك الحين عُرف بهرمون الجنس الأنثوي – وهو وصف أحادي البعد ارتبط باسمه.
يأتي اسم «الإستروجين» estrogen من الكلمة اليونانية «أوستروس» (oestrus)، وتعني حرفياً «ذبابة مزعجة»، تشتهر بإثارة الماشية ودفعها نحو نوبة غضب جنونية. ولكن علمياً، أصبح مصطلح estrus «الشبق» يعني الفترة في دورات التكاثر لدى بعض الثدييات، التي تكون فيها الإناث خصبة ونشيطة جنسياً.
أما البشر، فيدخلون مرحلة «الشبق»، بل يحيضون. ومع ذلك، حين أُطلق اسم «الإستروجين»، حُصر دوره في إثارة الشهوة الجنسية ودعم الصحة الجنسية الأنثوية. أما اليوم، فيجري الاعتراف بدور الإستروجين الذي قد يكون أهم أدواره على الإطلاق: تأثيره على الدماغ.
من ناحيتهم، اكتشف علماء الأعصاب أن الإستروجين ضروري لنمو الدماغ بشكل صحي، لكنه يساهم كذلك في حالات مثل التصلب المتعدد ومرض ألزهايمر. أضف إلى ذلك أن التغيرات في مستويات الإستروجين – سواء جراء الدورة الشهرية أو مصادر خارجية – يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصداع النصفي، ونوبات الصرع، وأعراض عصبية شائعة أخرى.
عن ذلك، قال الدكتور هيمان شيبر، طبيب الأعصاب بجامعة ماكجيل: «هناك عدد هائل من الأمراض العصبية، التي يمكن أن تتأثر بتقلبات الهرمونات الجنسية. وتنبغي إعادة توظيف الكثير من العلاجات المستخدمة في الطب التناسلي لعلاج هذه الأمراض العصبية». يذكر أنه أدرج اثني عشر منها في مراجعة حديثة نُشرت في «دورية طب الدماغ» (Brain Medicine).
واليوم، ترتب على إدراك أن الهرمونات الجنسية هي بالوقت ذاته هرمونات دماغية، تغيير في الطريقة التي يتعامل بها الأطباء مع صحة الدماغ والأمراض المرتبطة به؛ ما يساعدهم في توجيه العلاج، وتفادي التفاعلات الضارة، وتطوير علاجات جديدة تعتمد على الهرمونات.
المستقبلات في كل مكان
لدى النساء، يجري إنتاج الإستروجين بشكل رئيس في المبايض، مع كميات أقل تُنتجها الغدد الكظرية والخلايا الدهنية. أما لدى الرجال، فيُحوّل الإستروجين من التستوستيرون في الخصيتين، ويلعب دوراً حيوياً في إنتاج الحيوانات المنوية، وتقوية العظام، ووظائف الكبد، واستقلاب الدهون، وغيرها.
إلا أنه في كلا الجنسين، ينتج الدماغ كذلك إستروجينه الخاص؛ ما يؤكد أهميته العصبية. عن ذلك، شرحت ليزا موسكوني، عالمة الأعصاب ومديرة «مبادرة حماية دماغ المرأة»، التابعة لكلية طب وايل كورنيل، أن: «الدماغ يعدّ، جزئياً، عضواً غدياً صمّاوياً».
إن الدماغ غني بمستقبلات الإستروجين، التي تومض نشاطاً وخموداً طوال الحياة. وفي السابق، ساد اعتقاد بأن هذه المستقبلات تتمركز حول بُنى ذات وظائف تناسلية محددة، مثل الغدة النخامية pituitary والوطاء hypothalamus. في الواقع، «إنها موجودة بكل مكان»، حسبما ذكرت موسكوني، التي طورت تقنية PET (التصوير البوزيتروني) لرصد المستقبلات داخل الدماغ الحي. وأضافت: «لم نتمكن حتى من العثور على منطقة فارغة تماماً».
داخل الدماغ، يمكن للإستروجين أن يرتبط مباشرة بمستقبلات داخل الخلايا العصبية وخلايا أخرى، محدِثاً سلسلة من التفاعلات. كما يمكن كذلك أن يتحلل إلى نواتج أيضية، تُعرف باسم «الستيرويدات العصبية» neurosteroids، التي لها تأثيرات بعيدة المدى خاصة بها.
وأصبحت بعض هذه الستيرويدات العصبية، تُستخدم في علاجات منفصلة: «ألوبريغنانون»، Allopregnanolone ناتج أيضي من البروجستيرون، يشكل أساس دواء يُستخدم لعلاج بعض أنواع الصرع. ويجري حالياً اختباره في تجربة سريرية، بصفته علاجاً تجديدياً محتملاً لمرض ألزهايمر.
وداخل الرحم، يساعد الإستروجين القادم من الأم في تنظيم دوائر الدماغ العصبية للجنين، وتوجيه إنتاج خلايا الدماغ، والتأثير في نمو مناطق الدماغ المختلفة. وخلال التحولات الكبرى، مثل البلوغ، والحمل، وانقطاع الطمث، يساعد الإستروجين في تشذيب وإعادة تشكيل الدماغ من جديد.
ومع ذلك، يدرك الباحثون الآن أن الإستروجين يؤثر في تشكيل الدماغ في جميع مراحل الحياة؛ فهو قادر على تنظيم نشاط الخلايا العصبية، وتقليل الالتهاب، وزيادة اللدونة العصبية، والمساعدة في تحويل الغلوكوز طاقةً، ومنع تراكم اللويحات، وتحسين تدفق الدم داخل الدماغ.
إلا أن ما ينبغي الانتباه إليه أنه ليس كل هذه التأثيرات إيجابية، فقد وجد الدكتور شيبر، من خلال تجارب على القوارض، أن الاستخدام طويل الأمد للإستروجين، يمكن أن يؤدي إلى تقدم بعض مناطق الدماغ في السن. وقال: «لا يوجد هرمون يفعل شيئاً واحداً فقط»، مضيفاً: «أنا أرى الإستروجين سيفاً ذا حدين».
الحمل وحماية الدماغ
فيما مضى، كان علماء الأعصاب يعلمون أن للإستروجين تأثيرات تتجاوز الجهاز التناسلي، لكنهم اختاروا عدم دراستها: قبل عام 2016، كانوا يستبعدون إناث الحيوانات من التجارب عموماً، لتجنب التعامل مع الفروقات السلوكية والفسيولوجية الناتجة عن تغيّرات الهرمونات خلال الدورة الشهرية.
في هذا الإطار، تساءلت الدكتور روندا فوسكول، اختصاصية الأعصاب في «برنامج سن اليأس الشامل»، بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس: «كيف ستعرف ما إذا كان الإستروجين يحمي الأعصاب، إذا لم تُجرِ أي تجارب على الإناث؟!».
عام 1998، كانت فوسكول تبحث عن جزيء يحمي الدماغ من آثار التصلب اللويحي، الذي يهاجم الجهاز المناعي الخلايا العصبية، ويجردها من غلافها الواقي. ويُصيب التصلب اللويحي قرابة مليون أمريكي، معظمهم من النساء.
وقد بدأ بحثها بملاحظة سريرية: من المعروف أن الحمل يحمي النساء من أعراض التصلب المتعدد، ففي الثلث الأخير من الحمل، تنخفض معدلات الانتكاس بنسبة 70 في المائة؛ ويبدو أن الحمل فعال بقدر فاعلية أفضل الأدوية. ومع ذلك، تبقى هذه الحماية مؤقتة، فبعد الولادة، يتفاقم خطر الانتكاس بشكل حاد.
من جهتها، كانت فوسكول مدركة للأمر لأن الجهاز المناعي يهدأ في أثناء الحمل، على الأرجح لحماية الجنين الذي يُعد نسيجاً نصف غريب. إلا أنها اشتبهت في أن هناك سبباً أعمق عن ذلك. وقالت: «من المنطقي أن تمتلك الأم شيئاً لا يقتصر فقط على كونه مضاداً للالتهاب، بل يحمي الأعصاب كذلك».
وبالفعل، تبيَّن أن هذه المادة - الإيستريول ـ نوع من الإستروجين يُنتج أساساً عن طريق المشيمة. عام 2016، أظهرت فوسكول، من خلال تجربة سريرية عشوائية على 164 امرأة، أن علاج الإيستريول على مدار عامين، قلل بشكل ملحوظ من انتكاسات التصلب المتعدد.
كما بدا أنه يُحسن وظائف الإدراك، ويُقلل من ضمور المادة الرمادية في الدماغ.
وكان الإيستريول estriol معروفاً بكونه آمناً؛ إذ تستخدمه المريضات اللائي يعشن مرحلة انقطاع الطمث في أوروبا منذ عقود. وعلى عكس الإستراديول estradiol، لا يرتبط الإيستريول بقوة بمستقبلات الثدي؛ ما يعني أنه لا يحمل نفس خطر الإصابة بسرطان الثدي على المدى الطويل. ولذلك؛ وصفته فوسكول بأنه: «هدية للعلماء».
بالتأكيد، تبدو هذه نتائج واعدة لمرضى التصلب المتعدد. واليوم، تعكف فوسكول على دراسة ما إذا كانت هذه النتيجة تنطبق ليس فقط على مرضى التصلب المتعدد، بل على جميع النساء في سن اليأس. وقد طورت علاجاً هرمونياً نال براءة اختراع، يُدعى «بيرل باك» (PearlPAK)، يحتوي على الإستريول، وتبيعه شركة «كليوباترا آر إكس»، التي تشغل منصب مستشارة طبية لديها.
وبحسب الموقع الإلكتروني، فإن «بيرل باك» قادر على معالجة «مشكلات الذاكرة والصحة الإدراكية الناتجة عن انقطاع الطمث». وهذه الفرضية التي تحاول فوسكول اختبارها، من خلال مراقبة النساء اللواتي يستخدمن «بيرل باك» سنوياً، عبر الاختبارات الإدراكية. وعن هذا، قالت: «أنا فقط أطبق الطريقة التي نتبعها في علاج التصلب المتعدد على انقطاع الطمث».
ونبَّهت إلى إن النتائج لن تكون بمستوى قوة نتائج التجارب العشوائية، لكنها أشارت إلى أن شركات أخرى متخصصة في التعامل مع مشكلات سن اليأس، كانت تروج لفوائد مماثلة دون أدلة كافية. وأضافت: «على الأقل لدينا مادة حقيقية».
إرث مشحون
هذه ليست المرة الأولى التي يُروَّج فيها لعلاج الإستروجين، بصفته حلاً شاملاً لمشكلات الإدراك لدى النساء في سن اليأس. قال شيفر: «قبل عام 2000، كان يبدو أن الإستروجين دواءً سرياً».
في ذلك الوقت، كان يُعتقد أن الهرمون يحمي الدماغ من السكتات الدماغية ومرض ألزهايمر ـ وهو اعتقاد مدعوم بالكثير من الدراسات على الحيوانات وبعض الدراسات الرصدية على البشر.
إلا أنه عام 2003، انقلبت الأمور، فقد كشفت «دراسة مبادرة صحة ذاكرة المرأة» — تجربة سريرية محورية تتبعت التأثيرات طويلة الأمد للعلاج الهرموني لدى النساء، بعد انقطاع الطمث — عن أن النساء الأكبر سناً اللاتي تناولن الإستروجين فقط (وليس الإستروجين مع البروجسترون)، كُن أكثر عرضة للإصابة بالخرف بمقدار الضعف، مقارنة بالنساء اللاتي تناولن علاجاً وهمياً.
وقد توقّف الأطباء عن وصف الإستروجين للنساء بعد انقطاع الطمث، وتوقفت النساء عن تناوله، خوفاً من هذه النتائج. وعلقت مارغريت مكارثي، عالمة الأعصاب بجامعة ميريلاند: «كان موقف الكثير من العلماء على النحو الآتي: لماذا ندرسه؟ لن تتناول النساء الإستروجين بعد الآن، فلا فائدة من البحث»، مضيفة: «كان ذلك كارثياً على الأبحاث».
في وقت لاحق، تبيّن أن هذه النتيجة تنطبق فقط على النساء اللواتي بدأن العلاج بالإستروجين في سن 65 أو أكثر، أي بعد مرور أكثر من 10 سنوات على آخر دورة شهرية. أما فيما يخص النساء بين سن 50 و55، فقد وجدت مراجعة شاملة أن تأثير الإستروجين على خطر الإصابة بالخرف كان محايداً. ولم تُدرج النساء الأصغر سناً في الدراسة الأصلية.
والآن، أصبح على الباحثين تجاوز فكرة أن الإستروجين يحمي الدماغ، وطرح سؤال أكثر دقة: متى بالضبط، وكيف، يحمي هذا الهرمون الدماغ؟
التركيز على جذور ألزهايمر
يصل دور الإستروجين في صحة الدماغ إلى أكثر مستويات الجلاء والوضوح في سن اليأس، حين يسهم تراجعه في ظهور أعراض إدراكية تعرفها النساء جيداً وتكرهها: الهبّات الساخنة، اضطرابات النوم، وضبابية الدماغ. ويعتقد بعض علماء الأعصاب أن فقدان الإستروجين أحد الأسباب الرئيسة لكون النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر، بمقدار الضعف مقارنة بالرجال.
مع انحسار مستويات الإستروجين، يتغير كذلك الدماغ، فحتى سن اليأس، يعتمد الدماغ بشكل كبير على الغلوكوز مصدراً للطاقة، ويُساعد الإستروجين في تحويله طاقةً. أما بعد انقطاع الطمث، فيبدأ الدماغ في الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة، بما في ذلك استهلاك مادته البيضاء، حسبما كشفت برينتون في دراسات أجرتها على الحيوانات.
وقالت برينتون: «إنه استجابة للجوع»، مضيفة: «لا علاقة لهذا بالقدرة الإنجابية، بل بكل ما يتعلق بالدماغ الذي يمر بمرحلة انتقالية».
وقد تكون هذه المرحلة نقطة البداية التي يظهر فيها الضعف الإدراكي المرتبط بألزهايمر — ومن الناحية النظرية، قد يكون هذا الوقت الذي يمكن أن يساعد فيه العلاج بالإستروجين أو تدخل آخر في الوقاية من التدهور المعرفي. إلا أن برينتون لم تكن تمتلك وسيلة لرؤية ذلك داخل دماغ الإنسان. وفي عام 2014، تواصلت مع موسكوني، خبيرة تصوير الأعصاب، للحصول على المساعدة.
في ذلك الوقت، كان الأطباء قادرين على قياس مستويات الإستروجين في الدم فقط، لكن موسكوني أدركت أن ملايين الأميركيين يستعينون بنوع من العلاج القائم على الإستروجين، ولا أحد يعرف تأثيره على أدمغتهم. لذا؛ طورت تقنية تصوير تسمح برؤية مستقبلات الإستروجين في الدماغ، من خلال إعادة استخدام مادة مشعة تُستخدم أصلاً للكشف عن المستقبلات نفسها في سرطان الثدي.
عام 2024، فوجئت هي وبرينتون حين اكتشفتا أن عدد مستقبلات الإستروجين في الدماغ يبدو أنه يزداد بشكل كبير بعد انقطاع الطمث، ربما في محاولة لجذب المزيد من هذا الهرمون. أما المثير للاهتمام حقاً أنه كلما زاد عدد مستقبلات الإستروجين لدى المرأة، كانت نتائج ذاكرتها وقدراتها الإدراكية أسوأ.
وفي فبراير (شباط)، أطلقت موسكوني برنامج أبحاث بقيمة 50 مليون دولار، بتمويل من مؤسسة «ويلكم ليب»، تحت اسم «تقليل خطر ألزهايمر من خلال علم الغدد الصماء».
وتأمل موسكوني في رصد تحديد النساء الأكثر عرضة للإصابة بألزهايمر، بسبب تغيرات الدماغ المرتبطة بالإستروجين، ومعرفة ما إذا كان العلاج الهرموني المُقدم خلال فترة زمنية حرجة يمكن أن يُساعد في خفض خطر الإصابة لديهن.
* خدمة «نيويورك تايمز»