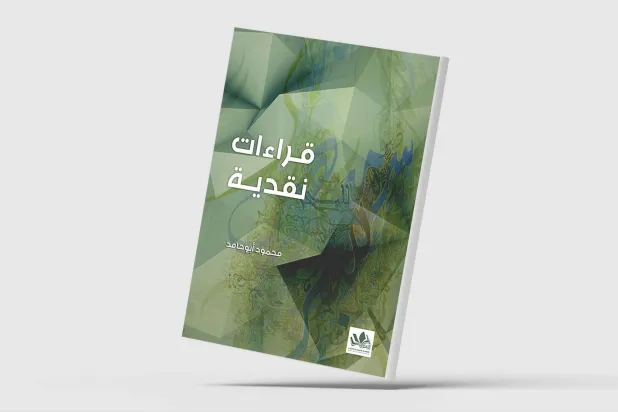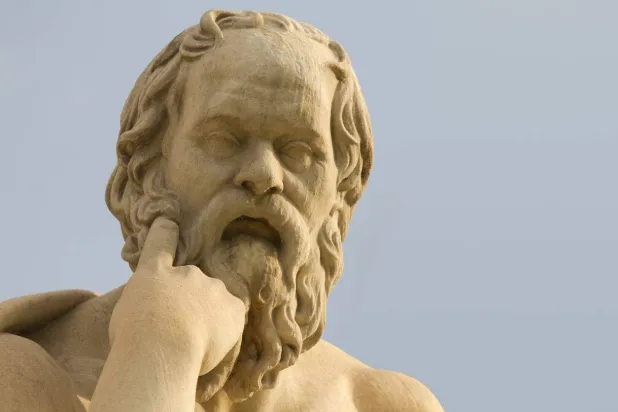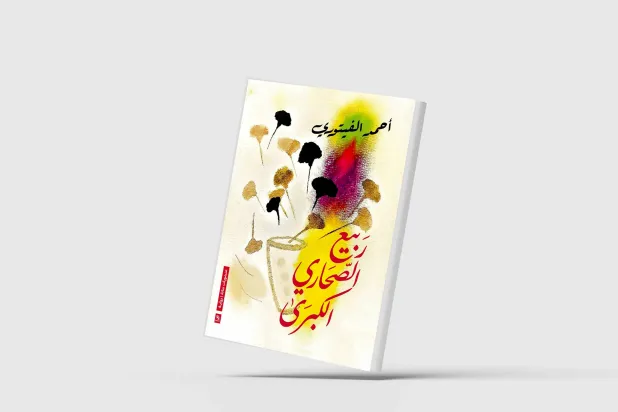لا توجد لحظة أفضل للتأمل في معنى الفن وحاجتنا إليه من لحظة غيابه الكامل عن جهاتنا الحسيّة، عندما تجلس وحيداً في صمت، لا صوت ولا صورة قريبة منك. أو عندما تكون من أولئك الذين يحرّمون على أنفسهم الاستماع إلى صوت الموسيقى لأسباب دينية فتبقى ممزقاً بين ما تعتقده واجباً وشيئاً غريزياً فيك. إنها أوضح صورة لاستحضار قيمة الفن، عندما يكون سبباً مباشراً في هذا الصراع بين الواجب والغريزة. ولربما يبكي الفرد من شدة الألم الذي يسببه التمزق الداخلي. هذا الفقدان التام للتجارب الفعلية الملموسة مع الفن يشبه أن يكون نوعاً من الموت، وبالتالي تصبح معانقة الحياة نوعاً من الذنب الذي يوجب الاستغفار.
لا حياة من دون فن، ذلك أن التجربة الفنية وتقديرها والحاجة إليها تبدو وكأنها متأصلة في جنسنا البشري، فالفن ليس شيئاً يحدث على هامش حياتنا، بل هو مقيم في صميم وجودنا.
إنه وسيلة نبرر بها وجودنا، وهنا نتذكر عبارة مارد الفلسفة هيغل «إن الروح لتتجلى في ثلاث: الفن والدين والفلسفة». أين سترى حضارة شعب ما إلا في تلك الثلاث؟ وتتفاوت الشعوب في تجلي روحها في واحد من هذه المجالي أكثر من الآخر. روح الشعب الإيطالي - على سبيل المثال - وثقافته وتاريخه وحضارته تتجلى في الفن بصورة أكبر من الفلسفة والعلم، رغم أنها بلاد غاليليو وأنها لا تخلو من الفلاسفة.
علاقة الإنسان بالفن قديمة جداً وليس من الصواب أن نحصر حياة الإنسان الأول في بحثه عن الطعام وعن الملجأ من خطر الحيوانات المفترسة. ثمة آثار وأحافير ورسوم، وأدلة مادية محسوسة ومعروفة تدل على خلاف ذلك. لقد كان الإنسان يبدع الفنون منذ فترة أطول بكثير من التاريخ المدون. ومع أن أقدم الفنون البصرية التي لا تزال باقية تعود إلى ما يقرب من أربعين ألف سنة، إلا أننا نغلّب أنه لا بد أن هناك أعمالاً أقدم لا نعرف عنها شيئاً بعد.
ولا يقتصر الفن على تحفيز العقل ومداعبة الحواس، بل من الأقرب أن ننظر إليه باعتباره جهداً فكرياً. وهنا نتذكر دعوى بعض الفلاسفة في أن واجب الفلسفة هو أن تكون خادمة للعلم التجريبي، تقدم له الأسئلة وهو يجيب عنها. هذا شطط بلا ريب، فعلاقة الفلسفة بالعلم ليست بأهم من علاقة الفلسفة بالفن. الفن ضرورة وليس شيئاً يستعمل لتمضية الوقت. هو كاشف عن الوجود هو الآخر.
الفن شيء معقد للغاية، وهو يتوقع منا أن نبذل جهداً كبيراً عندما نتعامل معه. ومع ذلك هو يساعدنا لإنجاز مهمة فهمه وتذوقه وتقديره، أعني أن العمل الفني يتحدث إلينا بمختلف اللغات، ابتداءً من اللوحات الخالدة التي تستفز العقل والحواس وتعكس في نفوسنا القبول أو النفور إلى موسيقى الجاز التي يتطلب فهمها وتقديرها ذكاءً خاصاً. مما بات معرفة عامة اليوم أن الأعمال الفنية العظيمة تحمل معها الكثير من الرسائل والمعاني، وكثيراً ما تظل هذه الرسائل باقية لقرون من الزمان. وقد تتغير مع مرور القرون والعقود، تاركة قوتها وأهميتها كما هي.
برغم إيماننا بوجود المساحات الميتافيزيقية الشاسعة التي تتمدد فيها الأعمال الفنية، فإن البداية يجب أن تكون من داخل مساحاتها المادية. لا يوجد بديل عن مادية العمل الفني، والتي تتعلق في نهاية المطاف وبشكل ثابت بحواسنا الخمس وبراعتنا التحليلية وفضولنا الفكري. من هنا تكون البداية. كما أن تقدير الفن، في أغلب الأحيان، هو تجربة جماعية. إنه يجمعنا عندما نذهب إلى السينما ونجلس متجاورين.
عندما يتناقش الناس في القضايا السياسية أو مباريات كرة القدم فقد يصلون إلى الشجار والعداوة والتقاذف بالصحون، لكن هذا لا يحدث عند النقاش حول عمل فني، بل تجد الناس في لحظات وكأن السكينة قد غشيتهم، في حالة خشوع صوفي. قد نتجادل حول قيمة هذه الأعمال وفضل عمل على عمل، لكننا متفقون على ضرورة التعبير الفني وقيمة دراسة الجماليات. ولا بأس بمثل هذه النقاشات الفنية وإن اختلفت وجهات النظر فالفن من أهم الوسائل التي نتوصل من خلالها إلى فهم بعضنا البعض. هذا الفهم لا يكون دائماً جميلاً، فالمخرج السينمائي الذي يستمتع بتصوير الدم وهو يخرج من الجسد بالصورة البطيئة، هو شخص عنيف أو يعاني من مرض نفسي ما.
لكن الأمر الإيجابي هو أن هذه الأعمال الفنية تعلمنا كيف نكون فضوليين بشأن ما هو مختلف أو غير مألوف، وفي نهاية المطاف تمهد الطريق لنا لقبوله وتقديره واحتضانه. هذا يحدث في المجتمعات السوية، أما المجتمعات الخائفة من «الآخر»، أعني التجمعات الآيديولوجية، ففي الغالب لا تتمكن من إنتاج أي أعمال فنية ثقافية ذات قيمة عليا. في حين نجد أن المجتمعات الحرة قادرة بكل سهولة على هز الآيديولوجيات المنغلقة على نفسها بالوصف والنقد.
في القرنين الماضيين احتدم النقاش حول كيفية مقارنة الفن والثقافة بالعلوم الطبيعية التجريبية وأيهما أكثر نفعاً للبشر، حيث تلعب العلوم الإنسانية دوراً أصغر حجماً على نحو متزايد، في حين جلبت العلوم إلى هذا العالم العديد من الاكتشافات والإبداعات الرائعة، إلا أنها مذنبة ومدانة عندما يتعلق الأمر بإنجازات الإنسان الأكثر شراً، الحرب النووية وتدمير الطبيعة وستون مليوناً ماتوا في الحرب العالمية الثانية لغير سبب مقنع بالجدوى.
في مقابل هذا الشر، يمكن للفن أن يصل إلى أكثر أماكن النفس البشرية ظلمة وأن يخرجها منها. إنه يفعل ذلك لمساعدتنا على الفهم والتجاوز. إنه حقاً يرفعنا ويرتفع بنا ويجعلنا أشخاصاً أفضل.