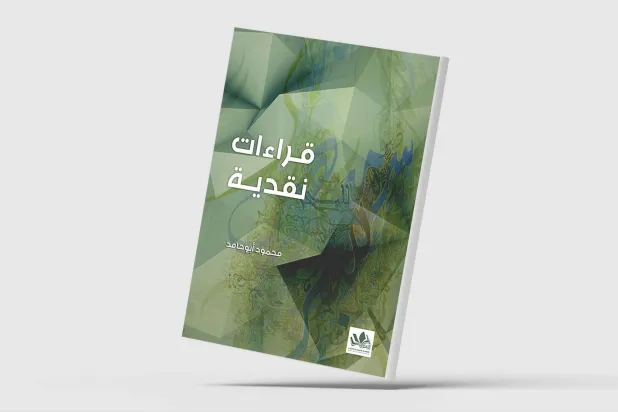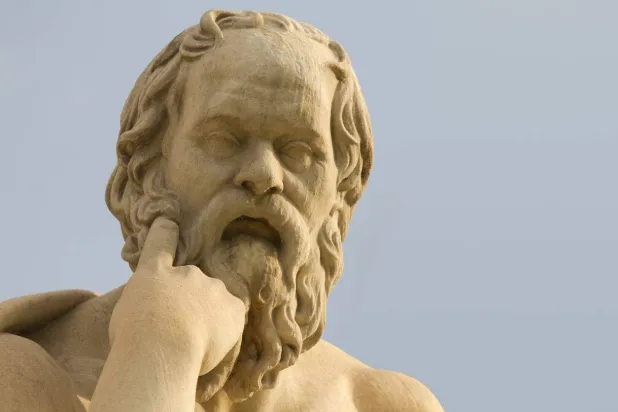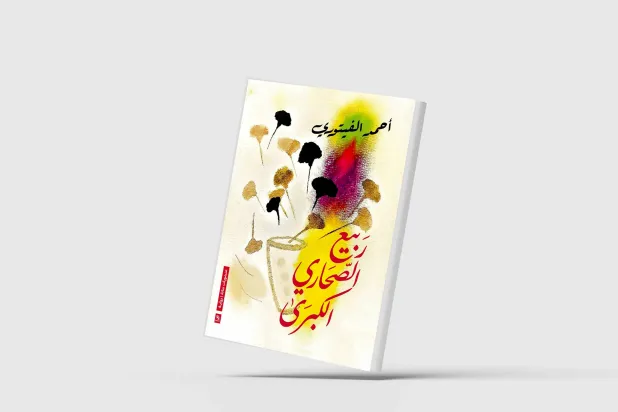كشفت أعمال التنقيب المتواصلة في الإمارات العربية عن سلسلة من المواقع الأثرية الموغلة في القدم، منها موقع مسافي التابع لإمارة الفجيرة. خرج هذا الموقع من الظلمة في 2003، حيث ظهرت على أرضه بالمصادفة مجموعة متفرقة من قطع برونزية متناثرة، صيغت على شكل أفعى ملتوية. وبعد 4 سنوات، باشرت بعثة تابعة للمركز العلمي الوطني الفرنسي أعمال التحرّي فيه بالتعاون مع هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، ودفعتها نتائج هذه الأعمال إلى مواصلة التنقيب في 5 حملات جرت على مدى 6 سنوات. ظهرت معالم المستوطنة بشكل جليّ خلال هذه الحملات، وتضاعف عدد القطع الأثرية التي خرجت منها، وتبيّن أن مجموعة كبيرة منها تحمل كذلك صورة هذه الأفعى الملتوية التي عُرف بها الموقع قبل استكشافه.
يحمل موقع مسافي الأثري اسم قرية مجاورة له تنقسم في زمننا إلى قسمين، أولهما تابع لإمارة رأس الخيمة، وثانيهما تابع لإمارة الفجيرة. يمتدّ هذا الموقع على مساحة يبلغ طولها 4 كيلومترات، داخل مزرعة من مزارع النخيل غرب هذه القرية، فوق سهل منبسط في شرق وادي العبادلة، على حافة الجهة الشمالية من سلسلة جبال الحجر التي تغطّي قسماً كبيراً من شمال سلطنة عُمان وجزءاً من شمال دولة الإمارات. يطلّ الموقع على وادي العبادلة، ويشرف على المدخل الرئيسي لوادي حام الذي يمتدّ حتى مدينة الفجيرة. تُشكّل مسافي واحة تقع في منطقة تسقي بمياهها هذين الواديين، كما أنها تسقي وادياً ثالثاً يلتقي بهما، هو وادي سيجي الذي يمتد من مدينة الذيد بالشارقة إلى أراضيها الجبلية.
حوت رمال هذه الواحة مستوطنة شُيّدت وسط الجبال وبعيداً عن الساحل في حقبة بعيدة تمتد من عام 1600 إلى عام 300 قبل الميلاد. وتُمثّل هذه المستوطنة حضارة ازدهرت في الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، من نهاية الحقبة التي تُعرف بالعصر البرونزي إلى الحقبة التي تُعرف بالعصر الحديدي. تمثّلت هذه المستوطنة بمبنى محصّن له سور يمتد على مساحة تتجاوز نصف كيلومتر من الناحية الغربية، في موازاة وادي سيجي. حوى هذا المبنى معبداً ومجموعة من المنشآت السكنية شهدت 3 أطوار من البناء تعاقب بعضها فوق بعض، كما تشهد أساليب البناء المتبعة. هكذا ظهرت آثار حضارة العصر الحديدي على مساحة واسعة من جنوب غرب منطقة مسافي السكنية، وبلغت الشارع الذي يربط بين هذه المنطقة ومدينة الذيد بالشارقة.
عُثر بين أطلال هذه المنشآت السكنية على بقايا أثاث حوى عدداً كبيراً من الأباريق والأوعية الفخارية، إضافة إلى بضع مجامر تميّزت بتكوينات تصويرية حيوانية. كما عُثر على العديد من الجرار المدفونة، منها جرّتان مليئتان بالسبائك والقطع المعدنية. حوى هذا الكنز 168 قطعة، وشكّل أكبر مجموعة معروفة من هذا النوع خرجت من موقع في هذه الناحية من جزيرة العرب. ضمّت هذه الغلة مجموعات أخرى من اللقى والكسور المتنوعة، منها مجموعة من المكتشفات البرونزية بلغ عددها 34 قطعة، حوت رؤوس سهام وحراباً. في المقابل، خرجت من المعبد المحدّد بجدار سميك مجموعة من اللقى، تضمّنت نحو 60 قطعة معدنية ذات أشكال ثعبانية، وأكثر من 200 قطعة فخارية زُيّنت بنقوش ناتئة تُمثل أفعى منقطة ملتوية، تعدّدت وضعيات التفافها بين قطعة وأخرى. وصلت القطع المعدنية بشكل شبه كامل، ومعظمها من النحاس. أما القطع الفخارية، فوصلت مجتزأة على شكل كسور متفرّقة في أغلب الأحيان، وتمّت إعادة تكوين عدد ضئيل من قطعها عن طريق جمع الكسور الخاصة بهذه القطع.
عُثر بين أطلال المنشآت السكنية على بقايا أثاث حوى عدداً كبيراً من الأباريق والأوعية الفخارية ومجامر تميّزت بتكوينات تصويرية حيوانية
تبدو هذه الأفعى واحدة من حيث الصنف، وتتميّز بشبكة من النقاط الدائرية تشكل سلسلة تمتد على مساحة بدنها الطويل، إضافة إلى نقطتين تعلوان رأسها العريض، وتشكّلان عينيها. تحضر هذه الأفعى على أوانٍ مختلفة، منها تلك التي تتميز بمقبض طويل عند طرفها، وتلك التي تتميّز بقواعد مستطيلة عالية، ومنها الأكواب والصحون والجرار التي تعددت تكويناتها. تلتف الأفعى حول قاعدة إناء طويلة تبدو أشبه بعمود فقد تاجه، ويشكّل ذيلها حلقة تنعقد حول الجزء الأسفل من هذا العمود. تظهر هذه الأفعى في وضعيّة مغايرة على قاعدة أخرى صيغت على شكل مخروط قصير، ويشكّل هذا النموذج شكلاً آخر من الأشكال المتبعة في هذا الميدان. في قطعة ثالثة، تحتلّ هذه الأفعى وسط قاع آنية من هذه الأواني المتعددة الأشكال، وتشكّل حلقة على شكل خاتم يعلوه رأس مرصّع. وفي قطعة رابعة، تحلّ هذه الأفعى الملتوية فوق قرص دائري صُنع كغطاء لآنية ضاع أثرها. وفي قطعة خامسة، تحلّ في شكل مشابه فوق قطعة مستطيلة مسطّحة صُنعت كمقبض لآنية أخرى اندثرت. وفي قطعة سادسة، تلتفّ حول نفسها في حلقات حلزونية ناتئة على جهة من جهات جرة فخارية، وتمثّل هنا نسقاً مغايراً يُعرف بالأفعى الحلزونية.
تحضر هذه الأفعى المرقّطة بقوّة في مسافي، غير أن هذا الحضور لا ينحصر قطعاً بهذا الموقع؛ إذ نجدها في مواقع أخرى تتوزع على أراضٍ عدة في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، منها موقع البثنة في وادي حام التابع لإمارة الفجيرة، وموقع ساروق الحديد في إمارة دبي، وموقع الرميلة في إمارة أبوظبي، وموقع مويلح في إمارة الشارقة، وموقع سلوت في سلطنة عُمان. يشهد هذا الحضور الجامع للموقع الخاص الذي تحتله الأفعى في المعتقدات الدينية والحياة الروحية التعبدية الخاصة بإقليم عُمان، حيث شكّلت على ما يبدو تعبيراً رمزياً للحياة والخصوبة والشفاء والبعث والإنماء، كما في بلاد ما بين النهرين، ونواحي عيلام وحواضر المشرق.