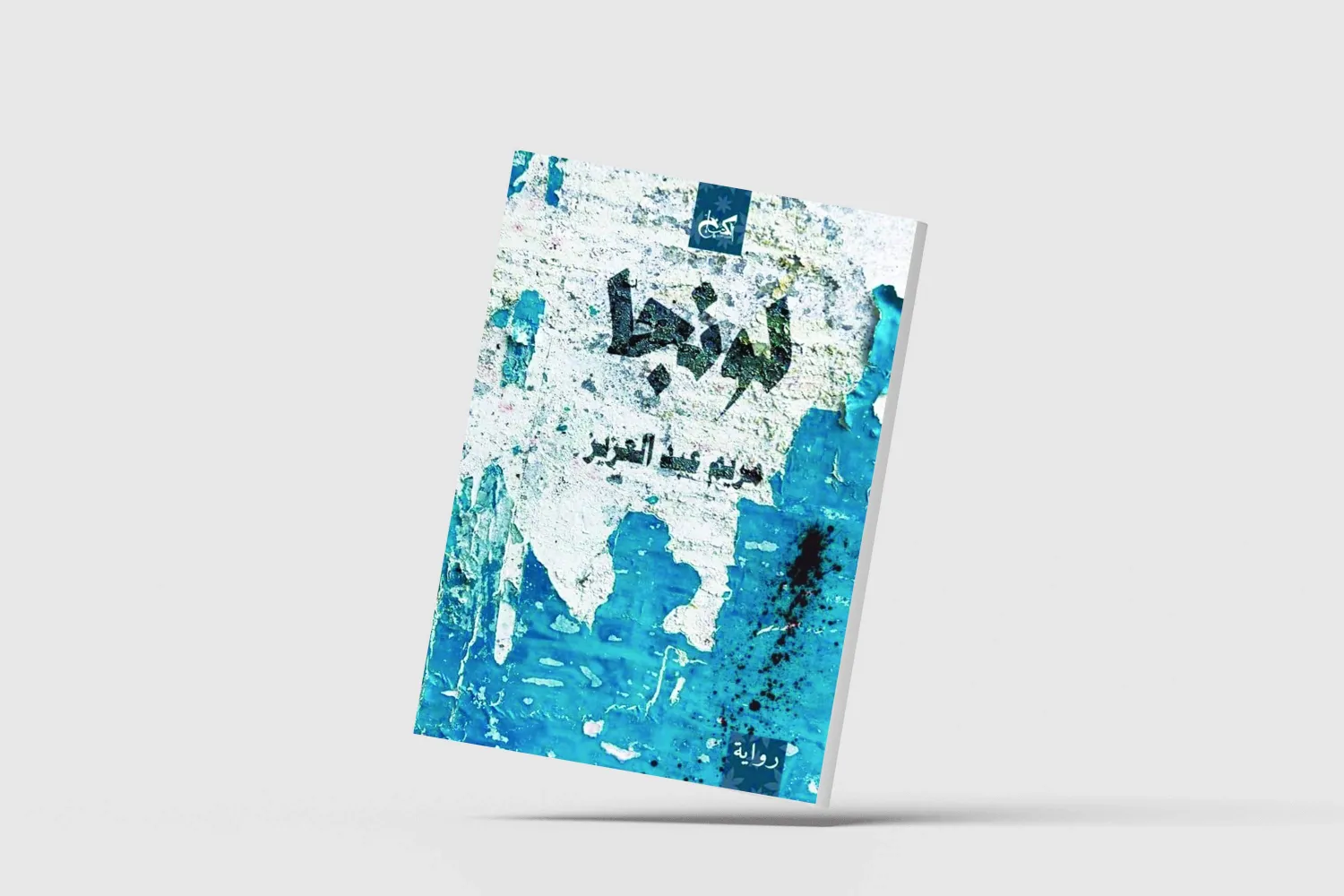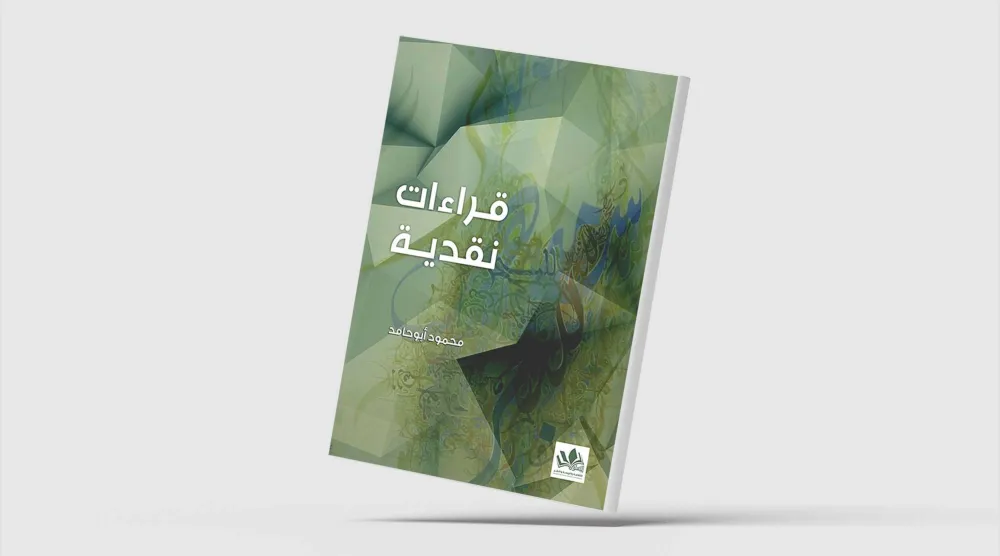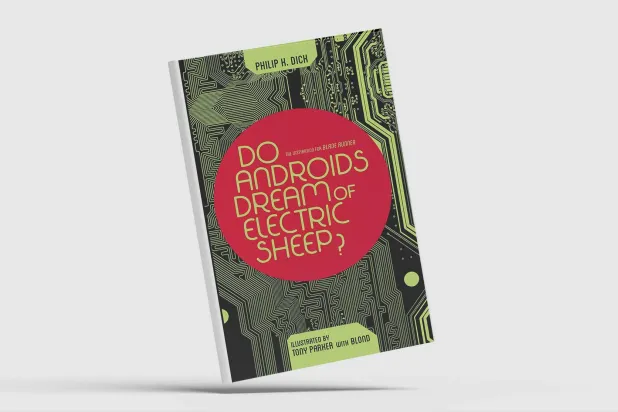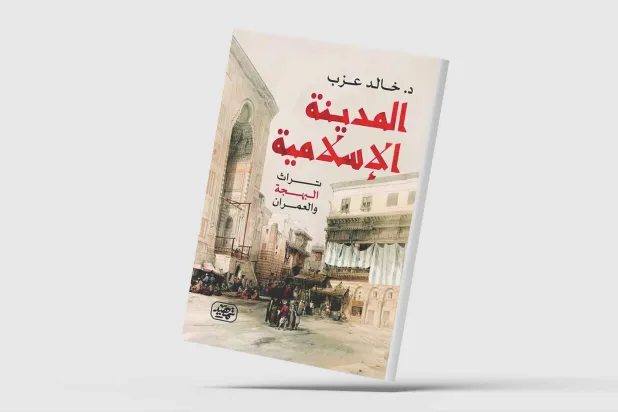تمهد الروائية المصرية مريم عبد العزيز روايتها الجديدة «لونجا» - دار «الكتب خان» للنشر بالقاهرة - بعتبة شارحة لعنوانها الذي قد يستوقف القارئ ويثير فضوله، فتعرّفه بأنه أحد قوالب الموسيقى العربية، الذي يتميّز بالانتقال المفاجئ والقفزات اللحنية والسرعة في الأداء، وهو التعريف الذي يمكن فهمه كتهيئة للإيقاع السردي، واللعبة التبادلية بين الموسيقى وأصوات الرواية.
وسرعان ما يظهر توظيف الكاتبة للمتن الموسيقي في معمارها الروائي، فتتناوب فصول الكتاب عناوين: «خانة»، و«تسليم»، و«تقسيم خارج الوزن»، وهي تسميات مُستمدة من حركة قالب «اللونجا» الموسيقي نفسه، الذي يتكوّن عادة من أربعة أقسام، كل منها يسمى «خانة»، وجزء خامس يتكرر بعد كل خانة يسمى «تسليم».
تفتح تلك التهيئة الموسيقية المجال لظهور صادم لبطل الرواية «شكري»، الذي يعمل عازفاً ومدرساً للموسيقى، حيث يُعثر عليه مُمدداً على الأرض تفوح منه رائحة العطن، بجسد منتفخ بعد أن غادرت روحه الحياة، وتحول إلى ما يشبه المومياء: «الانتفاخ الوحيد الذي رافق الرجل في حياته هو التجويف الخشبي للعود الذي يجلس محتضناً إياه في شرفة شقته، أو يحمله في جراب أسود مرتدياً بدلة أنيقة بنفس اللون في المرّات التي يشارك فيها بالعزف في حفل أو في جلسة طرب مُنغلقة»، وسرعان ما يقود جثمانه الذي يبدو عليه أثر جريمة، إلى انتشار الشرطة في منزل هذا العجوز، لتبدأ التحقيقات متخذة أبعاداً درامية كاشفة عن سيرة هذا العازف الذي «لم يعش سوى لحظات فخر قليلة في حياته»، كما يروي السارد العليم.
تقنية موسيقية
يستعير البناء الروائي للعمل التقنية الزمنية للموسيقى، بما فيها من استرجاع واستباق، حيث يتناوب جيران البطل شهاداتهم عنه، التي تتقاطع مع سيرته، فيبدو الزمن في الرواية سيالاً يحمل صوته من تدفق ذكريات الأبطال، التي تضئ على سيرة شكري، وتجعلهم في الوقت نفسه يظهرون في سياقات جديدة كاشفة عن تعقيداتهم الإنسانية، لتتكشف في فضاء هذه الجريمة شبكة من الجرائم، تبدو وكأنها تدل عليها، كما تكشف العلاقات المشحونة التي تجمع بين جيران البطل القتيل، وسط هيمنة من التلصص، والمراوغة، والجشع، والانطباعات الزائفة، على خريطة تلك العلاقات.
لا تنفصل صورة البطل الذي تتابع الرواية لغز موته المُلتبس عن الصور الذهنية التي يتبناها عنه الجيران، فتظهر منسجمة أحياناً ثم سرعان ما يصيبها التشظي مع تضارب الأقوال عنه، فهو رجل نزيه في أقوال البعض، ومُتصابٍ وغامض في أقوال البعض الآخر، وتزداد حكايته تعقيداً، بعدما تجتمع خيوط قصة موته المُلغزة بقصة موت «خالد»، وهو شاب في العمارة نفسها، يفصل بين حادثي الوفاة أسبوع واحد، وفي فضاء الحكي تتناثر الكثير من المُشتركات بينهما التي تتكشف عبر الرواية.
وعبر (139 صفحة)، تعزز الرواية من انتمائها للمجال الموسيقي، حيث شيّدت بناءً صوتياً للمكان، وما يشهده من صراع درامي، فجريمة القتل التي تُفجر الحبكة البوليسية تدور في عمارة كائنة في حي «عابدين» الشعبي، الذي يقع في وسط العاصمة المصرية، وهو معروف بصخبه، حيث ورش إصلاح السيارات تعزف «سيمفونياتها» الموازية لنميمة السكان، فيزاحمها الحضور الطاغي لأصوات الدق بالمطارق فوق الصاج، وهدير الموتورات، وسباب المعلمين لصبيانهم، فيما يبدو شبح «شكري» هنا هو شبح مدرس الموسيقى «الرايق»، و«المتسلطن» غير المُكترث، الذي يسير على هامش ذلك الصخب الدائر، يستأنس في مسيره بدندنات الشيخ زكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب، وتبدو المُفارقة أن جاره الشاب «خالد»، الذي يموت قبله بأسبوع واحد، كان يحمل السمت نفسه، على الرغم من أنه لم يكن عازفاً، ولكنه كان «سميعاً» كما كان يطيب لشكري أن يُناديه، ليبدو أن الحياة جمعتهما معاً في خندق لحنّي واحد، وكذلك فعل معهما الموت.
حضور شعري
تفتتح الكاتبة مريم عبد العزيز كل فصل ببيت شعري، من أشعار ابن عبد ربه الأندلسي، و«ألف ليلة وليلة»، إلى كلاسيكيات إبراهيم ناجي، في انسجام مع النقلات التي يتكشف فيها جانب جديد من سيرة البطلين الغائبين، وفي ظل نبرات صوتية أعلى لأبطالها الذين يتقاطعون مع حياتهما، أبرزهم «بشرى» الخادمة الأرملة التي تصبح في غمضة عين المُشتبه بها الأولى في جريمة قتل شكري، و«عادل» ابن أخيه والوحيد الذي يظهر من عائلته، فيطرح ظهوره أسئلة حول جوهر الانتماء العائلي، وتوريث الموهبة، فيرث منه عادل الفن بصورة مُغايرة، فهو يحلم منذ طفولته أن يصير «مسيو عادل» صاحب محل «الكوافير» الذي يتفنن في تصفيف شعر السيدات، ولكنه رغم وعيه بارتباطه «الفني» بعمه الموسيقي القتيل، إلا أنه يمتلئ بالنقمة عليه لتبديده الميراث الذي يطمع في أن يكون رأس مال افتتاح محل أحلامه.
لحن لم يكتمل
ومن ثم، يبدو العالم في الرواية مجرد مصيدة، فأحد شخوصها يدرك أنه «كما يراقب الناس فهناك من يراقبه، ويتصيّد هفواته ويبالغ فيها، واستخدامها كسلاح إذا تعرضت حياته لهجوم»، مما يشي بتفكيك لكتلة الحياة التي تبدو في ظاهرها الاجتماعي وثيقة، فيما هي معطوبة ومُفككة، فتصير الجريمة التي تقع في الحي القاهري القديم بشوارعه المتشعبة، خلفية لسرد أوسع يتتبع تعقيد الخريطة الإنسانية بالأساس، أكثر من تتبعه للغز بوليسي محض حول القاتل والجاني.
ومع تشعب الأدلة، يسترجع السرد في الفصل الأخير من الرواية الجلسة الأخيرة التي جمعت «شكري» و«خالد»، يشكو فيها العجوز للشاب قسوة السيدة التي لم يتخلص من حبها أبداً «اللحن الذي لم يكتمل»، فتعيد الرواية سيرة العجوز والشاب «الشبحين» إلى إنسانيتهما الهشّة، حيث يتبادل الاثنان الاعترافات والمرارة، وتنتهي بانسحاب الشاب مهزوماً، ليترك العجوز يتأمل كيف خالفت الحياة أمله، فصار مجرد مدرس مجهول للموسيقى، وكيف خذله عقله «فعجز عن ترجمة الحب لألحان».