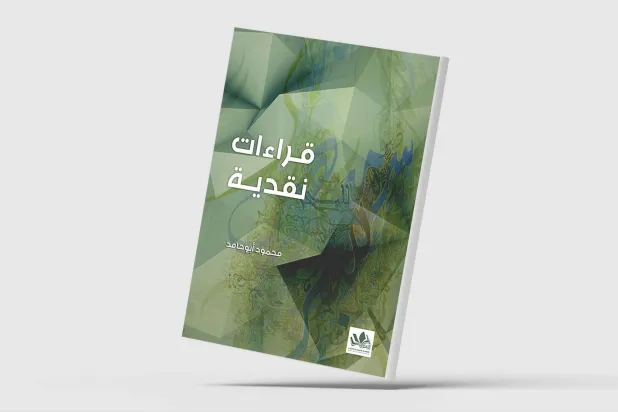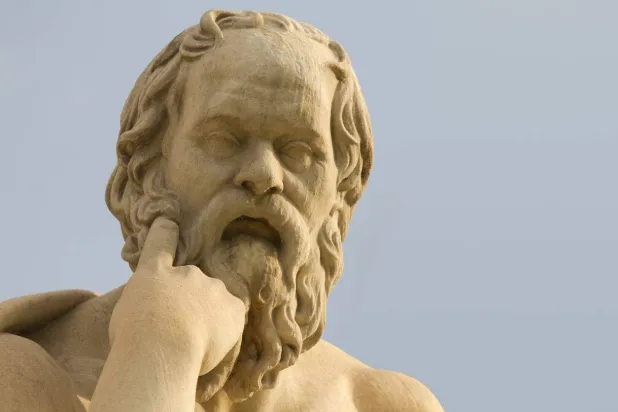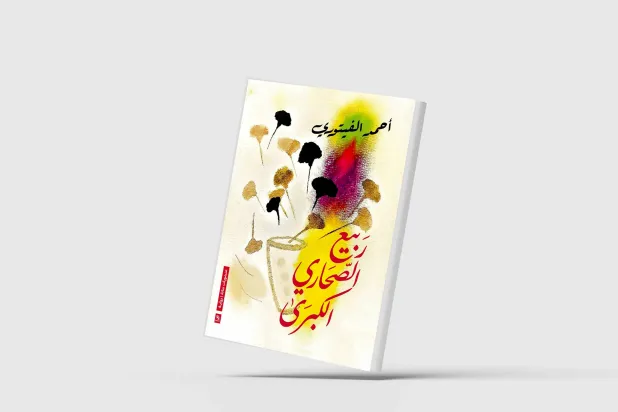يكتب سلافوي جيجك في كلّ شيء، وعن كلّ شيء، يتحمّل كلَّ التُهم التي تجعله منعوتاً بالخروج عن السياق، وفيلسوفاً أنزل الفلسفة إلى درك اليومي، وجرّدها من أسلحتها المتعالية، وعرّض الأفكار إلى سوء الظن دائماً.
اشتغل في السياسة بوازعٍ من شهوة المزاج الشخصي، والشغف بالمغامرة، مثلما اشتغل بالآيديولوجيا من منطلق أوهام الشيوعي المتمرد الذي لا يثق كثيراً ببداهات الصراع الطبقي، وكراهية الرأسمالية، حتى بدا وكأنه يصدّق حكايات الساحر الأغريقي الذي يؤمن بالنهايات الميتافيزقية للعالم، كما اشتغل في علم النفس بوصفه ممارسات في التطهير والاعتراف، وفي تخفيف حدّة التوتر الليبدوي، فعمد إلى استعارة كل الأدوات العيادية من جاك لاكان لكي يعرف أن هذا العلم المخادع يربط بين أزمة الجنس وأزمات الكينونة والجسد والثورة، ويسوّغ الحديث عن المخفي من أخطاء الحروب والديكتاتوريات والعنف، وتحت يافطة أن العيادي هو أنموذج الكائن الغربي، الذي يعاني من أمراض طبقية وسياسية وجنسية ووجودية، وأن علاقته بالعيادة تتحوّل إلى مجال للاعتراف، وللتنفيس عن طاقات مكبوتة، رغم معرفته بأن الكائن الواعي هو الوحيد الذي يمكنه ممارسة الكبت، والعيش مع التباسات اللاوعي الجمعي، وربما يخضع له، بوصفه توهماً بحيازة سلطة الإخفاء، وهي سلطة غير مرئية...

لكن الأخطر في اشتغالات جيجك هو شعبويته، وربما استعراضيته، فكثيراً ما يدعونا إلى ممارسات سقراطية، يجعل من الشارع منصته، ومن الحكمة خطاباً يومياً، ومن السياسة مجالاً للسخرية، ومن النكتة والكاريكاتير عتبات رمزية لفضح «المسكوت عنه» في الحروب القبيحة، وفي السياسات الأكثر قبحاً، ولإدانة ما يسمى بـ«المجتمع الدولي» وتعرية انتهازيته، وسكوته عن الأخطاء الكبرى التي تقود العالم إلى الكارثة، حيث يواصل سؤاله النقدي مع رعب العالم إزاء الخراب الآيكولوجي، فتبدو كتابته عن هذا الملف أشبه بالبحث عن شفرات للتطهير، بالمعنى الأخلاقي، أو المعنى الثقافي أو المؤسساتي، أو حتى المعنى «الشوارعي».
فهو يؤمن بأن تحديات «التلوث» و«النفايات» يمكنها أن تُدمّر العالم أكثر من الدمار النووي، وبهذا يسعى إلى تكريس شعبويته عبر اصطناع المزيد من المنصات في وسائل التواصل الاجتماعي، لكي يكون فيها سقراطياً، خطيباً آيكولوجياً، واعظاً بضرورة حماية المناخ والبيئة ومواجهة الاحتباس الحراري، ومنع صناعة الأسلحة النووية، والدعوة إلى الطاقة الخضراء، بوصفها طاقةً أكثر إنسانيةً، وصالحة لجعل الإنسان يثق بالطبيعة. فالحرب البيولوجية قد تكون هي الحرب المقبلة، إن كانت على شكل جائحة «كوفيد - 19»، أو عبر مظاهر المناخ المُهدد بالتلوث وتغوّل درجات الحرارة، أو عبر مظاهر استشراء العنف الداخلي للجماعات الهامشية، أو عبر احتجاجات شعبيّة ومنازعات اجتماعيّة وآيديولوجية في جميع أنحاء العالم، قد تترافق معها بوادر «حرب باردة جديدة».

هذا العنف، أو صورة الحرب المُهدِدة ليست بعيدةً عن الصراع السياسي الدولي، ولا عن طبيعة إعادة إنتاج «الثقافات المتعالية». فجيجك يتحدث عن علاقة العنف والكراهية بالآيديولوجيا، ومن منطلق الفكرة التي تؤكد على هوية ما تُنتجه «المركزية الأوروبية» في مختبراتها الآيديولوجية، وتمثلاتها في صيانة أنموذجها المتداول، عبر توصيفه كمواطن عالمي، وتوصيف قوته المسؤولة عن صناعة الحضارة والمستقبل. وعلى الآخرين أن يصدّقوا هذه الحكاية التي لم تكن بعيدةً عن تاريخ الفلسفة الأوروبية، فكانط كان عنصرياً في عديد أفكاره حول «اللون والمكان» وهيغل كان يؤمن بـ«المواطن الأوروبي» ونيتشه كان يضع إنسانه المتعالي نظيراً لهذا المواطن، وحتى هيدغر الفينومينولوجي أعطى للأوربة توصيفاً يربطها بالحضارة، وأن الغرب الذي يملك القوة، يمكنه أن يجعل المعرفة جزءاً من مفهوم الحضارة، ومن القوة المندفعة نحو السيطرة على العالم.
وأحسب أن مواقف جيجك من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وحتى موقفه إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة ليست بعيدة عن سرائر تلك النزعة المركزية، وعن حساسيتها، وربما عن قلقه إزاء طبيعة المتغيرات التي يمكن أن تتضخم مع تلك الصراعات، والتحوّل إلى مهددات، وإلى أشكال معقدة لسرديات حروب لم يتحمّلها الأوروبي، صانع المتعاليات الاستشراقية.
أزمة الأوروبي مع المركزية ليست بعيدةً عن علاقته بذاكرة الخطيئة، وأن دفاعه المستميت عنها يقوده دائماً إلى ذاكرة التطهير، وإلى ما أسسته من أوهام ميتافيزقية، وأحسب أن هذا هو ما دفع الكاتب الأميركي حميد دباشي إلى السخرية من هذه المركزية بالقول: «يعاني الأوربيون من النزعة الأوروبية قطعاً، كما أن الملا نصر الدين ظنّ بأن الموقع الذي ثبّت فيه لجام بغلته هو مركز الكون» (حميد دباشي/ هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟).
حديث المركزية الأوروبية، أو الغربية بمعنى أدق فتح أفقاً لحديث يتعلق بنقد الاستشراق، ولطبيعة ما يُثيره من أسئلة جديدة، تتجاوز نظرات إدوارد سعيد وفرانز فانون وغاياتري سبيفاك وغيرهم، ليس لأن «الاستشراق» خطاب زمني وتاريخي، بل لأن ما جرى ويجري جعل من الاستشراق قاصراً عن توصيف الصراع، والدفع باتجاه مراجعة أكثر شمولاً لمفاهيم معقدة مثل العولمة والأمركة والهيمنة، وهي ممارسات سياسية واقتصادية وآيديولوجية، تنطلق من فكرة المركزية، وتؤسس لها أجهزة صيانية تقوم على العنف والاغتيال، وعلى العقوبات، وعلى استنزاف الثروات، مثلما تقوم على المركزية المعلوماتية والإعلامية، وعلى تخليق «صور ذهنية» عن تلك المفاهيم، بوصفها جزءاً من الصور الذهنية عن سيطرة المتعالي.
أكد حميد دباشي هذا الأمر، عبر نقد تلك الأطروحات بالقول «إن ما يوحّد كلاً من جيجك وليفيناس وكانط هي فلسفة التعميم الذاتية، فهي تستند عندهم دائماً على نفي قدرة الآخرين على التفكير النقدي أو الإبداعي من خلال تمكين وتفويض وتخويل أنفسهم للتفكير بالنيابة عن العالم» (الفيلسوف سلافوي جيجك والقضية الفلسطينية - جعفر هادي حسن).
آراء حميد دباشي أثارت عصفاً فكرياً حول «المركزية الأوروبية» دعت سلافوي جيجك إلى الرد العنيف، بقوله «إن دباشي يريد فتح موضوع قديم، جديد، وهو إشكالية مركزية العقل الأوروبي» (علي سعيد: دباشي وجيجك والسؤال المستفز: هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟) وكأنه بهذا الرد يرفض القبول بوجهات نظرات «الشرق» الساخط على مركزية الغرب، وعلى أنموذجه الأوروبي.
تظل مراجعة فكرة المركزية الأوروبية موضوعاً إشكالياً، لأن مجادلتها ليست خاضعة بالضرورة إلى قياس قهري محكوم بعقدة المتعالي التاريخي، بل يتطلب الأمر وضعها في سياق ظروفها التاريخية، ومقاربتها من منطلق تمثيل الثنائية الملتبسة لـ«الأنا والآخر» بوصف الآخر جزءاً من تلك المركزية، ويملك تاريخاً ضاغطاً علينا، بدءاً من حروبه الصليبية، إلى حروبه التبشيرية، إلى حربه الآركيولوجية من خلال حملات الآثار في عدد من البلدان الشرقية، وصولاً إلى حقبة الاستعمار والاحتلال وما رافقها من عنف وتطهير إثني وهوياتي، وليس انتهاءً بفرضية الهيمنة الثقافية عبر الجغرافيا السياسية والاقتصادات التابعة والاستشراق بأقنعته المتعددة.
كما أن «الأنا» ليست بريئةً، وليست هي الضحية دائماً، فبقدر رثاثتها التاريخية وضعف أدواتها، وتشظي هويها، فإنها بدت أكثر التباساً في إطار أنساق حاكمة، صنعها الآخر أيضاً، وفرضها في سياق التداول كموجهات لتوصيف هامشية «الأنا» وعزلتها، عبر تأطيرها في اختراعات جيوسياسية مثل «العالم الثالث، الشرق الأوسط، الشرق الإسلامي، الدول النامية».
العالم لم يعد بحاجة إلى فلاسفة يفكرون على طريقة إيمانويل كانط، لكنه أيضاً يحتاج فلاسفة يفكرون بطريقة جيجك ودباشي وإدوارد سعيد
العالم ليس بريئاً
صحيح أن العالم لم يعد بحاجة إلى فلاسفة يفكرون على طريقة إيمانويل كانط، لكنه أيضا بحاجة إلى فلاسفة يفكرون بطريقة جيجك ودباشي وإدوارد سعيد، ليس لحساب تقعيد التفكير الثوري، بل لجعل «اللابراءة» مُحرضاً على التمرد، وعلى مواجهة تضخم الأقوياء من الذين يُفكّرون بصناعة «المراكز» المُستَبدة.
الجدل هو البراءة يتحمل مراجعات مفتوحة، منها ما يتعلّق بمناقشة المركزيات، والموقف من القضايا الإشكالية، مثل الموقف من «السامية» التي جعلها «العقل الصهيوني» أشبه بـ«الخطيئة الكبرى» لتسويق مفاهيم عن العنف والكراهية، وعن التعالق المريب بين التاريخ والأسطورة، فعبر «معاداة السامية» يتحول العالم إلى عدو، كما يدّعي الصهاينة، مثلما يتحول الموقف من العدالة إلى موقف آيديولوجي، يرتهن إلى حساسيات جعلها الغرب جزءاً من سياساته المركزية، في العلاقة مع الآخر، بوصف كيان إسرائيل أنموذجاً كنائياً لـ«النموذج الغربي» بقطع النظر عن عنصريته، وعن تقاطعه مع تاريخية فكرة «المواطن العالمي» التي تحدث عنه كانط.
أنموذج «الدولة اليهودية» هو تأكد على فقدان البراءة، وتجريد العالم من تنوعه، فدعوة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لليهود في فرنسا إلى المجىء لكيانه هو تكريس لمفهوم الدولة الدينية التي ستجعل من حروب المستقبل حروباً دينية ولا علاقة لها بالاقتصاد والجغرافيا والسياسة، وعبر استعارة تاريخية تنطلق من فكرة الانحياز إلى الضحية المثيولوجية، رغم شكوك جيجك حول الاعتماد على «صورة اليهود كضحايا في سبيل إضفاء الشرعية على سياسة القوّة الخاصة بها، فضلاً عن إدانة مُنتقديها باعتبارهم مُناصرين خفيين للهولوكوست، وأن اليهود أخذوا الأرض من الفلسطينيين، وليس من أولئك الذين كانوا السبب في معاناتهم؛ أولئك المدينين لهم بالتعويضات». (سلافوي جيجك: الصهيونية.. إلى أين؟).
أطروحات جيجك حول «لا براءة العالم» تجد في قضية الكراهية والعنصرية موضوعاً مهماً لمواجهة تضخم الآيديولوجيا العنصرية، إذ يربط بين هذا التضخم والعنف، ليدين من خلالها شكل «الدولة الدينية» ذي المواصفات الإسرائيلية بالقول «إن إنشاء دولة يهودية، يعني وضع نهاية لليهودية كدين، لذلك كان النازيون يؤيدون هذه الفكرة. وأن إنشاء هذه الدولة، في رأيه، يناقض التسامح، بل يعني كرهاً للآخرين، ويعني أيضاً التمسك بعنصرية خالصة» (سلافوي جيجك: الصهيونية.. إلى أين؟).