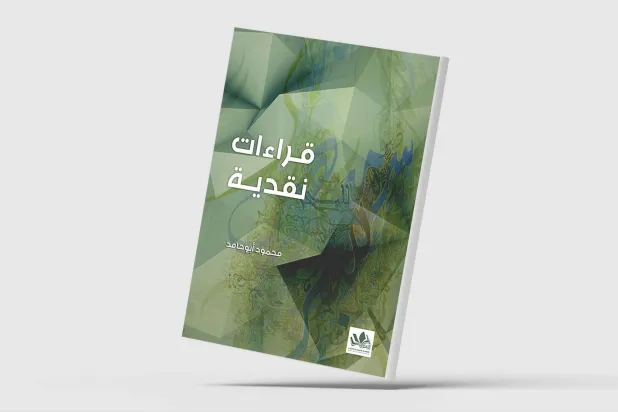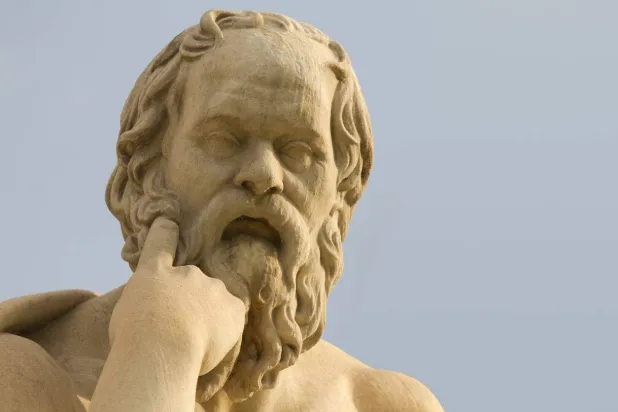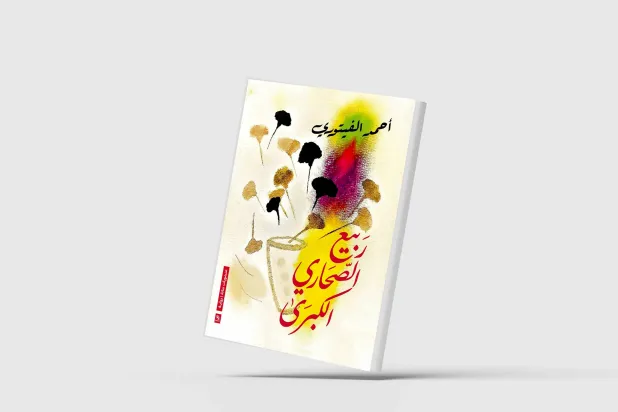يتعذر الحديث عن الحب دون التوقف ملياً عند «نشيد الأناشيد»، بوصفه أحد أهم النصوص المؤسسة لشعرية العشق والافتتان التي عرفها الكوكب الأرضي على امتداد العصور. ذلك أن في ثنايا هذا النص المدهش من جماليات أسلوبية وفنية، ومن تباريح العشق الروحي والجسدي، ما جعله شديد الأثر على الكثير من قصائد الحب التي كُتبت من بعده، بقدر ما شكّل على الدوام مصدر حيرة الباحثين الذين تناولوه بالنقد والدراسة والتحليل. ولعل أكثر ما يستوقفنا بشأن هذا النشيد، وقبل الولوج إلى جمالياته ودلالاته الفنية والإنسانية، هو وروده كسفْر مستقل من أسفار «العهد القديم»، التي تركز في مجملها على سرديات دينية تتعلق بخلق العالم وتتبُّع أحداثه المفصلية، وبسيَر أنبيائه الكثر وما عانوه، في سياق الصراع الدائم بين الخير والشر، من آلام ومكابدات.
والملاحَظُ أن حرص القرآن الكريم على تنزيه الأنبياء عن ارتكاب المعاصي، لم يقتصر على الملك سليمان وحده، بل طال أباه داود، الذي اقتصرت صورته في القرآن على العبادة والعلم وطاعة الخالق، فيما ينقل عنه «سفر صموئيل الثاني»، بأنه الرجل النزق الذي لم يتوان عن قتل قائد جيشه، لمواقعة زوجته «بثشبع»، وقد شاهدها تغتسل عاريةً، قبل أن تحمل في وقت لاحق بابنه سليمان. ولا تختلف صورة الابن في «العهد القديم» عن صورة الأب. ففي «سفر الملوك الأول» يظهر سليمان بوصفه الذكَر الممتلئ شبقاً، الذي شغف بنساء من جميع الأعراق، وبينهن من نهاه الله عن الزواج منهن، ولكنه «التصق بهن لفرط محبته لهن، فكانت له سبعمائة زوجة وثلاثمائة محظية، انحرفن بقلبه عن الرب».

وسواء تعلق الأمر بالأب أو بالابن، فإن إلحاح الرواية التوراتية على قدرات الملكين الجسدية الفائقة يعكس في عمقه نفياً واضحاً لعصمة الأنبياء، بقدر ما يبدو تباهياً بفحولة الحاكم اليهودي مقابل «تأنيث» الآخرين، أفراداً كانوا أم شعوباً وجماعات. وإذ تركز السردية التوراتية على افتتان بلقيس بجمال سليمان وسعيها الحثيث للظفر به، تذهب السردية القرآنية بالمقابل إلى أن سليمان هو الذي بذل كل جهده للظفر ببلقيس. إلا أن اهتمامه بها لم يكن بدافع شغفه المفرط بجمالها الفاتن، بل بهدف إبعادها عن ديانتها الوثنية، وإعادتها إلى طريق الإيمان القويم. وهو الأمر الذي يؤكده ما جاء على لسان ملكة سبأ في الآية الكريمة «ربِّ إني ظلمتُ نفسي وأسلمتُ مع سليمانَ لله ربِّ العالمين».
وإذ يحرص «النشيد» على إظهار سليمان في صورة الملك الشاعر الذي تيمه العشق، يبدو هذا الحرص بمثابة تصحيح متأخر للصورة النمطية التي رسمتها له أسفار «العهد القديم» الأخرى. ولعل التناقض الواضح بين صورة سليمان في «سفر الملوك» وصورته في «نشيد الأناشيد» هو الذي حدا ببعض الدارسين إلى الاستنتاج بأن سليمان قد يكون نظم «النشيد» في فترة كهولته، أي بعد تراجع تطلُّبه الجسدي، وتقدُّم الروح لكي تحتل مكانها اللائق على ساحة الهيام والوجد. ومن الباحثين من ذهب إلى مسالك ومقاربات أخرى؛ حيث تساءل أنسي الحاج في تقديمه لـ«النشيد» الذي أعاد ترجمته بلغة عالية، عما إذا كان هذا الأثر الاستثنائي من كتابة سليمان نفسه، أم هو «مجموعة أشعار بابلية المصدر في غناء حب عشتار وتموز؟ وهل كتبه كتّابه تحت الروح الهيليني، أم لملموه من الأدب الإسكندراني ونقلوه إلى العبرية؟». كما ذهب البعض إلى قراءات أخرى، فرأوا فيه رمزاً لاتحاد يهوه بإسرائيل أو المسيح بكنيسته.
والواقع أن في النشيد ما يترك الباب موارباً إزاء أي جواب حاسم بشأن مؤلفه أو مؤلفيه الحقيقيين. ومع أن اسم سليمان يتكرر غير مرة في فصوله، مثل «أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، كشقق سليمان»، أو «الملك سليمان عمل لنفسه تختاً من خشب لبنان»، أو «كان لسليمان كرْم في بعل هامون»، فإن في ذلك ما يرجح كونه بطل «النشيد»، وليس كاتبه بالضرورة. كما أن الأصوات الثلاثة التي تتعاقب على الكلام، وهي الرجل والمرأة والجوقة، يمكن أن تقودنا إلى الاستنتاج بأن النص أقرب إلى طقس عشقي ذي طبيعة دينية، كتبه شاعر أو أكثر، وتم تقديمه في الهيكل الذي بناه سليمان من خشب الأرز، تمجيداً له وتعظيماً لشأنه.
وقد يكون التداخل الملغز بين صورتي الملك والراعي في فصول «النشيد» المختلفة، واحداً من العناصر الإضافية التي تترك في ذهن القارئ المزيد من البلبلة واللبس حول هوية كاتبه. إذ ثمة ما يشير إلى أن العاشقين كانا راعيين من عامة الشعب، مثل «يا من تحبه نفسي، أين ترعى أين تربض عند الظهيرة؟»، أو «أيتها الجميلة بين النساء، أبرزي في أثر الغنم، وارعي جداءك عند مساكن الرعاة». كما أن حث المرأة حبيبها على الهرب، بقولها في المقطع الختامي «اهرب يا حبيبي وكن كالظبي أو كغفر الأيّلة على جبال الأطياب»، لا يستقيم مع مقام الملك الذي كانت تهابه الشعوب والكائنات كلها، بل يبدو فعل الطلب موجهاً إلى الراعي، الذي قد يكون دخوله على خط العلاقة، تجسيداً لحنين المرأة إلى سليمان نفسه في صورته الرعوية الريفية، بعيداً عن سطوة الحكم وأبهة السلطة المدينية.
وإذا كان من المتعذر فصل النشيد عما سبقه من مؤثرات وروافد مختلفة، بخاصة حوارات «إنانا» و«ديموزي» ذات الطابع الإيروتيكي، التي تقيم تماهياً واضحاً بين طقوس الزراعة والخصب والفعل الجنسي، كما بيّن جيمس فريزر في «الغصن الذهبي»، وصموئيل كريمر في «طقوس الجنس المقدس»، فإن «النشيد» يكتسب أهميته من جمالياته الفنية والدلالية، ومن مناخاته المدهشة التي تجمع بين الشغف المحموم ورغبة الانصهار بالآخر:
اجعلني كخاتم على قلبك
كخاتم على ذراعك
لأن الحب قوي كالموت
والغيرة قاسية كالهاوية
مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ الحب
والأنهار لا تغمره
كما تتضافر في النشيد، الذي يعده زنون كوسيدوفسكي «واحداً من أروع وأندر القصائد الشعرية الشهوانية في الأدب العالمي كله»، الحواس الخمس مجتمعة، لتمنح العلاقة العاطفية ما يلزمها من أسباب النشوة الجسدية والثمل الروحي. فهو يحتشد بشتى الألوان التي يضيء كل منها جانباً خاصاً من جوانب الكرنفال العشقي. فالمرأة في «النشيد» يبدو شَعرها شبيهاً بقطيع ماعز على جبل جلعاد، وشفتاها كسمط من القرمز، وعنقها كبرج من العاج. أما الرجل من جهته، فهو لحبيبته عنقود حناء، وغدائره كسعف النخل حالكة كالغراب، ويداه حلقتان من ذهب، وجسمه مغشّى بالياقوت الأزرق.
وفي هذا العالم البدئي للعناصر والكائنات، لا يتبقى من فاصل يُذكر بين الإنسان والطبيعة، بحيث تصبح النباتات حالة من أحوال الجسد الإنساني، ويصبح البشر بدورهم امتداداً للأشجار والنباتات. وحيث يبدو الخريف والشتاء رديفين رمزيين للشيخوخة والموت، يتقمص الربيع بالمقابل صورة القيامة، متكفلاً بإعادة الحياة إلى نصابها، وبضخ الدماء الحارة في العروق التي جمدها الصقيع. ولعل أكثر ما يجسد هذه التوأمة بين طرفي الخلق هو قول الرجل العاشق منادياً امرأته المعشوقة:
قومي يا خليلتي يا جميلتي وتعالي
فإن الشتاء قد مضى والمطر مرَّ وزال
الزهور ظهرت في الأرض
والتينة أخرجت فجّها
والكروم أزهرتْ وفاح عَرْفُها
ومع عزف النشيد على وتر العلاقة المتداخلة بين الجسد والروح، كما بين الديني والدنيوي، يظهر الاحتفاء بحاسة الشم وكأنه ضربٌ من ضروب اللعب المقصود على وتر الانجذاب الجسدي، وتنسُّمٌ لهبوب الأزمنة المنقضية على حدائق الرغبات. وإذ تتكرر في النص عبارات من مثل «مَن هذه الطالعة من القفر مطيبة بالمرّ واللبان» و«خدّاه كخميلة الطيب» و«حلْقكِ كخمر طيبة»، نلاحظ في الوقت نفسه تركيزاً على التفاح ومذاقاته وروائحه المشتهاة، كما في عبارات «عَرْف أنفكَ كالتفاح» و«تحت شجر التفاح نبهتك» و«قوُّوني بالتفاح فقد أسقمني الحب». وإذا كان من البديهي أن نستعيد مع التفاح شجرة الخطيئة الأصلية وثمار الإغواء الشهواني، فإن الاستدعاء المماثل للرمان والكرمة والنخيل وغيرها، يعكس في عمقه الأخير حنيناً موازياً للعودة إلى الفردوس. فبمثل تلك العودة أمكن للعري أن يكتسي ثوبه الطهور، وللشهوة أن تنبثق عن أكثر المشاعر صلة بالعفة، وللمدنس أن يدخل في عباءة المقدس. وفي ظل ذلك الانصهار الكلي بين العناصر والكلمات، أمكن للعاشقين المدنفين أن يتحولا إلى نسخة ثانية عن آدم وحواء، سابقة على ارتكاب الخطيئة، وأمكن للجوقة الشبيهة بالكورس في المسرح الديني أن تسأل المرأة الوالهة «ما فضل حبيبك على الأحباء، أيتها الجميلة؟»، لتجيب الأخيرة بلا تردد:
حبيبي أحمر ونضر
غدائره كسعف النخل حالكة كالغراب
عيناه كحمامتين على أنهار المياه
وجسمه عاجٌ يغطيه اللازورد
ساقاه عمودا رخام على قاعدتين من إبريز
وطلعته كلبنان.