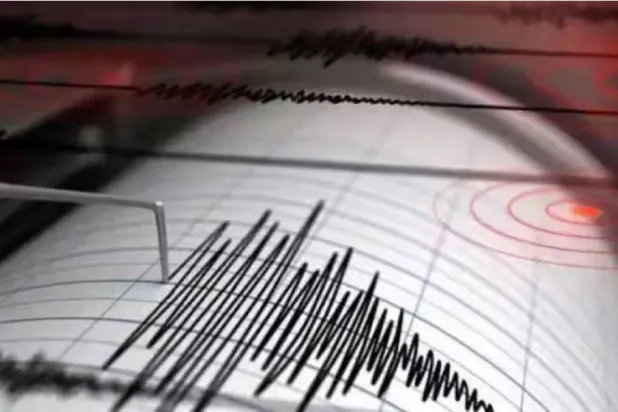بعد مرور عام على الزلزال المميت، يكاد يكون من المستحيل العثور على شخص لم يفقد أحد أفراد أسرته أو صديقا له أو أحد جيرانه في مركز مدينة هاتاي أو أنطاكيا، جنوبي تركيا. فقدت المدينة نصف سكانها تقريباً وقد هاجر العديد منهم إلى مدن مجاورة أو بعيدة كإسطنبول وأنقرة، بعد دفن أحبائهم وجمع بعض الأثاث من بيوتهم المدمرة.
ويحاول الناجون الآن إعادة بناء حياتهم وسط أنقاض المدينة، وبين مباني الأشباح، والغبار المبعثر المتراكم من مواقع الهدم، على وقع ضجيج المعدات الثقيلة التي لا تزال تعمل على هدم المباني المدمرة. بعد مرور بضعة أشهر على الزلزال، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة أصبحت شهيرة وتُظهر صاحب متجر يعيد فتح متجره مع بعض الترميم، واضعاً حاوية بين الأنقاض في وسط المدينة المهجورة، ولكن من دون أي زبون يلتفت إليه. وتحولت هذه الصورة وغيرها مما يشابهها رمزاً للناجين المطالبين بالاعتراف بوجودهم في المدينة في مواجهة موجة هجرة هائلة. فقد أصبح هجران المدينة ومحيطها مصدراً للقلق الحقيقي بين من تبقى من أن عملية إعادة الإعمار سوف تتعطل أكثر إما لغياب قوة عاملة مستقرة متبقية وإما لانتفاء الضرورة القصوى. وتم تصوير أصحاب المحال التجارية وهم يحملون بعض الماء والمكانس بأيديهم، وهي أدوات كفاحهم الرئيسية من أجل الحفاظ على المدخل نظيفاً وأنيقاً ضد الغبار والأنقاض التي عمّت الأمكنة كلها.
وعلى الجدران انتشرت كتابات رافقت صورة صاحب المتجر «المقاوم» وتقول «لم نغادر»، «لن تفقد الأمل؛ سوف نعود»، «انهارت بيوتنا، وليس أحلامنا». بعض هذه الكتابات على الجدران أطلقت على أكشاك الكباب وغيره من المأكولات الشعبية التي أعاد أصحابها افتتاحها بما هو متاح وبإصرار إبقاء ذكرى الزلزال حية وصمود شعب هاتاي لإعادة بناء حياتهم في المدينة. واليوم، مع الذكرى السنوية الأولى للزلزال، بات هناك العديد من المتاجر المفتوحة، وسوق الخضروات والفاكهة المحلية (البازار) تعج بالناس.
ومع ذلك، لكل منهم رواية يقصها علينا عن مدى صعوبة الحياة في هذه البقعة.

لم يتغير شيء
بعد عام من الزلزال يفاجأ الزائر بأن المكان ما زال على حاله. وكأن الزمن لم يمر منذ أن ضربت الكارثة. بدت المدينة مهدمة كما يمكن أن تكون. بين الأنقاض، كانت الخيام والحاويات والأواني المعدنية المؤقتة موجودة في كل مكان تقريباً، وهي تقوم مقام المنازل والمتاجر والمطاعم والمصارف والمكاتب.
تغير مشهد المدينة بشكل هائل. مناطق بكاملها سويت بالأرض حتى أن تجربة مشتركة شاعت بين الناجين كانت الضياع في أماكن يعرفونها طوال حياتهم. فلم يعد في الشوارع نقاط استدلال. وفي غياب الأشجار، أو الأبنية التاريخية، أو المقاهي، أو نقاط اللقاء التي كانت تميز المدينة، لم يتمكن السكان من معرفة أين كانت بيوتهم. وقال «ييغيت»، وهو طالب جامعي من أبناء المدينة إن مقابلة صديقه استغرقت منه ساعة تقريباً من المحاولة، بحيث لم يتمكن أي منهما من وصف موقعه. وقال: «انتهى بنا الأمر إلى استخدام (فيس تايم) ورفعنا صوتنا لنسمع بعضنا البعض ونستدل».
قرى الحاويات وعيش بالمياومة
واليوم يسكن العديد من الناجين الذين بقوا في المدينة إما في «مدن الحاويات» أو في الأطراف والقرى المحيطة بهاتاي. وفقا للإعلان الرسمي الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تقيم أكثر من 50 ألف أسرة في 175 بلدة حاويات منتشرة في جميع أنحاء المدينة. وقد تمكن أولئك الذين فقدوا منازلهم من الاستفادة من برنامج للمساعدات يغطي نفقات الانتقال وتكاليف الإيجار. ومع ذلك، فإن المبالغ المخصصة كجزء من البرنامج لا تكفي لإيجار شقة، بعد ارتفاع الأسعار ارتفاعاً صاروخياً سواء بسبب خسارة الأبنية السكنية أو بسبب ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

وبالنسبة للسكان الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه في القرى أو الأطراف وتخيروا الانتقال إلى مدن الحاويات، تخلوا عملياً عن المساعدة في الإيجار فيما لا يزال بعضهم وهم قلة يقيم في الخيام.
تضم إحدى مدن الخيام التي نُصبت في شارع فرعي على بُعد بضعة كيلومترات من وسط المدينة نحو 50 عائلة سورية. يعيش محمد في خيمة واحدة مع زوجته وأطفاله الستة. وعندما سُئل عما إذا كان يتلقى أي مساعدة، أجاب قائلاً: «بعض الناس جلبوا الطعام لبعض الوقت، ولكن ذلك توقف الآن». ومنذ الزلزال لم يعد محمد قادراً على العمل إذ سقط جدار على كتفه وهو يحاول الهرب من مسكنه فاضطر أبناؤه الثلاثة للعمل في محل لبيع الأثاث.
وتتلخص خطة رب الأسرة في تكييف الخيمة مع ما تقتضيه ظروف الشتاء واستمرار العيش فيها. ليس لديه كبير أمل في الترقية إلى حاوية. ويُشكل الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء أكبر مشقة بالنسبة له ولعائلته، لأنهم لا يحصلون على الكهرباء إلا كل يومين.
وفي الأجزاء الأخرى من أنطاكيا أيضا، لا يزال انقطاع مقومات العيش الأساسية يُمثل مشكلة كبيرة. توضح السيدة إليف، وهي مُعلمة تعيش الآن في إحدى بلدات الحاويات، أن الأمر أصبح أقل بؤساً، بالمقارنة مع الأشهر الأولى، ولكن عندما يحدث الانقطاع، يمكن أن يستغرق أحيانا 48 ساعة. وتقول: «بعد الزلزال، كانت الحاجة الفورية إلى إعادة الكهرباء بأسرع ما يمكن، فقام العمال بالسير بالكابلات إلى أي مكان بُغية الاستجابة بسرعة للاحتياجات. والآن، عندما يحدث انقطاع، يستغرق الأمر وقتا طويلا لمعرفة ما حدث لأي كابل».
وتمثل الأمطار مصدر خوف بسبب البنية التحتية الهشة للمدينة ومواقع السكن المؤقتة. ولا يقتصر سبب انقطاع الكهرباء على هطول الأمطار الغزيرة في كثير من الأحيان، بل إن معظم الحاويات ليست مضادة للمياه أصلاً ما يشكل خطراً مضاعفاً. إذ يتسرب الماء من الأعلى ومن الأسفل على السواء في الأماكن حيث تقع البلدات في السهول. ويُلقي الناجون باللائمة في ذلك على نقص التخطيط والتنسيق الذي استمر منذ عمليات الإنقاذ. تقول سينيم، وهي امرأة تبلغ من العمر 45 عاماً تعيش في حاوية مساحتها 21 مترا مربعا مع أطفالها الثلاثة وزوجها: «إننا غير قادرين على التخطيط لأي شيء، ونحاول فقط قضاء كل يوم بيومه». وكانت مدرسة أطفالها انهارت خلال الزلزال أيضاً وهم الآن مسجلون في التعليم عن بُعد.
لا مكان للعائلات
وفي العديد من الأسر الميسورة مالياً، هاجرت النساء إلى مدن أخرى من أجل تعليم الأطفال، في حين بقي الرجال في هاتاي لمواصلة عملهم. يوسف واحد منهم. يعيش حالياً في حاوية مُقامة في قريته ويستأجر شقة في إسطنبول لزوجته وأطفاله. بعد قضائه فترة قصيرة في إسطنبول، وجد الرجل صعوبة في استئناف العمل فعاد أدراجه إلى أنطاكيا لفتح محل الأحذية. بعد الزلزال، كان معظم زبائنه الجدد من الجنود وضباط الشرطة والعمال الذين جاءوا إلى المدينة كجزء من عمليات الإنقاذ أو لأعمال البناء. وفيما اتبعت العديد من الأسر نمطاً مماثلا، تغيرت ديموغرافيا المدينة بشكل كبير وقلبت نسبة الرجال إلى النساء من 61.8 في المائة إلى 38.1 في المائة، بحسب مركز هاتاي للتخطيط.
وفي الوقت نفسه، من نجت مبانيهم وخرجوا بأضرار «طفيفة» أو «متوسطة» عادوا تدريجياً وسط خوف دائم من الهزات الارتدادية أو زلزال آخر. أما أولئك الذين يعيشون في مبان متضررة إلى حد كبير نسبياً فقد غابوا في طي النسيان لعدة شهور، حيث انقسمت السلطات حول ما إذا كانت هذه المباني آمنة للعيش بعد التدعيم والتعزيز، أم أنه ينبغي هدمها وإعادة بنائها. ولم يكن حتى قبل 3 أشهر من الآن أن قالت منظمة الكوارث والطوارئ الحكومية إنها اتخذت قراراً بهذا الشأن بحسب كل مبنى.
تضامن شعبي بددته السياسة
في الأسابيع الأولى التي تلت الزلزال، تضامن العديد من الأفراد والمجموعات والمنظمات غير الحكومية مع الناجين، وخاصة مع سكان هاتاي. فلطالما اعتبرت المدينة مثالاً حياً للتعددية الثقافية، وهي التي تضم العرب العلويين، والسنة، والمسيحيين، والأرمن، واليهود. وحالما انتشرت الصور المفجعة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى قنوات التلفزة، حاول حتى المواطنون العاديون في أنحاء مختلفة من البلاد الوصول إلى المنطقة بوسائلهم الخاصة لإرسال التبرعات أو توفير قوة عاملة في عمليات الإنقاذ. وتأسست شبكات جديدة من التضامن داخل المدينة وخارجها للعمل على كيفية إعادة بناء الحياة. ولا تزال هذه القصص حية في ذكريات الناجين، إذ لدى كثيرين منهم ما يقولونه عن كيفية مساعدة جيرانهم أو أشخاص مجهولين لهم.
ولكنها ذكريات بالفعل. فبعد مرور عام طغت على روح التضامن النزاعات والخلافات، التي كان بعضها موجوداً أصلاً قبل وقوع الكارثة. ولا شك في أن المناخ السياسي البالغ الاستقطاب في البلد يعمل كمحفز إضافي لتعميق الخلافات والفجوات. وقد أبدى حزب الشعب الجمهوري حذراً خاصاً من الإجراءات التي اتخذتها حكومة حزب العدالة والتنمية إزاء المجتمع العربي - العلوي في المدينة - ثاني أكبر مجموعة بعد السكان السنة - والذي يُصوت عموماً لصالح حزب المعارضة الرئيسي.
وذكرت موجان، وهي صاحبة مطعم عمرها 45 عاماً، أن منطقتها لم تتلق أي مساعدات حكومية في الأيام الثلاثة الأولى من الزلزال، لأنها منطقة يسكنها بالأساس العرب العلويون. ومثل العديد من العرب العلويين الآخرين في المدينة، تعتقد موجان أن الحكومة تستخدم الزلزال لتفريق المجتمع من خلال جعل حياتهم أكثر صعوبة وفرض الهجرة عليهم بصورة غير مباشرة كخيار وحيد.
ووفقا للسيدة موجان، ازداد الانقسام بين السكان السنة والعرب - العلويين، بعد وصول اللاجئين السوريين إلى المدينة، وهو ما تعتبره أيضاً جزءا من سياسة الحكومة التقسيمية. كما أدى قراران صادران عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن مصادرة الأراضي في الأشهر التالية على الزلزال إلى إثارة مخاوف المجتمع العربي - العلوي. فقد سمحت هذه القرارات لوكالة الإسكان الحكومية (توكي) بمصادرة أراض لبناء مبان جديدة في «ديكمجة» و«غولدرين»، وهما حيان من مدينة أنطاكيا يسكنهما بشكل رئيسي العرب - العلويون. والقراران مرفوعان حاليا إلى المحكمة الإدارية. بعد فترة وجيزة من القرار الرئاسي، شرع أهالي قرية «ديكمجة» في مقاومة مصادرة بساتين الزيتون ونظموا عدة احتجاجات للحفاظ على أرزاقهم، ما أدى إلى مواجهات عنيفة بين الشرطة المحلية والأهالي.

الإعمار معضلة متشعبة
ويقول المحامي المحلي أجاويد ألكان: «هناك فوضى في المدينة، والساسة مستفيدون؛ فمن الأسهل أن يحكموا بهذه الطريقة». وإلى جانب تداعيات المشكلات الوطنية العامة على المدينة المنكوبة، صارت النزاعات في مختلف الشؤون جزءاً من الحياة اليومية». ويقول ألكان: «لا تخلو مجموعة واتساب من نزاعات. فهذه المجموعات تشكلت بين سكان الشقق ويتعين عليهم الآن أن يقرروا معاً ما ينبغي القيام به حيال المباني المنهارة». والخيارات هي إما إعادة البناء في نفس المكان، وهو ما يتطلب موافقة 50 في المائة من أصحاب المساكن، أو استبدال شقة من وكالة «توكي» بحقهم في الملكية. وأيا كان الخيار الذي سيتخذونه، سوف تُقدم الحكومة منحة قيمتها 750 ألف ليرة تركية (أي نحو 24 ألف و700 دولار) وقرضاً من دون فائدة بنفس المبلغ، يبدأ سداده بعد سنتين. بيد أن هذه المبالغ ظلت منخفضة للغاية مقابل معدل التضخم المرتفع في البلاد، فيما أغلب الناجين خسروا أعمالهم بالإضافة إلى مساكنهم وهذه المبالغ وإن كانت ضئيلة لكنها تفوق قدرتهم. وهم الآن يُعربون عن قلقهم من أن البنايات الجديدة قد تكلفهم أكثر بكثير مما قد تغطيه المنحة والائتمان معاً، وقد ينتهي بهم الحال إلى الوقوع في براثن الديون الضخمة.
راهناً، تُصنف المباني في المدينة إلى أربع مجموعات، وهي: «مُدمرة»، «أضرار جسيمة»، «أضرار متوسطة»، «أضرار طفيفة أو معدومة الضرر». وبدورها تحولت هذه التصنيفات أيضاً إلى مصدر رئيسي للخلاف، إذ رفع الكثير من السكان تقييم ممتلكاتهم إلى المحاكم على أمل تغييرها إما إلى أضرار «متوسطة» أو «طفيفة» للحيلولة دون هدمها. فمدينة هاتاي، وكذلك منطقتها المركزية أنطاكيا، مليئة بالمباني التي تحمل لافتة تقول «لا تهدم، ارفع إلى المحكمة»، حيث يخشى المالكون من أنهم إذا فقدوا حتى أطلال ما كانوا يمتلكونه، يمكن مصادرة أراضيهم لصالح بعض المشاريع الحكومية أو بناء مبان جديدة لا يمكنهم تحمل نفقات إعادة شرائها. وأعرب مسؤولون حكوميون عن قلقهم إزاء العدد الكبير من القضايا التي غمرت المحاكم المحلية وتؤخر عملية إعادة الإعمار من وجهة نظرهم.
البازار خلاف إضافي
أصبح «أوزون كارشي» (السوق الطويلة) أو البازار التاريخي للمدينة أكثر حياة وحيوية مما كان عليه قبل شهرين. ومع ذلك، يختلف أصحاب المتاجر فيما بينهم حول أهمية البازار. إذ تقضي الخطة الرسمية بهدمه وإعادة بنائه ببنية تحتية أفضل. ولكن لا يتفق الجميع مع تلك الخطة، ويوسف من أشد المعترضين. فهو يرى أن إعادة الإعمار سوف تستغرق وقتاً أطول بكثير مما هو مُعلن رسمياً، خصوصاً أن الحكومة لم تفِ بعد بأي من وعودها السابقة. وإذا ما تم هدم البازار، سوف يُنقل مؤقتاً إلى سوق الحاويات التي، بحسب يوسف، تفتقر إلى روح البازار التاريخي ولن تجذب أحداً.
ولا شك أن سكان المدينة الموالين للحكومة أكثر تفاؤلاً بشأن هذه العملية، ويعتقدون أنه إذا وضع الجميع ثقتهم في الحكومة، فالأمور ستسير بسلاسة أكبر. ولكن حتى سردار، الذي يعمل موظفاً مدنياً في بلدية أنطاكيا (بقيادة حزب العدالة والتنمية)، يعترف بأن الأمور تتحرك ببطء شديد مقارنة بالمدن الأخرى المدمرة. ويقول: «كأن هاتاي (شُرابة) مُعلقة بالبر الرئيسي. كأنها عبء إضافي ومشكلاتها لا تندرج في الأجندة السياسية كأولوية».
مثل هذه المشاعر شائعة بين سكان هاتاي، بصرف النظر عن هوياتهم الخاصة. سليم، على سبيل المثال، دهن جراره الزراعي بألوان قوس قزح ووصف في الخلف كيف تُركت المدينة وحدها بعد الزلزال. وعلق لوحة أرقام مؤقتة تقول «31 زلزال 4.17»، علماً بأن 31 هي رمز المرور في هاتاي، و4.17 ترمز للوقت الذي ضرب فيه الزلزال الأول المدينة بشدة. كان سليم يمتلك مطعماً قبل الزلزال، وقد اشترى الجرار القديم لاستخدامه كديكور في الواجهة غير مدرك أنه سيتحول إلى مصدر رزق. ففي الوقت الحالي، بات يستخدمه لجمع الأشياء من مواقع التدمير ولا يعرف ما العمل الذي يمكن أن يجده بعد ذلك.
الغموض الذي أصاب كل جوانب الحياة في هاتاي بالشلل تقريبا، مع غياب التحرك السياسي الفعال لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان، يختصر المناخ العام للمدينة بعد سنة من الزلزال. ولكن مع الانتخابات البلدية التي ستجرى في 31 مارس (آذار) المقبل تمحورت السياسة في المدينة حول الوعود الانتخابية التي تزيد الريبة والشك بين الناخبين في المدينة. فإذا لم يتحقق شيء من الوعود خلال عام، ماذا يرتجون في أشهر؟