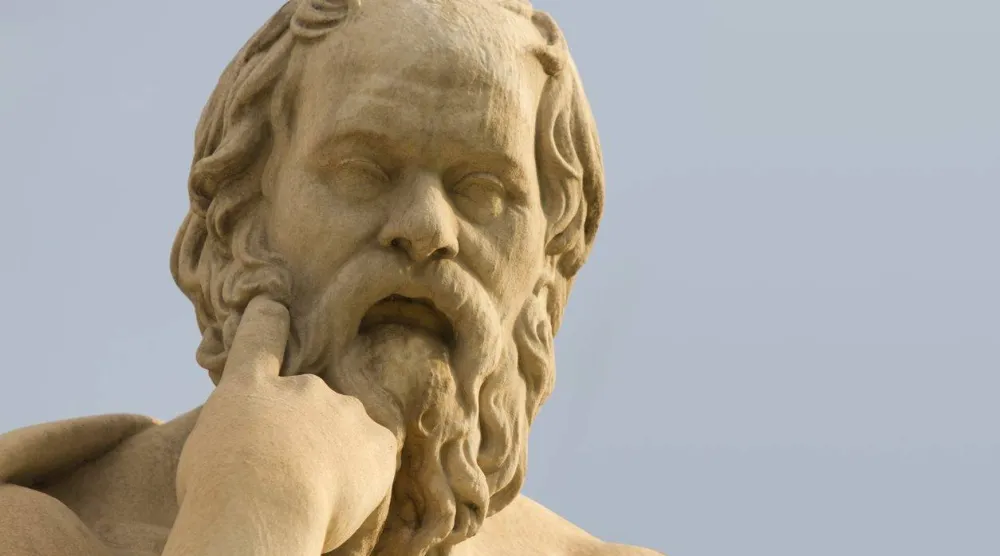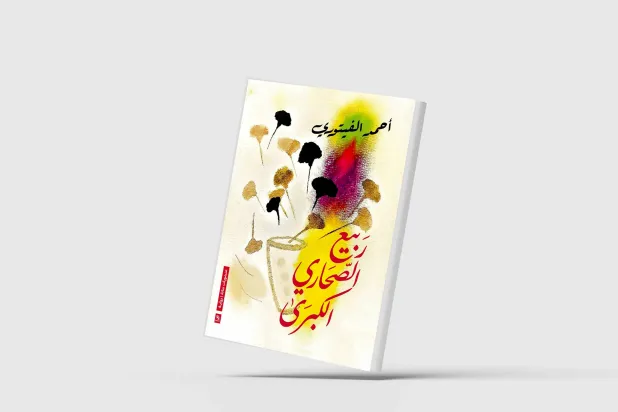ليست ممكنةً المجادلةُ في أن موضوع المقالة-العرض يُشَكِّلُ ظاهرة سردية أدبية في الإبداع السردي المحلي أو الإقليمي أو العالمي، إذ لا يعدو كونه ثيمةً تتكرر في ثلاث قصص وثلاث روايات تنتمي إلى أمكنة وأزمنة متباعدة نسبياً، وتقع الأحداث فيها في أمكنة وأزمنة مختلفة ومتباعدة نسبياً أيضاً. لكنه قابلٌ في الآن ذاته للاتساع ليكون ظاهرة في حال وجود نصوص سردية أو غير سردية موزعة على رقعة واسعة من العالم وتعالج الموضوع الذي أتطرق إليه.

القصص والروايات المشار إليها آنفاً: قصة ويليام فوكنر «وردة لإميلي»، ورواية «أغنية سليمان» لتوني موريسون، ورواية إسماعيل فهد إسماعيل «السبيليات»، ورواية «وشائج ماء» لعبده خال، و«حاملات الجثث» قصة ج. ج. سلفرمان، و«المرأة التي تحمل جثة» قصة تشي هوييْ (ترجمتها من اللغة الصينية جوديث هوانغ). يعرض كل نص منها امرأة - أو نساء كما في إحدى القصص- ترتبط بجثة، لأسباب وغايات بعضها يمكن إدراكها أو الحدس بها، وبعضها غير واضح حتى للشخصية نفسها. وتتباين ارتباطات الشخصيات بالجثث أو الرفات من ناحية تأثيرها عليها (الشخصيات) أو على من حولها، أو في فهم القارئ لها. بالمجمل تؤسس تلك الارتباطات بالجثث بعض ما يميز تلك الشخصيات عن غيرها في العمل نفسه، أو في أعمال أخرى.

عزلة وزرنيخ ونكروفيليا
عند الكتابة عن «وردة لإميلي»، يستحيل نسيان الجثة المحبوسة في الغرفة في الطابق العلوي لأربعين سنة في منزل الآنسة إميلي غريرسون. فبعد وفاتها تقاطر الناس إلى بيتها لإلقاء نظرة على جثمانها، الرجال بدافع «الاحترام تجاه معلم تذكاري قد هوى»، أما النساء فكان يحدوهن «الفضول لرؤية داخل منزلها الذي لم يره أحد... منذ ما لا يقل عن عشر سنوات خلت» (ترجمة سامر أبوهوّاش، 173).
بعد مواراة جثمانها الثرى، يقتحم المشيعون باب الغرفة المغلقة ليكتشفوا أنها مؤثثة كغرفة عرس، وعلى السرير جثة رجل، في وضعية العناق، وعلى الوسادة بجانبه «فجوة أحدثها رأس» وخصلة شعر رمادي قاتم. هنا يدرك القارئ، مثل أهل المدينة، أنها جثة مشرف العمال الشمالي «اليانكي» هومر بارون الذي رافقته إميلي حيناً من الوقت ثم اختفى، وظل اختفاؤه لغزاً. ويتذكر القارئ، أيضاً، الزرنيخ الذي حكى الصيدلاني للناس أنها اشترته، ورائحة العفن التي انبعثت من بيتها بعد ذلك. بلملمة هذه الخيوط تتشكل حكاية أنها قتلت بارون واحتفظت به ومارست «النيكروفيليا» معه.
خلال قراءته للنص، يتساوى القارئ مع أهل المدينة في عدم معرفة ما يحدث في بيتها بسبب توظيف فوكنر السارد بضمير المتكلم الشاهد الذي يتكلم بلسان مجتمعه، مما يُفْقِدُ القارئ التفوقَ المعرفي الذي يحدث عادةً في وجود السارد العليم فيما يسمى المفارقة الدرامية، حيث القارئ يعرف أكثر مما تعرفه الشخصيات، أو ما لا يمكنها معرفته.

امرأة ورفات وحمار
بعد انقضاء سنتين منذ وصولها وأبنائها وأحفادها وحميرهم التسعة للإقامة في الشمال، تقرر أم قاسم العودة وحدها إلى «السبيليات» في الجنوب؛ قريتهم التي أُخْليت من سكانها، مثل قرى أخرى، تنفيذاً لقرار القيادة العراقية إخلاء القرى والبلدات القريبة من ساحات المواجهة بين الجيشين العراقي والإيراني.
وتتوجه أم قاسم وأبو قاسم المريض وأولادهما وأحفادهما وحميرهم شمالاً، لينتهي بهم الترحال في «الطرف الجنوبي لمقبرة النجف الكبرى» (12)، حيث يقررون الإقامة، ولكن بدون أبو قاسم الذي وافته المنية في اليوم الثالث من سفرهم، فدفنوه بين نخلتين على جانب الطريق الدولية عند «المشارف الشمالية لمدينة الناصرية» (11).
تقرر أم قاسم العودة إلى «السبيليات» مدفوعة بالحب والاشتياق والحنين إلى مسقط رأسها، وذكريات الطفولة والصبا وحياتها مع أبو قاسم، إذ لم تحتمل البقاء في الشمال لأنها كانت تحس بالاختناق في الغربة، و«غير قادرة على تقبل واقع بقائها حيث الزمن مفتوح لا نهاية له». وتنطلق في رحلتها بصحبة حمارهم «قدم خير». وبعد سير يومين، تصل إلى قبر أبو قاسم وتنبشه لنقل رفاته، لأنه صارحها في إحدى زياراته لها في حلم بعدم ارتياحه في قبره بأرض قفر، ولن تطيب له الإقامة إلاّ في السبيليات.
تلف أم قاسم رفات زوجها وتيمم و«قدم خير» صوب السبيليات. رحلة امرأة ورفات وحمار، عنوانها الوفاء والحب والحنين إلى المكان الأول.
الجثة وتلك الرائحة في «وشائج ماء»
بين حليمة وأبيها الولي علاقة قوية، جعلتها لا تفكر في دفنه في مقبرة، بعيداً عنها. فأمرت ابنتها أروى بألاّ تخبر أحداً عن موته. وبعد غسله وتكفينه، استعانت بمجموعة من العُمّال الأفارقة لحفر قبر في الفناء، مُدّعيةً وجود أوانٍ نادرة في أكياس الخيش التي غطت بها جثمان أبيها. إصرار مليحة على الاحتفاظ بجثة أبيها يشبه إلى حد ما رفض إميلي فكرة دفن أبيها، قبل إذعانها في النهاية لتهديد القساوسة والأطباء «باللجوء إلى القانون والقوة». ويبدو أن ما لم يتحقق لإميلي مع جثمان أبيها تحقق مع هومر بارون الذي قتلته واحتفظت بجثته وفعلت معها ما فعلت كما يشي منظر الجثة في السرير. لكن مليحة لا يوجد من يمنعها من دفن أبيها في البيت، رغم الأذى والمعاناة اللذين يسببهما ذلك لأفراد أسرتها.
يروي حفيدها أمين عن معاناته من العفونة المنبعثة من قبر جد أمه ويُعبِّر عن استغرابه من قدرة تحمل رئتي جدته لتلك الرائحة، فلم يرها تتأفف أبداً. وبسبب رائحة بيتهم النتنة انهالت السخرية على سمعة أمه، كما عانى من ابتعاد أقرانه عنه. وبلغت المعاناة ذروتها في تحمل عناء الارتحال من بيت لآخر بسبب تأذي وشكوى الجيران من الرائحة، ما جعله لا يشعر بعلاقة حميمية مع ستة من البيوت التي سكنوها. أما في السابع، فالقبر فقد رائحته الكريهة وأصبح مزاراً. يبدو أن مليحة تحقق لها ما تريد.
انتشار الرائحة في الفضاء والمكان نقطة التقاء أخرى لرواية خال وقصة فوكنر.
حاملة الجثة والمجنون
من الشمال جاءت المرأة حاملة الجثة، يقول السارد مستهلاً قصة تشي هويي. ثمة تباين وتناقض واضحان في الشكل والمظهر بين المرأة والجثة: المرأة بشعرها الأبيض ووجهها الذي نبتت فيه الأخاديد والتجاعيد وجسمها الموسّم بالجروح والرضوض، بينما تبدو الجثة مصقولة وبرّاقة، بملابس فاخرة وألوان لامعة وزركشة ذهبية، فكأنها (الجثة) تعرض ثراءها، حسب قوله. منظر لافت كفاية لجذب الأنظار وإثارة الأسئلة الفضولية. فتتغير هوية الجثة حسب السائل ونوع السؤال.
لا تتذكر المرأة متى بدأت تحمل الجثة، العبء الذي لا تستطيع المشي بدونه، أو لا تريد التخلص منه أو لا تقدر على ذلك لأنها جثة أحد أقاربها، كما تقول لسائليها وآخرهم المجنون. لكنها تظهر في النهاية مبتهجة، تغني مع المجنون احتفالاً بالتخلص من الجثة عندما أثار كلامه فضولها فالتفت للخلف، لأول مرة، بقامة منتصبة لتنظر إلى الجثة، فانزلقت الجثة عن ظهرها. كان المجنون قد قال لها إن الجثة «ربها» الذي على ظهرها، نبت عليه العشب وأزهر وأثمر فاكهة.
تتباين ارتباطات الشخصيات بالجثث أو الرفات من ناحية تأثيرها عليها أو على من حولها، أو في فهم القارئ لها
مدينة حمّالات الجثث
في قصتها «حاملات الجثث»، تدفع ج.ج. سلفرمان بالثيمة-الفكرة إلى مستوى عال من الغرابة والقبح، بتصوير مدينة كاملة، الإناث فيها يتوزعن في ثلاث فئات: النساء اللاتي أعفين من حمل الجثث المحنطة لكبر سنهن، والنساء اللائي على رأس العمل-الحمل، ومن يتنظرن التكليف بالحمل المفروض مجتمعياً. كان الأمرُ عادةً في البداية ثم أصبح قانوناً يُنفَّذُ كل عام بإقامة طقس لتكليف الفتيات عندما يبلغن سناً معيناً. أما الذكور، الأولاد، فمعفون من حمل الجثث. تقول الفتاة الساردة: «الأولاد لا يحصلون على جثث. يتجولون بدون أعباء، يتمتعون بالحرية لفعل كل ما يريدون». أما الفتيات فَيُلَقّنّ أنهن محظوظات لتعلم معنى الحياة، والنظر إلى الموت في عيونه، ولفهم التضحية بعمق. إن حمل الجثث سيجعلهن أفضل.
قبل طقوس التكليف، تتكرر ما تسميها الساردة «جائحة» الظهور والأذرع والسيقان والأعمدة الفقرية المكسورة عمداً للتهرب من حمل الجثث، أو الهروب، والأخير أحد الخيارات التي تفكر فيها الساردة. تنتهي القصة بدفنها جثة خالها توأم أمها، العبء الذي حملته شقيقته إلى أن لم تعد قادرة على حمله.
وينتهي عرض حكايات حاملات الجثث، بـ«بايليت» موريسون، المرأة بدون سُرّة، صاحبة الاسم الخارج من الكتاب المقدس، الحكواتية و«المركز الأخلاقي» في الرواية، وأشياء أخرى. كانت تعتقد أن الكيس الأخضر الذي تحمله، طول الوقت، يحوي عظام الرجل الأبيض، وآخرون يظنون أن فيه ذهباً، لتعلم، قبل مقتلها، أنها كانت تحمل عظام أبيها.
* ناقد وكاتب سعودي