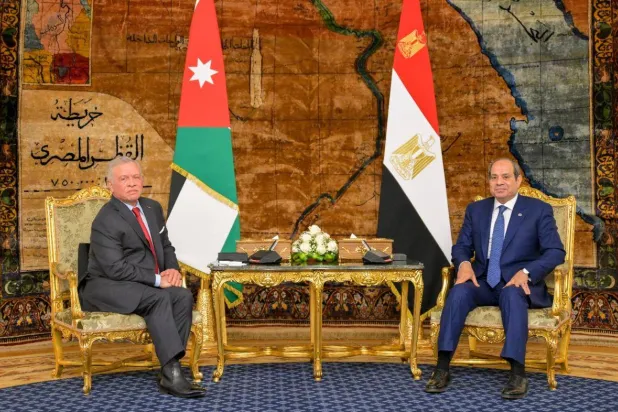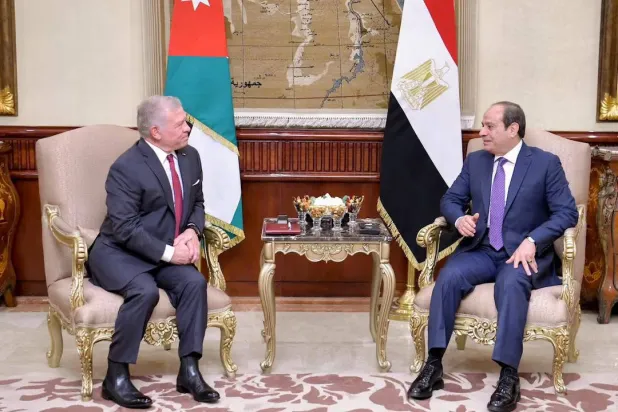تنّبه الأردن الرسمي مبكراً لمخاطر الحرب التي شنّتها إسرائيل على غزة بذريعة ما وصفته بـ«حق الدفاع عن النفس» بعد عملية «طوفان الأقصى». وفي حسابات الأردن الرسمي أن الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 15 ألف شهيد غزي نصفهم من الأطفال والنساء، هي حرب «ترويع» تهدف إلى تنفيذ مخططات «التهجير القسري» للسكان الأصليين، وإعادة بناء المعادلة الديمغرافية لصالح «يهودية الدولة» على حساب وجود «فلسطين الدولة»، واجتثاث خيار «حل الدولتين» من جذور مبادرات السلام. هذا الطرح لا يدعمه اليمين الإسرائيلي في دفع تهجير الغزيين إلى ناحية سيناء المصرية فقط، بل أيضاً هو خيار مطروح بقوة تجاه الدفع بسكان الضفة الغربية إلى تهجير آخر نحو الأردن، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء بشر الخصاونة طرحاً إسرائيلياً «يشكل تهديداً للأمن القومي الأردني، وهو بمثابة إعلان حرب على بلاده، باعتباره مساً مادياً لبنود من معاهدة السلام بين البلدين».
حتمية اشتداد الحرب على غزة، واحتمالات توسع نطاق الصراع الحالي في الأراضي الفلسطينية إلى الضفة الغربية، مخاوف أردنية حقيقية تتكشف مع التطورات اليومية؛ إذ تخشى عمّان من أن تكون أهداف تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء خيار «حل الدولتين»، وقطع الطريق على أي فرص لمفاوضات سياسية جادة تؤدي إلى إعلان قيام «الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس المحتلة»، في صميم ما تسعى تل أبيب لاستثماره في تصفية حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في غزة، وأيضاً تصفية أي حركة مقاومة في الضفة الغربية بعد حملة اعتقالات لنشطاء فلسطينيين تجاوزت ثلاثة آلاف معتقل، وأمام استشهاد أكثر من 300 فلسطيني في مدن عدة من الضفة.
موقف أردني حاسم
إزاء هذا الوضع، عبّرت السلطات الأردنية بقوة، وبتصريحات رسمية حادة، عن مواقفها، وفي رأسها رفض استهداف المدنيين في غزة، ورفض سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها إسرائيل، ورفض الحصار الجائر الذي قطع سلاسل الغذاء والدواء والوقود من الوصول إلى القطاع، وضرب المرافق الحيوية والبنى التحتية، ومنع الجرحى والمصابين والمرضى من حق العلاج بعد استهداف المستشفيات وقصفها، وكذلك ضرب المجمعات السكنية، وتوسع العدوان على مناطق في جنوب غزة بعد إفراغ شمالها من السكان. وبنظر الأردن، التأسيس لهُدن يومية لن يفضي بالضرورة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحتى اليوم لا تزال جهود الإغاثة وإيصال المساعدات إلى غزة أقل من المتطلبات اليومية للسكان الخارجين تواً من قصف استمر إلى نحو أكثر من 50 يوماً.

انقسام النخب حيال المصلحة الأردنية
اليوم، قد يصح الوصف بأن «سباق التعبير عن الغضب بين الجانب الرسمي والساحات الشعبية أردنياً» كان واضحاً حيال تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة. فقد عاشت الساحة الأردنية جملة من ردود الفعل بتصريحات رسمية «قاسية»، وبنبرة ملكية حادة، ومحاولات شعبية مستمرة لتنفيذ اعتصامات في محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان طمعاً بالوصول والاقتحام، ووسط ترحيب رسمي في توسع نطاق المظاهرات الشعبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وهنا تبرز أسئلة عن المخاوف من مستقبل الحرب الآنية ومدى اتساع نطاقها، متى يمكن أن تدخل الضفة الغربية رسمياً على خط تدهور الأوضاع وتطور الأحداث وصولاً لحرب مفتوحة، لا يمكن التقدير لمدى انتشار نيرانها وتوسع حلقاتها.
حقاً، لا يختلف المحللون على حقيقة أن هناك انقساماً حاداً في صفوف النخب الرسمية في تقييمها للموقف. وثمة مخاوف من أن تؤدي تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي، إلى رفع سقف طموحات الشارع الغاضب، لا سيما بعد وصفه لقانون معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية بأنها «وثيقة على رفٍّ يعلوها الغبار». ولقد جاء كلام الصفدي هذا في سياق إعلانه عن تجميد المفاوضات على اتفاقية تبادل المياه والكهرباء بين عمّان وتل أبيب، وبعد موقف الحكومة من استدعاء السفير الأردني من تل أبيب، والطلب بعدم عودة السفير الإسرائيلي إلى عمّان. وحسب مراقبين، تسبب هذا الأمر في فتح شهية المعارضة الإسلامية ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين - غير المرخصة - وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي»، وذراعها البرلمانية كتلة «تحالف الإصلاح الوطني»، تجاه تنفيذ ما صدر عن الصفدي من تصريحات.
الانقسام في صفوف النخب توزّع على موقفين:
الموقف الأول، يجد أن الصفدي، الذي لا يغرد خارج السرب الملكي في مواقفه وتصريحاته، ربما استعجل في تنفيذ الخطة الرسمية في اتباع سياسة «التصعيد المتدرج» في المواقف؛ إذ وضع مركز القرار الرسمي جملة «جميع الخيارات مفتوحة» أمام سؤال: كيف سيتعامل الأردن مع العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة؟ وكيف سيواجه الأردن خطر حكومة نتنياهو وتهديداتها المستمرة لمستقبل السلام مع عمّان؟ ويتساءل أصحاب هذا الرأي عن ماهية الأوراق المتبقية في يد الأردن الرسمي في حال تطورت الأحداث واتسع نطاق الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، خاصة أن الصفدي لم يضع جدولاً زمنياً لتنفيذ خطة المواقف الرسمية، بل ترك الجدل المحلي خلف ظهره وهو جالس أمام شاشات شبكات البث التلفزيوني عربياً وأميركياً وأوروبياً، الأمر الذي تسبب في حالة ارتباك دفعت بمجاميع من السفارات الغربية في عمّان لزيارة وزارة الخارجية والاستفسار عن مضامين تصريحات الوزير والموقف الأردني.
الموقف الثاني، أيّد رفع سقف الغضب الأردني الرسمي تجاه إسرائيل، واعتبر أن تقدّم الموقف الرسمي أسهم في تهدئة غضب الشارع، مع أن احتواء أي تطور على المستوى الشعبي قد يخدم شعبية المعارضة الإسلامية، التي لا تزال على ارتباطها بحركة المقاومة الإسلامية «حماس». فقد طالبت قيادات «حمساوية» الأردنيين بالخروج إلى الشوارع تأييداً لموقف المقاومة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي، وهو ما دفع وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة لاتهام الدعوات بأنها «غير بريئة»، لأنها خصت الشارع الأردني دون غيره في الشارع العربي. وفي هذا الصف من النخب هناك مراكز دراسات وحلقات نقاشية تتردد عليها النخب التقليدية تطالب بتقييم الواقع الجديد باعتبار أن «انتصار (حماس)» في الحرب الأخيرة «كسر لهيبة الاستعراضات الإسرائيلية بالقوة وتحالفها مع الولايات المتحدة». والتقييم من وجهة نظر هؤلاء يتمثل في اعتبار ما سبق مصلحة أردنية عليا. ويضاف إلى ذلك «نجاح سكان غزة، في مقاومة خطة التهجير الثالث الذي تسعى إسرائيل لتنفيذه على مراحل»، في ظل ما تعده عمان تهديداً جاداً بهدف حل أزمة حكومة اليمين الإسرائيلية على حساب دول الجوار، ونجاح مخطط تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
ومن هؤلاء أيضاً من يرسم ملامح علاقة مختلفة جذرياً بين عمّان وتل أبيب بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) بدء معركة «طوفان الأقصى»، وقبل ذلك اليوم؛ إذ ضرب العدوان على غزة العلاقة بين الأردن وإسرائيل بشرخ لن يعالجه سوى مبادرة بحجم استئناف العملية السياسية، وضمانات توفر ظروفاً جادة للوصول لحل يُفضي لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وفق تصريحات متلاحقة لوزير الخارجية الأسبق وأول سفير أردني في تل أبيب بعد توقيع معاهدة السلام مروان المعشّر.

قراءات الخصاونة
التباين في تقييم النخب الرسمية للموقف الأردني سعى لحسمه رئيس الوزراء بشر الخصاونة في ظهورين إعلاميين. ولعله نجح في تقديم جملة من التعريفات والاستخلاصات المحددة للموقف الرسمي ومستويات التنفيذ وارتباطها بحجم التصعيد الإسرائيلي، في محاولة «عقلنة» تفسير السقف الرسمي والغضب على مستوى مراكز القرار. ومن جملة التعريفات التي وضعها الخصاونة كان مفهوم «إعلان الحرب»، فأوضح أن أي «خطة تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، هي بمثابة «إعلان الحرب» من الجانب الإسرائيلي على الأردن، بعد التعدي على قانون المعاهدة الذي يمنع أي مساعٍ إسرائيلية لتهجير قسري للسكان، بمعنى المس المادي بواحد من أهم بنود اتفاقية السلام المبرمة بين البلدين عام 1994.
وحول الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، ومع تأكيده تعليق المفاوضات على اتفاقية الماء والكهرباء، أشار رئيس الوزراء إلى أن اتفاقية الغاز لا تزال نافذة؛ لكونها اتفاقاً بين شركتين خاصتين، وأن تدفق الغاز مستمر، غير أنه شدد على تحوط المملكة ببدائل عن الغاز الإسرائيلي بعد السؤال عن جاهزية دولتين عربيتين لبيع الغاز للأردن، لافتاً إلى أن ذلك سيرتب كلفاً عالية على الموازنة، وسيزيد من نسب عجزها التي لا يمكن تغطيتها إلا برفع أسعار الطاقة وقتها.
أما حول العلاقة مع «حماس»، فتجنب الخصاونة التعليق مباشرة، لكنه أكد أن المملكة ملتزمة بقرار «قمة الرباط» عام 1974، القاضي بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ومخرجات «اتفاق أوسلو» المبرم عام 1993، ومرجعية تمثيل السلطة الوطنية الفلسطينية للقرار السياسي الفلسطيني. وهو ما يقضي حتماً بعدم التعامل مع أي فصيل سياسي أو عسكري خارج نطاق السلطة الفلسطينية.
المخاوف من أخطار وشيكة
في هذه الأثناء، تتعاظم المخاوف من الحرب وتقدمها في أي لحظة تجاه جنوب غزة أو إلى مناطق الضفة الغربية؛ إذ تدرك عمّان أن إسرائيل تُفرط باستخدام القوة، وتتوسّع في نطاق عدوانها مستهدفة المدنيين بقصد بث الذعر بينهم، ودفعهم باتجاه وحيد هو مغادرة غزة نحو مصر، أو الضفة الغربية باتجاه الأردن، ولا تستبعد دوائر قرار محلية أن تكون حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل هي صاحبة السبق في إشعال جبهة الضفة.
بالنسبة للأردن، هذا يعني حصول ثالث تهجير بحق الفلسطينيين بعد نكبة اللجوء عام 1948، ونكسة النزوح عام 1967. وهو مخطط تهجير جديد يُفرغ الأرض من سكانها الأصليين على حساب دول جوار، وطبعاً سيكون العبء الأكبر على حساب الأردن، الأمر الذي تعده عمّان «خطراً أمنياً كبيراً؛ من جهة ينجح اليمين الإسرائيلي في تحقيق غايته في تفريغ الأرض، ومن جهة أخرى يعود شبح خطة (الوطن البديل) للفلسطينيين، خصوصاً في ظل معادلة ديمغرافية أردنية يمثل الفلسطينيون طرفاً ثابتاً فيها بوصفها حملة أرقام وطنية».
وهكذا، أمام الأخطار المحدقة جاء إصرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في واحد من لقاءاته مع ساسة أردنيين بارزين، على رفض «أي تفكير في إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها»، مشدداً على أن «أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، هذا أمر مرفوض ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية»، كما شدد على أن «الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ستدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع».
أيضاً، يرفض الأردن الرسمي الفصل بين مصير غزة والضفة الغربية، ويعتبر أن أي «سيناريو» يتناول قضية غزة وحدها، خدمة لأهداف إسرائيلية، في حين ترفض المراجع السياسية في البلاد أي حديث يسوّق لـ«سيناريوهات» ما بعد الحرب في قطاع غزة، وترى أن ما يطرح في هذا السياق «غير واقعي ومرفوض ولا يتعامل معها الأردن».
وبالتالي، يمكن القول إن جوهر المخاوف الأردنية دفع الموقف الرسمي إلى الإعلان عن «خياراته المفتوحة» في مواجهة مخططات إسرائيلية نحو دفع المدنيين الفلسطينيين تجاه تهجير جديد. وفي ظل خصوصية العلاقة الأردنية الفلسطينية، وضع مركز القرار جملة «سيناريوهات» للتعامل مع هذا الخطر. وقال مصدر مطلع «الشرق الأوسط»، إن «ثمة إعداداً جيداً لضمان تقديم الدعم والمساعدة للفلسطينيين على أرضهم، كما أن هناك إعداداً جيداً يرسم تصورات عملية للتعامل مع إدارة المشاعر الوطنية في حال وجود تهديد تهجير حقيقي».
المعنى هنا هو: «إمساك العصا من المنتصف»، ضمن حتمية الحفاظ على المصالح الوطنية الأردنية، وإفشال أي مخطط إسرائيلي لتنفيذ تهجير فلسطيني ثالث، وتثبيت مبدأ منع تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين، وهذا مع رفض استقبال موجات جديدة من الفلسطينيين في المملكة. فهذا ليس أمراً يضر بمصالح الأردنيين فقط، بل يخدم الرواية الإسرائيلية في إحياء خططها لضم المزيد من الأرض، وإنجاح مخطط «الوطن البديل» للفلسطينيين خارج أرضهم التاريخية. وعطفاً على حديث المصدر، توجد مخاوف أردنية حقيقية من تفاقم أزمة السلطة الوطنية الفلسطينية وتزايد إحباط قادتها أمام «العجز الحاصل» في وقف العدوان على غزة وغياب آفاق التهدئة. ثم إن تقييم الهُدن بنظام «المياومة» سيبقيها تحت تأثير الهشاشة وعودة أصوات القصف والمدافع، في ظل الدعم الأميركي لإسرائيل، وتبني الرواية الإسرائيلية مهما كان حجم تجاهلها لمصالح السلطة.
تصريحات تعيد تعبئة الشارع
في أي حال، بدا لافتاً كلام العين خالد الكلالدة عندما نقل لـ«الشرق الأوسط»، أنه يدعم اليوم ويطالب من موقعه التشريعي بعودة تدريس «منهاج القضية الفلسطينية في المدارس الأردنية»، وعودة «التدريب العسكري لطلاب الجامعات الأردنية بوصفه جزءاً من النشاطات الطلابية المنهجية». وبرأيه أن مثل هذه السياسات من شأنها أن تبعث برسائل قلق لدولة الاحتلال، «فلا يجوز أن يُعاقب الأردن على اعتداله وسط جنون المنطقة وتفجر أزماتها».
في المقابل، دعت نخب تقليدية إلى «الإدراك المبكر لخطر وشيك». وحظيت تصريحات النائبين والوزيرين الأسبقين ممدوح العبادي وسمير الحباشنة والأكاديمي صبري ربيحات، بقبول شعبي واسع عندما طالبوا في مناسبات مختلفة بـ«تسليح الشعب الأردني»، وتهيئة الرأي العام «لمواجهة عسكرية محتملة مع إسرائيل التي لا تلتزم بقيم معاهدة السلام مع الأردن، بل إنها تحاول العبث بالمصالح العليا للدولة الأردنية، مستمرة في فرض حلول لأزمتها على حساب الاستقرار الوطني».
وهنا تعود الأزمة المحلية إلى السباق في مخاطبة الشارع المُلتهب، فالاعتدال ولغة التحليل الهادئ لأزمة ساخنة، قد لا يحققان - بالنسبة للبعض - الغاية منهما، على الرغم من إدراك مركز القرار بأن اتساع نطاق الحرب سيُجبر المملكة على مواجهات مفتوحة. وتلفت مصادر سياسية أردنية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن تهديدات ميليشيات إيران و«حزب الله» على الحدود الشمالية لا تزال قائمة، وكذلك الأنباء عن تحركات «الحشد الشيعي» العراقي بين الحدود الشرقية واتصاله البرّي مع حلفائه الإيرانيين في سوريا، وسط مستقبل مجهول تنتظره عمّان على حدودها الغربية مع دولة الاحتلال. الأردن: التأسيس لهُدن يومية في غزة لن يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار

تفهّم لرفع حدة التصريحات الأردنية
> وصف مصدر سياسي أردني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، التي أطلقها لحظة وصوله إلى إسرائيل في زيارته «التضامنية» بعد أيام من الحرب على غزة، بأنها «مخيبة للآمال»، وتابع: «كان حرياً بالقادة الأميركيين مراعاة حجم الحرج لحلفائهم بعد تلك التصريحات، التي دعمت الرواية الإسرائيلية المزعومة وقتلها للمدنيين بذريعة (محاربة الإرهاب والدفاع عن النفس)». وأمام ما تصفه المصادر الدبلوماسية الأردنية من «تفهم» أميركي لموقف عمّان الرسمي وظروفه المركبة، لا يخفي الأردن صدمته مما عدّه «تماهياً» أميركياً، و«انجرافاً» غير مبرّر وراء الأهداف الإسرائيلية، ودعماً لقرار تل أبيب، والهرولة وراء سردية «المسار الجديد لمكافحة الإرهاب، حتى تحت يافطة المظلومية الفلسطينية». وهنا لا تبدو عمّان الرسمية تقف في صف «حماس» المقاومة، لكنها لا تستطيع الصمت حيال معاقبة اعتدال السلطة الفلسطينية ومنح أوراق مضاعفة لنقيضها في «المقاومة المتصلة بأجندات وأطراف خارجية ولها مصالح متناقضة مع المصلحة الفلسطينية في الحرب الدائرة»، مما يهدد بترك المدنيين عرضة للاستهداف في حرب لا تبدو أنها ستتوقف قريباً، ويجعل خطر «التهجير» قائماً كـ«خطر وشيك».