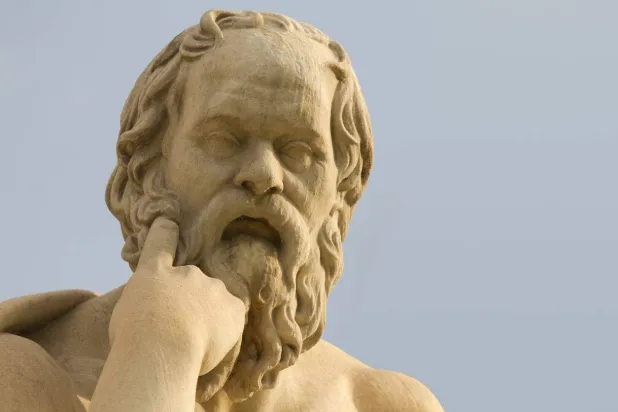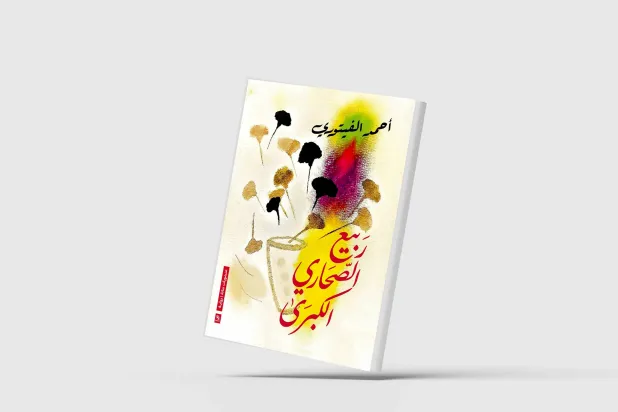يشكل عالم المقهى فضاءً جمالياً أثيراً في أعمال الفنان التشكيلي المصري عمر الفيومي، فلا يكف عن ملامسته والتحاور معه ومناجاته كأنه مخزن أسراره. فهو عالم مريح ينعكس في لوحاته بحيواته الإنسانية الدافقة، وبشره المفعمين بالونس والألفة. ويحرص الفيومي دائماً على إبراز حالة من التناظر الموسيقي بين مفردات هذا العالم والتي لا تتجاوز طاولة وبضعة كراسٍ، ومساحة من الفراغ الرخو، تظللها وجوه مسكونة ببهجة الفرح وبراءة الحزن ولهفة الترقب؛ وهو ما برز على نحو لافت في معرضه «وجوه ومقاهي» الذي استضافه أخيراً غاليري بيكاسو بالقاهرة.
في هذا المعرض يجدِّد الفيومي ولعه بعالمه الأثير، وبعاطفة بصرية هادئة يندمج في تفاصيله، يلتقط رائحته من ملامح الوجوه ومساقط النور والزوايا والظلال وكأنها مرايا متجاورة تنعكس عليها مرآته الخاصة. وفي كل هذا دائماً يحرص على نقطة ثبات جوهرية لا يغامر بالابتعاد عنها أو التمرد عليها، تتمثل هذه النقطة في تبسيط الشكل؛ وهو ما ينعكس تلقائياً على التكوين، حيث ينأى عن التعقيد والإيغال في الرموز والدلالات والعلامات؛ ومن ثم يرسم الشخوص بألوان زيتية - في الغالب - مسطحة وبسيطة تنعكس على الخلفية أيضاً، حيث يغمر اللونُ الصورة، وبمسحة من الفانتازيا يشدها إلى زوايا مباغتة موحداً الأعلى بالأسفل، والخلف بالأمام بعفوية بصرية سلسة لا عناء فيها.

بلغت هذه البساطة ذروتها الفنية بخاصة في اللوحة التي شكلت «بوستر» المعرض، حيث تطالعنا على أرضية المقهى مجموعات من البشر، تشي ملامحهم بأن ثمة حواراً لطيفاً وشجياً يسري فيما بينهم، بينما في الأعلى يطل عليهم ملاك في صورة إنسان، محلقاً بجناحيه في الفضاء، وتتسع دائرة التحليق، فنجد كرسياً طائراً أيضاً، بينما تتداعي صور البشر في الخلفية، وكأنها حلم يتراءى من بعيد، تظلله سماء المقهى في الداخل، والسماء ببراحها اللانهائي في الخارج.
يبدو كل هذا منسجما مع رؤية الفنان؛ فهو يرى أن اللوحة ابنة البشر والحياة، تنبع من خطاهم وهواجسهم وأحلامهم. وأن هذه النقطة هي رمانة ميزان تحفظ للصورة ألفتها على السطح وفي العمق، وفي الوقت نفسه، تكسبها مقدرة الانفتاح بحيوية على جغرافيا المقهى في الداخل والخارج. فالمقهى في اللوحات يبدو منفتحاً على الشارع، يطل عليه بأنفاس رواده، كما تنعكس عليه هواجسهم وهمساتهم، فهو دائماً مسكون بدبيب البشر وخطاهم اللاهثة في غبار الشارع والتي تتحول في اللوحات حالة لها رنين خاص، وذبذبة بصرية خاطفة وشيقة، تتضافر فيها أقصى لحظات النشوة والصمت. في خضم هذه النشوة نكتشف أن ثمة تبادل أدوار بين العالمين (المقهى والشارع)، كأن كليهما يفتش في الآخر عن لحظة من الأمان والحنان، مسروقة من جراب الزمن والواقع والحياة. هذا الهم الإنساني لا يأتي من فراغ، بخاصة إذا علمنا أن الفنان لا يرسم أي مقهى، إنما يرسم مقهى «الحرية»، الشهير بحي «باب اللوق» بوسط العاصمة، وهو أحد مقاهي القاهرة التي تتفرد بإرث خاص وعبق ضارب في التاريخ، ومكانة لدى قطاع كبير من الفنانين والشعراء والأدباء. ومن ثم يشكل المقهى، وعلى نحو خاص للفنان مساحة رحبة من النوستالجيا واللهفة للماضي، فضلاً عن كونه فضاءً جمالياً مفتوحاً على قوسي البدايات والنهايات.
تدفع الخلفية الأشكال في لوحات المعرض لتستوي في فضاء الصورة ببساطة وتلقائية، كما تُكسب إيقاع الخطوط حريةً في تنويع حركة الضوء والظل، ومن السمات الجمالية اللافتة هنا أن الصورة لا تخفي الشكل في داخلها، وإنما تحنو عليه وتحتويه، كأنه ثمرة من ثمرات الطفولة، طفولة المقهى والفنان معاً.
يكثف من أجواء هذا التنوع في المعرض حالة من التلاقح بين ثلاثة عوالم تشكيلية بينها ملامح مشتركة وعضوية، أولها عالم «البورتريه»، وهو عبارة عن صورة منفردة لامرأة أو رجل، لا تخلو منها معارض الفنان، ويهتم الفيومي في هذا العالم بالتعبير عن الوشائج التي تربط ملامح الشخصية بوعيها الظاهر والباطن، كما ينعكس على عين الفنان، ومدى قربه من الشخصية، سواء بشكل مباشر، أو عن طريق وسائط تلعب الذكريات فيها دوراً مهماً، يحاول الفنان أن تظل حاضرة في الرسم. وفي عالم الوجوه لا يكف عن اللعب مع نموذجه الأمثل المتمثل في «وجوه الفيوم» بسحرها الفني وألقها التاريخي المعروف، حريصاً على أن تتمتع الوجوه ببعض السمات الفرعونية، رغم حداثة الموضوع.
ويومض العالم الثالث بإيقاع المنظر الطبيعي، أو الحياة الساكنة، وهو الطابع الذي يسيطر على أجواء لوحات المقهى، فلا ضجر ولا صخب، بل عالم هادئ ومحايد، شديد الألفة والاعتيادية، هو ابن الطبيعة الإنسانية السمحة، بين جدرانه وعلى طاولاته تتخلص الوجوه من صلابة وجهامة الأشياء، وتلتقط أنفاسها بمحبة خالصة. ومن ثم يصبح الصمت إشارة وعلامة على حوار كتوم كامن في دواخل الشخوص، تخشى عليه من فوضى الخارج؛ لذلك تكتفي بالنظرة الخاطفة والإيماءة الشجية لبعضها بعضاً.

يرى الفنان أن اللوحة ابنة البشر والحياة تنبع من خطاهم وهواجسهم وأحلامهم
ينعكس هذا الصمت على صورة الكراسي الفارغة، ويطرح في الوقت نفسه سؤالاً ملحاً: ما الجديد هنا، ومفردة «الكرسي» متداولة في الفن التشكيلي، وأصبحت تيمة أساسية في منظور الرؤية لدى الكثير من الفنانين المؤسسين لتاريخ الفن في العالم. ومن أشهرها لوحة بيكاسو «حياة ساكنة مع كرسي خيزران» التي رسمها في عام 1912، وكان همّه معالجة تداعيات الأشياء في الصورة الساكنة بطرق فنية متنوعة، حتى باستخدام الخداع البصري، وحشو الصورة بأشياء متوهمة متخيلة، وعوضاً عن عدم استخدامه للون قام بلصق شرائح من القماش الزيتي، بطريقة الكولاج على مسطح الصورة، لتوهم بطبيعة النسيج المتغلغل لأعواد القصب في الكرسي. لقد أحدثت لوحة بيكاسو آنذاك ضجة في الأوساط الفنية، والبعض عدّها ثورة في الرسم، لكن سرعان ما انطفأ بريقها، وأصبح مجرد توثيق للحظة ابنة المغامرة الخلاقة في الفن.
على العكس من ذلك، يحافظ الفيومي على الطبيعة في قوامها الاجتماعي والإرث الشعبي للمنظر، شغوفاً بالأثر، ليس كحقيقة ماضوية، وإنما معاشة يمكن أن تمنحنا نفسها بشكل جديد. لذلك؛ يرسم الكرسي الخشب بسمته الشعبي المعروف، والذي بات مهدداً بالانقراض، مع طغيان الكراسي المصنوعة من البلاستيك، والألياف الصناعية. وهو الكرسي نفسه الذي لا يزال يجلس عليه بمقهاه المفضل، لقد أصبح وعاءً فنياً، يحفظ الكثير من خبرته البصرية ورهافته في التعامل مع الخامة والألوان والخطوط؛ لذلك يحافظ على معمار الكرسي، وقشرته البنية الخفيفة، ومسندة المقوس المريح، وينعكس هذا على الطاولة أيضا، بسطحها الرخامي الأملس وأرجلها الحديدية الصلبة، فيحرص على حيويتها حتى وهي شاغرة تنتظر القادمين، كما يحرص على انسيابية الألوان، فلا تتداخل في مساحات متناقضة ومتنافرة تشتت الصورة، إنما يؤكد دائماً على مصدرها الطبيعي، وأن الفن في المقهى هو تعبير حي، لا ينفصل عن حركة الحياة في الخارج.