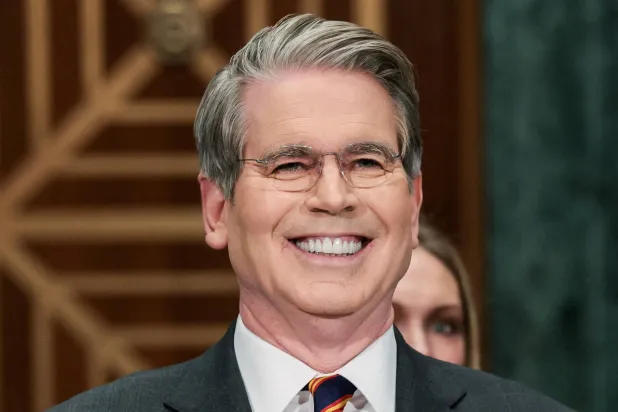تواجه الدول الأوروبية ظاهرة تضخّم ديونها السيادية في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة اتسمت بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتدني مستوى المعيشة، إذ بلغت معدلات التضخم في بعض الدول إلى 8 في المائة حسب إحصاءات «معهد أوروستا» لعام 2022. بعض الحكومات أخذت على محمل الجّد هذه المشكلة التي تهدد بزعزعة الثقة في «صلابتها» على مستوى الأسواق العالمية وإضعاف مكانتها على الساحة الدولية. وبضغط من بروكسل (أي المفوضية الأوروبية) شرعت الكثير من الحكومات الأوروبية في اتباع سياسات إصلاحية تقشفية بخفضها للميزانيات العمومية، وإعادة النظر في النفقات المخصّصة لقطاعي الصّحة والخدمات. ومن المنتظر أن تترك هذه الإجراءات آثارها على المستوى المعيشي للأوروبيين، بالأخص في الدول ذات الديون المرتفعة، وكذلك تعميق الخلاف بين «دول الشمال» الأوروبي «المقتصدة» و«دول الجنوب» التي تعتمد أكثر من غيرها على المساعدات الأوروبية. وعليه، يبقى مطروحاً السؤال: كيف ستتعامل كل حكومة مع تضخّم ديونها، بل والأهم... مَن سيدفع الفاتورة؟
في كتاب «الديون وصفة سحرية أم سم قاتل؟» (دار نشر تيليماك) للباحثة وخبيرة الديون آن لور كيشل، توضح كيشل فتقول إن «لجوء الدول الأوروبية للاستدانة ليس بالأمر الجديد، بل هو ميزة مشتركة عند الدول الغنية كالولايات المتحدة والصين. إلا أن اللافت للانتباه بالنسبة للديون الأوروبية هو نسبتها التي باتت في ارتفاع مستمر، والأهم تجاوزها الحاجز النفسي لـ100 في المائة من إجمالي الناتج الخام، وهو ما كان صعباً توقعه قبل الأزمة الصحية».
ولكن حتى الآن لا نستطيع وصف هذه الديون بـ«الخارجة عن السيطرة»، بل إن السؤال الذي يجب طرحه يتعلق باستعمالاتها، وبمعنى آخر التفريق بين الديون السيئة والديون الجيدة. وذلك لأن الأولى تُستعمَل في الإنفاق على المؤسسات العمومية، وقد تتحول إلى نقمة إذا ما تُركت تتراكم من دون التحكم فيها... أما الثانية فتستخدم للاستثمار في القطاعات الحيوية، لا سيما التكنولوجيا والتربية والتكوين، ولذا فهي مُحبذة، بل وضرورية من أجل تنمية اقتصاد الدول.
تخطي مستويات الأمان
كان «معهد أوروستا» قد نشر آخر حصيلة للديون الأوروبية، التي قدرها بـ13.300 مليار يورو، وهو ما يعادل 88 في المائة من نسبة الناتج المحلي لدول المجموعة. وعلى الرغم من أن البيانات الرسمية لعام 2022 كانت قد أظهرت تباطؤ وتيرة العجز المالي وانخفاض الديون الحكومية، فإنها تخطّت بالأساس مستويات الأمان، ووصلت إلى مناطق خطرة للغاية... حتى أصبحت مصدر قلق كبير لبروكسل التي تجد نفسها أمام معركة حقيقية لفرض تطبيق مقترحات خفض الدين، علماً بأن الدول الغنية لا تريد تحمل فواتير ثقيلة كما حدث في الماضي.
أيضاً، من المتوقّع أن ترفض عدة حكومات السياسات التقشفية ورفع الضرائب، لأن مثل هذه الإجراءات قد تثير غضب الشعوب، وتتسبب في اندلاع إضرابات واحتجاجات شعبية، وسيكون الوضع صعباً بشكل خاص على دول مثل إيطاليا واليونان والبرتغال. ومن جانبها، تنتقد حكومات اليمين واليمين المتطرف في أوروبا أيضاً تدخل بروكسل لمراقبة ميزانيتها وتعده مساساً بسيادتها. وهذا الأمر تشرحه الباحثة والخبيرة الفرنسية كيشيل بالقول إن «الدول التي تلجأ إلى الديون ستفقد لا محالة جانباً من سيادتها، والتجربة اليونانية خير دليل على ذلك. وما حدث مع الأرجنتين أيضاً، وكذلك فنزويلا، مثلاً، التي اضطرت من أجل الحصول على قروض تقديم ضمانات تمثلت في بيع 50 في المائة من أسهم شركتها النفطية لجهات أجنبية...».
أما جونتان ماري، الباحث ومؤلف كتاب «الدَّين العام، تقرير عن اقتصاد المواطن» (دار نشر لوسوي)، فيشرح بخصوص الديون الأوروبية: «علينا أن ننوّه أيضاً بالامتيازات التي حظيت بها هذه الدول من قبل الجهات الدائنة، والتي جعلتها لا تتردد في الاستفادة من هذه القروض... وهي الفوائد الضعيفة والآجال الطويلة وإمكانية الاقتراض بعملتها أي باليورو. إن رفض الاستفادة من هذه الامتيازات سيكون تصرفاً غير عقلاني مع منافسة الولايات المتحدة والصين اللّتين تلجآن إلى الديون بشكل مكثّف». وأردف ماري: «فرنسا، مثلاً، كانت تقترض بأقل من 1 في المائة، وقد استفادت من ذلك طويلاً. لكن الوضع أخذ في التغيّر، بما أن النسب ارتفعت إلى 3 في المائة بعدما أقدمت وكالة (فيتش) على خفض درجتها... ورغم ذلك فهي تبقى شروطاً مميّزة مقارنة بالدول الأفريقية التي تستدين بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 7 في المائة، بآجال قصيرة وبشروط قاسية».
«الرباعي المشاغب»

حقاً، مشكلة الديون الأوروبية تخصّ بعض الدول دون غيرها. فهناك من جهة «الدول المجتهدة» كألمانيا والنمسا والدنمارك ولوكسبورغ أو استونيا، وهي الدول «المُقتصِدة» التي تحترم توجيهات بروكسل بخصوص سياستها المالية. وفي المقابل، نجد الدول التي تعرف بـ«الرباعي المشاغب»، التي لم تنجح في تحقيق التعديلات الهيكلية الكافية التي تمُكنها من الامتثال إلى المبادئ التوجيهية لـ«معاهدة ماستريخت لعام 1992». وللعلم، تحّدُّ هذه المعاهدة من العجز الحكومي إلى 3 في المائة والدين العام إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بغية الحفاظ على سياسات مالية سليمة. وكان قد جرى تعليق هذه البنود إبان جائحة «كوفيد - 19» العالمية لتمكين الحكومات الأوروبية من التقاط أنفاسها.
غير أنه بعد انتهاء هذه الأزمة، خرجت الدول الأوروبية وهي مُثقلة بالديون أكثر من أي وقت مضى. وأربع منها تُسجل نسب مديونية تفوق الـ110 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وبنسبة 171.3 في المائة تعدّ اليونان أعلى هذه الدول مديونية، ولقد أخذت وضعيتها تسوء بعد الركود الاقتصادي الذي شهده العالم عقب الأزمة المالية عام 2008، إذ تراجعت معدلات النمو وتفاقم العجز المالي حتى تخلفت اليونان عام 2015 عن سداد ديونها.
كان تأخر اليونان عن دفع مبلغ 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي هو المرة الأولى التي تتخلف فيها دولة متقدمة عن دفع مثل هذه المبالغ في تاريخ الصندوق. وهنا نشير إلى أن الاتحاد الأوروبي تدخل عدة مرات لإنقاذ اليونان، وبمعية صندوق النقد الدولي صُرف نحو 100 مليار يورو مقابل تعهد حكومة أثينا برفع الضرائب واتخاذ إجراءات إصلاحية تقشفية. ولكن على الرغم من إعلان جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك، أن «اليونان تخطّت مرحلة خطيرة»، فإن الوضع خلق في نهاية المطاف أزمة ديون مستعصية عن الحل، أثبتتها القيود الاقتصادية والتخلف الهائل عن سداد ديون البلاد.
إيطاليا... قنبلة موقوتة؟

ومثل الدول الأخرى التي عرفت تضخّماً في مديونيتها إبان جائحة «كوفيد - 19»، فإن الوضعية في إيطاليا أصبحت مصدر قلق ليس فقط بسبب حجم الديون الضخم، ولكن أيضاً بسبب ارتفاع قيمة خدمة هذه الديون.
إذ يبلغ حجم الدَّين الإيطالي حالياً نحو 3 تريليونات دولار أميركي، أو ما يعادل نسبة 150 % من إجمالي الناتج المحلي الإيطالي. وحسب ليزلي ليبشتز، المدير السابق لمركز الدراسات الاقتصادية في صندوق النقد الدولي، «فإن الدَّين الإيطالي قد يهدد بوقوع أزمة مالية في منطقة اليورو»، لا سيما وأن إيطاليا تواجه أزمات جفاف غير مسبوقة، بالإضافة لارتفاع أسعار الطاقة ما يضعف الاقتصاد الإيطالي ويزيد من عجز الميزانية.
من ناحية أخرى، أرجعت تقارير أوروبية تضخم الديون الإيطالية بصفة خاصة إلى «سوء تسيير» المؤسسات العمومية، والدليل ما حدث للمنظومة الصحيّة في إقليم كالابريا (أقصى جنوب إيطاليا)، حيث وصل حجم الديون هناك إلى مليار يورو بسبب تبذير المال العام وتفشي الرشوة والبيروقراطية.
غير أن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والقيادية اليمينية المتطرفة، كانت قد انتقدت تدخل بروكسل بعد شراء البنك المركزي ديون إيطاليا الهشّة، ودعت إلى «تقليل اعتماد» بلادها على الدائنين الأجانب من خلال زيادة عدد الإيطاليين الذين يحملون أسهماً في الديون الإيطالية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا كانت قد بدأت في تأميم الديون منذ 2008، ونجحت في رفع النسبة إلى 13 في المائة. أما الهدف من ذلك فكان «تأميم الديون ضد الصدمات المالية الجديدة، والأهم تفادي التدخلات الأجنبية والحفاظ على سيادة البلاد».
في أي حال، إذا كانت أزمة الديون اليونانية قد هزّت الأسواق المالية العالمية في عام 2010، فمن المتوقع أن يكون للأزمة الإيطالية تأثيرها أيضاً، خصوصاً وأن حجمها الاقتصادي يمثل حوالي 10 أضعاف اقتصاد اليونان، وتمثل ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
ثم إن وجود حكومة يمينية متطرفة في إيطاليا من شأنه أن يعقد الأمور، في ظل الخلاف التقليدي بين «دول جنوب» أوروبا التي تعتمد على مساعدات الاتحاد الأوروبي، وبين الدول «المقتصِدة» في شمال القارة، كألمانيا وهولندا والنمسا، التي تطالب عادةً بضغط النفقات، خصوصاً ما يتعلق بدعم الدول الأوروبية الفقيرة في الشرق والجنوب، لكون «دول الشمال» هي التي تدفع دائماً التكلفة.
إسبانيا والبرتغال:
مساعٍ لخفض الديون

بعد إيطاليا تُعدّ البرتغال ثالث أكثر دول المجموعة الأوروبية مديونية بنسبة 113.9 في المائة من الناتج المحلي، وهي نسبة وصل إليها عام 2022 بعد جهود حثيثة بذلتها حكومة لشبونة لخفض الدين، ذلك أن النسبة كانت تفوق 135 في المائة عام 2020.
وكان وزير المالية البرتغالي فرناندو ميدينا قد أعلن خلال افتتاح مناقشة مجلس الوزراء لبرنامج «ميثاق الاستقرار الأوروبي 2022/2026»، أن هدف الحكومة «إخراج البلاد من دائرة الدول الأكثر مديونية والاقتراب من العتبة النفسية لـ100 في المائة من الناتج المحلي. ثم أضاف: «نحن نريد، ونستطيع، إخراج البرتغال من هذه الدائرة، ليس بحثاً عن أي مكافأة، بل لأنها أفضل وسيلة لحماية المؤسسات والعائلات البرتغالية...».
ومن ثم، نصل إلى المرتبة الرابعة. هنا نجد إسبانيا التي تمثل فيها الديون السيادية نسبة 3 من الناتج المحلي، أي ما يعادل حوالي 1500 مليار يورو لعام 2022. هذه النسبة، وإن كانت مرتفعة فهي في تراجع مستمر بعدما سجلت نسباً عالية إبان جائحة «كوفيد - 19» (125 في المائة)، علماً بأن إسبانيا كانت، بعد إيطاليا، أكثر الدول تضرراً من الجائحة، وارتفاع تكاليف المعيشة. بيد أنها بخلاف إيطاليا استطاعت أن تقف على رجليها من جديد، بعد اتخاذها عدة إجراءات لإنعاش اقتصادها عقب الركود الذي شهدته في تلك الفترة. وكان من أهم تلك الإجراءات: تنشيط القطاع السياحي، وعودة الاستثمار، والتحكم في معدلات التضخم.
لقد فاجأت إسبانيا الجميع حين أعلنت أن معدل النمو قد قفز عام 2022 إلى 5 في المائة. وهنأت نادية كالفينو، وزيرة الاقتصاد والصناعة، بلادها «التي أثبتت مرونة في مواجهة الرياح المعاكسة»، كما عبرت عن ارتياحها لأن نمو الاقتصاد الإسباني يفوق بشكل ملموس المعدل الأوروبي الذي تتوقعه بروكسل وهو 3.3 في المائة. والواقع أن الحكومة الإسبانية متفائلة بوضعها لدرجة إعلان رئيس حكومتها الاشتراكي بيدرو سانشيز، أن البلاد «وضعت نصب عينيها هدف النجاح في خفض نسبة المديونية إلى 112 في المائة من إجمالي الناتج الخام في أواخر 2023، ثم إلى 110 في المائة في 2024 إلى أن تصل إلى نسبة 109 في المائة مع مطلع عام 2025، كما تعهدت بذلك أمام شركائها الأوروبيين».
فرنسا: مقاومة الإصلاحات
على صعيد متصل، مثل باقي الدول التي اتخذت تدابير لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19» شهدت فرنسا انفجاراً تاريخياً لديونها وصلت حسب تقرير «أوروستا» إلى ثلاثة آلاف مليار يورو، أي ما يعادل نسبة 84 في المائة من ناتجها الإجمالي العام.
الأمر اللافت هنا هو السرعة التي تراكمت بها هذه الديون، ما جعل وكالة «فيتش» الدولية تقرر خفض التصنيف الائتماني لفرنسا كتحذير للحكومة، لا سيما وأن ميزانية البلاد لم تصل إلى وضعية توازن منذ 1975.
هذا، وسبق لوكالة «فيتش» أن أشارت في بيانها إلى أن «الجمود السياسي والاحتجاجات الشعبية (العنيفة أحياناً) يشكلان خطراً على البرنامج الإصلاحي للرئيس (إيمانويل) ماكرون». وكانت الحكومة الفرنسية قد صادقت في وقت سابق على مشروع تعديل المعاشات الذي ينّص على رفع السّ القانونية من 62 سنة إلى 64 سنة، واستناداً إلى المادة 49 - 3 من الدستور، جرى تبنّي النص من دون تصويت في البرلمان، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الاحتجاجات وأسابيع طويلة من المظاهرات وأحداث الشغب والتكسير.
ومع أن فرنسا تتمتع بثاني أكبر ثقل اقتصادي في أوروبا بعد ألمانيا، فإن الإنفاق على المؤسسات يشكل جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة، بالأخص نظام التقاعد الفرنسي. إذ يُصرَف على المتقاعدين سنوياً حوالي 340 مليار يورو ما يسبب عجزاً مالياً يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار يورو.
وبالمناسبة، كان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، قد قدّم خطة الحكومة لخفض الدَّين الوطني الفرنسي بأربع نقاط مئوية حتى عام 2027 من حوالي 112 في المائة إلى 108 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتمد الخطة على تخفيض النفقات واستبعاد أي خفض جديد للضرائب. لكن «ستاندارد آند بورز» - التي هي واحدة من ثلاث وكالات رئيسية للتصنيف الائتماني مع وكالتي «فيتش» و«موديز» - أبقت في الوقت نفسه على توقعاتها لآفاق «سلبية» ما يمكن أن يؤدي إلى خفض الدرجة في المستقبل. بل، وحذّرت الوكالة من «المخاطر» المتعلقة بتنفيذ أهداف الميزانية الحكومية. وأشارت من ثم، في هذا الإطار، إلى «غياب الأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي منذ منتصف 2022، ما قد يعرقل تنفيذ مخططات الحكومة. وبسبب تشديد شروط التمويل، يتطرق تقرير «ستاندارد آند بورز» أيضاً إلى «الانقسام السياسي» الذي يضفي حالة من اللا يقين على قدرة الحكومة على وضع سياسات تفضي إلى النمو الاقتصادي وإعادة التوازن الميزانية. وكانت «فيتش» قد خفّضت درجة فرنسا الشهر الماضي، معاقِبة بذلك باريس على إدارتها لمالية الدولة والأزمة الاجتماعية الأخيرة.
حقائق
ما هي الحلول الممكنة والمحتملة للأزمة؟
*من الواضح أن القواعد القديمة للتعامل مع مشكلة الديون أضحت بحاجة إلى تعديلات. ولذا تبنت المفوضية الأوروبية خطة لخفض الديون خلال العقدين المقبلين، لتبدو أكثر مرونة في التعامل مع هذه القضية الشائكة، بدلاً من انتهاج سياسات التقشف التي تثير الرأي العام في مثل هذه الظروف، حيث يواجه مواطنو معظم الدول ضغوطاً معيشية بفعل التضخم. ولكن على الرغم من هذه المرونة، يبدو أن خطط خفض الديون لن تمر من دون مواجهة مع الدول الأكثر مديونية، وفق خبراء اقتصاد.
المفوضية الأوروبية تحاول تطبيق سياسات اقتصادية مختلفة خلال العقدين المقبلين لتخفيف مُلزم لتلك الديون بمقدار 5 في المائة سنوياً للدولة التي يزيد فيها الدين عن النسبة المسموح بها والبالغة 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ولتجنب الفوضى وانهيار الاستقرار، تسعى المفوضية إلى خطط «موازنة وطنية» مُصممة لكل دولة على حدة. أي أنه لن يكون هناك تطبيق إلزامي على الجميع يتجاهل اعتبار خصوصية كل دولة، وهو ما يعني تغييراً جذرياً للنهج السابق لخفض الديون. وستستند المفوضية الأوروبية إلى مساعدة الدول على ضمان تحاشي زيادة الإنفاق الوطني أكثر من «النمو الطبيعي للاقتصاد».
وحتى لو كان العنوان التي ترفعه المفوضية «قواعد دين أبسط وشفافة وفعالة»، فإن بروكسل ستجد نفسها أمام معركة حقيقية لفرض تطبيق مقترحات خفض الدَّين، بخاصة أن الدول الغنية لا تريد تحمل فواتير أعلى مثل السابق. ولقد نقلت مصادر ألمانية عن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، قوله نهاية أبريل (نيسان)، إن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح، مضيفاً أنها تريد نظاماً يستند إلى قواعد ويؤدي إلى خفض «موثوق» في الديون.