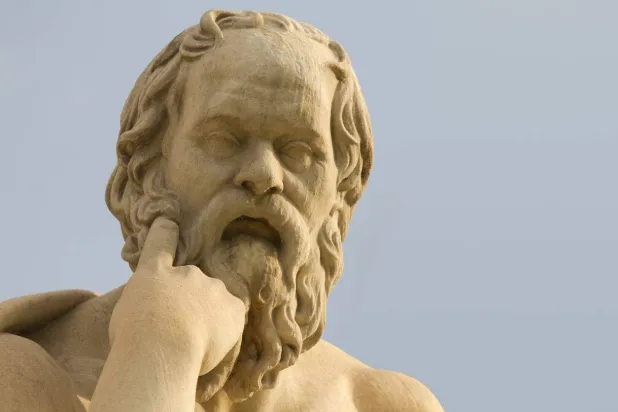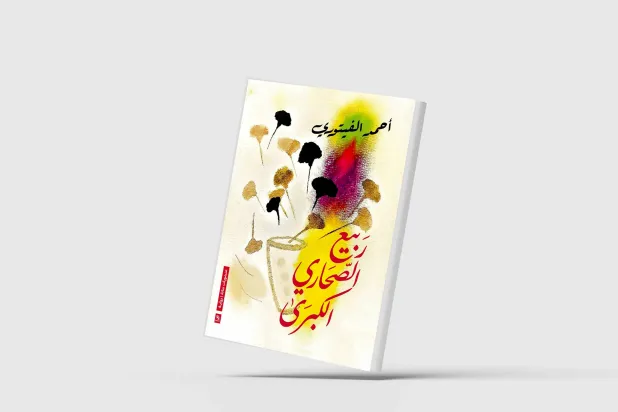من الصعب ألا يتوقف قارئ عربي عند عنوان قصة فرانتز كافكا «ثعالب وعرب»، ومن الصعب أيضاً ألا يقرأ العنوان، الذي يعرف أيضاً بـ«بنات آوى والعرب»، على أنه مؤشر واضح على إساءة للعرب بربطهم بالثعالب وبالمكر والخداع، النتيجة المنطقية للربط. ستفرض يهودية كافكا نفسها، لدى من يعرف انتماءه اليهودي، على أي تفسير للنص ابتداءً بالعنوان.
لكن القارئ سيفاجأ بأن النص السردي أو القصة القصيرة التي كتبها التشيكي اليهودي الشهير ليست كما يظن لأول وهلة. والحق أن من قرأ لكافكا غير هذه القصة يفترض به أن يتروى قبل إصدار حكم مسبق، فإن عُرف ذلك الكاتب الكبير بشيء أكثر من غيره فهو الطابع المحير لقصصه، تلك النصوص الملغزة التي لم يكتمل الكثير منها، والتي تأخذ القارئ حين تكون مكتملة في متاهات يصعب الخروج منها برؤية واضحة. ولا تكاد قصة «ثعالب وعرب» تخرج عن تلك المنظومة من التيه والحيرة وتعدد التفاسير تبعاً لذلك.
لكن القصة ليست أيضاً من مشهور كتابات كافكا، ولا هي بالتأكيد بين أفضل تلك الكتابات، لكن قد يكون عنوانها الإشكالي سبباً مضافاً لغيابها عن المختارات الشائعة من آداب العالم، الأدب الأوروبي تحديداً. ومع ذلك فالقصة ينتظمها ما ينتظم أعمال كافكا ليس من حيث الغموض أو طابع الأحجية الذي تتسم به فحسب، وإنما أيضاً من جانب أوسع هو انتماؤها إلى أدب أقلوي كان كافكا من أبرز كتّابه. السمة الأقلوية هي ما استرعى انتباه الفيلسوف الفرنسي غِل دولوز Deleuze وزميله في التأليف عالم النفس والمفكر الفرنسي الآخر فيلكس غطاري Guattari في دراستهما لكافكا من هذه الزاوية: «كافكا: نحو أدب أقلوي» (1975). يتحدث الكتاب عن سمات للأدب الأقلوي من أبرزها سعيه لما يسميه المؤلفان «اللاحدودية» أو «مقاومة الحدود» deterritorialization أي ما يحدث، حسب دولوز وغطاري، حين توظف أقلية إثنية أو لغوية لغة الأكثرية فتسعى إلى كسر طوق الهيمنة المحيطة بها، وتستقل بأدبها عن معطيات وآيديولوجيات تتسم بها ثقافة الأكثرية. الأقلية اليهودية في التشيك أحد الأمثلة، كما هم الكاتبان الآيرلنديان، بيكيت وجويس مثلاً، اللذان كتبا بالفرنسية (بيكيت) أو بالإنجليزية (جويس).

دولوز وغطاري معنيان بكافكا من هذه الزاوية، أي من حيث هو يكتب بالألمانية، وينتمي إلى أقلية غير ألمانية. لكن ماذا عن موقف كافكا من جماعته اليهودية؟ هذا السؤال هو الذي يقودنا إلى قصة العرب والثعالب.
يروي القصة رجل قادم من شمال أوروبا، كما يتضح تدريجياً، ويتضح أيضاً أن معه عربياً وأنهما ضمن قافلة توقفت في واحة، أي وسط الصحراء. قافلة قررت أن تقضي الليل في الواحة استعداداً لمواصلة الرحيل في الغد: «كنا نضع الرحال في الواحة. رفاقي كانوا نائمين. عربي، طويل وبلباس أبيض، مر من عندي. كان يراقب جماله وكان ذاهباً لمكان نومه». هكذا تبدأ القصة. الراوي في طريقه للنوم هو الآخر حين يسمع صوت الثعالب التي تقترب منه شيئاً فشيئاً إلى أن يأتي أحدها، الذي يبدو قائداً لها، فيتحدث مع الراوي. أجواء من الرعب الكافكوي بامتياز تمنح القصة بعداً رمزياً يدفعنا إلى البحث عن تفسير؛ لأننا ندرك أن الوضع غير واقعي ولا بد أن هناك مبرراً لوجود الثعالب أولاً ثم، وهذا هو الأهم، لقدرتها على الكلام. الأجواء الواقعية في الأسطر الأولى تتهشم بثعلب يقول للراوي إنه وجماعته من الثعالب ظلوا ينتظرون مجيء هذا الأوروبي الشمالي لأجيال لينقذهم من العرب. يقول إنه يخاف من العرب ويكرههم وإن على الراوي أيضاً أن ينتبه إلى أن أولئك العرب أهل عنف، فضلاً على أنهم كريهو السلوك والرائحة، لا يؤتمنون. ذلك على عكس أهل الشمال، كما يقول كبير الثعالب: «في الشمال هناك طريقة لفهم الأشياء لا يمكن العثور عليها هنا بين العرب. نتيجة لتعاليهم البارد لا يمكن لأحد أن يشعل فتيلاً من العقل. إنهم يقتلون الحيوانات ليأكلوها، ولا يأبهون بالجيف التي تترك لتعفن».
يستمر الحوار بين الراوي والثعلب ليتضح منه أن الثعالب تنتظر هذا الأوروبي المنقذ ليخلصهم من العرب، وذلك باستخدام مقص يسارعون بإحضاره لإتمام عملية القتل، لكن مطالبتهم الأوروبي أن ينقذهم تجري تحت ضغوط لا تخلو من عنف؛ فأحد الثعالب يضغط بفكيه على الأوروبي لكي يوافق. ثم يأتي العربي في اللحظة الحرجة ليكون المنقذ ليس للثعالب وإنما للأوروبي من الثعالب. وحين يعود ذلك العربي أو البدوي في الربع الأخير من القصة فإنه يؤكد للراوي أيضاً أنه على دراية بما قاله الثعلب؛ لأن ذلك يتكرر في كل مرة يأتي الأوروبيون إلى الصحراء، ثم يؤكد أيضاً أن العرب تعلموا كيف يتعاملون مع تلك الثعالب بالنظر إليهم مثل الكلاب: «إنهم كلابنا»، يقول. ثم يريه كيف يتغير سلوك الثعالب حين يرون جيفة لحيوان ميت وذلك برمي إحدى الجيف لجمل مات مؤخراً فيتكالب الثعالب عليه فيمزقونه ويلتهمون لحمه. وبذلك المنظر الدموي تقترب القصة من نهايتها، لكن ختامها عبارة للعربي: «سنتركهم لمهنتهم، لقد حان وقت الرحيل. لقد رأيتهم. مخلوقات رائعة، أليس كذلك؟ ويكرهوننا!».

بعض من تناولوا هذه القصة يرون أنها تقابل العرب بالمحافظين من اليهود، أي أن الثعالب هم اليهود، وهو تفسير مبني على موقف كافكا من الجماعة اليهودية في التشيك وكذلك من الصهيونية، ومعروف أن اليهود ودعاة الصهيونية حثوا كافكا على الرحيل إلى فلسطين وأنه رفض ذلك، مثلما رفض مثقفون يهود آخرون مثل فالتر بنيامين. كان كافكا منعزلاً عن الجميع كما هو معروف، لكن يبدو أنه كان يضيق بالجماعة اليهودية التي تلح عليه بآراء لا يتفق معهم فيها. والوضع ليس بالطبع خارجاً عن المألوف، فهو وضع اللانتماء الذي عرفه ويعرفه كثير من المثقفين الذين تنأى بهم آراؤهم عن المحيطين بهم. التاريخ مليء بأولئك وكذلك المجتمعات حيث كانت، لكن كافكا حالة متطرفة دون شك، فهو لم يكن كاتباً مبدعاً فقط. ظروف مرضه والإحباطات الكثيرة التي عرفها كانت كفيلة بمضاعفة العزلة التي أحاطت به.
من هنا يبدو أن الأقلوية ليست ما قد يحكم علاقة الجماعة القليلة والمختلفة بالأكثرية المحيطة بها، وإنما قد تكون حالة للفرد ضمن جماعته التي ينتمي إليها أو تحيط به وتشترك معه بخصائص تجعلها تتوقع منه الانسجام مع تطلعاتها. قبل كافكا كان سبينوزا في وضع أقلوي تجاه الجماعة اليهودية في هولندا، وقبل كافكا وإن بوقت قريب كان كارل ماركس في وضع أقلوي إزاء اليهود الألمان. تتحول الأقلوية إلى حالة، كما يقول دولوز وغطاري، خارج إطار الانتماء الإثني لتسم علاقة كل خروج على الجماعة. وفي تقديري أن وصف اليهود بالثعالب يحمل في تضاعيفه وصفاً لضعف الجماعات اليهودية واضطرارها للمكر كي تعيش في أوساط أوروبية مسيحية معادية. لكن لا بد أن كافكا أخذ في الاعتبار أيضاً حاجته للتواري عن تهمة الهجاء المباشر لجماعته.
لكن بعيداً عن الوضع الأقلوي، تطرح قصة كافكا علاقة اليهود بالأوروبيين على المستوى السياسي. إذا تبنينا التفسير الذي يربط الثعالب باليهود فإن وصف الأوروبي بالمنقذ ليس غريباً على الرؤية الصهيونية. إنه الأوروبي الذي أعطى وعد بلفور، والذي سيعين اليهود حيثما كانوا على الرحيل إلى فلسطين وإقامة الدولة اليهودية. الأدبيات الصهيونية ما بين الحربين وبعد الثانية تتكئ على أوروبا بوصفها الوسيلة الوحيدة لحل ما سمي بالمسألة اليهودية على النحو الذي يحقق الحلم الصهيوني، ويخلص الأوروبيين أيضاً من عبء الجماعات اليهودية المكروهة بصورة واسعة.
القصة ليست من مشهور كتابات كافكا ولا هي بالتأكيد بين أفضل تلك الكتابات، لكن قد يكون عنوانها الإشكالي سبباً مضافاً لغيابها عن المختارات الشائعة من آداب العالم، الأدب الأوروبي تحديداً