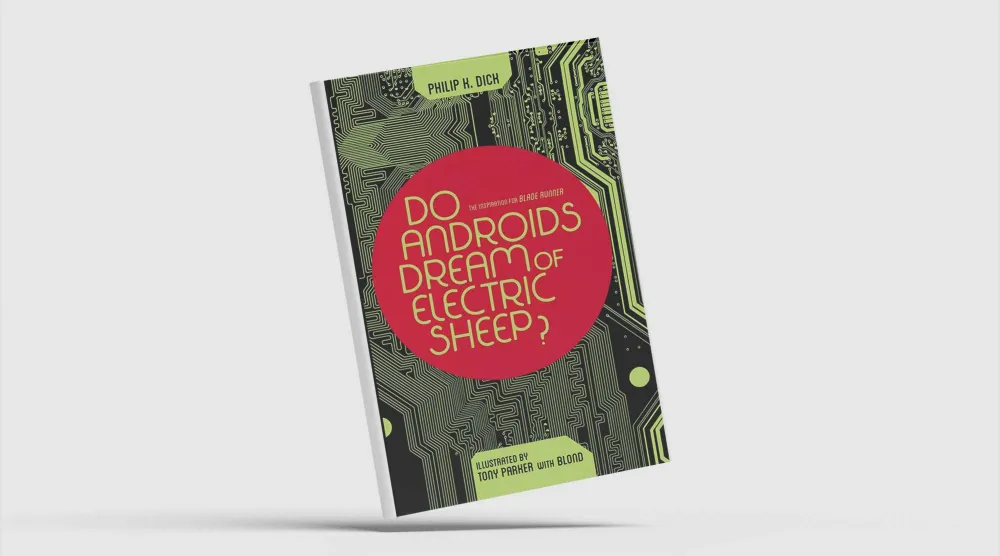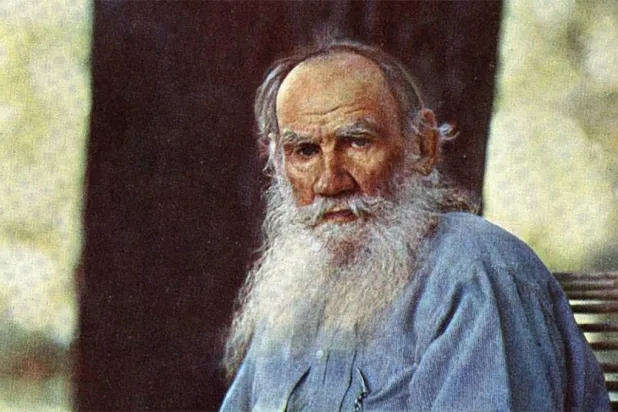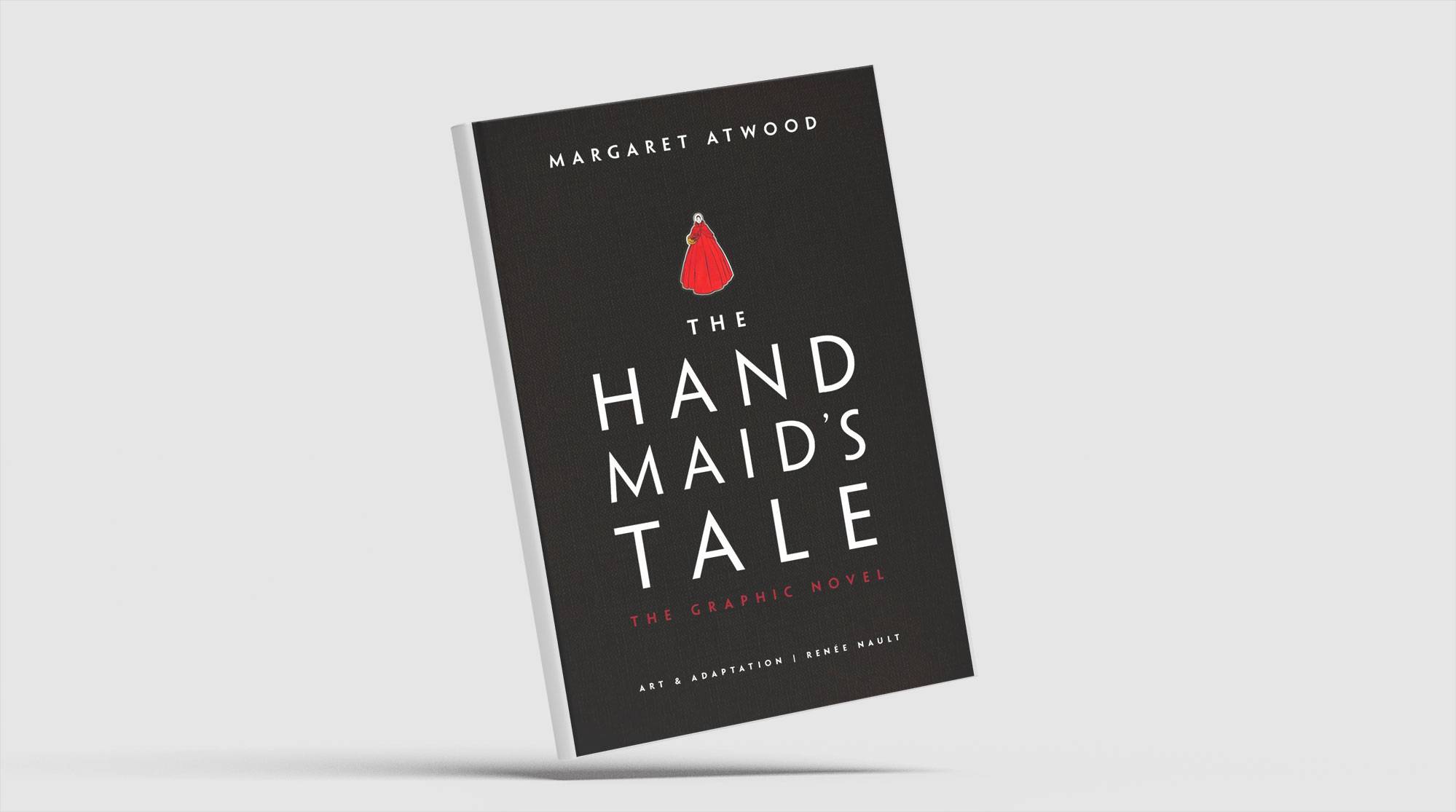يفرض القدر على بعض الشّعوب أن تعيش في عالم مقفل وبلا مخرج، ويظهر على الجميع عندها توقٌ إلى العيش في الماضي، لأنّه من المستحيل البقاء في القاع إلى الأبد. وعندما يكثر السّؤال وينعدم الجواب، لا يقدر غير الفنّ على تقديم الحلول. كلّ طَلَلٍ هو عمل فنّي لا يُملّ ولا تنفدُ طاقة الحياة فيه لأنّه حُمِّلَ بكلّ شذى الأيّام الغابرة، ويُعجب المرء به، ويتأمّله مثل أثَر مقدّس مصون في خزنة زجاجيّة. إنّ من يحاول العيش في ذكرى الأمس البعيد يفكّر في أمرين؛ الرّغبة في العزلة عن الحاضر، والتوق إلى التواصل مع الأسلاف، كما أنّ المستقبل لم يعد مغناطيسيّاً وجاذباً. بهذه الصّورة عبّر فلوبير عن انتقامه من العالم الذي كان يعيش فيه بكتابة رواية «صالامبو» وأقرّ بذلك بشكل عفويّ: «قليلون هم من سيكتشفون إلى أي حدّ ينبغي على المرء أن يكون حزيناً حتى يتكبّد عناء إحياء قرطاجة».
أوّل مرّة وقعت عيناي فيها على البحر كانت في «باكو»، وكان يفصله عنّي شارع عريض وشاطئٌ لم أتبيّنْه، ثم اتّجهتُ إليه وكان البرْجُ الشّهير باسم (قلعة الفتاة) يقع في طريقي، فاتّجهتُ بعيني بلهفة واحدة، نحو البرج وإلى جهة البحر، وصار منذ تلك السّاعة عندي مشهد الماضي معادلاً في موضوعه وفي شكله لرؤية البحر. سرتُ على الشّاطئ نحو نصف ساعة، عدتُ بعدها متعجّلاً لفحص القلعة شبراً شبراً، وكان الدّليل السياحي يشرح لي تفاصيلَ عن التاريخ وعن البناء والهندسة والحبّ والقهر والنصر في أنحاء البناء، وكذلك الهزيمة. وفي نهاية الزيارة كان عقلي ممتلئاً بأرقام السنين وبأسماء رجالات التاريخ، إلى أن تبخّر من مسام بدني كلّ ما رغبتُ فيه من حجارة البناء، ومن عطرها والحياة فيها، فرميتُ بنفسي نحو شاطئ البحر ثانية، وكنتُ أسير وأسير محاولاً نفض ما علق بي من مادّة مسمومة بعلم التاريخ الذي يكاد يتشابه في جميع جهات الأرض. ثم صار هذا الأمر من عوائدي التي لا أقبل بديلَها مهما كان السبب، كلما وجدتُ الحياة القديمة في طريقي صددتُ عن أي شيء تقوله كتب التاريخ، لأن ما أبتغيه هو الماضي وليس رجاله الذين صنعوا الحروب والهزائم والانتصارات الزّائفة.
تمثال الحجَر يبقى بعد زوال المدينة الحجر، ودليل السياحة في المكان القديم لا يقدّم للّزائر معلومة مفيدة، لأنّه يكْشط السّحر والفنّ عن الأثر القديم ويعيده إلى الواقع الحاضر، بينما يودّ بعضُنا أن يضحّي بسنينه على أن يحتويه دفء الماضي ورائحته، فتتغيّر عندها حياته وهو يتأمّل الحجارة خاشعاً. لقد احتوت أيّامه على أيّام وسنين وعقود جديدة، وهي وظيفة الفنّ الرئيسيّة؛ توسيع الحياة في جميع الجهات، عن طريق استرجاع واستحضار تجارب عاشها ناسٌ غيرنا، وانتقلت إلينا عن طريق سحر الفنّ، وهذا شرح لما تُدعى نظرية ادّخار الطاقة، أي نقلها من الماضي إلى أيامنا. دليل السياحة يشبه بحيرة سوداء تطمس فيها أقدامنا، تلوّثها بمعنى ما من آثار الحاضر، فتَعوق سيرَنا في الطّريق إلى اكتشاف الفنّ في التاريخ القديم وتاريخنا، والأمر هنا يشبه الفرق بين قراءة رواية «صالامبو»، أو كتاب علمي في التاريخ عن تلك الحقبة من الزمن.
كما لو أنّ للأحجار ذاكرة تحفظ الأحداث والأسماء، ولساناً ينطق وعيناً ترى وقلباً يخفق، والأرض التي تضمّ هذه الحجارة تختلف عن غيرها بالتأكيد. بهذه الصورة يخضع المكان القديم إلى ما يمكن أن ندعوه قانون الشعريّة، الذي يمنحه دثاراً حيّاً يملأ عين ساكنه دهشة، ويجعل ترابه يختلف ولون الماء الجاري، حتى الهواء كأنه مصنوع من مادة أكثر عذوبة. المكان بلا تاريخ شعري ليس مكاناً، بل هو قفْرٌ لا حياة فيه، ولا جماد، ويسري الأمر نفسه على المدينة التي نزورها وتلك التي نتخذها مثوى، بينما نجد المهندسين يصممون مدناً غريبة ويشقّون شوارعَ عريضة لا أوّل لها ولا آخر. لكنك تهجرها حتماً، ويقودك سيرك الحثيث إلى حيث تقع البلدة القديمة والسوق القديمة والناس العتيقون كأنهم أشباح تعيش في الماضي. هنا تنزلق بصمات الخلائق من على جدران المباني وسقوفها، وفيها كذلك مسحة من مشاعرهم، يذوبون فيها وتتعتّق مثل النبيذ بهم، ولا يسكن هذا الجزء من المدينة غودو وإخوانه، فهؤلاء يطلبون المدينة الحديثة، المتاهة الفارغة الصامتة، الخالية من أي نور للروح، محتَمين بأسوارها الزجاجيّة، منطوين على أسرارهم، ناطقين بلا شيء غير الكوابيس ورافضين أي فكرة للخلاص. هل يشبه هؤلاء قوم يأجوج ومأجوج، الذين حبسهم الإسكندر ذو القرنين ببناء سدّ منيع حولهم؟

يتجدّد في العاصمة بغداد في هذه السنين كل شيء، لكن نفسي بقيت مشدودة إلى الشّوارع القديمة والمقاهي القديمة والمطاعم. ليس في الأمر نوستالجيا مريضة تعشق كلّ ما في الماضي وتفضّله على الحاضر، لكنها رؤية شعريّة للوجود. اليوم ينتهي، الغد ينتهي لأنّه غير كائن، وحده الأمس لا ينتهي لأنّنا نعيشه في خيالنا، وكذلك في الواقع. الماضي مكتملٌ إذن ولهذا فهو من أعمال الفنّ، كما أن لفظة «الآن» غير حقيقيّة، لأنّ زمنها يمتدّ آلاف السّنين إلى الوراء، وبهذا يكون الماضي لا يزال حيّاً بالنّسبة إلينا، ولن ينتهي قَطُّ. عندما نقترب من المبنى القديم فإننا نعيش زمننا زائداً عقوداً تبلغ العشرات صارت ودَرَست، ولم تَمُت. يقول ميلان كونديرا: «إننا نعيش في الحاضر مغمَضي العيون ولن يمكننا أن نفهم ما نقع فيه من خيارات إلا عند انقضاء الحاضر، أي حينما يصبح ماضياً». الميّت هو الحاضر لأنه لا وجود له، ولأنه بلا خبرة مثل فرْخ غادر بيضَته في الحال، فلا يستطيع العيش وحده، وإن حاول جاهداً صارت عيشته من طينٍ غودويّ قاتم...
ثمّة نظريّة أميركيّة في فنّ العمارة تقول إن كلَّ جديد قبيحٌ حتماً، والمبنى الذي عمره نصف قرن وأكثر يكون باهي الصورة وإن كان دكّاناً مهجوراً في سوق الخردة. الجديد والمشغول بالمال الجديد، في أي مكان في الدنيا، ولأنه من صنع بني البشر، فهو مكانٌ عدمٌ يعيش فيه غودو وإخوانه، بينما مرّت على القديم يد الزمان - أي رسمته فرشاة لا تُقلّد ولا يكون لها بديل، ولهذا السبب تحرص الأمم المتحضّرة على الطريق القديم وغباره، وعلى الساحة القديمة تتردّد فيها أبواق القرون الغابرة، وعلى روح المباني بكلّ صورة، فلا يبدّل القائمون على فنّ العمارة ملّيمتراً من هذه التحف الأسطوريّة ثمناً بأعلى برج في مدينة جديدة تتآخى فيها الحداثة مع التطوّر.

قرأ يحيى حقّي مسرحيّة «في انتظار غودو» لصموئيل بيكيت مرات ولم يفهم، وأُصيب يوماً بحمّى شديدة وأتى على الكتاب بلهفة وأدرك معناه. سأتوقّف قليلاً مع هذه السخونة التي ألمّت بكاتبنا لأن عدم الكشف عنها ربما يصيب كلَّ ما قلته بالعطب. عندما يفقد المكان شعريَّته يتردّى ناسُه في صراع وجودي مع تناقضات لا تُحصى تزخر بها أرضُهم، كأنهم شخصيّات انفلتت من مسرحيّة بيكيت الشهيرة، دون هويّة واسم ووجه. في أرض غودو ثمة عدمية لا نهائيّة تتشرّب فيها الأشياء، وتسبب حمّى تلسع الجلد، وتهبط شيئاً فشيئاً إلى العظام، وهي ليست عرضاً من مرض بل هي جواب عن سؤال يبقى معلّقاً دون حلّ: كيف يمكن العيش في لا مُستقرّ؟ شعرية المكان إذن هي تعريف جديد للوطن، وحيثما عثرتَ على أرض فيها شعر فهي أرضك...
للكاتبة الأميركية ماري ليرنر قصة عنوانها «نفوس صغيرة» تصف فيها برجاً «أشبه بكتلة من التراب لأنه مبنيّ من الطابوق المفخور بالشمس الذي يثير سُمْكُه الدهشة، وبين كل 3 أو 4 أقدام طبقة من القصب. وأكثر ما لفت انتباهنا هي الطّراوة الغريبة للقصب، كأنه وُضِعَ قبل بضع سنوات فقط، مع أن أفضل الروايات تؤكد أنه بُنِي قبل أكثر من 4 آلاف سنة». شاهدتُ مثل هذا النوع من القصب في جدران زقورة عقرقوف، في المدينة التي تقع قرب بغداد، وكانت عاصمة للكيشيين في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وتلمّستْ يداي طراوتَه، وكان يبدو أكثر حقيقيّة من النّبات الحيّ. إن (عصب) الحياة في تلك الأزمان يشبه هذا القصب الذي لم يَمُت، لكنه تحمّل بحيوات مضاعفة عبر قرون من السنين، وصار كأنه خالد بهذه الواسطة.
ثمّة نظريّة أميركيّة في فنّ العمارة تقول إن كلَّ جديد قبيحٌ حتماً والمبنى الذي عمره نصف قرن وأكثر يكون باهيَ الصورة وإن كان دكّاناً مهجوراً في سوق الخردة
أختم الكلام بمشهد من حياة أغاثا كريستي مع زوجها عالِم الآثار ماكس مالوان، وكان يعمل في أحد التلال غرب نهر الفرات، وطلب منها أن تختار ثوباً ترتديه في ذلك اليوم، وكي يصفه لزوجته فإنه اختار استعارة من صميم عمله، فجاء وصفه آثاريّاً: «البسي تلك السترة الضاربة إلى الخضرة التي تحمل نقشاً معينيّاً على شكل تلّ (خلف)». قاطعته زوجته قائلة: «أتمنى عليك ألّا تستخدم لغة الحفريّات في وصف ثيابي». لقد اختار عالم الآثار في ساعة أن ينظر إلى الماضي بعين أديب شاعر، وهذا ما أرتئيه وأفضّله في كلّ مرة أقتربُ فيها من المبنى الجديد والقديم والأقدم. تمثال الحجر يبقى، والمدينة القديمة ليست سوى تمثالٍ كلّها من حجر، وإلّا ما سكنتها الأشباحُ وغيرُ الفانين من بني البشر.