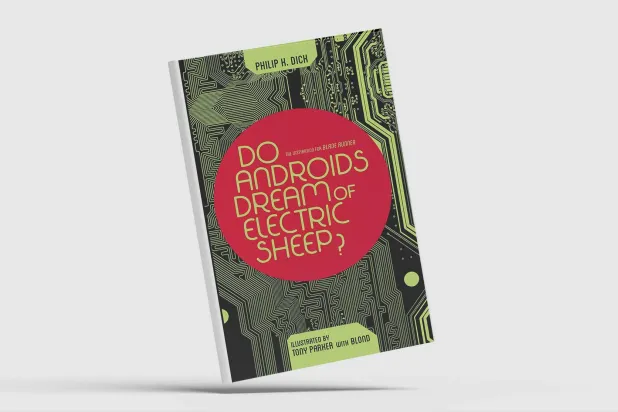في رواية «احتياج خاص» للكاتب الروائي المصري عمار علي حسن تبدو الأحلام بؤرة مركزية للسرد، بمفهومها المباشر كمرادف للمنام وما يراه النائم في منامه، ومفهومها الأبعد والأكثر شِعرية وهو ما يحلم الإنسان بتحقيقه، وغالباً ما يكون صعب المنال.
ويتناول الكاتب في روايته الصادرة حديثاً، عن «الدار المصرية اللبنانية»، ثيمة الأحلام من خلال قصة صداقة ذات ظروف استثنائية تربط بين بطليه (سمير عبيد) مدرس اللغة العربية، و(ممدوح علم الدين) الموظف في إدارة لتوزيع السلع الغذائية، وعلى الرغم من أن عمر تلك الصداقة لا يتجاوز أياماً معدودة، فإنها كانت قادرة على تغيير حياة مدرس اللغة العربية، مع اتساع فضوله للاقتراب من عالم ذلك الموظف البسيط حد الهوس بما يدور فيه، لا سيما تلك الأحلام التي يراها في منامه، التي تنفتح على عالم موازٍ للحياة «تكلم عن أحلامه، ليس على أنها مجرد منامات ليل تغيب أو تغيم أو تتشظى، أو تُلقى في غياهب النسيان فور صحوه، إنما على أنها حياة كاملة، فيها أكثر مما تمناه في طفولته، وفي صباه حين طاله الوعي».
يجتمع البطلان في لقائهما الأول في يوم من أيام ثورة يناير بميدان التحرير وسط العاصمة المصرية، يلتفت مدرس اللغة العربية إلى ممدوح علم الدين، الرجل النحيل الذي يسير بين الناس يحكي عن حُلم يراوده يراه في منامه كل ليلة، مجذوباً بحلمه حد لفت النظر، فيجد سمير عبيد لديه ما يستحق الإصغاء على هامش ما يحيط بهم من صخب وشعارات «كان يحكي حلمه للعابرين. بعضهم كان يهشه كذبابة، وبعضهم كان يستمع إليه قليلاً، ثم يمصمص شفتيه، ويتركه يكمل حكايته للأرصفة، وجدران البنايات. قلة تعجبت مما يقول، وظنت أنه وليّ».
يسعى عبيد لتوطيد علاقته بهذا الرجل الذي يحكي له عن حلمه المتتابع الذي ينتهي كل ليلة مع صحوه، ليتابعه الليلة التالية من حيث انتهى، حيث يعيش فيه حياة بديلة يلتقي، بحبيبة تبادله المحبة، ويعيش معها حياة رغيدة موازية يكون فيها أستاذاً جامعياً مرموقاً يُدرّس علم النفس.
تبدأ محنة هذا البطل مع بدء تلاشي هذا الحلم المتتابع، الذي يكف عن زيارته، فيفشل رغم محاولاته الضنينة القبض على أي بصيص لاستدعائه من جديد، ومع تلاشي هذا الحلم، يتلاشى ممدوح علم الدين من أرض الواقع ويختفي، فلا يجد له أحد أثراً، ويفشل صديقه سمير عبيد معلم اللغة العربية في العثور عليه من جديد.
وفي محض بحثه عن صديقه المختفي، يجد عبيد نفسه وقد استجمع ما لديه من بلاغة وطاقة سردية كامنة وراء وظيفته التقليدية معلماً للغة العربية بمدرسة ثانوية، ويبدأ في كتابة حكاية صاحبه «الغائب» التي صار ممتلئاً بها، وراح يفيض بها على الورق، في تجربة كتابة روائية هي الأولى له، يؤرقه كيفية بناء حكاية متماسكة عن حياة صديقه الغائب المتشظية ما بين كابوس هو حياته اليومية نفسها، ومنامات تُهديه حياةً بديلة، فيضع خطة للكتابة، راعى فيها أن يعرض العالمين المنفصلين تماماً لبطله «أحدهما أبيض في سواد الليل، والثاني أسود في بياض النهار».
وهكذا بدأ في الكتابة نصف للصحو ونصف للمنام، ثم يقرر أن يُطوّر سرده ويُقسمه إلى فصول متتالية على أوقات أو حالات خمس هي (ما قبل النوم ـ غشاوة ـ نوم ـ صحو ـ ما بعد الصحو) وتكون مرحلة الـ«غشاوة» هي تلك الحالة السرمدية ما بين المنام واليقظة، تلك التي يتخيّل فيها بطله وهو يغادر عالماً ليتسلمه عالم آخر بكل تناقضاتهما الجنونية، منذ أن يُخرجه خيط نور الصباح الذي يتفاداه خشية الاستيقاظ على كابوس صراخ ووعيد أهل البيت، وأهل الشارع، والعمل، الذين يتبارون في إشعاره بالدونية، ثم يحمل له الليل والنعاس أمل العودة لحياة تتبدل فيها ملابسه الرثة إلى ملابس نظيفة، وتتسع جدران شقته الصغيرة لتصير بيتاً فسيحاً يطل على أحواض الورود، لا شيء مشتركاً بين العالمين سوى اسمه، فهو الشخص نفسه، النحيل والممتلئ، الفقير حد الإعدام، والمستور حتى الثراء والرفاه، فزوجته المتسلطة في يومه وحبيبته الغيداء في حلمه تناديانه بالاسم نفسه (ممدوح علم الدين) «ويعود من حياته الأخرى، ليجد نفسه في الحياة الراهنة، الشخص الراقد في مخدعه لا يفصل بين شخصين يعيش فيهما سوى غمضة عين وانتباهتها، لحظة تنقله من موت صغير إلى حياته القاسية التي اعتادها».
وتواجهه خلال كتابته تلك الرواية عدة عثرات، أولها سد الفجوات التي لا يعرفها عن حياة بطله وصديقه الغائب التي لا يُحيط بكثير من أسرارها، فيتنقل بحثاً عن معلومات يستوفي بها المزيد عن حياة صديقه، التي يستخدمها في رسم شخصيته، لا سيما حول تاريخه الشخصي والأسري وسنوات شبابه الجامعي وصولاً لجلوسه خلف مكتب صدئ في وزارة التموين متمسكاً بنزاهته رغم عُسر حاله المادي، وصولاً لمعرفة ما إذا كان صاحبه مريضاً بالفصام وإذا كان هذا الحُلم أحد أعراض مرض يُعاني منه.
أما العقبة الأخرى في كتابة روايته كانت في التداخل بين العالمين، والعبور من حلقة إلى أخرى لإحكام تخييله المستوحى من سيرة صاحبه مُوزعاً بين صحوه ومنامه «كانت الخواطر التي راحت تنهمر في نفسي، والأفكار التي تدفقت على رأسي، جعلتني متحيراً بعد أن اختلط الحلم بالصحو، وتقاربت المسافات بينهما إلى درجة جعلتني مدركاً الصعوبة التي سأواجهها في الفصل بين الحالتين».
إن الكتابة عن صديق «غائب» ليست فقط استدعاءً لحضوره الخاص، إنما «احتياج» لمواصلة حُلم تسرّب بين صحو حياة ومناماتها، واقتفاء لوصيّة صاحبه الأخيرة التي أطلقها في لقائهما الأخير قبل اختفائه: «امضِ خلف حلمك مبصراً، ولا تسأل أحداً».