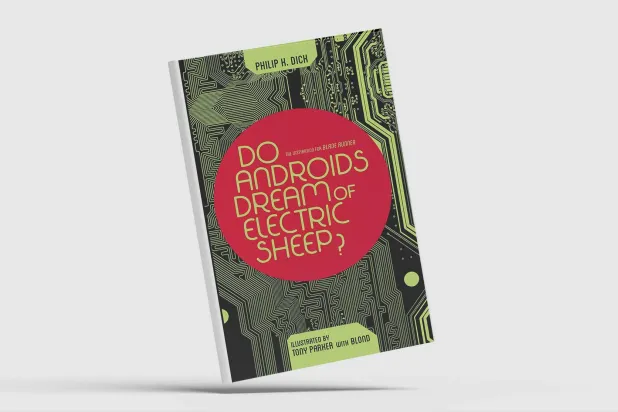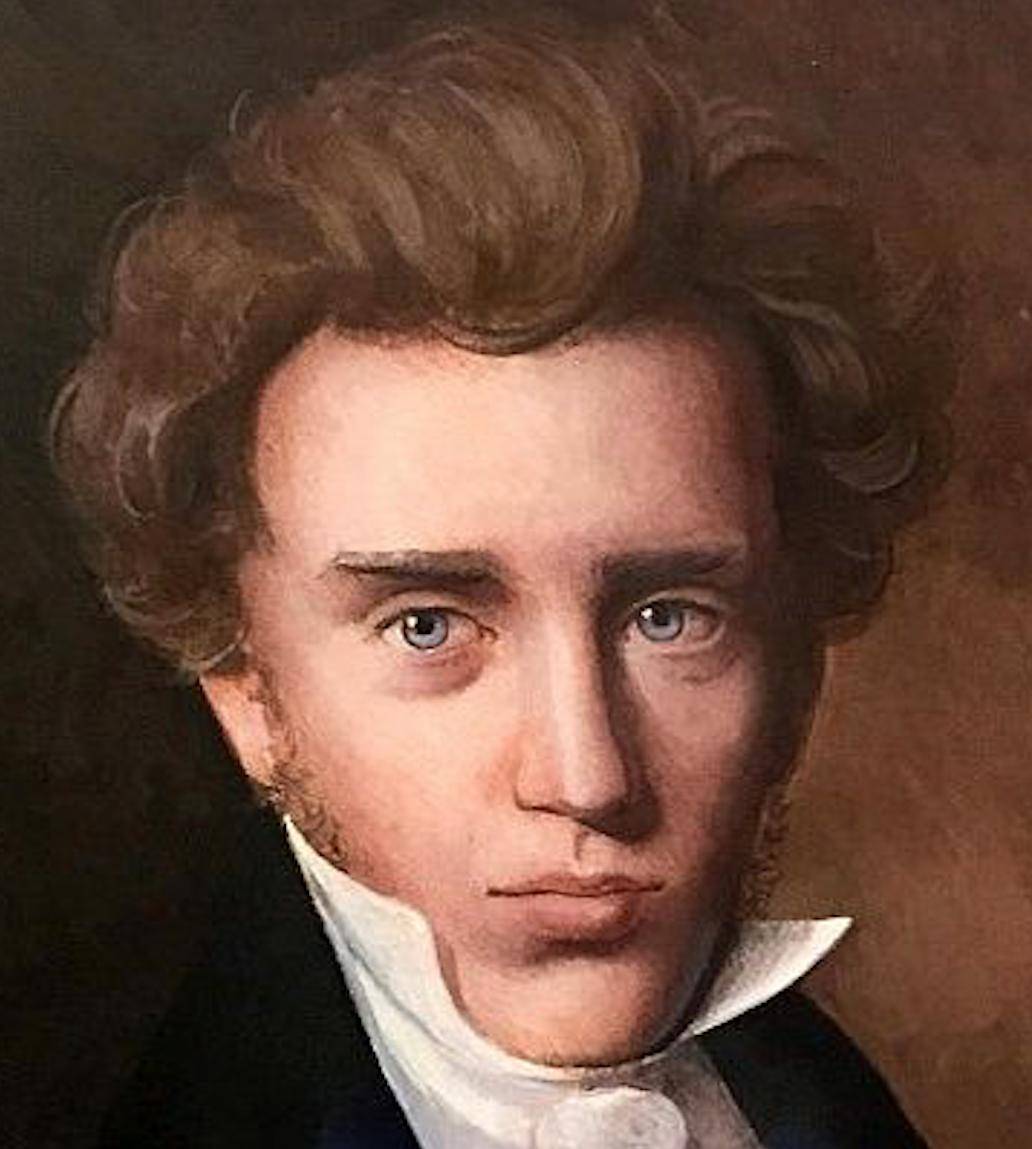الدكتور فوزي البدوي، أستاذ الدراسات اليهودية ومقارنة الأديان بكليّة الآداب والفنون والإنسانيات في تونس، وعضو المجمع التونسي للآداب والعلوم والفنون (بيت الحكمة)، ومدير مجلة معهد الآداب العربية، وعضو مجلة حوليات الجامعة التونسية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، لديه عدد من الكتب والدراسات والأبحاث في علم الأديان والفنون والإنسانيات، من بينها كتابه المهم: «الجدل الإسلامي اليهودي»، وبحثه المعنون: «نبي الإسلام في مرآة اليهودية»، كما ترجم دراسة المستشرق البريطاني روبرت سيرجنت «العهود مع يهود يثرب وتحريم جوفها».
بمناسبة حضوره ومشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب، أجرت «الشرق الأوسط» معه الحوار التالي:
- صلة المشرق بالمغرب
> تشارك في فعاليتين خاصتين ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب. هل توضح لنا طبيعة هاتين المشاركتين؟
- مشاركتي في معرض الرياض هي تلبية لدعوة كريمة من إدارته، للحديث فيما اعتبره جزءاً من شواغلي الأكاديمية، وهو باب ترجمة النصوص الدينية، ضمن شاغل أعم، هو دورها في عملية المثاقفة بين الحضارات والأديان والقول الفلسفي في الحوار الثقافي المعاصر. وسوف أتحدث من خلال نماذج عن أهمية ترجمة أهم الآثار اللاهوتية في العصر الحديث، فيما تعرف بديانات الكتاب في مجالات اللاهوت، وفلسفة الدين، وتاريخ الأديان، وتأثيرها المنتظر والمرجو في عملية تجديد الفكر الإسلامي. هذا لأني أعتبر مشكلات الأديان في العصر الحديث متشابهة، وإن اختلفت الخصوصيات. ومثلما انشغل أجدادنا باستلهام الفكر اليوناني في تأسيس علوم الإسلام وضبطها، فإنّ المطلوب اليوم هو عدم الانغلاق، وربط الصلة من جديد بسُنة استنَّها أسلافنا. وسأخصص حيزاً لبيان أهمية دور الجامعات ومراكز الترجمة ومراكز الأبحاث في تحقيق هذه الغاية.
> كيف تجد الاحتفاء بالفكر والثقافة التونسية في معرض الرياض الدولي للكتاب؟
- معرض الرياض هو مناسبة مهمة جداً للتعريف بالفكر والثقافة في تونس، وربط الصلة بين المشرق والغرب الإسلامي، كما كانت تسميه المصادر القديمة. ومن المهم أن يطَّلع القارئ العربي والإسلامي من خلال هذا المعرض على إسهامات التونسيين في مجالات الفكر الإسلامي والترجمة، والأدب قصة ومسرحاً وشعراً، والفنون بشكل عام. ومن المهم أن يضع القارئ العربي في الحسبان أن تونس كانت إلى جانب لبنان ومصر موطن ما عرفت بالنهضة العربية في القرن التاسع عشر التي ساهمت في تجديد اللغة العربية والفكر السياسي والاجتماعي. فقد ساهم جامع الزيتونة من خلال أعلامه الكبار في دفع الإسلام إلى مواجهة العالم الحديث، من خلال تطوير الفكر المقاصدي علي يد العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور، صاحب التفسير الشهير، والتنبيه إلى إصلاح التعليم الديني في كتابه «أليس الصبح بقريب»، علاوة على مساهمة الحركة الإصلاحية التونسية في قضايا تعليم المرأة وحريتها. وقدمت تونس للعالم العربي نصوصاً بالغة الأهمية علي يد المصلح الطاهر الحداد، لتلتقي بحركة الإصلاح المصرية والشامية. كما قدمت الشابي في مجال الشعر، وصولاً إلى ما تشهده تونس اليوم من ظهور روائيين كبار من الجنسين، تشهد الجوائز الكبرى التي يحصلون عليها على حيوية هذا الفكر في هذه الرقعة المهمة من العالم العربي الإسلامي. ولا شك أن لدى المركز التونسي للترجمة، والمجمع التونسي للآداب والفنون (بيت الحكمة) والجامعات التونسية، ومختلف دور النشر الحية، ما يقدمونه للإنسان العربي المهتم. والمملكة العربية السعودية باستضافتها تونس، وتنزيلها المنزلة التي تستحق باعتبارها «ضيف شرف» إنما تأتي فعلاً كريماً، وتعبر عن صداقة كبيرة ومتينة ممتدة، منذ الزعيمين الراحلين: الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، والحبيب بورقيبة، اللذين كان لقاؤهما التاريخي سنة 1951 فاتحة علاقات ثرية ومستمرة.
- الدراسات اليهودية
> أنت أستاذ الدراسات اليهودية في الجامعة التونسية، ولك مساهمات فكرية عبر المؤلفات والكتابات والمقابلات، للدعوة إلى قراءة التيارات اليهودية وفهمها. ما هدف هذه القراءة؟
- فعلاً، أنا موكل باليهود واليهودية، أتتبع دراستها منذ زمن. وهذا الشغف بدأ من سنوات الشباب وامتد بعد ذلك إلى الجامعة، وما كان مجرد ولع صار مسألة خاضعة للشروط والضوابط الأكاديمية. والحقيقة أن الاهتمام باليهودية لا يحتاج إلى كبير تبرير؛ فالدواعي لا تخفى على أحد، فهي دينية وتاريخية ولغوية وسياسية بطبيعة الحال. ففيما يتعلق بالمسائل الدينية يعرف الجميع أن جزءاً كبيراً من التاريخ الإسلامي ونشأة الإسلام وظهور القرآن، مما له صلة باليهود واليهودية، وهو ما بينته في أكثر من مناسبة وفق مقاربة جديدة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى صلات النحو العبري والنحو العربي منذ أيام مروان بن جناح وسعديا الفيومي ويهودا حيوج.
أما في السياسة فالأمر لا يحتاج إلى فضل بيان، فنشأة الكيان الصهيوني ومن قبل الحركة الصهيونية احتاجت وتحتاج من العرب والمسلمين فهم هذه المستجدات، فهي ستظل تؤثر في تاريخ العرب الحديث وبقوة، وما لم يفهم العرب جيّداً وبطريقة علمية ما الذي حدث فإنهم لن يستطيعوا الإجابة عن كل التحديات الآنية والقادمة، والتي أزعم أنها خطيرة العواقب على وجودهم.
* هل لهذا السبب دعوتَ لتأسيس مراكز أبحاث في الدراسات اليهودية؟
- الحقيقة أني دعوت منذ سنوات طويلة، ولكني لم أفلح حتى اليوم، في أن ألفت النظر إلى ضرورة الإنفاق على تأسيس مراكز بحث حقيقية في الشؤون الإسرائيلية، وتخصص الدراسات اليهودية في الجامعات، وفق أفضل المعايير الدولية. وقد سعيت إلى فعل ذلك في تونس منذ بداية التسعينات، ولكني صرفت النظر تماماً عن الموضوع لكثرة العوائق، لأتفرغ إلى التدريس الجامعي، آملاً في تكوين جيل قد يتحمل المسؤوليات في المستقبل عندما تنضج العقليات، ولتكون للسياسيين الجرأة على فهم أن مكمن القوة هو المعرفة، وأن إسرائيل لا يمكن مواجهتها بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة، كما يقول نزار قباني في «هوامش على دفتر النكسة».
> وهل ثمة منهج تقترحه؟
- في قضية المنهج، الأمر ليس معقداً؛ إذ يكفي امتلاك مناهج المعرفة التاريخية والفلسفية والدينية الحديثة في الوصف والتحليل والتوقع، والابتعاد قدر الإمكان عن العاطفيات، والاستعداد لتحمل كل التبعات التي يؤدي إليها البحث الحر، وهو ليس بالأمر الهين ولا المتوفر دوماً في عموم العالم العربي. وقبل هذا وبعده، يجب أن يتوفر القرار السياسي الذي يعتبر اليهودية والصهيونية وإسرائيل مسائل فائقة الأهمية، وتحتاج إلى أن توفر لها الدول العربية المال والكفاءات ومناخ الحرية الأكاديمية للعمل والإنتاج، إنارةً للقرار السياسي. وهذا أحد أوجه الحاجة إلى تفادي هذا التقصير الذي أدى –ويؤدي- إلى وخيم العواقب على العرب في العصر الحديث.
> هل قصّر العرب في الاشتغال بفهم اليهودية؛ ثقافةً وفكراً ومجتمعاً، عبر تأسيس مراكز دراسات متخصصة؟ أنت أشرتَ -في عديد من مشاركاتك- إلى أن إسرائيل فيها أكثر من 35 مركزاً للدراسات العربية، بينما لا يوجد سوى ثلاثة أو أربعة مراكز في العالم العربي!
- نعم، العرب مقصرون في الاشتغال باليهودية ومتعلقاتها من كل النواحي. وعلى الرغم من أن الريادة في الاهتمام في هذا المجال كانت للمصريين ثم السوريين والعراقيين واللبنانيين والتحق بهم المغاربة، فإن المُطّلع يعرف حجم العوائق التي تعاني منها هذه الأقسام من جهة المكتبات والتمويل والنشر. وكثيراً ما يُنظر إلى منتسبيها وخريجيها على أنهم «طابور خامس»! وأتذكر دوماً الحرقة التي لازمت أحد كبار هذا التخصص، المرحوم رشاد الشامي الذي لم يفلح في تحقيق حلمه في تأسيس مركز بأتم معنى للكلمة في هذا المجال. ويبدو أنني أسير على خطاه في نفض اليد من أن تتكفل جهة سيادية وسياسية بأخذ الأمور مأخذ الجدّ؛ لأنه لا يمكن التعويل في مثل جسامة هذه المسائل على المبادرات الفردية التي تظل مطلوبة في كل الحالات، وهذه هي حال المراكز القليلة في العالم العربي المهتمة بهذا الشأن، وهي: «المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية» المعروف اختصاراً بـ«مدار»، ومركز «الزيتونة للدراسات والاستشارات»، إضافة إلى «مؤسسة الدراسات الفلسطينية»، و«مركز الأبحاث الفلسطيني» الذي ترأسه الراحل أنيس صايغ، وقد سرق شارون محتوياته أثناء مداهمته في اجتياح لبنان. هذا علاوة على «معهد البحوث والدراسات العربية» التابع للجامعة العربية، و«مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية».
وكما هو ملاحظ، فإنّ عدد هذه المراكز قليل جداً، مقارنة بحجم التحديات السياسية والفكرية التي يعانيها العالم العربي. وقد تأسس أهمها في فترة الستينات، حينما كانت هناك إرادة سياسية لمواجهة إسرائيل. ولا شك في أن عددها قليل جداً مقارنة بما تتوفر عليه إسرائيل من المراكز البحثية التي تهتم بالعالم العربي والإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. وهذا العدد الذي ذكرتُه في إحدى دراساتي إنما هو قديم جداً يعود إلى التسعينات، والواقع الحالي أكبر من هذا بكثير. وقد بينتُ في دراسة لي عن الجامعات الإسرائيلية وإنتاجاتها فيما يتعلق بالدراسات الإسلامية مثلاً، أن الأمر يبعث على الانشغال حقاً، فإسرائيل ليست قوية بصواريخها وأسلحتها وتكنولوجياتها فحسب؛ بل أيضاً بهذه الإرادة: إرادة المعرفة للعرب والمسلمين؛ معرفة تبذل لها الأموال وتكوّن الرجال، وهذا بلاغ للناس ولينذروا به.
> لماذا نحن بحاجة إلى دارسة اليهودية خصوصاً؟
- هذه الحاجة مُلحة وضرورية وعاجلة! وسأحدثك أولاً من الجانب الأكاديمي؛ فعندما أدرّس لطلبتي تاريخ اليهودية ديناً ولغة، فإنّ ما يتوفر لدي باللغة العربية لتقديمه لهم لا يقاس البتة بما هو متوفر في اللغات الأجنبية الأساسية، من جهة الكمّ والقيمة الأكاديمية. وهذا يحيل على توفر القادرين من الباحثين على بداية سدّ هذا الفراغ بشكل منظم ومؤسسي، ووفق خطة طويلة المدى، لتصبح اللغة العربية قادرة على توفير مادة محترمة وموثوقة من المعارف للأجيال القادمة، ولعموم الناس المتعطشين لهذه المعرفة؛ خصوصاً من الشباب.
> كيف يجب أن نقرأ اليهودية؟
- المواطن العربي اليوم تماماً كالباحث الشاب عندما يريد أن يدرس اليهودية، فهو ضحية لعدد من الأخطاء: أولها الثقافة الشعبية المتوارثة التي تجعلنا نفهم اليهودية من خلال الإسلام. وهذا خطأ فادح جداً، والمطلوب هو أن نفهم أولاً وقبل كل شيء اليهودية كما يفهمها معتنقوها، وأن نتحرر من الفهم الإسلامي لليهودية الذي قد يكون مطلوباً لاحقاً، ضمن منظور مقارني لا غير، أو للوقوف في وجه استراتيجيات للكتابة خطيرة، تنتشر في كثير من الجامعات أو المؤلفات أو الشبكات الغربية بالأساس، ولكن هذه مسألة ثانية في الترتيب. وقد ساهمت السياسة مع الأسف في فترة الستينات في تجهيل المواطن العربي باليهودية -على الرغم من بعض الجهد السليم- نتيجة خلط بين متطلبات المواجهة العسكرية والسياسية، ومتطلبات المعرفة وتحرير وعي المواطن العربي، وهو خلط ندفع ثمنه إلى اليوم. وتجربتي الشخصية في التعليم الجامعي جعلتني أصرف وقتاً ثميناً في بداية كل سنة أكاديمية، لتحرير عقول الطلبة من العوائق الفكرية والسياسية التي تمنع قيام معرفة أكاديمية سليمة، وخصوصاً تنظيف أدمغة الطلبة من الآثار المدمرة لانتشار أدبيات معاداة السامية البائسة المنتشرة في الأسواق، من نوع «بروتوكولات حكماء صهيون»، وكتاب «كفاحي»، و«الكنز المرصود في قواعد التلمود»، و«فطير صهيون» الذي يتحدث عن تهمة الدم التي لم يعرفها الإسلام إطلاقاً، وهلمّ جرّا، وهي أمور خطيرة جداً تحرّف المعرفة باليهودية، وتحرّف الصراع السياسي والعسكري، وتخدم الطرف المقابل أيّما خدمة، دعائياً وسياسياً.
- «الجدل الإسلامي اليهودي»
> لديك كتاب عن «الجدل الإسلامي اليهودي»، وأنت تُرجع هذا الجدل لمجموع النصوص التي تركها المسلمون حتى حدود القرن الـ16. ما طبيعة هذه النصوص؟ وماذا أسست في تكوين العلاقة بين الطرفين؟
- قضيت في الحقيقة نحو عقدين من الزمن لإعداد هذه الأطروحة، وكانت تسمى في تونس «دكتوراه الدولة»، وإنجازها هو الذي حملني على تحقيق حلم الطفولة في دراسة اللغة العبرية، في تحقيق لوصية الرسول الأكرم لزيد بن ثابت الأنصاري الذي أولى اهتماماً بالغاً بهذا، مع أنه كان أميّاً، ولم يكن محاطاً بمراكز للدراسات الاستراتيجية كما نقول اليوم (وأرجو أن تكون حاضرة في معرض الرياض إذا ما تم الانتهاء من المسائل الفنية)، وقد احتجت إلى اختصارها في مجلدين، بعد أن كانت في أربعة مجلدات، وقد توقفت عند القرن السادس عشر للميلاد أو العاشر للهجرة؛ لأن اهتمام المسلمين باليهودية من جهة التأليف والكتابة قد انتهى مع هذه الفترة، ولم نعد نعثر تقريباً على نصوص ذات بال. وعموماً فإنّ حقبة دخول العالم العربي وبعض الإسلامي تحت الحكم العثماني لم تؤدِّ إلى ظهور نصوص ذات بال، بالإضافة إلى أن القيمة المعرفية للكتابة حول اليهودية قد تضاءلت شيئاً فشيئاً، وغابت بعض مظاهر القوة في الردود التي تميزت بها نصوص القرن الرابع والخامس على وجه الخصوص، والنصوص الخالصة في الجدل لا تتجاوز السبعين بين مفقود ومطبوع ومخطوط، في حين أن النصوص اليهودية في الرد على المسلمين لا تتجاوز أصابع اليد، وهو عدد ضئيل جداً إذا ما قورن بالجدل الإسلامي المسيحي الذي كان أكثر أهمية وعمقاً. وقد سعيت في الحقيقة من خلال هذا العمل إلى سد الفراغ في هذا الاهتمام، بعد أن تم الاشتغال من قبل باحثين آخرين بالجدل المسيحي الإسلامي والإسلامي المسيحي، فقمت بدوري بسد هذا الفراغ من الجانبين، وباللغتين، بعد أن كانت هناك دراسات جزئية مبثوثة هنا وهناك.
> تقول إن الجدل الإسلامي اليهودي يعود لمجموع النصوص التي تركها المسلمون حتى حدود القرن 16؛ لكن الجدل يتخذ اليوم شكل الصراع. وسط الاشتباك الحضاري والسياسي، هل تغيرت غايات هذا الجدل؟
- كان أحد أهداف اهتمامي بهذا الموضوع هو إفهام مسلمي اليوم أن الصراع الحالي هو صراع جديد لا صلة له بما عرفه المسلمون قديماً في موضوع العلاقات الإسلامية اليهودية، وأن الصراع السياسي والعسكري اليوم مع إسرائيل هو صراع من نوع جديد مختلف كلياً، وأنه من العبث محاولة فهمه انطلاقاً من أدبيات الجدل القديمة، منهجاً واستراتيجياً ووسائل.
> هل تقول إن العالم العربي والإسلامي يتلقى تزييف وعي فيما يتعلق باليهود أو إسرائيل؟
- للأسف أجد هذا «العمى التاريخي» متفشياً في كثير مما تلقي به دور النشر العربية. وهو يفسد وعي المواطن العربي وفهمه لليهودية من ناحية، ولإسرائيل من ناحية أخرى. ومثلما فشل المسلمون في القرن التاسع عشر في التفريق بين أوروبا الأولى المسيحية التي عرفوها في القرون الوسطى وأوروبا الثانية: أوروبا الاستعمار في مرحلة الإمبريالية بالمفهوم الاقتصادي للكلمة المغلفة بقشرة دينية، وتعاملوا مع الثانية بمنطق الأولى، فكذلك يفعل غالب العرب اليوم حينما يعتبرون إسرائيل اليوم هي اليهودية القديمة التي حاربوها من خلال مسائل النبوة والنسخ والتحريف وما إلى ذلك.
> إذن ما هي إسرائيل اليوم؟
- إسرائيل اليوم هي نتيجة مسار معقّد للفكر الغربي المسيحي من ناحية، ولتطورات داخلية للجماعات اليهودية الأوروبية بالأساس. بدأت منذ الأنوار الغربية الخارجة من رحم البروتستانتية، ثم من رحم الأنوار اليهودية المعروفة بـ«الهاسكالاه» كحل سياسي ثالث وأخير لفشل الاندماج لأسباب معقدة. ولم تتدخل اليهودية في مسار تشكل الحل الصهيوني إلا بشكل متأخر، لم يتضح جلياً إلا بعد اندماج الصهيونية السياسية بفكر الربِّي أفراهام يتسحاق كوك، فيما عُرفت بـ«الصهيونية الدينية» التي ستدخل الحياة السياسية بقوة منذ السبعينات مع النكسة العربية، لتتحول شيئاً فشيئاً إلى قلب نظام الحكم في إسرائيل اليوم، وهذه الصهيونية لا صلة لها بالعلاقات الإسلامية اليهودية القديمة، ولا بالجدل الديني القديم إلا في حدود ضيقة جداً جداً. وباختصار: إذا كان عليك أن تفهم إسرائيل والصهيونية فالأفضل أن تفهم تاريخ يهود أوروبا والمسيحية أولاً، وليس تاريخ الإسلام.
> أنت ترى أن الجدل الإسلامي اليهودي هو «هامشي» إذا ما قيس بالجدل الإسلامي المسيحي. وأنت ترى أن سرديات الجدل مع المسيحيين كُتبت في عصر القلق الإسلامي من الإمبراطوريات المسيحية وما تمثله من خطر على المسلمين، بينما لم يكن لليهود سلطة تمثل تهديداً، ولذلك كان الجدل معهم هامشياً. هل توضح لنا هذه الفكرة؟
- نعم، كان الجدل الإسلامي اليهودي هامشياً مقارنة بالجدل الإسلامي المسيحي، من جهة عدد النصوص أولاً، ومن جهة عمق الخلافات. ذلك أن الخلافات الإسلامية المسيحية خلافات عقائدية بالأساس، ترجع إلى قضايا الألوهية والتثليث وطبيعة المسيح والفداء والصلب، أو ما عرفت بـ«المسيحولوجيا»، وهي قضايا معقدة تساندها قوى سياسية وإمبراطوريات شكلت مصدر قلق للمسلمين، وصراعاً لقرون عديدة؛ بينما لم تكن لليهود هذه المكانة، وكان الخلاف معهم بالأساس فقهياً في غالب الأحوال، ومرتبطاً أيضاً بقضايا النسخ والتحريف والنبوة، في حدود لا تصل إلى عمق وشدة الخلاف المسيحي الإسلامي. ولم يشكل اليهود بعد أن أنهى الرسول والخلفاء من بعده تأثيرهم السياسي والعسكري في الجزيرة تحدياً؛ ذلك أن النبي أدرك بعد السنة الثانية للهجرة ضرورة إنهاء الوجود السياسي والعسكري ليهود يثرب، وحفظ لهم وضعيتهم العقائدية بأن اعتبرهم أهل كتاب، ووضعيتهم الاجتماعية داخل المدينة الإسلامية بأن اعتُبروا أهل ذمة، ولم يتسببوا في قلاقل للإمبراطورية الإسلامية إلا في فترات قصيرة زمن العباسيين مثلاً، ولم يكن ذلك ذا بال في السير العام للتاريخ الإسلامي إلى حدود 1947.
> لديك بحث بعنوان «نبي الإسلام في مرآة اليهودية»، ألا ترى أن المسلمين ليسوا وحدهم من يرسم صورة مشوهة عن الآخر؟
- يعرف كثيرون الصورة السلبية التي رسمتها المسيحية في القرون الوسطى للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يعرف كثيرون أن اليهودية التقليدية قد نظرت إلى النبي بالصورة نفسها تقريباً، فنسر الكنيس الربي موسى بن ميمون كان يصف النبي بـ«المشوجاع»، وذلك في نصوص «دلالة الحائرين»، وفي «الرسالة إلى أهل اليمن»، وغيرهما، وكان القرقساني أيضاً يصفه بـ«الفسول»، وهي صفات سلبية وقبيحة، وكان هذا هو الحال في مناخ القرون الوسطى. والحقيقة فإنّ الأديان بشكل عام قليلاً ما ترسم صورة إيجابية عن الآخر، وهي في الحقيقة لا تكره الآخر بقدر ما ترسم صورة لنفسها في حقبة ما. ومثلما يقول أدونيس في عبارة شهيرة: «أنت لا تكرهني؛ بل تكره الصورة التي كوَّنتها عني، وهذه الصورة ليست أنا؛ بل أنت».
> ما أهمية دراسة تاريخ الأديان في تجلية الصورة؟
- أهمية تاريخ الأديان هي أنه يحرر هؤلاء المشتغلين بالأديان من هذه المناخات، ومن هذه الروح العدائية التي نحتاجها من أجل فهم حقيقي للآخر. وقد بينتُ في أكثر من محاضرة هذه الصورة التي شكَّلتها اليهودية للإسلام ولنبي الإسلام. وحللتُ من الجهة المقابلة كيف نظر المسلمون إلى أنبياء التوراة خصوصاً، كما تحدث عن هذه النظرة كتاب «الملل والنحل». وقد آن الأوان لكي نخرج من مناخات القرون الوسطى؛ يهوداً ومسلمين ومسيحيين.
- دستور المدينة
> ترجمتَ دراسة المستشرق البريطاني روبرت سيرجنت «العهود مع يهود يثرب وتحريم جوفها». سيرجنت وصف هذه الوثيقة بـ«دستور المدينة»، واستغرب قلة اهتمام الباحثين بها، يقول: «لم يعتنِ بها إلا قلة من المختصّين من المؤرّخين؛ سواء أكانوا من المسلمين أو المستشرقين الغربيين»، فما الذي تؤسسه هذه الوثيقة (العهود)؟ وعلى ماذا تتكأ؟
- هذه الوثيقة مهمة جداً في فهم تشكُّل نشأة الإسلام. ويعود جانب من أهميتها إلى أنها من الوثائق القليلة التي سَلِمتْ من النقد التاريخي العنيف الذي قامت به المدرسة المراجعية الأنجلوسكسونية، غير أن أغلب العرب امتشقوها في سياق جدالي منذ عصر النهضة في مواجهة الغرب، للقول إن الإسلام عرف أول دستور، وأول من تحدث عن حقوق الأقليات والمواطنة...إلخ، وهو أمر فيه نظر، يعرفه المحصلون، وفوَّتوا على أنفسهم فهم جوهر ما سُميت «الصحيفة»، وهو تلخيصها لأسس الرسالة المحمدية. فقد حددت هذه الصحيفة أولاً منزلة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في المدينة، باعتباره حكماً بين كل مكونات المجتمع اليثربي من اليهود والمسلمين وغيرهم، من خلال تحويل نظام التحكيم الجاهلي من نظام اختياري إلى نظام ملزم، يكون الالتجاء إليه قاطعاً وضرورياً، وتكون أحكامه ملزمة لأتباعه ولمن قبل ببنود الصحيفة. والأمر الثاني هو تغيير منزلة يثرب بتحويلها إلى «حرم»، تماماً كما كان وضع مكة، تأسيساً لسِلم اجتماعي ضروري، لترسيخ الدعوة، ووضع حد للفتن المسلحة. فقد كان على وعي بهشاشة التعايش بين الأنصار والمهاجرين، وهو الأمر الذي كشفته بوضوح غزوة بني المصطلق، ثم تلاه تغيير الاسم من يثرب إلى المدينة، في إشارة إلى وجود سلطة مركزية. ويبدو أن مفهوم المدينة كان في ذهن النبي نفياً مطلقاً لمفهوم القرية الذي ارتبط في القرآن بمعانٍ سلبية، لم تشذ عنها سوى مكة (أم القرى)، وقد سميت المدينة أيضاً «أكالة القرى».
أما الأمر الثالث، فهو نشأة مفهوم الأمة، حينما سيتم الحديث عن أمة المسلمين، والأمة الوسط التي أخرجت من صفوفها المنافقين واليهود. وهكذا يبدو أن ارتباط الأمة بالمدينة واضح جداً. فإذا كانت الأمة هي النقيض لمفهوم القبيلة والعشيرة القائمة على رابطة الدم والعرق والنسب، فإنّ المدينة هي النقيض لمفهوم القرية المرتبطة بالبداوة. والنبي باستقراره في المدينة؛ حيث انغلق الوحي، يكون قد ضمن لجماعة المؤمنين تواصلاً أساسياً بين هذه المفاهيم وعمق الرسالة المحمدية والكتاب.
ولا شك أن التحول من القرية إلى المدينة في صلب التفكير التاريخي هو دخول للأمة في التاريخ، وهو دخول سيكتمل بولادة مفهوم جديد كان غائماً في البداية، هو «الجهاد» الذي يدخل الأمة في تاريخ الجديد هو تاريخ الخلاص أو التاريخ المقدس، بالمعنى الذي يعطيه تاريخه الأديان لهذا المفهوم.
> تقول أيضاً إن الإسلام «مدين» في بداية نشأته إلى المكون اليهودي؛ لكون القرآن يتحدث في أجزاء واسعة من نصوصه عن اليهود والعلاقة بهم. أين وجه الفضل الذي تركته اليهودية على الإسلام؟
- وجه الفضل الأساسي هو تمكين الإسلام من الانفصال عن المكوّن اليهودي، بعد تمثّله وتشرّبه. فالإسلام من وجهة نظر هيغيلية هو التوليفة التي جاءت بعد الأطروحة اليهودية ونقيضها المسيحيّ، وهذا أمر يجب أن يهضمه المسلمون جيّداً. وقد وضحتُ هذا الانفصال رمزياً من خلال ثلاث مسائل: أولها حادثة عمر بن الخطاب، عندما غضب الرسول من فرحه بجوامع من التوراة التي جاء بها من بيت مدارس اليهود بيثرب، قائلاً له: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتِ بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. أنا حظُّكُم من الأنبياء، وأنتم حظِّي من الأمم»، ثم نصّ الصحيفة التي اعتبرت اليهود في البداية أمة مع المؤمنين: «لليهود دينهم وللمسلمين دينهم»، وهذه الصحيفة لم تعمر طويلاً، وبدأ الرسول في إخراجهم من مدينته أولاً، ومن كتابه ثانياً. ثم حديث: «إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»، بعد أن كان الأمر: «حدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». ولا شك أن هذا الانفصال عن التقاليد المسيهودية واليهودية بالذات، أمر معروف في تاريخ الأديان، ينبغي الاهتمام به والرجوع إليه.
> على عكس ما يعتقده الباحثون، أنت ترى أن «الإسلام من صميم التيار المسيحي– اليهودي» ووريثه الشرعي، وتطلق عليه وصف «المسيهودي»، فهل تفسر لنا هذه الفكرة؟ أليس الشائع هو أن المسيحية هي امتداد للتراث اليهودي؟
- في الحقيقة، لا يتحدث القرآن عن المسيحية؛ بل عن النصرانية أساساً، والمسيحية البولسية غائبة تقريباً كلياً عن المادة القرآنية، مقابل حضور لما يعرف بالتعاليم المسيهودية التي نقترحها لترجمة «jewish christianity»، وهي جماع حركات عاشت بعد قرن ونصف قرن تقريباً من ظهور المسيح، وتشكلت من جماعات يهودية انسلخت عن اليهودية التقليدية من جهة قبولها يسوع مسيحاً، وبقائها على التعاليم الهلاخية القديمة، وعرفت أوجها مع ما تعرف بكنيسة أورشليم، وستبدأ هذه الجماعات في الاندثار منذ أن طاردتها المسيحية البولسية واليهودية التقليدية، سواء بسواء، لأسباب يعرفها المحصلون لتاريخ هذه الجماعات، وهي عند تفرقها خوفاً من المطاردة والتعذيب، لجأ بعضها إلى الجزيرة العربية، وكان لها تأثير مهم في تشكل الحياة الدينية في الجزيرة قبل ظهور الإسلام وبعده بقليل. وظل أثر هذه الجماعات موجوداً حتى القرن الرابع للهجرة، تشهد بذلك نصوص القاضي عبد الجبار مثلاً في «تثبيت دلائل النبوة». وعلى كلٍّ، فإنّ هذا المنحى في البحث لا يستقيم إلا حينما ننخرط في مجال معيّن من الدراسة، هو تاريخ الأديان المقارن، وله ضوابط وشروط يعرفها المحصلون لهذا العلم.