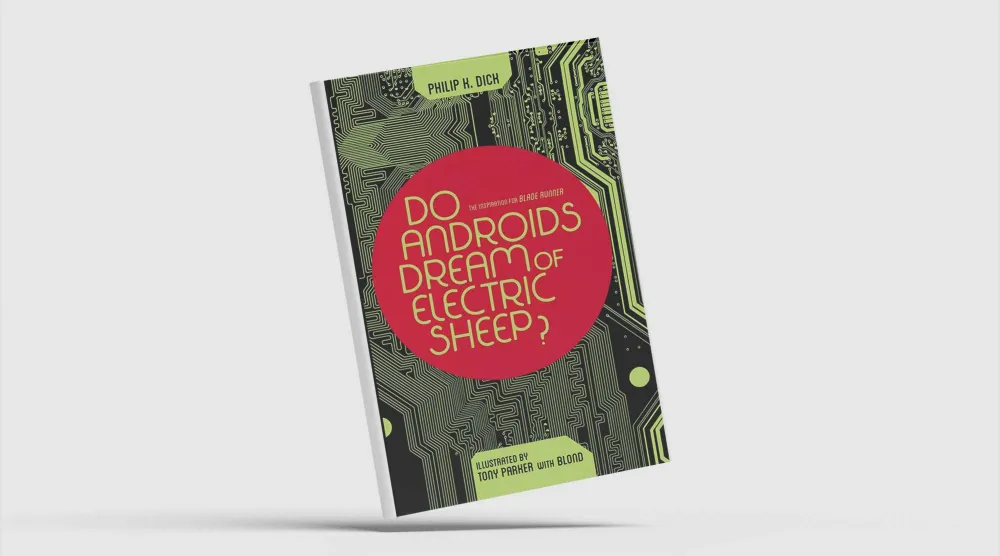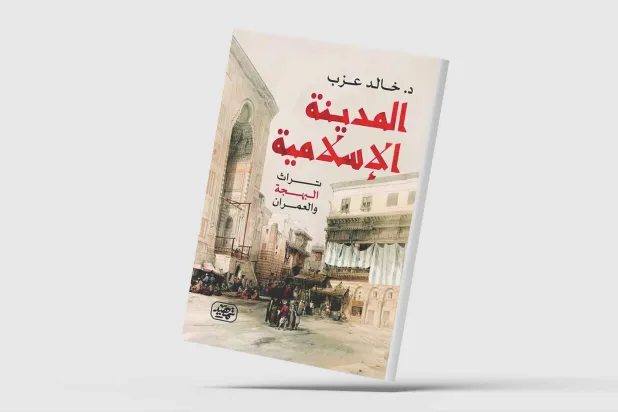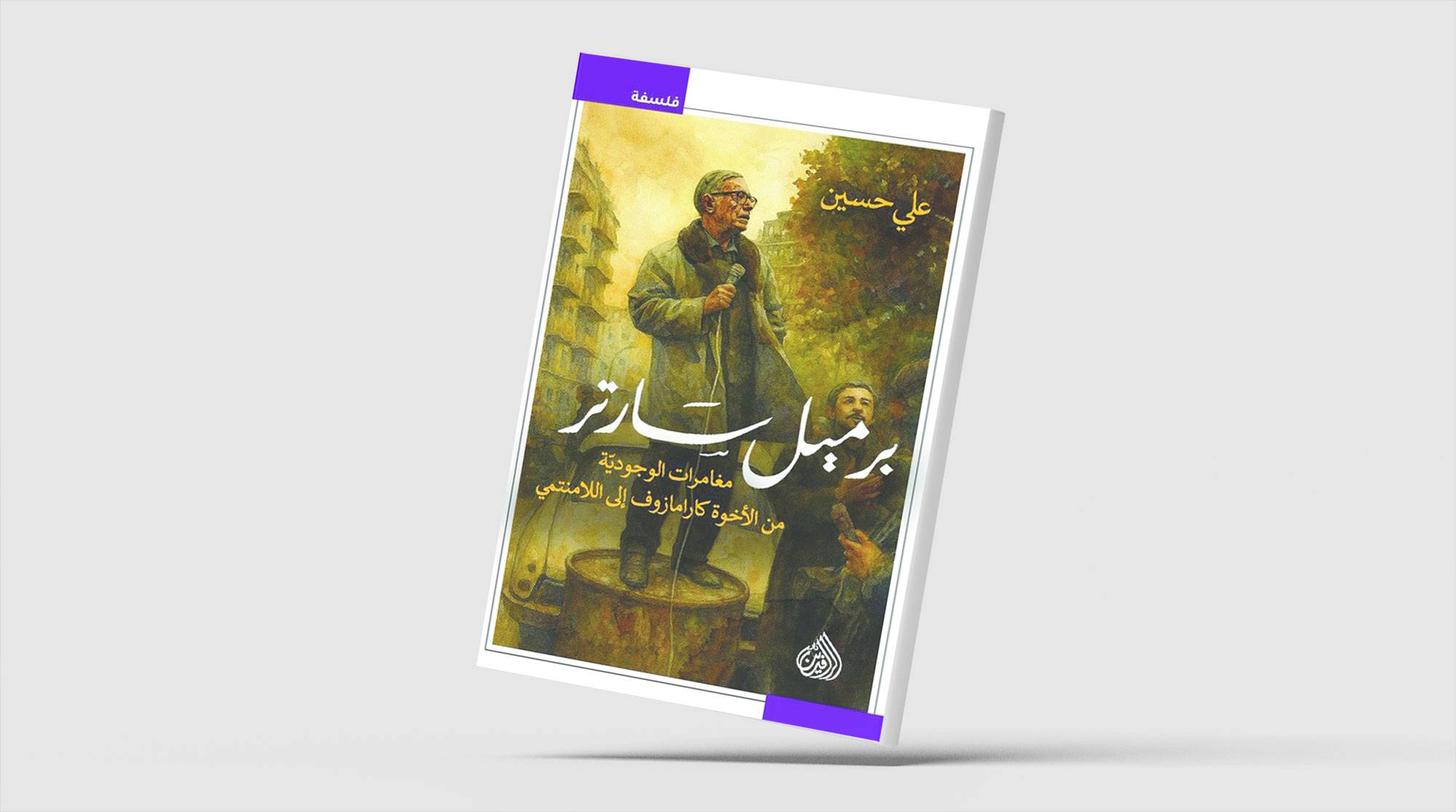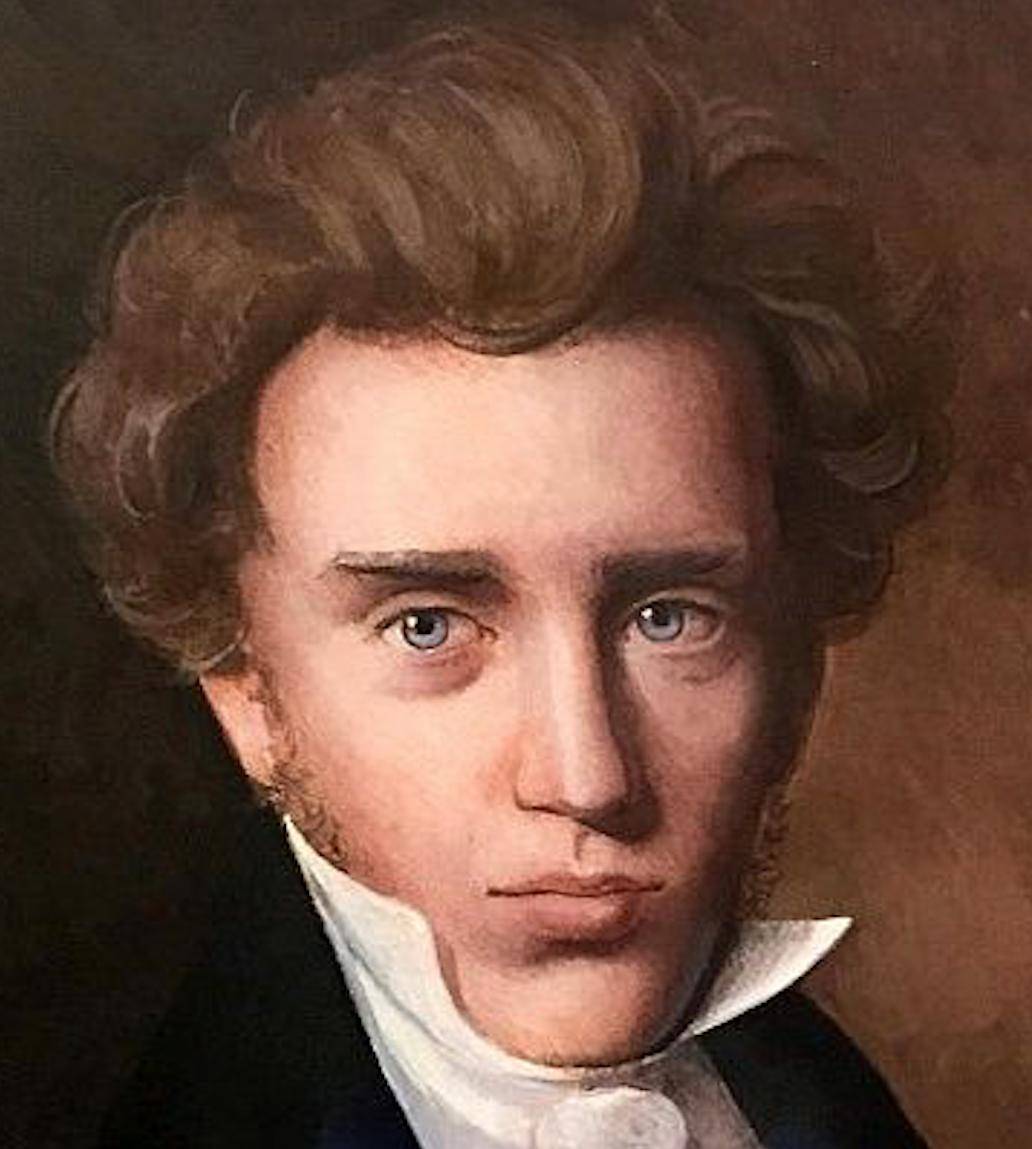من أهم صفات المؤمنين بالأديان السماوية (والإسلام من بينها) أنهم يؤمنون بعالم الغيب كما يؤمنون بعالم الشهادة. وقد ورد في بداية القرآن الكريم في سورة البقرة أن من صفات المتقين أنهم (يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) – البقرة: 3 - فقدم الإيمان بالغيب على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة...
لذا فإن مفهوم الغيب وأسراره والتعامل معه منذ بداية البشرية له أهمية قصوى في حياة الإنسان، أو على الأقل المؤمن، وفي دينه وعقيدته. وقد أدرك د. حسين رشيد الطائي هذه الأهمية فخصص له كتاباً تحت عنوان «مفهوم الغيب وأقسامه في القرآن الكريم»، سابراً فيه أغوار الموضوع تاريخياً ولغوياً وعقدياً، ومن حيث العلاقة بين الغيب والمفاهيم المتعلقة به مثل النبأ والخبر، والاطلاع والإظهار.
وركز المؤلف على أهمية المقارنة بين الغيب وبين الأسطورة والخرافة والفروق بينها. ففي حين أن الغيب منشؤه السماء يكون منشأ الأسطورة الأرض. وبينما الإيمان بالغيب يوافق الاستدلالات العقلية وقائم على العلم والإيمان، فإن الإيمان بالأسطورة يخالف تلك الاستدلالات ومرده الجهل. ويقول الباحث إن الإيمان بالغيب له أهداف سامية توجه الإنسان نحو الرقي والتمسك بالفضيلة والمعروف، لكن هذه الأهداف ليست من بين شروط الإيمان بالأسطورة والخرافة.
وبعد أن ينتهي الباحث من سرد هذه المقارنات والجوانب المهمة في مفهوم الغيب والإيمان به، يتناول في الباب الثاني من الكتاب أقسام الغيب، حسبما جاء في التنزيل الحكيم. فيقسم المفهوم إلى الغيب المطلق والغيب النسبي، ويدرج تحت القسم الأول غيب الإحاطة وغيب الإبداء والكتم والإسرار والعلن. ثم يفصل لكل من هذه الأقسام بذكر الآيات التي وردت في القرآن الكريم ويشرح المقصود من المفاهيم التي تتعلق بهذه الأقسام كالسر والعلن والإبداء والكتم والجهر والإكنان والإخفاء والنجوى، وكذلك الأسباب التي أدت إلى تقديم بعض هذه المفاهيم على البعض الآخر في الآيات القرآنية. ويدرج تحت بند الغيب النسبي غيب الأخبار الماضية وغيب الاطلاع وغيب الإظهار.
ويسهب الباحث في الموضوع بالحديث عن الأمور التي تندرج تحت مفهوم الغيب سواء في الماضي كأمور بدء الخلق والخليقة وسيرة وتاريخ الأمم البائدة والمنقرضة، أو في المستقبل مثل العلم بكنه ما في الأرحام وعلم الساعة ويوم القيامة ومآل الأرض والسماوات والخلائق جميعها وحتى مآل الروح أثناء قيام الساعة.
ليس من المبالغة لو قلنا إن الباحث بذل كثيراً من الجهد في الإلمام بهذا الموضوع المهم والإحاطة بجل - إن لم نقل بكل - جوانبه في أكثر من 200 صفحة من الحجم الكبير، مستنداً في جهوده إلى أكثر من 80 مرجعاً ومصدراً من الكتب التي تناولت موضوع الغيب أو جزءاً منه. صدر الكتاب عن مكتبة الكوثر في العاصمة العراقية بغداد.
الغيب وما يفرّقه عن الأسطورة
https://aawsat.com/home/article/3493201/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%91%D9%82%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9



الغيب وما يفرّقه عن الأسطورة
حسين الطائي يكتب عن مفهومه وأقسامه في الكتاب العزيز

- لندن: مسعود لاوه
- لندن: مسعود لاوه

الغيب وما يفرّقه عن الأسطورة

مواضيع
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة