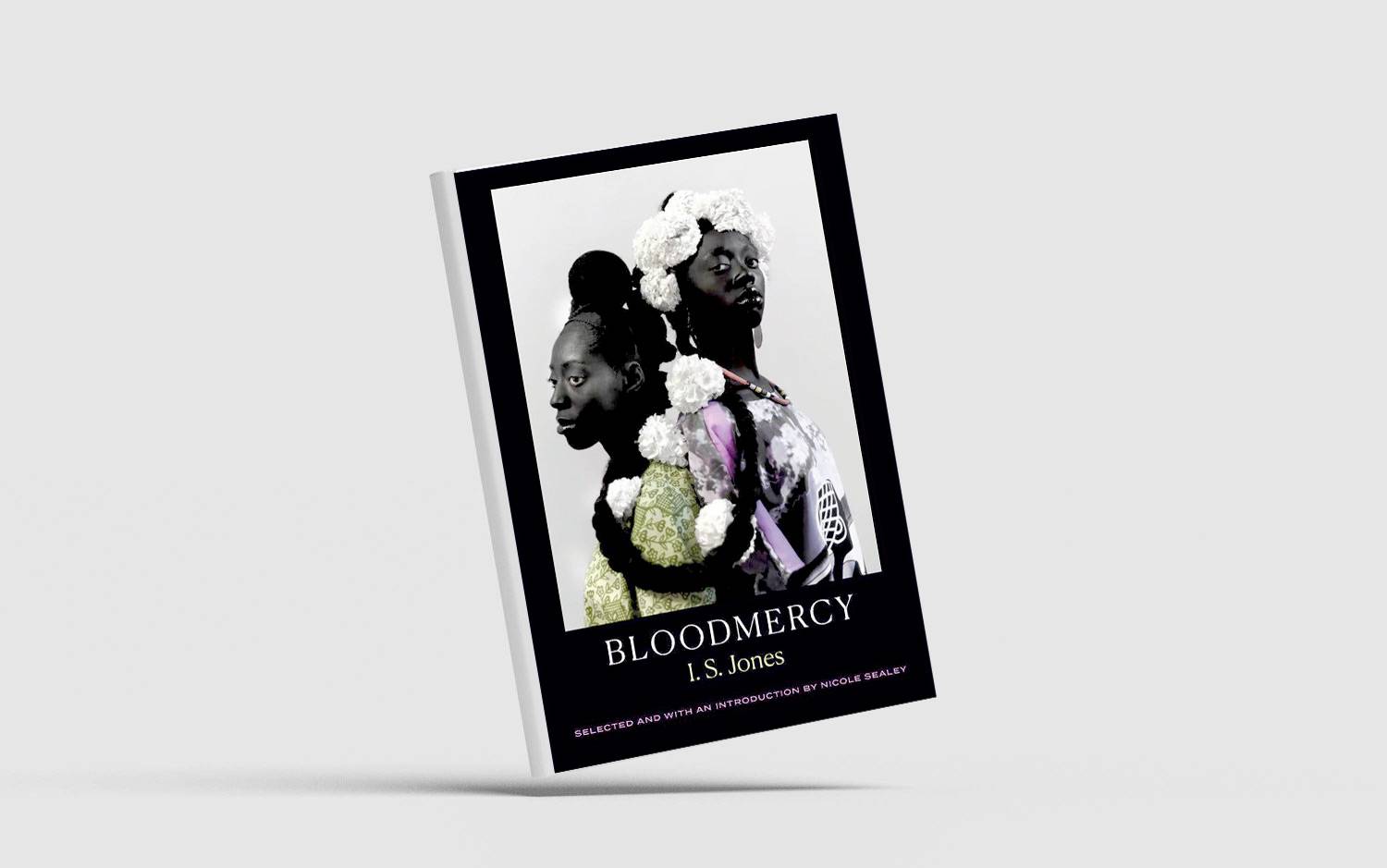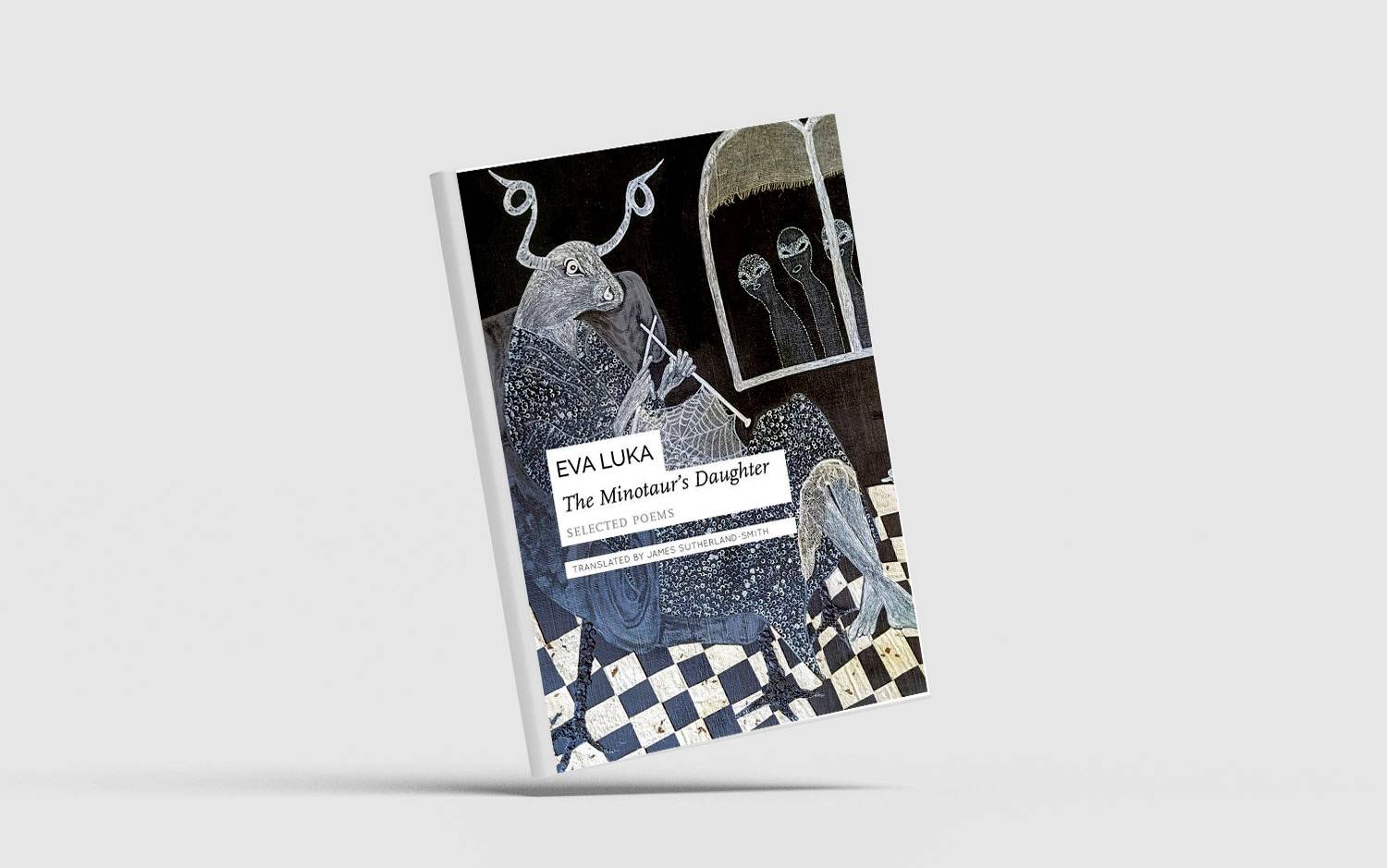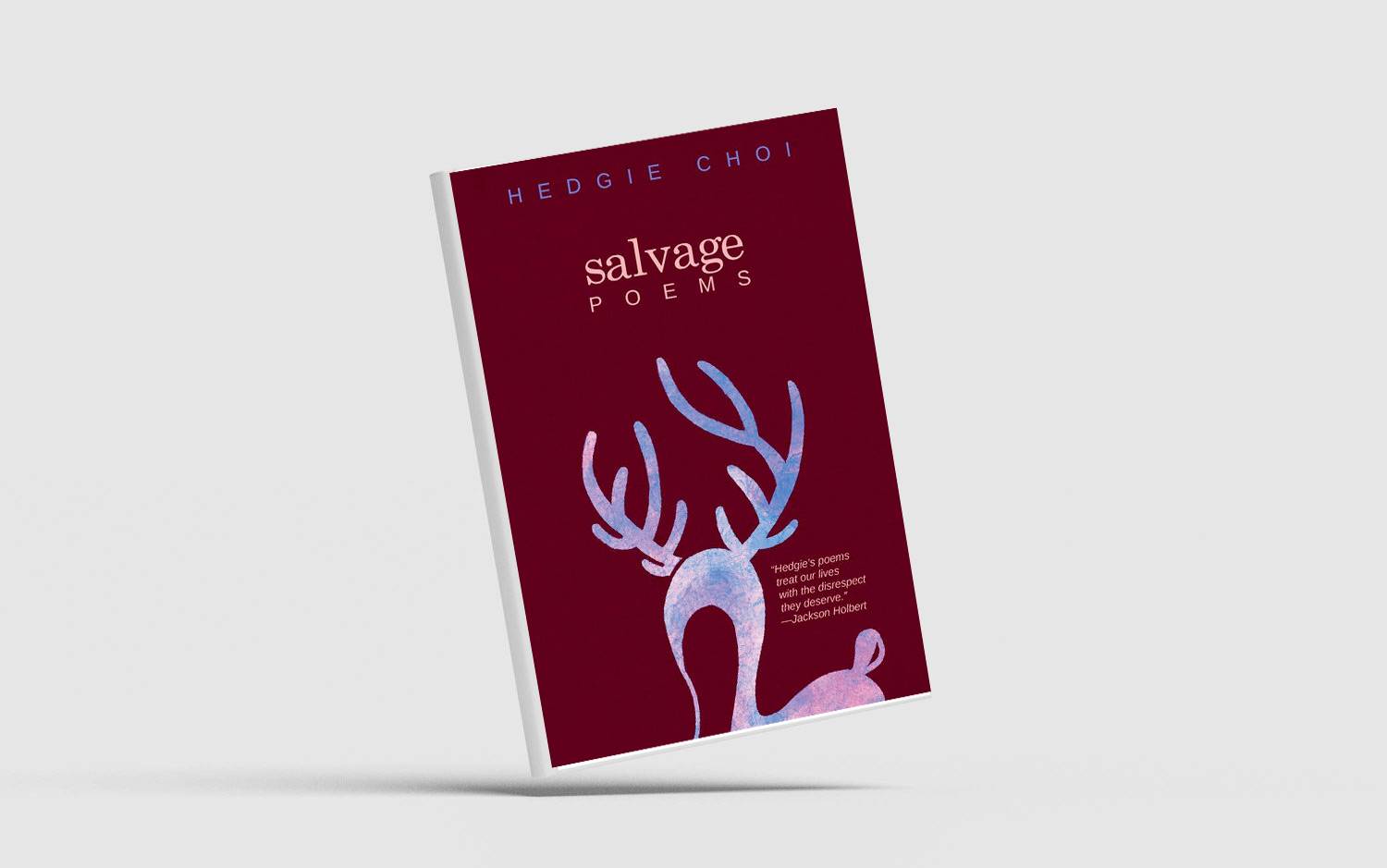يرى كثيرون أنه لا يمكن الوثوق بآراء الشعراء حين يكون في ميدان السياسة، منطلقين من فكرة أنَّ الشعراء انفعاليون آنيون، يتفاعلون مع الحدث بطريقة غير عقلانية، وبالنتيجة لا يمكن التعويل على آرائهم في السياسة. وبصراحة، هذه الفكرة من الممكن أنْ تفتح باباً للحديث عن الشعراء السياسيين، وأقصد بذلك الشعراء الحقيقيين الذي عُرفوا ووسِموا بأنهم شعراء مؤثرون في خريطة الشعر، ولكنهم في الوقت نفسه عملوا في السياسة، فمنهم من نجح ومنهم من أخفق.
إنَّ خريطة الشعراء السياسيين خريطة طويلة عريضة، ولا يمكن رسم حدود واضحة تفك هذا الاشتباك، فمن امرئ القيس الذي فقد ملك أبيه بسبب الشعر إلى آخر شاعر معاصر معنا دخل ميدان السياسة، وله رأي في العملية السياسية، فما بينهما، عددٌ كبيرٌ من الشعراء الذين التصقت السياسة بمشروعهم الثقافي، ولم تنفك تسير بخطٍ موازٍ مع الشعر. والشعراء السياسيون هم غير الشعراء الذين كتبوا في السياسة، فلا تكاد تخلو تجربة شاعر من الشعراء العرب من رأي له في السياسة، من خلال نصوصه واحتجاجه، على ما دار أو ما يدور حوله، وهذا الصنف هو غير الصنف الذي أبحث عنهم، إنَّما هؤلاء مشتركون بالهموم العامة للناس، سابقاً وحالياً.
الشعراء السياسيون -كما قلنا- ابتداء من امرئ القيس الذي لهث وراء ملك أبيه، ولكن الشعر واللهاث خلف النساء، سواء في الواقع أو في النصوص، أعميا عينه عن أنْ يحافظ على ملك أبيه، ويضيع بشكل نهائي، حيث يقول:
بكى صاحبي لمَّا رأى الدرب دونه
وأدرك أنَّا لاحقان بقيصرا
فقلتُ له لا تبكِ عينُك إنَّما
نحاول ملكاً أو نموت فنُعذرا
وفي هذين البيتين إشارة للملك الذي يحاوله امرؤ القيس، والذي ضاع منه، ويبدو أيضاً أن التحالفات منذ زمن طويل بالنسبة لنا، نحن العرب، والحفاظ على ملكنا، لا تتم إلا برضا القيصر عنا.
ومن امرئ القيس إلى بعض الخلفاء الذين عُرفوا بأنَّهم شعراء، أمثال يزيد بن معاوية الذي يروي له ابن خلكان في وفيَّات الأعيان بعضاً من عيون شعره، ومنها:
تقول نساء الحي: تطمعُ أنْ ترى
محاسن ليلى؟ مت بداء المطامعِ
وكيف ترى ليلى بعينٍ ترى بها
سواها؟ وما طهرَّتها بالمدامعِ
وكذلك الوليد بن عبد الملك الذي يقول:
وإنْ لم أكن فيكم خطيباً فإنَّني
إليكم إذا جدَّ الوغى لخطيبُ
ولكنهم خلفاء أشداء، لم يكن الشعر هاجسهم الرئيس، إنما الملك والخلافة هي التي تسوسهم، بخلاف امرئ القيس الذي خلق للشعر، وليس للملك، لذلك حافظوا على ملكهم بقوة، وهذا يُحيلنا إلى بعض الخلفاء الشعراء من العباسيين الذين تولوا الحكم، وفقدوه لأيام وأسابيع، أو بالكاد سنة واحدة، مثل «ابن المعتز» الذي عُرف بشعره، وبكتابه المهم في البديع، كما أن الأندلس فتحت شهية الخلفاء للشعر كثيراً، فمثلاً «المعتمد بن عبَّاد» الخليفة الأندلسي الذي حكم إشبيلية وقرطبة، واتسع سلطانه حتى وصل إلى مرسية، وله ديوان شعر طبع في القاهرة عام 1951، حيث جمعه «أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد»، يقول في بعضٍ من قصائده:
ولقد شربتُ الراح يسطعُ نورها
والليل قد مدَّ الظلام رداءَ
حتى تبدَّى البدر في جوزائه
ملكاً تناهى بهجة وبهاء
إنَّ معظم الخلفاء الذين كتبوا الشعر كان فعلهم ذلك من باب الإلمام بكامل المعارف التي تأدبوا عليها، حيث يقف الشعر في المقام الأول من تلك المعارف، ولكن جل كتابات الخلفاء هي من الشعر الخالي من روح الشاعر المتمرد المجنون، وهو أقرب إلى شعر العلماء أو النظم بشكل عام، لذلك لم تحفظ ذاكرة الشعر على طول رحلة الشعر العربي إلَّا نادراً من نصوص بعض الذين حكموا أو عملوا في السياسة، حتى إن هناك طرائف تُروى عن أبي نؤاس بأنَّه في أحد الأيام، وفي مجلس الخليفة «المأمون»، وهو من أكثر الخلفاء ثقافة ووعياً، أنشد المأمون قصيدة له في مجلسه، ومن ثم طلب رأي أبي نؤاس بها، فأجابه أبو نؤاس بأنها خالية من البلاغة، فغضب المأمون وأمر بحبسه في الإسطبل مع الحمير والبغال، وظل أبو نؤاس شهراً في ذلك المكان، ولمَّا أفرج عنه ذهب إلى مجلس الخليفة المأمون ثانية، وعندها أنشد المأمون قصيدة جديدة له أيضاً، ولمَّا انتهى منها قام أبو نؤاس، فنادى عليه المأمون: إلى أين يا أبا نؤاس، فقال له: إلى الإسطبل، يا أمير المؤمنين.
وبهذا، فإن تاريخنا العربي، تاريخ الحكم والسياسة والشعر، هو تاريخٌ ملتبسٌ، بحيث وقف الدين في بدايته موقفاً حاداً من الشعر، وكأنَّ الشعر مصدرٌ للقلق على الزعامة، بوصف الشاعر متصدياً معروفاً ناطقاً باسم القبيلة، وبهذا فهو في الواجهة التي تُعدُّ موقفاً ثقافياً يُحاصِر في بعض المرات المواقفَ السياسية، ومن تلك اللحظة فالصراع قائمٌ بين الثقافي والسياسي، ونادراً ما اجتمعا بشخصٍ واحد، وحين يجتمعان، فإنَّ الصراع بين السياسي والثقافي، والشعري تحديداً، لن يكفَّ أبداً، وحين تنتصر القصيدة على الموقف السياسي، سيسقط ذلك الحاكم في العادة، كامرئ القيس وابن المعتز، اللذين اتخذا من الشعر طريقة سلوك وحياة، لذلك فإنَّ السياسي الذي بداخلهما انهزم أمام الثقافي، ولكن الثمن هو فقدان الملك.
إنَّ صراع السلطة والشعر تجلَّى في شخصية «المتنبي» تجلياً كبيراً، وهو الشاعر العظيم الذي لم يستطع الشعر أنْ يملأ روحه، فقد بقي لاهثاً وراء السلطة والملك، فهو العظيم الذي ينتظر من كافور ولاية ليكون عليها أشبه بالمحافظ أو القائم مقام، حيث يقول:
أبا المسك هل في الكأس فضلٌ أنالُه؟
فإنَّي أغنَّي منذ دهرٍ وتشربُ
فيما نرى موقفاً آخر للشريف الرضي الذي يمتدح أحد الخلفاء العباسيين، ولكنه يقول له لا فرق بيني وبينك بصفتهما أبناء عمومة:
عطفاً أمير المؤمنين فإنَّنا
في دوحة العلياء لا نتفرَّقُ
ما بيننا يومَ الفخار تفاوتٌ
أبداً كلانا في المعالي معرقُ
إلَّا الخلافة ميّزتك فإنَّني
أنا عاطلٌ عنها وأنت مطوَّقُ.
وحين نصل للعصر الحديث، نجد على سبيل المثال «الجواهري» الذي يصف في «مذكراته» لحظة الحنق والغضب التي وصل لها في يوم من الأيام لأنَّ الحكومة استوزرت «محمد رضا الشبيبي» مرة، ومرة «علي الشرقي»، وهما من أقاربه، ولم تستوزره، فيقول: «كنتُ أكاد أمزَّقُ عباءتي لأنَّني لم أستوزر مثلهما، وإلا فبماذا يفضلانني»، فيما يورد الدكتور «محمد حسين الأعرجي» رسالة كتبها الجواهري في عام 1980 إلى أحد أصدقائه من زعماء المعارضة العراقية، يقول في بعض منها: «المصيبة، يا حبيبي، أن هناك من لا يتذكرني إلَّا عندما يحتاج أنْ أغنَّيه، حتى لكأنَّي لستُ شيئاً غير ذلك، وحتَّى لكأنَّ كل ذلك التاريخ وكل تلك الجولات وكل تلك التضحيات لا تستحق أكثر من أنْ تُسمَّى شعراً، وصاحبها شاعراً، وعلى هذه المقاييس المضحكة المبكية معاً كان الواقع المر يطبق علي حين تُقتسمُ الحصص، ولك أنْ تتذكر الشواهد عليها». والغريب أنَّ الجواهري لم يتغير إزاء طموحه للسلطة، فمنذ أن كان عمره في الثلاثينيات، كان غاضباً لأنَّه لم يستوزر، وحتى حين وصل عمره إلى الثمانينيات، كان غاضباً أيضاً لأنَّه لم يُشمل بتوزيع الحصص، والأغرب من ذلك أنَّه كان منزعجاً من صفة الشاعر فقط، فهي لا تُشبع غرورَه -على ما يبدو- رغم أنَّه ملأ الدنيا المعاصرة، لكنَّه بقي طامحاً لأن يكون له مستقبلٌ سياسي.
فالجواهري الشاعر لم يكتف بالشعر، إنما يطمح لمكانٍ سياسي، فيما يتخذ «صدام حسين» موقفاً آخر لا يقل غرابة عن موقف «الجواهري»، ولكنه في اتجاه مغاير تماماً، ذلك أن أحد الشعراء العراقيين يروي لي أنه جاء مع أحد وفود المحافظات لزيارة صدام حسين.
وبعد أن أنهى الوفد طلباته، انصرفوا جميعاً، لكن صدام حسين طلب من الشاعر أن يبقى. ويذكر لي ذلك الشاعر أنه بقي في القصر الجمهوري ما يقارب الثلاثة أيام، في كل ليلة يلتقي به صدام حسين، ويعرض عليه قصائده، حيث يقول لي صديقي الشاعر: بات الخوف يهيمن عليّ، فكيف لي أن أقول لصدام حسين إنك تكسر في الوزن. ولكنه كان يقول له: «سيدي، ثمة مشكلات في العروض»، فيقول له صدام حسين: نعم، أنا الآن أقرأ في ميزان الذهب، وأحاول أن أتعلم العروض. وقد بقي صديقي الشاعر على هذه الحال ثلاثة أيام، في كل ليلة يعرض صدام حسين عليه قصائده، والشاعر يبدي ملاحظاته، إلى أن دخلت أميركا إلى أفغانستان، عندها تغير جدول الرئيس، وعاد صديقي إلى محافظته؛ موقفان غريبان بصراحة، حاكم مثل صدام حسين يملك كل شيء، لكنه يطمح في أنْ يكون شاعراً، والجواهري الشاعر الذي يملك قيادة الشعر على مدى قرن من الزمن، يطمح أن يكون وزيراً أو مسؤولاً في الحكومات.
لقد انخرط معظم الشعراء العراقيين المعاصرين، وخصوصاً بعد الخمسينيات في الحركات السياسية، وانتظموا مع الأحزاب في ذلك الوقت، وكان الحزب الشيوعي من أكثر الأحزاب التي انخرط في صفوفه الشعراء، ولكن لم يصلوا إلى مصدر القرار المؤثر في حركة البلد، إلا أنهم حصلوا على الدعم الإعلامي من ماكينة الحزب في ذلك الوقت، أمثال عبد الوهاب البياتي وسعدي يوسف وآخرين، فيما اختط بعض الشعراء خط القومية العربية، وحزب البعث على وجه التحديد، ليكونوا جزءاً من ماكينته العقائدية، ومن خلاله تسلموا مناصب في إدارة الدولة، بعد سيطرة حزب البعث على مقاليد الحكم في العراق بعد 1968، وظهرت طبقة من الشعراء الذين خرجوا من حاضنة البعث، ليستلموا مناصب كبرى في إدارة الدولة، أمثال الشاعر شاذل طاقة الذي كان وزيراً للخارجية، والشاعر صالح مهدي عماش الذي كان وزيراً للداخلية ونائباً لرئيس الجمهورية، والذي كانت له سجالات شعرية معروفة مع الجواهري، وكذلك الشاعر شفيق الكمالي الذي أصبح وزيراً للثقافة، وحميد سعيد وسامي مهدي وعبد الأمير معلة الذين أصبحوا وكلاء لوزارة الثقافة على مدى سنوات طويلة من حكم حزب البعث، كما أن هناك قيادات أخرى في مفاصل حزب البعث، أمثال الشاعر كمال الحديثي وآخرين.
ولنا بـ«محمود درويش» مثالٌ كبيرٌ على ذلك، فهو من حرر «وثيقة استقلال فلسطين» التي كُتبت وأعلِنت في الجزائر عام 1987، ولكنَّه عاد واختلف مع «ياسر عرفات» بعد اتفاقية «أوسلو» التي وصفها «درويش» بأنَّها خيبة أمل، والتي على أثرها رفض درويش تولي منصب وزير الثقافة.
الثقافي والسياسي نادراً ما اجتمعا في شخصٍ واحد
من امرئ القيس إلى محمود درويش


الثقافي والسياسي نادراً ما اجتمعا في شخصٍ واحد

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة