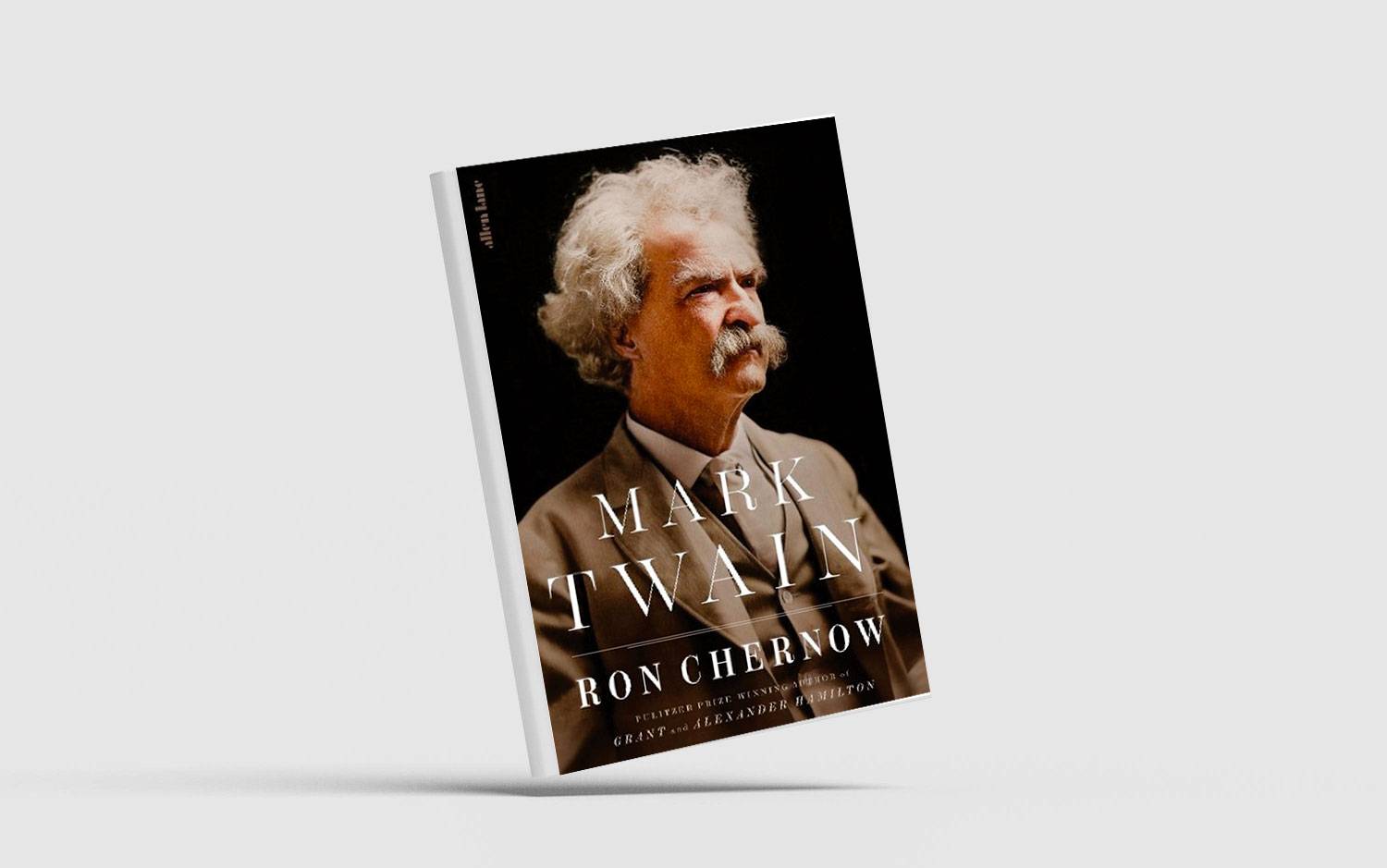يمثل المفكر الاجتماعي الألماني ماكس فيبر (Weber)، واحداً من أهم رواد المدرسة الألمانية والعالمية في علم الاجتماع، بعد تأسيسه على أيدي إميل دركهايم وأوجست كومت، من عدة حقب قبله. ورغم تعدد نظرياته، إلا أن واحدة من أهمها على الإطلاق كان في مجال علم الاجتماع الديني، أي دور الدين في التطور، أو في التخلف الاجتماعي والاقتصادي، وهنا المقصود ليس الدين بالمفهوم العقائدي أو التفسيري. وكان من أهم أعماله على الإطلاق كتابه «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» الصادر في 1905، فكانت رسالته الأساسية هي أن حركة الإصلاح الديني (البروتستانتية) برؤيتها ورسائلها الجديدة، بعيداً عن الكاثوليكية وسيطرة الكنيسة بتعاليمها في أوروبا على مدار قرون ممتدة، ساهمت في وضع اللبنات الأساسية لإنجاح التجربة الرأسمالية في المناطق التي انتشرت فيها لأسباب تتعلق بتفسيراتها للكتاب المقدس والمخالفة للكاثوليكية، خصوصاً ما يتعلق منها بأخلاقيات العمل والثراء.
وقد انطلق فيبر من فرضية واقعية، وهي أن الدول والمقاطعات البروتستانتية كانت أكثر المناطق في القارة الأوروبية رأسماليةً ونجاحاً، وقد برر ذلك باتفاق الفرق البروتستانتية جميعها على رفض التفسير الكاثوليكي لآية النص المقدس «أن يدخل الجمل في ثَقْب الإبرة أيسرُ من أن يدخل الغني ملكوت الله»، حيث اتفقت الفرق على أن المقصود منها ليس الثراء في حد ذاته، ولكن «الجشع» المتولد عنه أو الغرور أو البخل، وهو ما فتح المجال أمام مفهوم العمل لإصابة الثراء من دون أي قيود.
لقد كان دور الراهب الإصلاحي مارتن لوثر، جوهرياً في توجيه دفة الرؤية الجديدة، ليس فقط لأنه فتح المجال أمام فرص الثراء، وشجعه، ولكن أيضاً لأنه أضفى لمفهوم الفردية بُعداً جديداً كان من نتائجه توجيه الدفة نحو الاهتمام بالفرد في الدنيا، بعيداً عن سيطرة أو وساطة الكنيسة الكاثوليكية، فمنح للفرد قيمة أكبر مقابل، ليس فقط الدعوة نحو الفكر الجماعي في الكاثوليكية، ولكن أيضاً نحو الحرية الفردية غير المقيدة إلا بتقوى الله ومراعاة تعاليمه دون رقيب، أو تسلط من قبل مؤسسة دينية، وقد أدت هذه الفردية لظهور مفهوم جديد نحو العمل، وأهميته، باعتباره جزءاً من رسالة الإنسان على الأرض، وما يستتبعه من ثراء بطبيعة الحال طالما أنه لا يتعارض مع التعاليم الإلهية.
وفي الفترة الزمنية نفسها، ظهر فريق جون كالفن، مؤسس الحركة «الكالفينية»، التي دفعت في الاتجاه نفسه، ولكن بوسيلة أخرى. ونظراً لإقرارها مفهوم «التسيير»، أي أن الإنسان مسيرٌ، لأن الله سبحانه وتعالي قد اصطفى بالفعل منذ البداية عباده الذين سيدخلون الجنة، ولكنهم لا يعرفون ذلك، فبالتالي يكون الثراء، في حد ذاته، إشارة إلهية بنعمته على العبد، ومن ثم يزيد فرصه في النجاة في الآخرة. وبهذا المفهوم قُضي على الربط بين الثراء والخطيئة، وذلك شريطة التقوى، وأن يُستخدم الثراء في صنع الخير، وهكذا أصبح توليد الثروة جزءاً مهماً من المعتقد، وهو نفس ما دعت إليه الكنائس البروتستانتية برؤى مختلفة. وقد أدى ذلك لتحول مفهوم العمل من مجرد وسيلة للحياة إلى حافز للثراء لإبراز رضاء المولى سبحانه على الفرد، وهو ما خلق مفهوم «أخلاقيات العمل» التي وردت في عنوان كتابه، وأدت إلى النجاح النسبي المقارن للتجربة الرأسمالية في المقاطعات البروتستانتية.
كان فيبر بطبيعة الحال على نقيض الفكر اليساري البازغ في أوروبا، فعارض فكر كارل ماركس، لا سيما وصفه للدين بأنه أفيون الشعوب، يُستخدم من أجل إخضاع الطبقات المختلفة لمصلحة الطبقة الغنية والحاكمة في الأطر، سواء الرأسمالية أو غيرها. وأياً كان هذا الخلاف، فقد أكد فيبر أن أخلاقيات العمل، وفقاً لكل الأديان، كانت من العوامل الحاسمة في تطور المجتمعات، ولكننا لا يجب إغفال رؤيته أن كثيراً من الأديان الأخرى، منها الإسلام، لم تفرز نتائج البروتستانتية نفسها، وذلك بالنظر إلى مستوى النمو في الدول الإسلامية في مطلع القرن الماضي، والتقدير هنا أن فيبر تجاهل أو لم يتعمق في أساسيات الدين الحنيف، ولكنه أخذه بالرؤية الإجمالية لأوضاع شعوبه، فمن أسباب التخلف وعدم انتشار الرأسمالية والتقدم في العالم الإسلامي آنذاك كان الحكم العثماني لقرون ضحلة ممتدة، إضافة إلى ما تلاه من حركات استعمار، إضافة إلى فساد النخب السياسية المرتبطة بالاثنين، وذلك إضافة لجملة من الأسباب الأخرى، التي لا يمكن إرجاعها للإسلام.
وهنا يكون التعميم الذي يشمل الإسلام في حاجة لمراجعة نقدية، فنحن أمة «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ»، وقوله تعالى «المال والبنون زينة الحياة الدنيا»، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه»، ولكن المشكلة في كثير من الأحيان ترتكز على نظرة الباحث للإسلام، ومدى عمق معرفته به، لتقييم دوره في المجتمع، فضلاً عن خطورة الخلط بين الإسلام وتاريخ المسلمين، ولهذا حديث آخر، ولكن يبدو أن الظواهر الاجتماعية صارت لما فُسرت له أو به... فرفقاً بالإسلام.
11:8 دقيقه
ماكس فيبر و«ثقافة العمل» في الأديان
https://aawsat.com/home/article/2301796/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B1-%D9%88%C2%AB%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86



ماكس فيبر و«ثقافة العمل» في الأديان

ماكس فيبر

ماكس فيبر و«ثقافة العمل» في الأديان

ماكس فيبر
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة